الف) علوم پایه در تحصیلات طلبگی
گام اول: ضرورت اطّلاع عمومی
[شاید بهصورت کلی بتوانیم بگوییم کسی که میخواهد در سطوح مختلف عالم دینی باشد، اگر بخواهد هم در اعتقادات دینی و هم در احکام دینی جامع همه اینها باشد، ضروری ترین چیزی که برای او هست، اطلاع او بر معلومات عمومی آن زمان است. یعنی بداند که بالای هفتاد درصد و هشتاد در صد مردم آن زمان در ذهنشان چه چیزی است. از باورهای علمیای که دارند مطلع باشد، ولو خود او قاطع باشد که غلط است. اما باید بداند که در ذهن آنها چیست؟ هر زمانی نسبت به ارتباطات آنها و مطالب علمی و کشفیات علمی که بوده، تراز معلومات عمومی تفاوت میکند. یعنی الآن در کلاسهای سوم و چهارم دبستانهای ما معلم مطالبی را میگوید که در یک زمانی در تخصصی ترین کلاسهای ریاضی و نوابغ ریاضی در آن زمان مشغولش بودند. اما حالا بشر کار کرده و آنها معلومات عمومی شده و در دبستان آنها را به بچهها یاد میدهند.
پس در هر زمانی معلومات عمومی خاص خودش را دارد. این اولین قدم است؛ اطلاع بر معلومات عمومیای که در ذهن همه است.
گام دوم: آشنایی با مرزهای دانش
قدم دوم این است که بیش از معلومات عمومی اطلاع داشته باشد که در رشتههای تخصصی نظریات راقی و آنهایی که بین اهل تخصص مطرح است و مرز دانش است را هم بداند. وقتی اینها را بداند برای او فایده دارد. تأکیدی که من همیشه دارم این است که ردهبندی کنیم؛ یعنی در شناسایی دنبال، زودتر علوم پایه باشد تا علوم روبنایی. اما اگر وقتی دنبال علوم پایه برود که جوانیاش گذشته، چیزهایی به دست او میآید که وقتی به آنها نیاز دارد نمیتواند سرجایش از آنها استفاده بهینه کند. اما اگر در ایام جوانی این علوم پایه را کار بکند، علوم روبنایی را بعداً فرا بگیرد راحت است. چون در علوم مختلف هر کجا بحث، به چالش کشیده شود و به آن علوم نیاز پیدا کند، وقتی آن علوم را کار کرده باشد کم نمیآورد. در آن فضا حرفی برای گفتن دارد. چرا؟ چون علوم پایه دستش است. نباید مدام کاسه گدایی خود را بردارد و سراغ دیگران برود. من اینها را مکرر عرض کردهام. لذا معلومات عمومی و دانستن علوم ردهبندی شده نیاز است.
علوم مورد نیاز مجتهد
در وافیه و قوانین بود. البته قوانین بعد از آن است و شاید ناظر به وافیه باشد. علومی که مجتهد ضرورتا باید بداند و علومی که خوب است مجتهد بداند را شماره گذاشته بودند. نمیدانم مجموع آنها ٢۵ مورد میشد یا ده مورد ضروری بود و ٢۵ مورد جدا از آنها بود. آنها خیلی خوب است. مواردی است که علمای قدیم فرمودهاند؛چه برسد به زمان ما که به آن اضافه میشود[1].
تأثیر آشنایی با مرزهای دانش
اما تأثیر آن چیست؟
تفکیک بین مسائل علمی حل شده و نظریّات حل نشده
ببینید در بعضی از مطالب علوم هست که تشخیص آن بسیار مهم است که خود اهل علم میدانند دیگر این بحث علمی رد شده است؛ پل های پشت سر آن خراب شده است[2]. این یک چیزی است که برای اهل فن حالت نظریه ندارد، کالشمس شده است، این مطالب را باید از آن هایی که بین اهل فن هنوز نظریه است، جدا کند. هنوز در تب و تاب خودش است. خیلی مهم است که یک روحانی اینها را بداند. یک دفعه به فضای یک بحث علمی برود که نزد متخصصین معلوم است که در تاریخ این علم، دیگر برگشت ندارد؛ شما همینطوری یک چیزی برای خودتان میگویید. کسی که اینها دستش باشد، میداند که این دیگر برگشت ندارد. این رفت. متخصص فن میداند. روحانیِ جامع این را تشخیص میدهد.یک سری مباحث علمی اینچنین است. البته یکی-دو تا نیست. خب این برای اطلاعات خودش و همچنین در فضای بیرونی نیاز است.
مباحث دیگری هست که هنوز در حد نظریه است. نظریه غالب و رایج که آن را هم ردهبندی میکنیم. سر جایش میداند که مخاطب اینها را باور دارد بر طبق آن حرف میزند. اگر جایی باشد که اصطکاک پیدا میکند توضیح میدهد. میگوید این نظریه است و ده مورد دیگر را مثال میزند. میگوید این نظریهها در فلان زمان پیش آمده و با فاصله ده-بیست سال نظریات بعدی آنها را رد کرده. خود شاهدهای تاریخی خیلی مهم است تا مخاطب شما ببیند که این فضا هست.
اما اموری در علم هست که پل های پشت سرش خراب شده و قابل برگشت نیست؛ کسی که میخواهد مبلّغ خوبی برای دین و جامعهای باشد که سر و کارش با مطالب علمی است، باید اینها را بداند؛ اینها را بفهمد و درک کند. البته اینها در هر زمانی بوده است. آن مسائل علمیای که تمام شده و قافله علمی از آن رد شده و دیگر قرار نیست برگردد، ما باید آنها را بدانیم. دیگر به میدان آنها نرویم و زور بیخودی بزنیم. خیلی مسائل به این شکل است. یعنی کسی که اینها را میداند وقتی میبیند کسی میخواهد به میدان اینها برود، میگوید خب به میدان اینها برو تا چند روز بعد بفهمی! در ذهن تو جدا نشده؛ نظریات علمی، تئوری های علمی، بحثهایی که هنوز خود متخصصین نمیدانند که مطلب چیست، با آن جایی که مراحلی است که مطلب از آن رد شده، تفاوت میکند
[1] مرحوم فاضل تونی ابتدا به بیان نه علم دخیل در اجتهاد می پردازند:
البحث الثالث:
فيما يحتاج إليه المجتهد من العلوم، و هو تسعة، ثلاثة من العلوم الأدبية، و ثلاثة من المعقولات، و ثلاثة من المنقولات.
فالأول من الأول: علم اللغة.
و الاحتياج إليه: ظاهر، إذ الكتاب و السنة عربيان، و معاني مفردات اللغة إنما تبين[1] في علم اللغة.
و الثاني: علم الصرف.
و الاحتياج إليه: لأن تغير المعاني بتصريف المصدر- المبين معناه في علم اللغة- إلى الماضي و المضارع و الأمر و النهي و نحوها؛ إنما يعلم في الصرف.
و الثالث: علم النحو.
و الاحتياج إليه: أظهر، لأن معاني المركبات من الكلام إنما يعلم به. و الاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة إنما هو لمن لم يكن مطلعا على عرف النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام، كالعجم مطلقا، و العرب أيضا في هذه الأزمنة، لا مثل الرواة، و من قرب زمانه منهم، على أن الاحتياج في هذه الأزمنة أيضا، متفاوت بالنسبة إلى الأصناف كالعرب و العجم.
و الأول من الثاني: علم الأصول.
و الاحتياج إليه: لأن المطالب الأصولية مما يتوقف عليه استنباط الأحكام، مثلا: كثير من المسائل يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية و نفيها؛ و تحقيقها إنما هو في الأصول، و كذا على كون الأمر للوجوب أو لا؟ و كذا الوحدة و التكرار؟ و الفور و التراخي؟ و أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ و كذا وجوب مقدمة الواجب، و ظاهر أنها لا تعلم من اللغة و غيرها، و ليس أحد الشقين في هذه المذكورات بديهيا حتى يستغنى عن تدوينها و عن النظر فيها، و كذا ليست هذه المذكورات مما لا يتوقف عليه العمل، و كذا الحال في مباحث النواهي، و حكم ورود العام و الخاص، و المطلق و المقيد، و المجمل و المبين، و القياس مطلقا، أو منصوص العلة، و وجوب العمل بخبر الواحد و عدمه، و إن أمكن ادعاء ثبوت وجوب العمل بالمتواتر، من علم الكلام، و هكذا بقية المطالب.
و الثاني: علم الكلام.
و وجه الاحتياج إليه: أن العلم بالأحكام يتوقف على أن الله تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه، و لا بما يريد خلاف ظاهره، من غير بيان، و هذا إنما يتم إن لو عرف أنه تعالى حكيم مستغن عن القبيح، و كذا يتوقف على العلم بصدق الرسول و الأئمة عليهم السلام.
و الحق: أن الاحتياج إليه، إنما هو لتصحيح الاعتقاد، لا للأحكام بخصوصها.
و الثالث: علم المنطق.
و الاحتياج إليه: إنما هو لتصحيح المسائل الخلافية و غيرها، من العلوم المذكورة، إذ لا يكفي التقليد سيما في الخلافيات، مع إمكان الترجيح، و كذا لرد الفروع الغريبة إلى أصولها، لأنه محتاج إلى إقامة الدليل، و تصحيح الدليل لا يتم بدون المنطق إلا للنفوس القدسية.
و اعلم: أن العلوم المذكورة، ليس جميع مسائلها المدونة، مما يتوقف عليه الاجتهاد، بل و لا أكثرها على الظاهر؛ و القدر المحتاج إليه، مما لا يمكن تعيينه إلا بعد ملاحظة جميع الأحكام، و يكفي لصاحب الملكة[1] الرجوع إلى ما يحتاج إليه عند الاحتياج، كما لا يخفى.( الوافية في أصول الفقه ؛ ص250-٢۵٢)
و الأول من الثالث: العلم بتفسير الآيات المتعلقة بالأحكام، و بمواقعها من القرآن، أو من الكتب الاستدلالية، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.
و المشهور: أن الآيات المتعلقة بالأحكام نحو من خمسمائة آية، و لم أطلع على خلاف في ذلك.( الوافية في أصول الفقه ؛ ص256)
...و الثاني من القسم الثالث: العلم بالأحاديث المتعلقة بالأحكام، بأن يكون عنده من الأصول المصححة ما يجمعها، و يعرف موقع كل باب، بحيث يتمكن من الرجوع إليها.
و يتصور في حق المتجزي الغناء عنها، ببعض الكتب الاستدلالية، كما لا يخفى.
و الثالث من الثالث: العلم بأحوال الرواة في الجرح و التعديل، و لو بالمراجعة إلى كتب الرجال.
و وجه الاحتياج إليه: أن الاجتهاد بدون التمسك بالأحاديث غير متصور، و ليس كل حديث مما يجوز العمل به؛ إذ كثير من الرواة نقلوا في حقهم أنهم من الكذابين المشهورين، فلا شك في وجود رواية الكذب، و ربما لا يمكن التمييز بغير الاطلاع على حال الراوي.( الوافية في أصول الفقه ؛ ص260-٢۶١)
ایشان در ادامه به بررسی علوم دیگر از جمله ریاضیات و هیئت و هندسه و جایگاه آن ها در اجتهاد می پردازند:
..و اعلم: أن هاهنا أشياء اخر، سوى العلوم المذكورة، لها مدخلية في الاجتهاد، إما بالشرطية، أو المكملية:
الأول: علم المعاني.
و لم يذكره الأكثر في العلوم الاجتهادية، و جعله بعضهم من المكملات، و عده بعض العامة من الشرائط و هو المنقول عن السيد الأجل المرتضى في الذريعة و عن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم و المتعلمو عن الشيخ أحمد المتوج البحراني في كتاب كفاية الطالبين
الثاني: علم البيان.
و لم يفرق أحد بينه و بين علم المعاني في الشرطية و المكملية إلا ابن جمهور فإنه عد علم المعاني من المكملات، و سكت عن البيان و علل ب: أن أحوال الإسناد الخبري، إنما يعلم فيه، و هو من المكملات للعلوم العربية.
الثالث: علم البديع و لم أجد أحدا ذكره إلا ما نقل عن الشهيد الثاني في الكتاب المذكور و صاحب كفاية الطالبين فإنهما عدا العلوم الثلاثة أجمع في شرائط الاجتهاد.
و الحق: عدم توقف الاجتهاد على العلوم الثلاثة، أما على تقدير صحة التجزي: فظاهر، و أما على تقدير عدم صحة التجزي: فلأن فهم معاني العبارات لا يحتاج فيه إلى هذه العلوم، لأن في هذه يبحث عن الزائد على أصل المراد.
فإن المعاني: علم يبحث فيه عن الأحوال التي بها يطابق الكلام لمقتضى الحال، كأحوال الإسناد الخبري، و المسند إليه و المسند و متعلقات الفعل، و القصر و الإنشاء، و الفصل و الوصل، و الإيجاز و الإطناب و المساواة.
و بعض مباحث القصر و الإنشاء المحتاج إليه يذكر في كتب الأصول.
و البيان: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. و ما يتعلق بالفقه من أحكام الحقيقة و المجاز مذكور في كتب الأصول أيضا.
و البديع: علم يعرف به وجوه محسنات الكلام. و ليس شيء من مباحثه مما يتوقف عليه الفقه.
نعم، لو ثبت تقدم الفصيح على غيره، و الأفصح على الفصيح، في باب التراجيح- أمكن القول بالاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة لغير المتجزي، و له- في بعض الأحيان- إذ فصاحة الكلام و أفصحيته مما لا يعلم في مثل هذا الزمان إلا بهذه العلوم الثلاثة، و كذا على تقدير تقدم الكلام الذي فيه تأكيد أو مبالغة على غيره، و سيجيء الكلام على هذه الأمور في باب التراجيح إن شاء الله تعالى، و لكن لا شك في مكملية هذه العلوم الثلاثة للمجتهد.
الرابع: بعض مباحث علم الحساب، كالأربعة المتناسبة، و الخطئين و الجبر و المقابلة و هو أيضا مكمل و ليس شرطا، أما في المتجزي: فظاهر، و أما في غيره: فلأنه ليس على الفقيه إلا الحكم باتصال الشرطيات، و أما تحقيق أطراف الشرطية فليس في ذمته، مثلا: عليه أن يحكم بأن من أقر بشيء فهو مؤاخذ به، و ليس عليه بيان كمية المقر به في قوله: (لزيد علي ستة إلا نصف ما لعمرو، و لعمرو علي ستة إلا نصف ما لزيد) مثلا، فتأمل.
الخامس: بعض مسائل علم الهيئة، مثل ما يتعلق، بكروية الأرض، للعلم بتقارب مطالع بعض البلاد مع بعض أو تباعدهما، و كذا لبعض مسائل الصوم، مثل: تجويز كون الشهر ثمانية و عشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص.
السادس: بعض مسائل الهندسة، كما لو باع بشكل العروس مثلا
السابع: بعض مسائل الطب، كما لو احتاج إلى تحقيق (القرن) و نحوه.
و ليست هذه العلوم محتاجا إليها، لما عرفت، و إلا لزم الاحتياج إلى بعض الصنائع، كالعلم بالغبن، و العيوب، و نحو ذلك.
الثامن: فروع الفقه.
و لم يذكره الأكثر في الشرائط.
و الحق: أنه لا يكاد يحصل العلم بحل الأحاديث و محاملها بدون ممارسة فروع الفقه.
التاسع: العلم بمواقع الإجماع و الخلاف، لئلا يخالف الإجماع.
و هذا شرط لا يستغني غير المتجزي عنه؛ و هذا العلم إنما يحصل في هذا الزمان بمطالعة الكتب الاستدلالية الفقهية، ككتب الشيخ، و العلامة، و نحوها.
العاشر: أن تكون له ملكة قوية، و طبيعة مستقيمة، يتمكن بها من رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية، و اقتناصالفروع من الأصول؛ و ليس هذا الشرط مذكورا في كلام جماعة من الأصوليين.
و تحقيق المقام: أن الدليل النقلي إذا كان ظاهرا أو نصا في معناه، و لم يكن له معارض، و لا لازم غير بين، و لا فرد غير بين الفردية؛ فلا يحتاج الحكم بمعناه و العمل به إلى هذا الشرط، بل تكفي الشرائط السابقة، مثلا: في العلم بأن الكر من الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، من قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء»- لا يحتاج إلى أكثر من العلم بمعاني مفردات هذا الحديث من اللغة و الصرف، و بالهيئة التركيبية من النحو؛ و هذا ضروري.
و أما عند وجود المعارض: فيحتاج إلى الملكة المذكورة للترجيح، و كذا للعلم باللوازم غير البينة، كالحكم بوجوب المقدمة، و النهي عن الأضداد عند الأمر بالشيء، و بمفهوم الموافقة و المخالفة، و نحوها، و ربما يحتمل كفاية العلم بالمطالب الأصولية لهذا القسم.
و العمدة في الاحتياج إلى الملكة إنما هو للحكم بفردية ما هو غير بين الفردية للكلي المذكور في الدليل، أو لمعارضه، أو لمقدمته، أو لضده، أو نحو ذلك(الوافية في أصول الفقه ؛ ص۲۸۰-٢٨۴)
ایشان نیز با تفاوت گذاری بین تحقق اجتهاد و کمال آن، دسته اول را شامل یازده علم می دانند:
يتوقف تحقق الاجتهاد و كماله على أمور.
أما ما يتوقف عليه تحققه، فهو أمور:
الأول، و الثاني، و الثالث: العلم بلغة العرب، و الصرف، و النحو،
فإن الكتاب و الحديث عربيان و يعرف أصل مفردات الكلام من علم اللغة و تصاريفها الموجبة لتغيير معانيها بالمضي و الاستقبال و الأمر و النهي و غيرها من الصرف، و معانيها التركيبية الحاصلة من تركيب العوامل اللفظية و المعنوية مع المعمولات من علم النحو.
و العلم بالمذكورات إما بسبب كون المجتهد صاحب اللغة كالمستمعين للخطابات المحاورين مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام من أهل اللسان، أو بسبب التعلم من أفواه الرجال، أو ممارسة كلامهم بحيث يحصل له الاطلاع، أو بالرجوع الى الكتب المؤلفة فيها، فلا وجه لما يقال: إن العربي القح[1] لا يحتاج الى علم الصرف و النحو و اللغة.
و يمكن تحصيل مراد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام بتتبع كلماتهم و مزاولتها، إذ المراد من القول بتوقف الاجتهاد على تلك العلوم هو معرفة مسائلها التي يتوقف الفهم عليها بأي نحو حصل، مع أن كثيرا من العلماء المتتبعين الممارسين من العرب أيضا ربما يحتاجون الى مراجعة الكتب التي ألفوها في هذه العلوم فضلا عن غيرهم، خصوصا في بعض الألفاظ.
الرابع: علم الكلام،
لأن المجتهد يبحث عن كيفية التكليف، و هو مسبوق بالبحث عن معرفة نفس التكليف و المكلف، فيجب معرفة ما يتوقف عليه العلم بالشارع، من حدوث العالم و افتقاره الى صانع موصوف بما يجب، منزه عما يمتنع، باعث للأنبياء مصدقا إياهم بالمعجزات، كل ذلك بالدليل و لو إجمالا.
و التحقيق، أن العلم بالمعارف الخمسة و اليقين بها لا دخل له في حقيقة الفقه.
نعم، هو شرط لجواز العمل بفقهه و تقليده، فإذا فرض أن كافرا عالما استفرغ وسعه في الأدلة على ما هي عليه و استقر رأيه على شيء على فرض صحة هذا الدين، ثم آمن و تاب و قطع بأنه لم يقصر في استفراغ وسعه شيئا، فيجوز العمل بما فهمه.
و لا ريب أن محض التوبة و الإيمان لا يجعل ما فهمه فقها، بل كان ما فهمه فقها، و كان استفراغ وسعه على فرض صحة المباني.
و هذا هو التحقيق في رد الاحتياج الى العلم بالمعارف الخمس، لا أن ذلك لا يختص بالمجتهد، بل هو مشترك بين سائر المكلفين، كما ذكره الشهيد الثاني في كتاب «القضاء» من «شرح اللمعة» و غيره.
نعم، يمكن أن يقال: إن معرفة أن الحكيم لا يفعل القبيح، و لا يكلف بما لا يطاق، يتوقف عليه معرفة الفقه، و هو مبين في علم الكلام.
و وجه توقف الفقه عليه أن الخطاب بما له ظاهر، و إرادة خلافه من دون البيان قبيح، فيجوز العمل بالظواهر، و يترتب عليه المسألة الفقهية.
فإذا قلنا: إن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، فيترتب عليه أن المسألة الفقهية هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ، فأمثال ذلك، هذا هو الموقوف عليه من علم الكلام.
الخامس: معرفة المنطق،
لأن استنباط المسائل من المأخذ يحتاج الى الاستدلال، و هو لا يتم إلا بالمنطق، و كون الاستدلال بالشكل الأول و القياس الاستثنائي بديهيا، و تحصيل النتائج من المقدمات غريزيا طبيعيا، لا ينافي الاحتياج إليه فيما عرض الذهن مرض الاعوجاج و الغفلة بسبب الشبهات.
كما أنه قد يحتاج الطبع الموزون الى استعمال العروض لنفسه أو لردع غيره من الغلط و الاشتباه، و ذلك غير خفي على من زاول الاستدلال في العلوم.
و ما يقال: من أن المنطق لو كان عاصما عن الخطأ لما أخطأ المنطقي في الاستدلال ضعيف إذ الإنسان جائز الخطأ في كل مرحلة إلا من عصمه الله، و لكنه محفوظ عن الخطأ في الأغلب.
السادس: معرفة أصول الفقه،
و هو أهم العلوم للمجتهد، و لا يكاد يمكن تحصيل الفقه إلا به، و لا بد أن يكون على سبيل الاجتهاد، لكثرة الخلافات فيه، بل و كذلك الكلام في خلافيات اللغة و النحو و الصرف أيضا مما يتفاوت به الأحكام، كالاجتهاد في معنى الصعيد و الإزار و الأنفحة، و نحو ذلك. و يكفي في الأصول الظن فيما لم يمكن فيه تحصيل العلم.
و ما قيل: من أن مسائل الأصول مما لا بد فيه من العلم مطلقا، فلا تحقيق فيه، و قد أشرنا إليه سابقا، و وجه توقف الاجتهاد و الفقه عليه من وجوه:
الأول: أن من أدلة الفقه، الكتاب و السنة، و لا ريب أنهما وردا قبل ألف سنة أو أزيد، و لا نعلم اتحاد عرف الشارع و عرفنا، بل نعلم مخالفتهما في كثير و نشك في كثير.( القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج۴، ص: ۴۶۱-۴۶٢)
...السابع العلم بتفسير آيات الأحكام
و مواقعها من القرآن أو الكتب الاستدلالية بحيث يتمكن منها حين يريد، و هي خمسمائة آية عندهم.
و بعض الروايات التي تدل على تقسيم القرآن أثلاثا: الى السنن و الفرائض و صفة أهل البيت عليهم السلام و أعدائهم، أو أرباعا: فيهم عليهم السلام، و في عدوهم، و في السنن و الأمثال، و في الفرائض و الأحكام، و نحو ذلك، فهي ليست على ظاهرها كما لا يخفى.
و لعل المراد تقسيم مجموع القرآن من الظهور و البطون، و إلا فلا يستفاد من ظاهرها إلا المقدار المتقدم، و قد مر الكلام على حجية ظواهر القرآن من الأخباريين و الجواب عنهم فراجع.
الثامن العلم بالأحاديث المتعلقة بالأحكام
سواء حفظها أم كان عنده من الأصول المصححة ما يرجع إليها عند الاحتياج و عرف مواقع أبوابها.
و قد أشرنا الى مقدار الحاجة في باب احتياج العمل بالعام الى الفحص عن المخصص، و وجه الاحتياج ظاهر.
التاسع العلم بأحوال الرواة من التعديل و الجرح
، و لو بالرجوع الى كتب الرجال.
و وجه الاحتياج أن العمل بالأخبار مشروط بتوثيق الرجال و الاعتماد عليهم إذا بنينا إثبات حجية خبر الواحد على الأدلة الخاصة به، كما أشرنا إليه في بيان شروط العمل به، أو أن مراتب الظنون تختلف باختلاف أحوال رجال السند إذا بنيناه على الدليل الخامس من جهة أنه ظن.
و بملاحظة ذلك يتفاوت حال الأخبار و يتميز الراجح عن المرجوح، إذ لا ريب أن كون الرجل ثقة مثلا مما يوجب الظن بصدق خبره، و ذلك لا ينافي إمكان حصول الظن بأمور أخر.
فإن التحقيق أن جواز العمل بأخبار الآحاد لا ينحصر في الخبر الصحيح، بل و لا الموثق و الحسن أيضا، بل كثيرا ما يعمل بما هو ضعيف في مصطلحهم لاعتضاد الخبر بما يوجب قوته، و قد أشرنا الى ذلك في مباحث أخبارالآحاد، مع أنه مما ورد في الأخبار من وجوه الترجيح بين الأخبار مثل قوله عليه السلام:
«الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما» و قوله عليه السلام: «خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك»( القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج۴ ؛ ص۴۷۷-۴٧٩)
...العاشر [في العلم بمواقع الاجماع]
أن يكون عالما بمواقع الإجماع ليحترز عن مخالفته، و هو مما لا يمكن في أمثال زماننا غالبا إلا بمزاولة الكتب الفقهية الاستدلالية، بل متون الفقه أيضا.
و من ذلك يظهر أن معرفة فقه الفقهاء أيضا من الشرائط لا من المكملات، كما ذكر بعضهم، فإن الإنصاف أن فهم الأخبار أيضا مما لا يمكن إلا بممارسة تلك الكتب و مزاولتها، فضلا عن معرفة الوفاق و الخلاف، و موافقة العامة و المخالفة و غير ذلك.
الحادي عشر [في الملكة المستقيمة]
أن يكون له ملكة قوية و طبيعة مستقيمة يتمكن بها من رد الفروع الى الأصول، و إرجاع الجزئيات الى الكليات و الترجيح عند التعارض، فإن معرفة العلوم السابقة غير كافية في ذلك، بل هي أمر غريزي موهوبي يختص ببعض النفوس دون بعض، فإذا كانت هذه الحالة موجودة في نفس و انضم إليها معرفة [العلوم] السابقة، فيحصل له ملكة الفقه، يعني قوة رد جزئياته الى كلياته.
و أصل تلك الحالة لا يحصل بالكسب، بل له مدخلية في زيادتها و تقويتها. إذا أردت معرفة ذلك فلاحظ من ليس له الطبع الموزون، فإنه لا ينفعه تعلم علم العروض، و كذلك سائر العلوم، فربما يصير شخص ماهرا في علم الطب و لا يقدر على معالجة المرض.( القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) ؛ ج4 ؛ ص500-۵٠١)
و أما ما يتوقف كمال الاجتهاد عليه، فهو أمور.
الأول: علم المعاني و البيان و البديع، و نقل عن الشهيد الثاني رحمه الله[1] و الشيخ الأحمد بن المتوج البحراني أنه جعل الثلاثة من شرائط أصل الاجتهاد. و عن السيد رحمه الله أيضا أنه جعل الأولين من الشرائط، و غيرهم جعلوا هذه العلوم من المكملات.
و الحق، أن بعض الأولين مما يتوقف عليه الاجتهاد، مثل مباحث القصر و الإنشاء، و الخبر من علم المعاني، و ما يتعلق بمباحث الحقيقة و المجاز، و أقسام الدلالة من علم البيان، لكن القدر المحتاج إليه منهما مذكور في كتب الأصول غالبا، و هو لا ينافي كونهما مما يتوقف عليه أصل الاجتهاد.
ثم إن جعلنا الأبلغية و الأفصحية من مرجحات الأخبار و الأدلة، فلا ريب حينئذ في الاحتياج الى العلوم الثلاثة، إذ لا يعرفان عادة في أمثال هذا الزمان إلا بملاحظة العلوم الثلاثة.
و التحقيق، أن الفصاحة إذا أوجب العلم بكون الكلام عن المعصوم عليه السلام أو الظن المتاخم كما يظهر من ملاحظة «نهج البلاغة» و «الصحيفة السجادية عليه السلام» و سائر كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فمدخليته واضحة.
و كذلك إذا أوجب رجحان كون الحديث من الإمام عليه السلام بحيث صار معارضه موهوما عند المجتهد، و لكن ذلك نادر في أخبار الفروع.
و الثاني: بعض مسائل الهيئة مثل ما يتعلق بكروية الأرض لمعرفة تقارب مطالع البلاد و تباعدها. و يترتب عليه جواز كون أول الشهر في أرض غير ما هو أوله في بلد آخر، و جواز كون الشهر ثمانية و عشرين يوما لبعض الأشخاص، و لا يبعد كون ذلك من الشرائط.
و يمكن أن يقال: يكفي في ذلك للفقيه العمل على مقتضى قولهم عليهم السلام: «صم للرؤية و أفطر للرؤية»[1]. و كذلك الحال في معرفة القبلة، فإنه يكفيه الاستقبال فيما يمكن له العلم، و العمل بالظن فيما لا يمكن. و العمل بما ورد في المضطر لو لم يحصل له الظن أيضا.
و الثالث: بعض مسائل الطب، للاحتياج الى معرفة القرن، و المرض المبيح للفطر، و أمثال ذلك، و ليس ذلك من الشرائط، لأن شأن الفقيه بيان الحكم باعتبار الشرطيات لا بيان أطرافها، فيقول: القرن يوجب التسلط على الفسخ في النكاح، و المرض المضر يبيح الفطر.
و أما حقيقة القرن و المرض فليس معرفتهما شأن الفقيه، و إلا لزم أن يعلم الفقيه جميع العلوم و الصنائع أو أغلبها، لاحتياج أطراف الشرطيات إليها، مثلا يجب على الفقيه أن يحكم بأن المبيع إذا خرج معيبا فللمشتري الخيار أو إن ظهر له الغبن فله الخيار أو يثبت في الأمر الفلاني الأرش، و أما معرفة العيب و الغبن و الأرش فلا يجب عليه كما لا يخفى.
و الرابع: هو بعض مسائل الهندسة مثل ما لو باع بشكل العروسمثلا، و يظهر الوجه مما تقدم.
و الخامس: بعض مسائل الحساب مثل: الجبر، و المقابلة، و الخطائين، و الأربعة المتناسبة مما يستخرج بواسطتها المجهولات.
و يظهر وجه عدم الاشتراط مما تقدم، فإن شأن الفقيه فيما لو سئل عنه إذا قال أحد: لزيد علي عشرة إلا نصف ما لعمرو، و لعمرو علي عشرة إلا نصف ما لزيد، أن يقول: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فلا يجب عليه تعيين المقدار.
ثم إن القدر الواجب من تلك الشرائط المتقدمة هو ما يندفع به الحاجة، فلا يجب صرف العمر الكثير في تحصيل المهارة في كل واحد منها، فإن الفقه الذي هو ذو المقدمة يحتاج الى صرف العامة العمر فيه، فصرف العمر في مقدماته يوجب عدم الوصول الى ذي المقدمة، مع أن الفقه أيضا مقدمة للعمل و العبادة، فلا بد من عدم الغفلة و صرف العمر فيما لا يعنيه.( القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج۴، ص: ۵۱۲-۵١٣)
[2] برخی از این مسائل عبارتند از:
١- امتناع خرق و التیام در افلاک
۲- نیازک ها و سببش
۳- زمین مرکزی و منظومه شمسی
۴- عدم اتصال جسم طبیعی به نحو ارسطویی
۵- عدم کیف بودن نور
۶- گنگ بودن عدد پی و ای و طلایی و جذر دو و...(سایت فدکیه، صفحه فهرست موضوعات و مسائل علمی که پایان یافته تلقی می شوند)
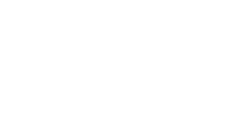
بدون نظر