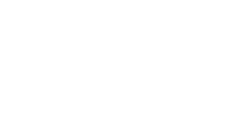صاحب جواهر
[الفرض الأول النية]
الأول النية، و هي لغة و عرفا إرادة تؤثر في وقوع الفعل، و بها يكون الفعل فعل مختار، و هو المراد ممن فسرها بالقصد على ما يظهر من ملاحظة كثير من كلمات الأصحاب و بعض كلمات أهل اللغة نعم ربما فسرت بالعزم في بعض عبارات الأصحاب و الصحاح، بل يستفاد من إطلاق كثير من الأخبار[1] كما لا يخفى على من لاحظ باب استحباب نية الخير و العزم عليه، و باب كراهية نية الشر من كتاب وسائل الشيعة، و المراد بالعزم الإرادة المتقدمة على الفعل سواء حصل قبلها تردد أولا، فما ينقل عن المتكلمين من الفرق بينه و بين النية بذلك غير واضح الوجه، كالفرق بين النية و مطلق الإرادة بالمقارنة و عدمها، و حاصل ما نقل عنهم ان الإرادة إما أن تكون مسبوقة بتردد أولا، فالأولى العزم، و الثانية إما ان تكون مقارنة أو لا، فالأولى النية، و الثانية إرادة بقول مطلق، و هو كما ترى. نعم لا يبعد دعوى اشتراك لفظ النية بين الإرادة المتقدمة التي تسمى بالعزم، كما هو ظاهر ما عن الجوهري، و يؤيده ملاحظة كثير من الاستعمالات، و بين الإرادة المقارنة المؤثرة في وقوع الفعل، مع احتمال دعوى الحقيقة في الثانية خاصة.
و كيف كان لا نعرف لها معنى جيدا[2] شرعيا، نعم ربما وقع في لسان بعض المتشرعة إطلاقها على الإرادة مع القربة، بل هو مدار قولهم النية شرط في العبادات دون المعاملات، و منه اشتبه بعض متأخري المتأخرين، فادعى أن لها معنى جديدا، و هو واضح الفساد كما لا يخفى على من لاحظ كلمات الأصحاب في معناها و إطلاقها و استعمالاتهم و غير ذلك، فلا حاجة للإطالة، نعم لما لم يكتفوا بمطلق القصد في صحة العبادة بل كان المعتبر قصدا خاصا على ما ستعرف جعلوا ذلك كله من متعلقات النية، و لذا تراهم بعد ذكرها يذكرون كيفيتها، فيشتبه على غير المتأمل أنه معناها عندهم، و ظهر لك مما تقدم من معنى النية انها من الأفعال القلبية التي ليس للنطق فيها مدخلية كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ في الخلاف و المصنف و العلامة و الشهيدان و غيرهم، و من هنا اعترض على المصنف باستدراك قوله تفعل بالقلب بعد ذكره أنها إرادة، و ربما أجيب عنه أنه جيء به لا خراج إرادة الله عن مسمى النية، لمكان كونها لا تفعل بالقلب، فيقال: أراد الله و لا يقال: نوى الله، بل في التنقيح لا يصدق على إرادة الله تعالى انها نية بالإجماع، قلت: و لعله لخصوص لفظ النية دون نحو نوى، و إلا فقد قال العلامة في المنتهى: انه يقال: نواك الله بخير أي قصدك، و في الصحاح نواك الله أي صحبك في سفرك و حفظك، قال الشاعر:
|
يا عمر و أحسن نواك الله بالرشد |
و اقرأ سلاما على الذلفاء بالثمد |
و في القاموس نوى الله فلانا حفظه، و الأولى في الجواب ان يقال: انه ذكره المصنف للرد على بعض الشافعية حيث أوجبوا اللفظ، و هو مع انه مجمع على بطلانه عندنا كما في كشف اللثام لا دليل عليه، بل لا دليل على الاستحباب أيضا و إن ظهر من بعض الأصحاب.
و ما يقال من التعليل: بان اللفظ أعون له على خلوص القصد، أو انه زيادة مشقة فيستتبع الثواب فيه مالا يخفى، بل أقصى ما يفيده الأول الاستحباب العارضي لا الذاتي، و نحن نقول به بحسب اختلاف الناوين، بل قد يصل إلى حد الوجوب كما إذا توقف الإخلاص عليه، و قد يحرم إذا كان بالعكس، إلا أن الأحوط الترك مع الاختيار فرارا من التشريع، و حيث كان المراد بالنية ما عرفت كان الدليل على وجوبها - بعد توقف صدق الامتثال و الإطاعة و التعبد و ما دل من الكتاب و السنة على الإخلاص في العبادة المتوقف عليها، إذ المراد به إتيان الفعل بقصد كونه امتثالا لأمر الله خاصة - الإجماع المنقول على لسان جماعة كالشيخ و ابن زهرة و العلامة، بل هو محصل، و ما عساه يظهر من المنقول عن ابن الجنيد من الاستحباب فهو - مع عدم صراحة عبارته و معارضته بنقل المصنف عنه في المعتبر خلافه - ضعيف جدا، فلا يقدح، و
قول علي بن الحسين (عليهما السلام)[3] في حسنة أبي حمزة: «لا عمل إلا بنية» و نحوه روي[4] عن النبي (صلى الله عليه و آله) و قول رسول الله (صلى الله عليه و آله)[5] «إنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز و جل، و من غزا يريد به عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى» و
قوله أيضا[6] في خبر أبي عثمان العبدي عن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا قول إلا بعمل، و لا قول و لا عمل إلا بنية، و لا قول و لا عمل و لا نية إلا بإصابة السنة» و في الوسائل أنه رواه
الشيخ مرسلا عن الرضا، و غير ذلك.
و ما وقع من بعض متأخري المتأخرين - من المناقشة في الاستدلال بهذه الأخبار لاحتمال توجه الحصر فيها إلى الكمال دون الصحة، و ترجيح الثانية على الأولى لكونه أقرب المجازات إلى الحقيقة معارض بأنه فيه تخصيصا للأعمال بالعبادات خاصة - ضعيف جدا، لما فيه من المخالفة لفهم العلماء الماهرين، و لغلبة استعمال مثل هذا التركيب في نفي الصحة كما هو واضح، و خروج غير العبادات منه غير قادح، بل هو أولى من غيره لشيوع التخصيص، لا يقال: ان بعض هذه الأخبار لا تنطبق على ما ذكرت من معنى النية، مثل
«إنما الأعمال بالنيات» و نحوه، لأنا نقول: مع انا نجوز إطلاقها على غير ما تقدم مجازا انه قد يشتبه المراد من متعلق النية أما بإضمار أو نحوه، و في إطلاق نفس النية، كما في قوله:
«إنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى» الى آخره. بل التأمل الصادق في مثل قوله (إنما الأعمال) و نحوه يقضي بأنه أدل على المطلوب منه على غيره لما فيه من إطلاق النية على غير ما نحن فيه، فتأمل جيدا.
و إذ قد ظهر لك المراد من النية علمت أن الأمر فيها في غاية السهولة، إذ لا ينفك فعل العاقل المختار حال عدم السهو و النسيان عن قصد للفعل و إرادة له، و من هنا قال بعضهم: انه لو كلفنا الله الفعل بغير نية لكان تكليفا بالمحال، و هو حسن بناء على ما ذكرنا من معنى النية، بل لعله لذا أغفل المتقدمون ذكرها و بيان شرطيتها،
لكن لما كان لا يكفي في صحة العبادة وجود النية بالمعنى المتقدم، بل لا بد من ملاحظة القربة منها و حصول الإخلاص، و هو في غاية الصعوبة، بل هو الجهاد الأكبر للنفس الأمارة بالسوء، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار[7] الواردة في الرياء و الحذر عنه، و انه أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة المظلمة، و كانت القربة في حال الإخلاص من متعلقات النية، إذ يجب عليه قصد الفعل امتثالا لله خاصة صعب أمر النية من هذه الجهة، و صح اشتراطها في العبادات دون المعاملات، و بحث عنها المتأخرون، بل لعل المتقدمين بذكرهم في أوائل كتبهم اشتراط الإخلاص في العبادة و التحذير من الرياء و نحوه اكتفوا عن ذكر النية بمعنى القصد، لعدم إمكان حصول الإخلاص بدونه،
و بما ذكرنا ظهر لك مراد من جعل أمر النية في غاية السهولة، و كذا من جعلها في غاية الصعوبة، لاختلاف الحيثيتين، إلا أنه ربما ظهر من بعض عبارات بعض الأصحاب صعوبة أخرى للنية من غير تلك الحيثية، و ذلك لأنه جعلها عبارة عن هذا الحديث النفسي و التصور الفكري، فلا يكتفى بدون الاخطار بالبال للقصد مع ما يعتبر معه من القربة و الوجه و غيرهما مقارنا لأول العمل، فبسببه يحصل بعض أحوال لهم تشبه أحوال المجانين، و ليت شعري أ ليست النية في الوضوء و الصلاة و غيرهما من العبادات كغيرها من سائر أفعال المكلفين من قيامهم و قعودهم و أكلهم و شربهم، فان كل عاقل غير غافل و لا ذاهل لا يصدر عنه فعل من هذا الأفعال إلا مع قصد و نية سابقه عليه ناشئة من تصور ما يترتب عليه من الأغراض الباعثة و الأسباب الحاملة على ذلك الفعل، بل هو أمر طبيعي و خلق جبلي، و مع هذا لا ترى المكلف في حال إرادة فعل من هذه الأفعال يعتريه شيء من تلك الوسوسة و ذلك الاشكال، بل هو بالنسبة إلى العبادات الأخر من الزيارات و الصدقات و عيادة المرضى و قضاء الحوائج و الأدعية و الأذكار و قراءة القرآن و نحو ذلك لا يعتريه شيء من تلك الأحوال، بل هو فيها على حسب سائر أفعال العقلاء، فما أعرف ما ذا يعتريه في مثل الوضوء.
و من هنا كان التحقيق ان النية عبارة عن الداعي الذي يحصل للنفس بسببه انبعاث و ميل إلى الفعل، فان المكلف إذا دخل عليه وقت الظهر مثلا و هو عالم بوجوب ذلك الفرض سابقا و عالم بكيفيته و كميته و كان الغرض الحامل على الإتيان به انما هو الامتثال لأمر الله ثم قام من مكانه و سارع ثم توجه إلى المسجد و وقف في مصلاه مستقبل القبلة فأذن و أقام ثم كبر و استمر في صلاته فان صلاته صحيحة شرعية مشتملة على النية و القربة، فظهر بذلك أنه لا تنحصر النية في الصورة المخطرة بالبال.
لا يقال: ان الاخطار أشد في حصول الإخلاص، لأنا نقول: انه ينبغي القطع في عدم مدخلية ذلك فيه، ألا ترى انه إذا غلب على قلب المدرس أو المصلي حب الشهرة و السمعة و ميل القلوب اليه لكونه صاحب فضيلة أو ملازم عبادة و كان ذلك هو الحامل له على تدريسه و عبادته فإنه لا يتمكن من نية القربة و الإخلاص فيها و ان قال بلسانه و تصور بجنانه أصلي أو أدرس قربة إلى الله كما هو واضح،
و حاصل الفرق بين القول بالإخطار و الداعي إما بان يقال: ان الأول يؤول إلى إيجاب العلم بالحضور وقت الفعل بخلاف الثاني، فإنه يكتفى بالحضور من دون علم و التفات الذهن، و ما عساه يظهر من بعضهم - من أنه بناء على الداعي يكتفي بوجوده و إن غاب عن الذهن حال الفعل، و لذا لم يفرقوا بين الابتداء و الاستدامة - مما لا ينبغي الالتفات اليه و يقطع بفساده، و كيف يعد مثل هذا الفعل في العرف بمجرد هذا العزم السابق منويا و مقصودا، أو يقال في الفرق بينهما: ان المراد بالداعي انما هو العلة الغائية للفعل الباعثة للمكلف على إيجاده في الخارج، و هو ليس من النية في شيء، بناء على ما ذكرنا انها مجرد القصد و الإرادة، و إطلاق لفظ النية عليه في لسان بعضهم انما هو بحسب الاصطلاح المتأخر، فنقول حينئذ يكتفى بقيام الداعي في المكلف لكن لا بد من حصول الإرادة للفعل حين التعقل و إن غفل عن الداعي له في ذلك الوقت لكن بحيث لو سئل لقال أريد الفعل لذلك، و بهذا تظهر الثمرة بينه و بين القول بالإخطار، فتأمل جيدا. و لعل الأولى أن يجعل المدار بناء على الداعي على مالا يعد في العرف انه فعل ساه خال عن القصد ليكتفى بذلك، و يأتي إن شاء الله تعالى في الاستدامة للبحث تتمة.
و كيفيتها أن ينوي الوجوب في الواجب أو الندب في المندوب كما هو خيرة المنتهى و الإرشاد و التحرير و الشهيد في اللمعة و الألفية، و هو المنقول عن الغنية و المهذب و الكافي، و ربما نقل عن الراوندي و ابن حمزة و نسب إلى الأكثر في بعض حواشي الألفية، و في آخر انه المفتي به، و عن كتب أهل الكلام من مذهب العدلية انه يشترط في استحقاق الثواب على واجب ان يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه على رأي» كما هو ظاهر اختيار السرائر و التذكرة و جامع المقاصد، و فسر الوجه بأنه اللطف عند أكثر العدلية، و أنه ترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة، و الشكر عند الكعبي، و مجرد الأمر عند الأشعرية، و عن الروضة دعوى الشهرة على وجوب نية الوجوب في الصلاة، بل في ظاهر التذكرة الإجماع عليه هناك، و لعله يفرق بين الصلاة و بين ما نحن فيه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى، و من هنا نقل عن بعضهم أنه أنكر الوجوب هنا و قال به في الصلاة.
و كيف كان فقد اختار المصنف في المعتبر في المقام عدم الوجوب، و اليه ذهب كثير من متأخري المتأخرين و جملة مشايخنا المعاصرين، و هو المنقول عن المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية، بل نقله الشهيد في نكت الإرشاد عن المرتضى و ظاهر الشيخ في الاقتصاد و عن المصنف في الطبرية، بل ربما كان ظاهر سلار و الجعفي، لإطلاقهم النية على ما قيل كظاهر النافع، بل قد يكون ظاهر الشيخ في المبسوط أيضا، لأنه ذكر وجوب نية رفع الحدث أو استباحة مشروط بالطهارة و لم يتعرض للوجوب و الندب، بل قد يكون ظاهر المتقدمين، لتركهم التعرض للنية أصلا، و لعله الأقوى في النظر، لكن ليعلم ان من تعرض لوجوب نية الوجوب (منهم) من أطلق نية وجوبه، و (منهم) من يظهر منه وجوب ملاحظته علة و غاية، فلا يكتفي به لو لا حظه قيدا، و لعله لظاهر المنقول عن كتب المتكلمين، و عن الوسيلة «وجوب ملاحظته وصفا لا غاية».
و على كل حال فأقصى ما يمكن أن يستدل به لهم أن الامتثال بالمأمور به لا يتحقق إلا بالإتيان به على وجهه المطلوب، و هذا لا يحصل إلا بالإتيان بالواجب واجبا و الندب ندبا، و بان الوضوء يقع تارة على وجه الوجوب و أخرى على الندب، و لما كان الفعل قابلا لأن يقع لكل منهما كان تخصيصه بأحدهما محتاجا إلى نية، لأن قصد جنس الفعل لا يستلزم وجوهه، فكل
فعل كان قابلا لأن يقع على وجوه متعددة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النية، و إلا فبدون ذلك لا يعد ممتثلا لأحدها، فمن أوقع مثلا ركعتين و لم ينو أنهما صبح أو نافلة لم يمتثل أحد الأمرين، إذ قصد التعيين لا إشكال في شرطيته و انه لا يتحقق الامتثال بدونه، إذ ليس في الروايات و لا في غيرها ما يدل على حصول البراءة بدونه، بل قد يشعر
قوله (صلى الله عليه و آله) «و انما لكل امرئ ما نوى» بوجوبه، على أنه قد استفاض عنهم (عليهم السلام) «أنه لا عمل إلا بنية» و لم يعلم كيفيتها و هي و إن كانت شرطا للعبادة و لكن الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط، و أيضا فالشك واقع في جزء النية فيجري عليها ما يجري عند الشك في جزء العبادة، لكونها لمعنى جديد إما حقيقة أو مجازا و هو غير معلوم.
و لا يخفى عليك ما في الجميع (أما الأول) فلأنه إن أريد بوجوب إيقاع الفعل على وجهه إيقاعه على الوجه المأمور به شرعا فمسلم، لكن كون النية المذكورة مما تعتبر شرعا أول البحث، و إن أريد به إيقاعه مع قصد وجهه الذي هو الوجوب أو الندب فهو ممنوع، و هل هو إلا مصادرة، و إن أريد به الإشارة إلى وجوب الاحتياط في العبادة فهو راجع إلى التأييد الأخير و ستسمع ما فيه.
(و أما الثاني) - فمع كونه خروجا عن النزاع أولا، لكون الكلام في وجوب نية الوجه لنفسه لا لكونه مقدمة للتعيين، فان التعيين قد يحصل بغير ذلك من القصد إلى ذات وضوء مخصوص و نحوه، و عدم اقتضائه الوجوب الغائي ثانيا - فيه ما قاله الشهيد في الروضة: «انه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب و الندب، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا، و بدونه ينتفي» لكن قد يقال عليه: ان التعدد قد يكون بزعم المكلف لجهل أو غيره، بل إن أراد بقوله لأنه في وقت الى آخره انه لا يصح أن يقع وضوء مستحب لغاية مستحبة فهو ممنوع و إن كان فيه خلاف، إلا أن الأقوى صحته، و لا منافاة بين وجوبه لغاية و استحبابه لأخرى في وقت واحد، و إن أراد ان وضوء تلك العبادة لا يكون حينئذ إلا واجبا فهو مسلم، لكن الأول كاف في حصول الإبهام المحتاج إلى التعيين، فالذي ينبغي ان يقال في المقام: انه لا إشكال في وجوب التعيين حيث يكون المكلف به متعددا نحو صلاة الصبح و النافلة، فإن الامتثال يتوقف عليه، و لأن صرف الفعل إلى واحد دون آخر ترجيح بدون مرجح، و الجنس لا يقوم بدون الفصل، إذ الفرض ان الأمر وقع بخاص، لكن هذا إذا كان المكلف به متعددا كل منهما غير الآخر إلا أنهما متفقان بالصورة، أما في مثل المقام فلا تعدد في المكلف به، إذ هو رفع حدث واحد، و كونه مطلوبا على جهة الاستحباب لغاية و على جهة الوجوب لأخرى لا يقتضي تعدده، و إلا لاقتضى وجوب ملاحظة خصوصيات الغايات مع انه لا قائل به، و استحباب التجديدي انما هو ترتيبي فلا اجتماع حينئذ، فلا يجب التعيين.
و أما ما يقال: ان التعدد قد يكون بزعم المكلف ففيه ما قد عرفت من أنه اشتراك لا يضر، فلو زعم المكلف جهلا منه مثلا ان وضوء الفريضة يكون على جهة الوجوب و يكون على جهة الندب و أوقعه بقصد الثاني أو لم يعينه مع قصده القربة فإن الظاهر أن وضوءه صحيح، لا يقال: ان
قوله (صلى الله عليه و آله): «لكل امرئ ما نوى» ينافي ذلك، لأنا نقول: الظاهر أن المراد منه معنى آخر من الإخلاص و كون الفعل لله أو لغيره، أو إذا كان المكلف به متعددا فتأمل و لاحظ.
نعم لو زعم المكلف جهلا منه أن ذمته مشغولة بوضوءين أحدهما وجوبي و الآخر استحبابي و أوقعه مع ذلك غير معين لأحدهما أو أوقعه بقصد فعل الاستحبابي يمكن القول بالفساد، لحصول الإبهام المحتاج الى التعيين، و هو مفقود في الأولى، و فاسد في الثانية، مع أنه لا يخلو أيضا من إشكال و تأمل إلا إذا لم يكن قاصدا للامتثال، و إلا فحيث يتحقق لا يبعد أن يقال: بالصحة فيهما معا و إن لم يعين في الأولى، لحصول التعيين في الواقع و ان أخطأ في الثانية، فتأمل جيدا. و أما الكلام في التأييد السابق ففيه أولا ان لفظ الوضوء ليس من المجملات حتى تجري فيه القاعدة المذكورة كما سيظهر لك من الأخبار البيانية[8] و ما يقال -: انه و ان لم يكن لفظ الوضوء منها لكن لفظ النية لاستعماله في معنى جديد غير معلوم لنا - يدفعه ظهور ان ليس للفظ النية معنى غير المعنى اللغوي، على انه ان سلمنا ان لها أو للوضوء معنى جديدا مجملا أمكن دعوى القطع أو الظن المعتبر بعدم دخول نية الوجوب أو الندب فيها أو فيه، لخلو الكتاب و السنة و كتب المتقدمين عن الإشارة إليها مع عمومية البلوى بها و احتياج الناس إلى ذلك في اليوم الواحد مرات متعددة، لكثرة العبادات من الواجبات و المستحبات المتكررة في كل يوم بالنسبة إلى أكثر الأشخاص فلو كان قصد الوجوب أو الندب معتبرا لأكثر الشارع من الأمر بالتعليم و التعلم، و لشاع في الأعصار و الأمصار، و اشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، و لخطبت بها الخطباء على رؤوس المنابر و نادت بها الوعاظ، مع انه لم يصل إلينا في ذلك خبر و لا أثر، بل الأخبار[9] الواردة في كيفية التعلم خالية عن الإشارة إلى شيء من ذلك، و مثله الكتاب العزيز مع بيانه حقيقة الوضوء بقوله تعالى[10]«إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ» الى آخره، و ما يقال: - ان الآية قد ترك بيان أكثر
شرائط الوضوء من إباحة الماء و المكان و نحوهما، فلعل النية من ذلك القبيل، على أن اعتبارها ليس في الوضوء وحده لتذكر فيه، بل هي في سائر العبادات - فيه مع أنه غير تام على القول بأنها شطر لا شرط أنه لا إشكال في دخولها في الكيفية و ان قلنا انها شرط، و ليس حالها كحال غصبية الماء و المكان و نحوهما كما لا يخفى، و كونها جارية في سائر العبادات لا يقتضي تركها عند بيان كيفية العبادة.
ثم انه على تقدير ذلك كان ينبغي ذكرها و بيانها في آية أو رواية مستقلة مع أنه لا شيء من ذلك، بل قد يظهر من بعض الروايات خلافه، فإنهم (عليهم السلام) لا زالوا يأمرون بالمستحبات بلفظ (افعل) الظاهر في الوجوب، بل يشركون بين الواجب و المستحب بلفظ واحد، و في بالي أن في
بعض الأخبار[11] أنه سأل أحد الأئمة (عليهم السلام) «عن شيء فأمره به، ثم جاءه في السنة الثانية فسأله عنه ثم أمره به ثم جاءه في السنة الثالثة فسأله عنه فأذن له في تركه» فهناك فهم أنه مستحب، بل مما يؤيد ما ذكرنا انه لا ريب في أن طاعتنا لله تعالى على نحو طاعة العبيد لساداتهم، و من المقطوع به ان أهل العرف لا يعدون العبد الآتي بالفعل الخالي عن نية الوجوب أو وجه الوجوب عاصيا، بل يعدونه مطيعا ممتثلا ممدوحا على فعله، و الحاصل صفة الوجوب و الندب من الصفات الخارجة عن تقويم الماهية، بل هما من المقارنات الاتفاقية و مثلهما القضائية و الأدائية و القصرية و التمامية و الزمانية و المكانية و نحو ذلك، على انه كيف يتم وجوب نية الوجه و عدم استحقاق الثواب إلا بها كالامتثال مع أنه في كثير من المقامات لا يعرف الفعل انه واجب أو مندوب لاشتباه موضوع أو اشتباه حكم، مع أن القول بالسقوط هنا مما لم يرتكبه ذو مسكة، كالقول بتحقق الامتثال حينئذ، و قصدهما على سبيل الترديد غير مفيد، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في عدم وجوب نية الوجوب و الندب أو وجههما لا قيدا و لا غاية، نعم نقول: بوجوب ذلك حيث يتوقف عليه التعيين، لعدم حصول الامتثال حينئذ إلا به، بل لعل مراد من اشترط ذلك ذلك كما يقضي به بعض أدلتهم، لكنك قد عرفت انه لا اشتراك في الوضوء يوجب ذلك، لا يقال: ان جميع ما ذكرت أقصى ما يفيد الظن بعدم الوجوب لكنه ليس ظنا منشؤه آية أو رواية، بل هو من أمور خارجة عن الأدلة الأربعة، مع عدم القول بان كل ظن حصل للمجتهد حجة، لأنا نقول: - بعد إمكان منع ذلك لرجوع بعض ما ذكرنا إلى الأدلة المعتبرة - انا نمنع عدم حجية كل ظن حصل للمجتهد بالنسبة إلى موضوع العبادة و إن منعناه في أصل الحكم، لمكان كونها من الموضوعات التي يكتفى فيها بالظن، فتأمل جيدا.
بقي شيء و هو ان اللازم مما ذكرنا عدم وجوب نيتهما، أما لو نوى كلا منهما في مقام الآخر جهلا أو غفلة لا تشريعا فربما ظهر من بعضهم بطلان الوضوء حينئذ، و احتمل تنزيل كلام المعتبرين لاشتراط نية الوجه عليه، و للنظر فيه مجال، إذ قد يقال: انه بعد تحقق قصد الامتثال بالعبادة و تشخصها و الفرض انها مطلوبة للشارع مرادة، فنية انها واجبة و هي مستحبة أو بالعكس لا يؤثر في ذلك فسادا، و مثل ذلك جميع الصفات الخارجية التي هي من المقارنات الاتفاقية بعد تشخيص أصل المكلف به كما هو واضح لمن تأمل، نعم قد يقال: بحصول الاشكال فيما لو جهل جعل صفة الوجوب أو الاستحباب مشخصة لما زعم تعدده جهلا مثلا كما تقدمت الإشارة إليه سابقا، و الله أعلم.[12]
[1] الوسائل - الباب - ٦ و ٧ - من أبواب مقدمة العبادات.
[2] ظاهراً تصحیف کلمه جدیدا است همان طور که در جواهر طبع جدید هم جدیداً ضبط شده است.
[3] الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب مقدمة العبادات - حديث ١.
[4] الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب مقدمة العبادات - حديث ٢.
[5] الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب مقدمة العبادات - حديث ١٠.
[6] الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب مقدمة العبادات - حديث ٢.
[7] الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب مقدمة العبادات.
[8] الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب الوضوء.
[9] الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب الوضوء.
[10] سورة المائدة - الآية ٨.
[11] الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب نواقض الوضوء - حديث ٩.
[12] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ، جلد: ۲، صفحه:۷۵- ۸۵