الابطال بقدر الضروره
١.اصول متقابله
الف) اصاله الفساد؛ اصاله الصحه
اصاله الفساد در معاملات
وحید بهبهانی
رسالة في أصالة عدم الصحّة في المعاملات
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين، اللّهم إيّاك نعبد، و إيّاك نستعين و نستهدي، فلا تكلنا إلى أنفسنا القاصرة.
اعلم! أنّ الصحة في المعاملات عبارة عن ترتّب أثر شرعي عليها، و هي حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي، فلو لم يكن دليل فالأصل عدم الصحّة حتّى يثبت بدليل، لأصالة العدم، و أصالة بقاء ما كان على ما كان.
مثلا: الثمن كان ملكا للمشتري، و المبيع ملكا للبائع، فالأصل عدم النقل و الأصل بقاؤهما على حالهما حتّى يثبت الخلاف، للاستصحاب و العمومات و الإطلاقات المقتضية لذلك، و الإجماع على ذلك، كما لا يخفى على المطّلع.
و أيضا، الحكم الشرعي بالنسبة إلينا منوط بالدليل بلا شبهة، فعدم الدليل دليل عدمه بالنسبة إلينا، لأنّ عدم العلّة علّة للعدم
و أيضا، الأصل براءة الذمّة عن لزوم أمر من الأمور الشرعيّة و آثارها.
و أيضا، ورد في الكتاب و السنّة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع، مثل آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ و غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.
و أيضا، إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك، سيّما الفرقة الناجية.
و بالجملة، لا تأمّل في أنّ الأصل عدم الصحّة حتّى تثبت بدليل.
فإن قلت: الفقهاء يقولون: الأصل الصحّة.
قلت: مرادهم منه العمومات الدالّة على الصحّة مثل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و غيره، و لا شكّ في أنّه إذا دلّ عموم على الصحّة تكون صحيحة البتّة، فالعموم دليل، و الكلام في أنّه ما لم يكن دليل على الصحّة فالأصل عدمها.
فإن قلت: فأيّ فائدة في هذا الأصل بعد تحقّق العموم؟
قلت: الفائدة أنّه كثيرا ما لا يثبت الصحّة من العموم، مثلا: إذا أردنا إثبات صحّة بيع من عموم أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ،فلا شكّ في أنّ إثباتها يتوقّف على أمور:
الأوّل: ثبوت كون ذلك بيعا حقيقة في اصطلاح الشرع، فيحتاج إلى استفراغ الوسع، و بذل الجهد بحسب الطاقة في تحصيل اصطلاح الشارع و ما هو الحقيقة في محاوراته في ذلك الزمان، فلا يمكن الإثبات لغير المجتهد.
و أمّا المجتهد، فإن حصّل الاصطلاح فذلك، و إن لم يحصّل- كما هو الظاهر من أنّه لا يحصّل- فلا بدّ من تحصيل المعرفة بكونها بيعا حقيقة، عرفا أو لغة، و المعرفة إنّما تكون بالأمارات المذكورة في أصول الفقه، إذ مجرّد إطلاق البيع عليه لا يقتضي أن يكون حقيقة، لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة عند معظم المحقّقين من الفقهاء، و المجاز خير من الاشتراك عندهم.
مع أنّ الاشتراك أيضا لا ينفع مجرّدا عن القرينة بالنسبة إلى اللفظ، كما أنّ المجاز لا ينفع بالنسبة إلى اللفظ مجرّدا عن القرينة، فلا يتأتّى الإثبات من هذه الجهة أيضا إلّا للمجتهد العارف بالأمارات الأصولية، و حجّية تلك الأمارات.
مع أنّه ربّما لا يتأتّى في موضع أمارة من تلك الأمارات، فلا يثبت الصحّة.
و إذا تحقّق الأمارة، و ثبتت الحقيقة العرفيّة أو اللغويّة، فلا يكفي ذلك ما لم يضمّ إليه أصالة عدم التغيّر و التعدّد، حتّى يثبت كون ذلك اصطلاح الشارع أيضا، لأنّ المعتبر هو اصطلاح زمان صدور ذلك الكلام، كما هو الظاهر و محقّق في موضعه.
و ربّما لا يتأتّى أصالة عدم التعدّد و التغيّر، لثبوت التعدّد، أو ظهور التغيّر مع عدم مرجّح و معيّن.
الثاني: ثبوت كونه من الأفراد المتعارفة للبيع الحقيقي، لأنّ المفرد المحلّى باللام غير موضوع للعموم، فالعموم الحاصل منه لا يزيد عن الأفراد المتعارفة ، و لا يشمل الفروض النادرة.
مع أنّه على تقدير كون عمومه من قبيل عموم الموضوع للعموم، فربّما يتأمّل في شموله للفروض النادرة أيضا، فتأمّل.
الثالث: ثبوت أنّ الحلّية تستلزم الصحّة في المقام، و الظاهر ثبوته كما لا يخفى على المتأمّل، إذ ظاهر أنّ المراد ليس حلّية قراءة صيغة البيع، بل المراد حلّية نفس البيع، و هو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان الانتقال و اللزوم، فاللّه تعالى قرّرهم على ذلك، فتدبّر.
الرابع: عدم تحقّق نهي من الشارع عليه السّلام عن الّذي يراد إثبات صحّته، لا بعنوان الخصوص و لا بعنوان العموم.و المناهي الخاصّة لا ضبط لها، بل هي مذكورة في مواضعها، و أمّا العامّة فسنشير إليها.
فساد المعاملة بالنهي
و إنّما قلنا: عدم تحقّق نهي من الشارع لأنّ الفقهاء منهم من يقول: بأنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد- و هم الأقلّون - فالمعاملة المنهي عنها فاسدة عندهم البتّة.
و أمّا القائلون بعدم اقتضائه الفساد فيها- و هم الأكثرون - فإنّهم يقولون بذلك فيما إذا ثبت صحّته من دليل لا ينافيه النهي، و لا يضاده التحريم.
فإذا لم يثبت صحّته أصلا لم يكن صحيحا، مع قطع النظر عن ورود النهي عنه، فكيف إذا ورد النهي عنه؟! إذ لا شكّ في فساد مثله عندهم، لما عرفت،و كذا إذا ثبت صحّته من خصوص مثل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ ، لأنّ الحلّية تنافي النهي و الحرمة، و كذا وجوب الوفاء.
و كذا استثناء قوله إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ ، لأنّه استثناء من النهي و الحرام.
فظهر أنّ النهي في مثل ذلك أيضا يقتضي الفساد عندهم بلا شكّ و لا شبهة، إذ النهي يقتضي خروج ذلك عن العمومات عندهم، كما لا يخفى على المطّلع على أقوالهم و طريقتهم، فإنّهم صرّحوا بأنّ الأحكام الخمسة متضادّة، و أنّ اجتماع الضدّين في الحكم الواحد من المحالات عندهم، و إن تعدّدت الجهة و الحيثيّة و ظهر ذلك التعدّد، مع أنّه ربّما لا يظهر ذلك فيما نحن فيه، فتدبّر.
نعم، لو كان الصحّة ثابتة من غير أمثال العمومات المذكورة، فالنهي لا يقتضي الفساد، لأنّ الصحّة عبارة عن ترتّب أثر شرعي، فلا ينافي ذلك النهي و الحرمة، لأنّ الحرام كثيرا ما يترتّب عليه الآثار الشرعيّة، فإنّ الشارع مثلا قال: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل و المهر و العدّة و الرجم و غير ذلك ، و إذا دخل أحد بزوجته و هي حائض- مثلا- عالما عامدا يكون حراما بلا شبهة، و مع ذلك يجب عليه المهر كاملا و عليها العدّة، و عليهما الغسل.
لكن يتداخل الغسلان في الحائض على القول بالتداخل، و كذا يترتّب عليه سائر ما يترتّب على الدخول بالزوجة، و كذا الحال في الدخول بالأجنبية.
و غير ذلك من المعاملات و أحكامها، فتدبّر.
فساد العبادات بالنهي
أمّا العبادات، فجلّ الشيعة- بل كاد أن يكون كلّهم- اتّفقوا على أنّ النهي فيها يقتضي الفساد لأنّ الصحّة فيها عبارة عن موافقة الأمر، و ما هو مثل هذا المعنى، و العبادة أمر راجح و مأمور به قطعا، و المرجوحيّة ضدّه، فضلا عن أن يكون حراما.
و لذا يقولون: إنّ العبادة المكروهة معناها أنّها أقلّ ثوابا و إلّا فهي راجحة عندهم من دون مرجوحيّة، و ربّما يقولون: إنّ الكراهة تتعلّق بما هو خارج عن نفس العبادة أو جزئها أو شرطها.
و من هذا حكم بعضهم بصحّة مثل البيع وقت النداء، مصرّحا بأنّ النهي تعلّق بأمر خارج و هو ترك السعي إلى الجمعة و الاشتغال عنها.
الخامس: تحقّق شرائط مورد البيع، فإنّ البيع هو نقل ملك عين إلى آخر بعنوان المبايعة العرفيّة أو اللغويّة أو الاصطلاحيّة على حسب ما مرّ.
و ربّما زيد على ذلك كونه بصيغة مخصوصة و ربّما قيل بأنّ البيع هو نفس تلك الصيغة و ربّما قيل: يتحقّق البيع في المنفعة أيضا فلا بدّ من معلوميّة كون المبيع- مثلا- ممّا يملك شرعا، و معلوميّة الإذن في النقل شرعا و معلومية تحقّق النقل و الخروج من ملك البائع، و معلوميّة تحقّق الدخول إلى ملك المشتري و عدم المانع من الخروج و الدخول شرعا، و معلوميّة أنّ الصيغة هل هي معتبرة شرعا أو لغة أو عرفا أو هي نفس البيع، أو ليست بمعتبرة أصلا، و غير ذلك.
و بالجملة، الحكم بتحقّق الصحّة، و ترتّب الآثار شرعا، مثل الانتقال بعنوان اللزوم أو الجواز، و غير ذلك من الآثار الشرعيّة يتوقّف على الثبوت من الشرع، و من لوازم الانتقال تعيّن الشيء بحسب الواقع، إذ غير المعيّن كيف ينتقل؟! نعم، يتحقّق الانتقال في الأمر الكلّي الّذي هو قدر المشترك بين أفراده و الكائن مع مشخّص، و هو معيّن و التشخصات خارجة، و شروط لتحقّقه.
و أمّا التعيّن عند المتبايعين، فلعلّه يرجع إلى الغرر و السفه و كون الشيء معرضا للنزاع بين المسلمين و الناس.
و ربّما يظهر النهي عن مثله من الأخبار، مثل ما ورد في باب السلف و بيع التمر و بيع الدينار غير الدرهم ، و غير ذلك، فليلاحظ و ليتأمّل.هذا، مع ادّعاء الإجماع فيما ادّعوه فيه، فتأمّل.
المناهي العامّة
ثمَّ اعلم أنّ المناهي الواردة بالعنوانات العامّة عندهم، مثل النهي عن بيع الغرر و الضرر و المسكر و الخبائث و الميتة و ما لا منفعة معتدّا بها له، لأدائه إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دلّ على فساد معاملة السفيه و حرمتها .
و كذا النهي عن بيع الحرام، لما ورد من أنّ اللّه تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ، و لعلّه يظهر ذلك من فحاوى الأخبار أيضا .
و كذا النهي عن البيع الّذي هو إعانة في الإثم ، و الّذي هو إسراف ،
و بيع النجس الّذي لا يقبل الطهارة إلّا الدهن للاستصباح أو أعمّ منه، أو العذرة أيضا كما قال به بعض المتأخّرين ، و ربّما يظهر هذا النهي من إجماعهم و فحاوى الأخبار ، فليلاحظ.
و كذا يظهر من كلام القدماء أيضا، فلينظر.
و قس على ما ذكرنا حال الإجارة و غيرها، فتأمّل.
و من المناهي العامّة، قول المكلّف: لا أفعل إلّا بالعوض، فيما ثبت وجوب عطائه عينا كان أو منفعة، عينيّا كان الوجوب أو كفائيّا، إذا كان الوجوب من مثل الخطاب بأفعل مطلقا، لأنّ القول بأنّي لا أفعل إلّا بالعوض عصيان، كأن يقول: لا أصلّي اليوميّة، أو: لا أصلّي على هذا الميّت إلّا أن تعطوني اجرة.
و أمّا ما ثبت وجوبه لأجل حصول النظام و رفع الضرر، مثل الصناعات، و وجوب بيع الأعيان المحتاج إليها، عينيّا كان الوجوب- كما هو الحال في الفروض النادرة- أو كفائيّا- كما هو الحال في الفروض الشائعة- يجوز أخذ العوض، لأنّ القدر الثابت من العقل و النقل هو القدر المشترك بين الإعطاء مجّانا و بلا عوض و الإعطاء بالعوض.
بل الثابت منهما بعنوان الضرورة أو اليقين جواز الإعطاء بالعوض و عدمه بغير العوض، إلّا في فرض نادر غاية الندرة لو تحقّق، و هو عدم تمكّن المحتاج المضطرّ من العوض حالّا و لا مؤجّلا بوجه من الوجوه، فإنّه حينئذ يجب الإعطاء بغير العوض، إلّا أنّه له أن لا يعطي ما لم يشتره منه فيحسبه مكان زكاته و أمثالها، و إن لم يشتره فله أن يجبره بالشراء بوساطة حاكم الشرع إن كان، و إلّا فبالمؤمنين حسبة، و إن لم يكونوا فله أن يعطي بقصد العوض و يأخذه قهرا حفظا إيّاه عن الهلاك.
على أنّ النظام لا يحصل في غير صورة نادرة، إلّا بجواز أخذ العوض و عدم الإعطاء بغير العوض[1].
رسالة في أصالة الصحّة و الفساد في المعاملات
بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على أشرف الخلق محمّد و آله الطاهرين.
أمّا بعد، فيقول الأقلّ الأذلّ، محمّد باقر بن محمّد أكمل عفى اللّه عنهما:
فاعلم يا أخي، أنّ المهم و المقصود الأصلي في المعاملات هو الصحّة و الفساد. في كثير من المواضع يحكم الفقهاء بالفساد، و الغافل عن حقيقة الحال إذا رأى دليلا على الفساد يقبل، و إذا لم ير يطعن على الفقهاء، و يقول بالصحّة، مدّعيا أنّ الأصل هو الصحّة حتّى يثبت خلافه فلم يثبت، و لا يتفطّن بأنّ الأصل عدم الصحّة لا الصحّة، لأنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي، فهي حكم شرعي بل ربّما يكون أحكاما شرعيّة إذا كان المترتّب آثارا شرعيّة، كما هو الغالب.
و لا شبهة في أنّ الحكم الشرعي موقوف على الدليل الشرعي فيما لم يكنالحكم شرعيّا.
على أنّه إذا كان الأصل هو الصحّة، يلزم أنّ يكون كلّ من يعامل معاملة يكون شارعا أو شريك الشارع في الشرع و التشريع، و أن لا يكون التشريع حراما.
فإن قلت: الفقهاء يستدلّون بأصالة الصحّة.
قلت: يتمسّكون بها في موضع ثبت حكم من الشرع صحّة و فسادا، و لا يدري أنّ الواقع من المسلم هل يكون من الصحيح، أو الّذي ثبت فساده، فيقولون: الأصل صحّة ما وقع منه، حملا لتصرّف المسلم على الصحّة، و هو إجماعي، و ظاهر من الأخبار و أمّا إذا لم يعلم حكم شرعا، فكيف يمكنهم القول بأنّ الأصل ثبوت الحكم شرعا إلى أن يثبت عدم ثبوته شرعا؟! فإن قلت: ربما نراهم يتمسّكون بهذا الأصل، فما لم يعلم حكمه يثبتون به حكمه.
قلت: لعلّ المراد من الدليل مثل العمومات. و لو ظهر أنّ مرادهم غيره، فلا شبهة في توهّم المتمسّك، إلّا أن يريدوا منه مجرّد قراءة صيغة تلك المعاملة، و إعطاء كلّ واحد من المتعاملين ما له بطيب نفسه منه، فمنعهما عن الأمرين تكليف لم يثبت من الشرع، و الأصل عدمه، و الأصل براءة ذمّتهما.مع أنّ «الناس مسلّطون على أموالهم»، كما ورد في النصّ ، و ورد أيضا «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه»
لكن ليس هذا صحّة المعاملة، إذ لم يترتّب على المعاملة أثر أصلا، مثل نقل الملك و لزومه و غير ذلك، بل العوضان باقيان على حالهما السابق من أنّ كلّ واحد منهما يتصرّف الآخر في ماله ليس بمعاملة فإنّ ثمرة البيع هي النقل و غير ذلك ممّا هو معروف.
فظهر ممّا تلوناه، أنّ الأصل في المعاملة الفساد و عدم الصحّة، إلّا أن يثبت الصحّة بدليل، من إجماع أو نصّ خاص أو عام، مثل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أمثاله.
فإن قلت: غاية ما ثبت ممّا ذكرنا أنّ الصحّة لا يثبت إلّا بدليل، لأنّ الأصل الفساد، و عدم الصحّة، لأنّ الفساد شرعا أيضا يحتاج إلى دليل شرعي، فكيف يكون الأصل الفساد؟! قلت: قبل وقوع المعاملة المشكوكة حالها كان الثمن مال المشتري و المبيع مال البائع، و لم يكن خيار و أمثال ذلك من مراتب البيع، فالأصل بقاء الكلّ على ما كان عليه و عدم تحقّق تغيّر أصلا، و لا يترتّب أثر مطلقا، و هذا عين الفساد.
و أصالة البقاء إجماعي، مضافا إلى استصحابه و ظهوره من الأخبار ، مع أنّ عدم الدليل دليل عدم الحكم عندنا، كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعيّة، فتأمّل.
و الحاصل، أنّ فساد المعاملة لا يحتاج إلى دليل، بل الأصل الفساد، و إنّما المحتاج إليه هو الصحّة، و دليلها غالبا هو العمومات، أو الإطلاقات.
و لا بدّ أن تكون المعاملة فردا حقيقيّا للعام، فمجرّد إطلاق لفظه عليها لا يكفي، لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، فلا بدّ من مراعاة أمارات الحقيقة، و أن يكون من الأفراد المتبادرة المتعارفة للعام إن كان الاستدلال من الإطلاقات، لانصرافها إلى الأفراد المتعارفة و الشائعة، بل و إن كان الاستدلال بالعمومات أيضا، على إشكال.
و لا بدّ أن يكون الأمران بالنسبة إلى اصطلاح زمان الشارع و لسانه، و لو كان بكونه من أصالة العدم و البقاء، و ما ماثلها في موضع يجري فيه[2].
شیخ جعفر کاشف الغطاء
المطلب الثاني في أنّ الشكّ إذا تعلّق بصحّة عبادة أو معاملة، و كذا جميع المؤثّرات من إحياء موات، أو حيازة، أو سبق إلى مشترك كوقف عام، و غيرها، حكم بالفساد؛
لأنّ الأصل عدم فراغ الذمّة، و عدم الاستحقاق، و عدم الآثار، إلا أن يقوم دليل على صحّتها، و أمّا بعد ثبوت الأصل و حصول الشكّ في غيره فعلى أقسام:
أوّلها: الشكّ في بعضيّة الأبعاض، كالشكّ في أنّ السورة، أو التسبيحة الثانية أو الثالثة عوض القراءة، و في الركوع و السجود أجزاء مقوّمة أو لا، و أنّ القبول جزء من الإقالة و الوصيّة، أو اللفظ جزء من البيع، و باقي العقود المتعلّقة بالمال أو لا، مثلًا.
و الحكم في الجميع بطلان العبادة و المعاملة، مع عدم الإتيان بذلك المحتمل؛ لأنّ الأصل عدم تحقّق الحقيقة، فالشكّ فيه شكّ فيها، و الشكّ فيها شكّ في شمول دليلها لها، فيرجع إلى القسم الأوّل، و هو الشكّ في الأصل.
و الحاصل أنّه إذا تعلّق الشكّ في أجزاء الأقوال، كما إذا تعلّق باسم شخص، أو نوع، أو اسم عقد أنّه مركّب من كلمتين فما زاد، أو غير مركّب، فلا معنى لتمشية الأصل فيه؛ لأصالة عدم الدخول في الاسم، و لأنّ اللغة إنّما تثبت بطرق مخصوصة، و ليس أصل العدم منها.
و متى كان الشيء يحتمل أنّه جزء المعنى، أو خارج عنه، قضي بجهل تحقّق الحقيقة، و الأصل عدمها.
ثانيها: الشكّ في شرطيّة الشروط و مانعيّة الموانع في المعاملات المبنيّة و نحوها ممّا لا يدخل في العبادات بالمعنى الأخصّ.
و مقتضى القاعدة نفيها بالأصل؛ لأنّ الشروط و الموانع فيها خارجة بنفسها و تقييدها عن تقويم حقيقتها؛ لأنّ أسماءها موضوعة للأعمّ من صحيحها و فاسدها؛ إذ ليس لأكثرها أوضاع جديدة، بل هي باقية على حكم وضع اللغة، و ليس فيه تخصيص بالصحيح، و لو ثبت في بعضها الوضع الجديد فالظاهر منه عدم التقييد.
و لو فرض في بعضها وضع جديد دخل فيه التقييد، ساوت العبادة في تمشية الأصل.
ثالثها: الشكّ في شروط العبادة بالمعنى الأخصّ من بدنيّة، أو ماليّة، أو جامعة للصّفتين و الذي يظهر من تتبّع محالّها و قضاء الحكمة فيها و الفهم عند إطلاقها، و صحّة سلبها، و ثبوت دورانها ، أنّها موضوعة للصحيح منها، فإنّا نرى صدق الاسم دائراً مدار الصحّة فلو أتى بالأجزاء تماماً مع الإخلال بشرط، أو الإتيان بمانع، لم يدخل تحت المصداق، و ترتّب عليه حكم التارك.
و لو خلت عن الأجزاء و الأركان، كلا أو جُلا، مع الصحّة بقي صدق الاسم و مفسد العمل يصحّ الإطلاق مع وجوده في الجهل، و هكذا.
و إذا كانت الصحّة قيداً في صدق الاسم كان التقييد داخلًا، فإذا حصل الشكّ في القيد جاء الشكّ في التقييد، و يرجع إلى حكم الشكّ في الجزء الراجع إلى حكم الشكّ في الأصل.
و الظاهر أنّه لا اعتبار لمطلق الشكّ، فليس مجرّد احتمال الشرطيّة أو الشطريّة قاضياً بالثبوت، و إلا لزم عدم إمكان معرفة حقائق العبادات و المعاملات.
فيخصّ هذا الأصل بالإجماع بشكّ جاء من اختلاف الأدلّة، أو اختلاف كلمات الفقهاء، بحيث يحصل شكّ معتبر؛ و بذلك يحصل الجمع بين كلماتهم في قبول هذا الأصل مرّة، و إنكاره مرّة.
ثمّ وجوب الإتيان بالمحتمل موقوف على الاطمئنان بعدم ترتّب الفساد بالإتيان بالزيادة، و إلا عارض الأصل مثله، و تساقطا، و رجع إلى أصل الفساد.
و العبادات و أجزاؤها الموضوعة وضع المعاملات حكمها في إجراء الأصل حكمها، كما في الأذكار، و الدعوات، و التعقيبات، و الزيارات، و التسبيحات في الركوع و السجود، و الغسل و المسح و نحوها.
و إذا دار العمل بين العبادات و غيرها، رجع إلى الشكّ في الجزء، فيحكم بكونه
عبادة، كالشكّ بين المعاملات و الأحكام، و بين العقود و الإيقاعات، و بين الإيقاعات و الأحكام، فإنّ الأوّلة مقدّمة على الأخيرة؛ لرجوع ذلك إلى الشكّ في الأجزاء.
و ما شكّ في ركنيّته ركن في العمد و السهو؛ و ما قام الدليل على عدم ركنيّته في السهو يحكم بركنيّته في العمد، هذا كلّه إذا تعلّق الشكّ بأجزاء المركّب.
أمّا الشكّ في الجزئيّات من القليل و الكثير، فالأصل نفي الزائد فيها، إلا في مثل ما يترتّب نفي الزائد فيه على وقوع الفعل سابقاً كالمقضيّات، فإنّ الأصل فيها يقتضي البناء على الكثير، ما لم يدخل في قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت.
و لو لا قيام الدليل على هذا التقدير بالاجتزاء بحصول المظنّة في البراءة لقلنا بلزوم التكرار حتّى يحصل اليقين[3]
اصاله الصحه در معاملات
میرزای قمی
المقدّمة الأولى: في تحقيق معنى قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و استدلال الفقهاء به في تصحيح العقود و لزومها، فإنّهم قد تداولوا ذلك في جميع الأعصار و الأمصار.
و قد يستشكل بأنّ المراد إن كان ما يسمّى عقدا لغة، فيلزم أن يكون كلّما يخترع و يصدق عليه أنّه عقد يجب الوفاء به. و التخصيص بالصحيحة منها يستلزم التخصيص الغير المرضيّ، فإنّ الباقي في جنب المخرج كالمعدوم.
و إن أريد العقود المتداولة المتعارفة في زمان الخطاب، فهي غير معلومة.
و يمكن دفعه بأنّ العقود المتعارفة المتداولة في زمانها من البيع و النكاح و الصلح و الهبة و الإجارة و نحوها ممّا ذكره الفقهاء لا ريب فيه تعارفها و تداولها في ذلك الزمان أيضا. و إنّما هي المتداولة في زماننا هذا، و الأصل عدم التغيير.
و استدلالاتهم ترجع إلى إثبات هذه العقود، و يتمسّكون بها في تصحيح هذه إذا شكّ في اشتراط شيء فيها، أو وجود مانع عن تأثيرها، و نحو ذلك، لا تصحيح عقد برأسه.
و أمّا مثل شركة الأبدان و المغارسة و الشغار و نحو ذلك، فإن لم تجعل من أقسام هذه العقود بأنّ بطلانها من جهة فقدان شرط أو وجود مانع، فلا يلزم من إخراجها التخصيص الغير المرضيّ، كما لا يخفى.
و الظاهر أنّ المراد بالإيفاء بالعقد العمل على مقتضاه ما دام باقيا، فلا ينافي وجوب الإيفاء كون بعض العقود جائزا كالشركة و المضاربة و نحوهما.
و بالجملة، الظاهر أنّه ليس من الأمر وجوب نفس العقود، كما لا يخفى، و لا وجوب الالتزام بها أبدا؛ لجواز الفسخ في اللازمة منها بالتقايل و الطلاق أو غيرهما و كذا في الجائزة، فالمراد هو وجوب الإيفاء على مقتضاها ما دامت باقية على حالها.
بيان معنى الآية
ثمّ إنّ الظاهر أنّ المخاطب بالآية كلّ واحد من المكلّفين على ما هو التحقيق من إفادة صيغة الجمع العموم الأفرادي، لا المجموع من حيث المجموع.
فحينئذ، يلزم التجوّز في العقود بإرادة أحد طرفي العقد من الإيجاب و القبول؛ إذ لا يصدر من كلّ واحد إلّا أحدها، إلّا مع تعدد الحيثيّة، كما لو اتّحد الموجب و القابل، فيكون من باب أَوْفُوا بِالْعَهْدِ و يُوفُونَ بِالنَّذْرِ و يكون المراد الإيفاء على مقتضى الإيجاب أو القبول.
أو المراد وجوب الإيفاء على مقتضى نفس العقد الحاصل من الإيجاب و القبول، فلا يكون من باب أَوْفُوا بِالْعَهْدِ و يُوفُونَ بِالنَّذْرِ.
و على أيّ تقدير، فيصحّ الاستدلال بها على صحّة الفضولي.
و لا يرد أنّه لا معنى لوجوب إيفاء البائع فضولا على مقتضى بيعه، فإنّ الإيفاء على الاحتمال الثاني، واضح بعد تمامه بالإجازة، و كذلك على الأوّل؛ لأنّ مقتضى إيجاب البائع فضولا العمل على مقتضى بيعه، و يجب عليه أن يعتقد كون المبيع مال المشتري بعد إجازة المالك، و تترتّب عليه ثمرته.
هذا ما حقّقته في سالف الزمان في وجه الاستدلال بالآية.
و لكن الّذي يظهر لي الآن بعد التأمّل أنّ ذلك لا يخلو من إشكال بملاحظة ظاهر اللفظ، و أنّ الجمع المحلّى حقيقة في العموم لا العهد، و بملاحظة تداول العلماء الاستدلال بذلك على الإطلاق، و بملاحظة عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ العقد، و هو في الأصل الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال.
بيان معنى العقد
و المراد بالعقد هنا: العهد الموثّق على سبيل المجاز، تسمية المعلّق باسم المتعلّق، فالعقد هو التوثيق و التسديد في الأصل، و هو يتعلّق بالعهد و غيره.
قال الجوهري: «عقدت الحبل و العهد و البيع فانعقد»
فالمراد بالعقود هنا العهود الموثّقة، كما صرّح به جماعة من المفسّرين .
و يمكن دفع الإشكال الأوّل مع التزام إرادة مطلق العقود و العهود الموثّقة؛ مراعاة للمعنى اللغوي بأنّ لزوم التخصيص الغير المرضيّ لو سلّمنا أكثريّة الغير المتداولة في الشرع، إنّما هو إذا أريد بعموم العقود العموم النوعي، و هو خلاف التحقيق، بل المراد هو العموم الأفرادي.فإذا لوحظت الأفراد، فلا ريب أنّ أفراد العقود المتداولة أكثر من أفراد غيرها، سيّما في مثل البيع و الإجارة و النكاح.
فبعد منع ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ العقد يبقى على عموم المعنى اللغوي.
فكلّما ثبت بطلانه بدليل كالميسر و الأزلام و الربا و الرهان بغير ما جوّزوه في محلّه و المغارسة و نحوها، فيخرج و يبقى الباقي.و إلى ذلك ينظر استدلالهم بهذه الآية في لزوم العقود اللازمة.
فالجواز في مثل الوكالة و المضاربة و الشركة و نحوها إنّما ثبت بالمخصص، و إلّا لقلنا باللزوم فيها أيضا.
و لذلك تأمّل بعضهم في بطلان شركة الأبدان و الوجوه و نحوهما لو لم يكن إجماع فلا يلزم وجود الدليل في كلّ واحد من خصوصيات العقود صحّة و لزوما، بل المحتاج إليه الفساد و الجواز.
و لا بدّ في هذا المقام من معرفة أنّ الصحّة الّتي هي من أحكام الوضع تتوقّف على التوظيف من قبل الشارع.
و كون الأصل إباحة العقد أو براءة الذمّة عن العقاب و المؤاخذة على معنى آخر لا يستلزم ترتّب الأثر الذي هو معنى الصحّة المبحوث عنه هنا؛ فإنّ مقتضى أصل الإباحة و البراءة و إن كان جواز المعاهدة و المعاقدة و جعل الآثار مترتّبة عليها عند العباد، و لكنّه لا يثبت بمحض ذلك عدم انفكاك الآثار عن المؤثّرات، و لزوم الوفاء بها بحيث لو تخلّفوا عنها كانوا معاقبين.
و أمّا بعد ثبوت تجويز ذلك الجعل من الشارع: فيلزم ترتّب الآثار على المؤثّرات، و لا يجوز التخلّف.
فمعنى الصحّة التي هي حكم من أحكام الوضع هو حكم الشارع بلزوم الترتيب.
نعم، قد يلزم الترتيب بدون حكم الشارع أيضا فيما استقل به العقل في الحكم بلزومه، كردّ الوديعة و أداء الدين، و لكنّه أيضا من الأحكام الوضعيّة الثابتة من الشرع بلسان العقل إذا حكم العقل بالاستقلال من جملة الأدلّة الشرعيّة فتظهر ثمرة توقيفيّة الأحكام الوضعيّة فيما لم يستقلّ بحكمها العقل.
فلو فرض أنّ أهل العرف قد واضعوا البيع، و جعلوا من آثاره تملّك كلّ من المتبايعين ما كان في يد الآخر، و لما يبلغ من الشرع الحكم بذلك الترتّب و لزومه، فيجوز ردّ كلّ منهما ما في يده إلى الآخر مع استرداد ما كان له أوّلا بدون رضا الآخر، فمقتضى أصل البراءة و الإباحة جواز المعاقدة، و جواز اعتقاد التملّك بها، و جواز التصرّف المالكي في كلّ من الطرفين.
و أمّا ثبوت الملكيّة الواقعيّة في نفس الأمر، و عدم جواز الأخذ منه مع ردّ عوضه إليه بدون رضاه و أمثال ذلك: فيتوقّف على حكم الشرع، و هو معنى الصحّة[4].
صاحب عناوین
العنوان السابع و العشرون [في بيان أصالة الصحة في العقود
عنوان 27 قد تقرر: أن الأصل في المعاملات كالعبادات الفساد، بمعنى عدم ترتب الأثر شرعا، لأن ترتبه عليه أمر توقيفي يحتاج إلى ثبوته من الشرع، فما لم يثبت فالأصل عدمه. و الظاهر: أن كون البناء على أصالة الفساد في كل ما شك في ورود دليل على صحته مجمع عليه فيما بينهم، و إنما البحث في أنه هل يثبت قاعدة كلية تدل على الصحة أم لا؟
فنقول: الشك في الصحة و الفساد تارة يكون في نفس الحكم الشرعي، كالشك في صحة الصرف من دون قبض، و الوقف بدون قصد القربة، و نحو ذلك، و إليه يرجع الشك في الموضوع المستنبط، لأنه راجع إلى معرفة مفاد الدليل، فيكون الشك في شمول اللفظ لذلك الفرد المشكوك مؤديا إلى الشك في حكمه، لا بمعنى كون الشك مسببا عنه، بل بمعنى بقائه على ما كان سابقا قبل قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و شككنا في أن البيع هل يعم ما وقع بلفظ (ملكت) أو ما وقع بالمعاطاة، أم لا؟ و لازم ذلك بقاؤهما مشكوكي الحكم كما كانا قبل ورود الدليل،لعدم وجود دليل واضح يدل على صحتهما، فيرجعان إلى أصالة الفساد لو لم يثبت قاعدة أخرى. و بالجملة: الشبهة في الموضوع المستنبط راجع إلى الشك في الحكم. و تارة يكون في الموضوع الصرف، كما إذا وقعت معاملة في الخارج و نحن نعلم أنها لو وقعت على الطريق الفلاني لكان صحيحا شرعا، و لو وقعت على طريق آخر مثلا كانت فاسدة، و لكن لا ندري أنها وقعت بأي الطريقين، فهنا مقامان:
المقام الأول في شبهة الحكم
و الظاهر: البناء في المشكوك في العقود على الصحة و يأتي الكلام في الإيقاعات و الوجه في ذلك يتخرج من أمور عديدة
الأول: أنه لا ريب أن المعاملات إنما هي أمور ضرورية للتعيش، و ليس من مخترعات الشرع ، بل لا ريب في أن المكلفين يحتاجون إلى نقل الأعيان بعوض أو بدونه، و كذلك المنافع بعوض أو بدونه. و يحتاجون إلى الشركة و الاسترباح و الاستئمان و النيابات و التناكح، و نحو ذلك، و يتولد من ذلك البيع و الصلح و الهبة و الإجارة و العارية و الوكالة و الشركة و المضاربة و النكاح و المزارعة و المساقاة و الجعالة، و غير ذلك من العقود. و لا يخفى على كل من له درئه: أن هذه كلها من الأمور المتداولة بين الناس على اختلاف الأنواع و الأشخاص، بل قد تداول بينهم ما ليس داخلا تحت هذه العقود المعنونة في الفقه، فإنهم يستعملونها على حسب حاجاتهم، و بعضها يمكن تخريجها بحيث يدخل تحت أحد المذكورات، و بعضها مما لا يمكن. فيعلم من ذلك تداول هذه الأمور في زمن الشارع أيضا، فلو كان المشكوك فيه حراما و فاسدا لم يقرر الشارع لهم على ذلك، مع أن ظاهر اتصال هذا التداول إلى زمن الشرع كون الشارع قد قررهم على ذلك، و تقريره دال على صحته و إمضاء الشارع له، و هو معنى ترتب الأثر.
الثاني: أن نقول: إن المشكوك فيه بعد ثبوت تداوله لو كان فاسدا لاشتهر و تواتر ، لعموم البلوى و شدة الحاجة، و الفرض أنه لم يشتهر و لم يظهر، فدل على عدم كونه فاسدا في نفس الأمر. فإن قلت: إنه لو كان صحيحا لاشتهر و تواتر، مع أنه لم يظهر، فعلم أنه فاسد. قلت: حيث إن هذا شيء متداول عند الناس، و من المعلوم أنه لم يكن طريقتهم السؤال عن كل ما هو بأيديهم، سيما مع علم الشارع به، و كانوا يبنون فيما فعلوه على الموافقة للواقع حتى يظهر من الشارع المنع عنه و بيان عدم صحته، فالمحتاج إلى البيان إنما هو الفساد، فما لم يبين علم عدمه، و عدم المنع بيان لصحته. فإن قلت: إذا كان مقتضى الأصل الأولي الفساد، فلعل سكوت الشارع من باب الاتكال على أن المكلفين يبنون على الفساد، لأنهم يعرفون ذلك بعقولهم، فتكون الصحة هي «المحتاج إلى البيان منه. قلت: هذا إذا لم يعلم الشارع بارتكاب المكلفين به، فإذا علم به علم أن بناءهم ليس على الفساد ما لم يظهر من الشرع منع، فعدم ظهور منعه مع ذلك دليل على الإمضاء، و هو المطلوب.
الثالث: أن عموم قوله عليه السلام في الرواية المشهورة: (الناس مسلطون على أموالهم يقتضي صحة العقود المتفرعة عليها في الجملة و إن لم يدل على ترتب تفاصيل الأحكام. و بيان ذلك: أن المولى إذا أعطى لعبيده كل واحد منهم شيئا من الأمتعة و الأموال ثم قال: (كل واحد منكم مسلط على ما أعطيته إياه) و لم يقيد التسلط بشيء دون شيء، يفهم أنه لو باعه أو ملكه غيره أو آجره أو شرك فيه أو نحو ذلك فكلها مقبولة عند المولى، فيصير المعنى في عموم تسلط الناس على أموالهم: أن كل ما يتصرفون فيه بحسب ما يريدون مقبول عند الشارع، بمعنى: أنه جعل لهم هذه التصرفات و أمضى لهم ذلك. و احتمال أن يراد: تسلطهم على أموالهم في الأكل و الشرب و اللبس و الركوب و نظائر ذلك من التصرفات و الانتفاعات لا يساعد عليه الإطلاق، إذ ليس هناك تشكيك حتى ينصرف إلى ما ذكر، و لا قرينة صارفة عن الإطلاق. و لا ريب أن البيع و نحوه أيضا من طرق الانتفاع بالمال و التصرف فيه، و قد سلطه الشارع على ذلك على الإطلاق. و دعوى التسلط مع بقاء المال على ما ليته له، مدفوعة بأنه خلاف الظاهر. كما أنه لو قيل: بأن الظاهر من الرواية ورودها في بيان أصل التسلط في الجملة و ليس واردا في مقام بيان الإذن في التصرفات حتى يتمسك بإطلاقه، فالمراد منه: تسلطهم على ما لهم على نحو ما قرره الشارع من أنواع التصرفات و طرقها، فلا يكون عموم التسلط مثبتا لصحة معاملة مشكوكة، بل معناه: أن كل طريق قررناه للتصرفات و أمضيناه في ترتب الآثار فالناس مسلطون في أموالهم بالتصرف على تلك الطرق و لا حجر عليهم في ذلك. أجبنا عنه: بأن انصراف التسلط على الطرق المقررة غير ظاهر من اللفظ، و لم يقم على ذلك قرينة، بل الظاهر عند التأمل كون مثل هذه العبارة إنشاء لإمضاء تصرف المالك أي نحو أراد، فمقتضاه: أن كل نحو تصرفوا فيه فهو مقبول عندي و ممضى، و ليس معنى الصحة إلا ذلك.
مضافا إلى أن الفقهاء يستدلون به في كون الأسقاط موجبا للسقوط، و في كون الإذن مبيحا للتصرف، و نحو ذلك من المقامات، بتقريب: أنه ماله و الشارع سلطه عليه، فإذا أسقطه فلا كلام فيه، و نظير ذلك يذكرونه في الحقوق، و الظاهر عدم الفرق. فنقول: إذا ملكه لغيره فهو مسلط، و ليس معنى تسلطه إلا وقوع ما فعله عند الشارع، و تقييده بكونه على نحو قرره الشارع حتى يحتاج في ذلك إلى إثبات الصحة من خارج دعوى بلا بيان، و الفهم العرفي بانصرافه غير ظاهر. فإذا ثبتت القاعدة في الماليات تثبت في غيره أيضا بعدم القول بالفصل، فإن من قال بأصالة الصحة في بعض العقود قال به في الجميع، فتدبر.
الرابع: قوله تعالى في سورة المائدة يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و تحرير الدلالة على المدعى بأن يقال: إن الإيجاب و القبول الواقعين بين المكلفين لا ريب أنه داخل في العقود، لأن معناه الربط، و الإيجاب و القبول ربط شيء بآخر، فيشمله ذلك. أو بأن معناه: العهد أو العهد المؤكد، فيشمل الإيجابين أيضا، لأنه عهد من المتعاقدين و مؤكد كذلك، لبناء العقود على الدوام و الثبات كما يقرر في محلها فيدخل تحت العموم، و ظاهر الأمر وجوب الوفاء بكل ما هو عقد، و كل ما وجب الوفاء به من المكلفين فهو صحيح، إذ ليست الصحة إلا ترتب الأثر شرعا، فإذا أمضى الشارع ما وقع بالوفاء به و العمل بمقتضاه فعلم كونه مؤثرا في ذلك. و بعبارة اخرى: لا نريد من الصحة إلا قبول أثره المقصود عند الشارع، و هو حاصل من الأمر بالوفاء و ملخص كلام أهل اللغة و التفسير في هذه الآية الشريفة: أن صاحب الكشاف.
قال: إن العقد العهد الموثق، لشبهه بعقد الحبل و نحوه، و هي عقود الله التي عقدها على عباده و ألزمها إياهم، و قيل: هي ما يعقدون بينهم من عقود الأمانات و المبايعات و نحوهما، و الظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله و تحريم حرامه، و أنه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل، و هو قوله: أحلت لكم و قال الطبرسي: إن العقد أوكد العهود، و اختلف في هذه العهود على أقوال:
أحدها: أنها عهود أهل الجاهلية بينهم على النصرة و الموازرة و المظاهرة. و ثانيها: أنها عهود الله في حلاله و حرامه. و ثالثها: العقود التي يتعاقدها الناس بينهم و يعقدها المرء على نفسه، كعقد الأيمان. و رابعها: أمر أهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل بما في التوراة و الإنجيل في تصديق نبينا صلى الله عليه و آله و ما جاء به من عند الله. و أقواها القول الثاني كما رواه ابن عباس، و يدخل فيه جميع الأقوال الأخر و قال البيضاوي: و لعل المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقد الله سبحانه و تعالى على عباده و ألزمها إياهم من التكاليف، و ما يعتقدون بينهم من عقود الأمانات و المعاملات . و نقل عن الراغب: أن العقود ثلاثة أضرب: عقد بين الله و بين عباده، و عقد بين المرء و نفسه، و عقد بينه و بين غيره من البشر. و ظاهر الآية يقتضي كل عقد، سوى ما كان تركه واجبا و في الصافي عممه كذلك و المقدس الأردبيلي في آيات الأحكام قال: يحتمل كون المراد العقود الشرعية الفقهية، و لعل المراد أعم من التكاليف و العقود التي بين الناس و غيرها، كالأيمان و في الخبر في الصافي: أن رسول الله صلى الله عليه و آله عقد عليهم لعلي عليه السلام بالخلافة في عشرة مواطن، ثم أنزل الله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السلام . و الحاصل من ذلك: أن المراد هنا إما مطلق العهود، أو عهود أمير المؤمنين عليه السلام، أو عهود الجاهلية، أو عهود الله على عباده، و هي التكاليف، أو العقود التي بين الناس، سواء خصصناها بالمتداولة، أو عممناها بالمخترعة، أو جميع ذلك. و لا ريب أن الآية الشريفة بظاهر الأمر بالوفاء تدل على الصحة فيما دخل تحت عموم العقود و إن بقي الإشكال في الجواز و اللزوم، و سنذكر في عنوان آخر إن شاء الله تعالى. فالمهم هنا: بيان ما يدخل تحت العموم حتى يثبت الصحة في المشكوك منه. فنقول: أما اختصاصهابعهود أمير المؤمنين عليه السلام: فهو خلاف الظاهر، و الخبر الواحد لا يكفي في الاختصاص على فرض تسليم الدلالة، مع أنه لا دلالة فيه غايته أنه مورد نزول الآية، و المورد لا يخصص العام من هذه الجهة و إن بقي فيه شبهة إرادة العهد، و سيجيء الكلام فيه. مضافا إلى أن العهد لأمير المؤمنين عليه السلام إنما هو داخل في باطن الآية، كما يعلم ذلك من ملاحظة تفسير أكثر الآيات المذكور فيها مثل العهد و الأمانة و نظائر ذلك، بل بعد التتبع يعلم أن غالب آيات القرآن مؤول إلى علي عليه السلام و أولاد الطاهرين، و هو لا ينافي الاستدلال بالظواهر. مع أنه يمكن أن يقال: إن الميثاق لأمير المؤمنين عليه السلام عبارة عن وجوب إطاعته و ثبوت ولايته، و قبوله مستلزم للإتيان بالتكاليف كملا، لكون التخلف عنه تخلفا عن إطاعته في ذلك الجزء المتخلف عنه. و بالجملة: لا قدح في الآية من هذه الجهة. و أما إرادة عهود الجاهلية: فلم يقم على تخصيصها بها قرينة، و لم يذكره أكثر أهل اللغة و التفسير، مع بعده عن سياق الآية جدا و مخالفته لما رجحه أكثر أهل التفسير بل كلهم. و أما إرادة التكاليف خاصة: فهو أيضا تخصيص من دون مخصص، إذ في اللغة و العرف تعم تلك و غيرها، و قد عممها جماعة من أهل التفسير و اللغة. و كلام صاحب الكشاف و إن كان ظاهرا في اختصاصها بها، لكنه غير مسموع، بلا شاهد بل هو اجتهاد صرف معارض بكلام غيره مع احتمالإرادة ما يعم عقود الناس أيضا من الحلال و الحرام، كما مر في كلام الطبرسي أنه رجح قول ابن عباس ثم قال: و يدخل فيه جميع الأقوال الأخر (كما ذكرناه آنفا فالظاهر من ذلك حينئذ إرادة العقود و العهود و التكاليف كلها، أو الأول خاصة، أو مع الثاني. و على كل تقدير: فتعم عقود الناس، كما هو محل البحث. فكل ما يسمى عقدا لو شك في صحته و فساده لفقد ما يحتمل كونه شرطا، أو وجود ما يحتمل كونه مانعا، أو للشك في كون شيء شرطا، أو كونه مانعا يحكم بالصحة، لدخوله تحت العموم. نعم، بقي هنا كلام، و هو أن المراد بالعقود بعد شموله لمحل البحث هل العقود المتعارفة في زمن الشارع، أو كل عقد مخترع أو متعارف؟ و تظهر الثمرة فيما لو أريد تشريع عقد جديد لثمرة مقصودة، فهل يمكن التمسك في صحته بالآية أو لا؟ فعلى الأول: لا يمكن، لانصرافها إلى المتعارفة، فيحتاج في دخول المشكوك فيه في الآية إلى العلم بأنه من العقود المتعارفة، و الفرض أنه مخترع. و على الثاني: نعم ، لصدق أنه عقد، فيدخل. رجح جماعة كون المراد: المتعارفة، و لعل السر في ذلك: أن الجمع المحلى باللام و إن كان يفيد العموم بالوضع إلا أنه محتاج إلى عدم وجود قرينة العهد أو مجاز آخر، و هنا ليس كذلك، كما ذكروا نظيره في الاستغراق العرفي، و مثلوا له بقولهم: جمع الأمير الصاغة. و توضيحه: أنه لا ريب في كون العقود معروفة بين الناس على حسب ما يحتاجون إليه في أمر معاشهم، فإذا كان متداولا هذا التداول فلا ينصرف هذا الخطاب إلا إلى ما هو المتداول، فيكون الاستغراق عرفيا، بمعنى كونه منصرفا إلى المعهود من العقود، فإذا ثبت كون عقد متعارفا في ذلك الزمان و صح دخوله تحت العموم ينفي شرطية المشكوك فيه أو مانعيته بالأصل و بإطلاق الآية، لا إذا شك في الصحة و الفساد من جهة الشك في كونه متعارفا داخلا تحت الآية أم لا. و يبقى الكلام حينئذ في معرفة المتعارف و غيره، فنقول: الميزان في ذلك حصول التعارف الان و عدمه، فإنه كاشف عن الزمان السابق بأصالة التشابه و عدم التغير
و لا يبعد منع الانصراف إلى المتعارف، نظرا إلى أن العموم الاستغراقي إنما هو مفيد لعموم الأفراد لا الأنواع على مقتضى الوضع و العرف، و حمله على استغراق الأنواع مما لا شاهد له، فإذا اشتمل الأفراد عموما، فإما أن يراد منه الأفراد المتعارفة، أو مطلقا. فعلى الثاني: يلزم العموم مطلقا، و هو المطلوب. و على الأول: فاللازم عدم إمكان التمسك بها في الأفراد القليلة الوقوع من البيع و الصلح و غير ذلك من الأنواع المتعارفة أيضا، لأنها غير داخلة، فتنتفي ثمرة الآية في الاستدلال، إذ لا يقع الشك الموجب للتمسك بها إلا في فرد له نوع ندرة. مضافا إلى إطباق الأصحاب على التمسك بها في الأفراد النادرة من الأنواع الغالبة، بل في الأفراد التي هي أشد ندرة بحيث لا يكاد يقع، و ليس هذا إلا لعدم الانصراف إلى المتعارف. مع أنا نقول: إن عدم تعارف الوجود لا يضر في دلالة العام، لأنه يشمل النادر أيضا، و إنما ذلك يمنع في المطلق، مضافا إلى أن المانع غلبة الإطلاق، و أما غلبة الوجود إذا لم يكن في إطلاق اللفظ عليه شبهة فنمنع الانصراف. و ما يقال: إنه لا منافاة بين التعميم في الأفراد للنادرة و في الأنواع إلى الغالبة. قلت: نعم، لا منافاة في ذلك، لكن الحمل يحتاج إلى دليل، إذ الحمل إما أن يكون للغلبة فلا وجه لإدخال الأفراد النادرة، بل ينبغي عدم إدخالها، لأن الفرد إنما هو مورد العموم، فلا وجه لأن يقال بخروج النوع النادر دون الفرد. و إن كان احتمالإرادة العهد من العام فلا قرينة له سوى غلبة الوقوع، و هو مشترك بين النوع و الفرد. و الحاصل: لم أجد وجها في إخراج الأنواع النادرة دون الأفراد النادرة من الأنواع الشائعة. و احتمال: أن يكون السبب وجود الأفراد النادرة مع شيوع النوع في الجملة، بخلاف النوع النادر الغير المتعارف، فإنه غير واقع أصلا مدفوع بمنع وجود جميع أفراد النوع الشائع التي يختلف باختلافها الحكم، و منع عدم وجود النوع النادر. و القائلون بحمل الآية على المتعارفة يقولون بعدم شمولها للعقود الموجودة إذا لم تكن متعارفة بحيث يكشف عن تداولها في زمن الشرع، فلا وجه لاعتبار عدم الوجود أصلا. فلو عممنا الآية الشريفة لكل ما يسمى عقدا و قلنا بشموله لنادر الأنواع و الأفراد إلا إذا انجرت الندرة إلى حد يشك في كونه عقدا، فلا يشمل لكان أوفق بظاهر الآية، و أوسع في الاستدلال.
نعم، شمولها للأفراد الشائعة من الأنواع المتعارفة واضح، و للنادرة منها أيضا لا إشكال فيه، و للأنواع النادرة محل خفاء. و لكن الظاهر العموم، فلا يفترق الحال بين الشك في النوع أو الفرد بعد العلم بتعارفه أم لا في إدراجه تحت الآية و الحكم بالصحة بعد ثبوت كونه عقدا. و يمكن أن يقال: إن المتعارف عند الناس لما كان إطلاق العقد على البيع و الإجارة و النكاح و المسابقة و نحو ذلك، فكأنهم يعدون هذه الأنواع أفرادا للعقد، بل لا يسبق إلى النظر من قولك: (كل عقد) إلا البيع و الصلح و نحوهما، دون هذا البيع و ذلك و نحو ذلك، فينصرف إلى الغالب في الأفراد الإضافية المركوزة في الأذهان، و يصير بمنزلة (أوفوا بالبيع و الصلح) و يعم حينئذ كل فرد من الأنواع المتعارفة و إن كان نادرا، لتعلق الحكم بالطبيعة السارية في جميع أفرادها، و الندرة لا تقدح في ذلك.
و هذا الكلام له وجه تخريج، إلا أن الآية على المختار شاملة لكل عهد بظاهر لفظ العموم و كلمة المفسرين، فينبغي ارتكاب هذا الكلام في التكاليف أيضا بوجوب الوفاء بالأنواع الشائعة كالصلاة و حرمة الزنا و إن كان في أفرادها النادرة، دون الأنواع النادرة، و هو خلاف ظاهر الآية و ظاهر أهل التفسير، بل ظاهرهم الإطباق على إرادة الحلال و الحرام مطلقا، فكذلك في العقود، فتدبر. فلا وجه لرمي الآية الشريفة بالإجمال كما يتراءى من بعض المتفقهة و لا حملها على الأنواع المتعارفة كما طفحت به كلمة طائفة من المدققين، و الله العالم....
الخامس : عموم ما دل من الروايات على أن المؤمنين أو المسلمين عند شروطهم
كما سيذكر إن شاء الله تعالى في بحث الشروط بتقريب دلالتها على أن كل شرط لازم، و الشرط عبارة عن الالتزام، و هو مفيد للصحة فيما هو كذلك، و العقود كلها فيها إلزام و التزام، لأنها نوع عهد، كما قرر. أو يراد من الشرط الربط و تعليق شيء بشيء كما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى فيشمل العقود أيضا، لأنها ربط و تعليق لأحد الطرفين، و حيث ثبت إمضاء الشارع لكل شرط فيشمل محل البحث. و خروج ما خرج بالدليل لا يقدح في كون العام حجة في الباقي، و يجيء في المقام زيادة توضيح[5]
اصالة الصحه در ایقاعات
العنوان الثامن و العشرون في بيان أصالة الصحة في الإيقاعات
عنوان 28 هل في الإيقاعات أيضا أصل يدل على الصحة فيما شك في حكمه من جهة شرط أو مانع، أو شككنا في مشروعية أصله أم لا؟ و قد يتمسك في ذلك بأمور: أحدها: عموم (المؤمنون عند شروطهم لو أريد منه الإلزام و الالتزام، و لا ريب أن الإيقاعات كالطلاق و الظهار و العتق و الإذن و نظائر ذلك التزامات لمقتضياتها، فتدخل تحت العموم و يثبت كونها ممضاة من الشارع. و يجيء هنا البحث السابق في الحمل على المتعارف و عدمه، و يجيء الكلام السابق في التعميم للأفراد و الأنواع، و يتمسك به، حتى في الشك في مشروعية إيقاع من الإيقاعات من أصله، كإخراج مال عن ملك مالكه بقوله: (أخرجته عن ملكي) و نظائر ذلك. لكن يمكن أن يقال: إن الظاهر من كون المؤمنين عند شروطهم الشروط الواقعة بينهم، فلا يشمل غير ما هو بين اثنين، و الإيقاعات كلها أو أغلبها التزامات بين المكلف و بين الله، لا شرط بينه و بين آخر.
و يمكن المنع بأن المراد: كل مؤمن لا بد أن يقف عند شرطه و لا يتجاوزه، و لا دلالة فيها على الوقوع بين الاثنين، و لا انصراف أيضا، و بعد ما ثبت عدم المنع من جانب الشارع بل أمره بالوقوف عنده تثبت صحته، إلا ما دل الدليل على خروجه، فيخرج. و المناقشات مع أجوبتها مما لا يخفى، خصوصا بعد ما ذكرنا في العقود. و ثانيها: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لما مر أن المراد بالعقد هو العهد، و هو شامل للإيقاعات، بل بعضها دخوله مصرح به في كلام أهل اللغة و التفسير كالنذر و اليمين و العهد و غير ذلك و بذلك يسقط اعتبار الوقوع فيما بين الاثنين في معنى العقد، لإطباق أهل اللغة و التفسير كما عرفت على دخول اليمين تحت العقد لغة و عرفا، أو دخوله في المراد من الآية الشريفة، و لا بدع في دخول الإيقاعات كافة تحت العقد، سيما بقرينة ما ذكر، و بمعونة كلام الراغب و غيره من أهل اللغة. و دخول مثل الشفعة و الخلع و نظائرهما أوضح من غيره. و لا مانع [منه ] سوى ما يستفاد من كلمات الأصحاب من كون العقد عبارة عما يحتاج إلى الطرفين، و هو كاشف عن فهمهم من الآية ذلك، و هو يصير موهنا للعموم في الآية إلى هذا الحد، و يؤيد كلام من اعتبر وقوعه بين اثنين، و الجرأة على مخالفتهم من الأمور المشكلة، و لكن لو ادعى ذلك لم يكن بعيدا جدا و لقد رأيت في كلام بعض من تأخر التنبيه على هذا التعميم، أظن أنه السيد السند المعاصر السيد محمد باقر الرشتي أطال الله بقاه و لا بأس به . و ثالثها: قوله عليه السلام: (إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام بتقريب: أن الرواية دلت على أن المحرم و المحلل هو الكلام لا غيره، و الإيقاعات إنما هي من مقولة الألفاظ و الكلام، فينبغي أن يكون محللا و محرما، إلا إذا دل دليل على خلافه. و لكن لقائل أن يقول: إن مدلول الرواية: أن غير الكلام لا يحلل و لا يحرم، لا أن كل كلام محلل و محرم. و دعوى: أن الرواية أسندت الحكمين إلى جنس الكلام و نفى عن غيره و مقتضاه ثبوت هذا الحكم في كل فرد من أفراده بالعموم الجنسي، مدفوعة بأن ذلك فرع كون الكلام مسوقا لبيان حكم الكلام، و هنا ليس كذلك، بل هو مسوق لنفي الحكم عن غير الكلام، كما لا يخفى. و من هنا يندفع احتمال عموم الحكمة، لابتنائه على عدم الفائدة في الكلام لو لم يحمل على العموم، و هنا ليس كذلك، إذ ليس فائدة الرواية إثبات الحكم للكلام حتى يقال: إن الفرد المنتشر منه غير مفيد للفائدة و المعهود غير متحققفثبت العموم، بل فائدة الخبر نفي الحكم عن غيره و إن كان في طرف الإثبات مجملا بحسب الكلية و الجزئية، فتدبر. و هذا كله بالنسبة إلى تأسيس القاعدة في نوع العقد و الإيقاع، و إلا ففيما دل على مشروعية العقود و الإيقاعات المعنونة في الفقه من الأدلة الخاصة عموما أو إطلاقا كفاية في مقام الشك في جزء أو شرط أو مانع. نعم، لو أريد إحداث عقد أو إيقاع جديد غير منصوص بالخصوص فلا بد من تأسيس هذا الأصل بحيث لا ينحصر على الأنواع المتعارفة، حتى يثمر في هذا،
المقام. و هذا الفرض مع إشكاله و إن قويناه سابقا قليل الثمرة.
المقام الثاني في شبهة الموضوع
من عقد أو إيقاع صادر في الخارج لا يعلم أنه من النوع الصحيح أو من النوع الفاسد مع العلم بالصحيح و الفاسد من الأدلة، فهل يمكن أن يقال: إن الأصل هنا أيضا كونه صحيحا أم لا؟ وجهان: يحتمل أن يقال: إن عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و (المؤمنون عند شروطهم) و نظائر ذلك مما دل على الصحة عام شامل لهذا الفرد قطعا، و لم يخرج من ذلك قطعا إلا ما علمنا فساده، و ما شك فيه فهو داخل تحت العموم، لعدم العلم بالخروج. و يحتمل أن يقال: إنا إذا علمنا بخروج نكاح الشغار مثلا و عقد المغارسة و بيع الربوي و بيع المجهول و الطلاق بغير شاهدين و نحو ذلك عن عموم العقود و الشروط، ثم شككنا في الفرد الموجود في الخارج عن مكلف هل أوقعه مجهولا أو معلوما؟ فيرجع هذا إلى عدم العلم بأن هذا الفرد داخل في المخصص، أو داخل في العام، نظير قولنا: أكرم بني تميم إلا الطوال، و شككنا في زيد مثلا من بني تميم أنه طويل أو قصير، فيرجع الشك إلى كونه تحت العام أو المخصص، و فيه للأصوليين قولان: قول بأنه داخل تحت العام كما ذكر في الاحتمال الأول و لهم على ذلك وجوه: أحدها: أن الظاهر من أهل العرف إلحاق هذا الفرد بالعام، إذ لو قال قائل: (كل كل رمانة إلا ما هو من البستان الفلاني) فإذا وجد رمانة و شك في أنه من ذلك البستان أو من غيره يأكله، و لا يفهمون من هذا الخطاب في هذا المقام إلا كونه مقيدا بالعلم و أن الخارج ما علم كونه من ذلك البستان لا ما هو كذلك واقعا، و طريقة أهل العرف حجة، إذ ليس إلا من فهمهم من الخطاب ذلك. و ثانيها: أن إخراج نوع خاص أو صنف خاص من ذلك العام يدل على كون ذلك الوصف المأخوذ في المخصص من الموانع. بعبارة أخرى: يعلم من ذلك أن الدخول تحت العام و كونه من أفراده مقتض لهذا الحكم، و إنما المانع هو هذا الوصف المأخوذ في العنوان، و إذا صار كذلك، فلو شك في كونه من ذلك البستان مثلا و عدمه في المثال السابق يصير الشك في وجود المانع مع العلم بالمقتضي، و لا ريب أن الأصل عدم المانع فيثبت الحكم. و احتمال: أن كونه من غير ذلك البستان مقتض فالشك حينئذ موجب للشك في المقتضي، خلاف الظاهر من الإدخال و الإخراج المفهومين من العموم و التخصيص ظاهرا، إذ ليس ظاهرهما عرفا إلا أن المقتضي عبارة عن كونه من أفراد العام، و المانع ليس إلا اتصافه بما أخذ في المخصص، فتدبر. و ثالثها: أن العام أكثر أفرادا من المخصص، بمعنى أن الخارج غالبا بل مطلقا أقل من الداخل، فإذا شك في كون هذا الفرد من أحدهما فالظن يلحقه بالعام ترجيحا لجانب الغلبة، و إن كان يرد عليه: أن هذا ليس ظنا حاصلا من الخطاب، فإن الظن بكون المشكوك من غير ذلك البستان للغلبة لا يوجب الظن بإرادته في العموم من حيث اللفظ و إن أوجب الظن بأنه من أفراد ما هو [من مظنون الإرادة، فتدبر. و بالجملة: الكلام هنا لا يخلو عن نوع دقة، و الاعتماد على فهم الفطن اللبيب. و رابعها: أن الفرد المشتبه و إن كان يحتمل كونه من أفراد العام و المخصص في الحكم واقعا، و اللفظان و إن كانا منصرفين إلى الواقع، لكن بعد طريان الاحتمال و الإجمال في دخوله تحت أحدهما في الواقع يصير حكمه الواقعي مجهولا، فيرجع إلى الظاهر، و لا ريب أنه في الظاهر دخوله تحت العام متيقن، لصدق لفظه عليه قطعا، و صدق المخصص عليه مشكوك، و لا يترك اليقين بالشك، فيحكم فيه بحكم العام عملا بالظاهر مع اشتباه الواقع، و هو المدعى. و قول بأن الرجوع في ذلك الفرد المشتبه إلى الأصل، فإن كان حكم العام موافقا للأصل كقوله: (كلوا مما في الأرض جميعا إلا الخبيث) فشك في كون شيء من الخبيث و عدمه على طريق اشتباه الموضوع الصرف بعد معرفة مفهوم اللفظين و كان الأمر للإباحة، ألحقناه بالعام. و إن كان حكم الخاص موافقا للأصل كقوله: (اقتلوا المشركين سوى اليهود) فشك في واحد أنه من اليهودأم لا، فالأصل البراءة عن وجوب القتل، أو الأصل حرمة قتل كل نفس سوى ما ثبت، و هذا غير معلوم الدخول تحت أحد الأمرين. و أما القول بأنه يدخل تحت المخصص مطلقا فلا قائل به على الظاهر، لأنه مخالف للأصل على الظاهر، و حيث يكون مطابقا له فليس دخوله تحته، بل تحت الأصل، بمعنى الإلحاق حكما. و الوجه فيه: أن اشتباه الموضوع مع العلم القطعي بعدم خلوه في الواقع عن أحد الأمرين لا يوجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ، إذ قد علم عدم إرادة ظاهره من العام فكيف يعمل بظاهره؟ و لا يمكن إدخاله تحته بمعونة أصالة عدم التخصيص، إذ ليس هذا لو اخرج عنه تخصيصا آخر، بل إنما هو فرد من أفراد ما خرج بنوعه، فليس هذا حادثا جديدا حتى ينفى بالأصل. و كثرة أفراد ما هو خارج بنوعه لا يوجب زيادة في التخصيص. و غلبة العام أو أفراده غير موجب للظن بالموضوع الصرف في كونه مرادا من اللفظ حتى يندرج تحت ظواهر الألفاظ. و إقدام أهل العرف على إلحاقه بالعام في غير ما كان موافقا للأصل محل نظر، بل ممنوع، و إن شئت فلاحظه فيما خالف الأصل حتى يتضح الأمر، فيكون الأقدام اتكالا على الأصل لا فهما من الخطاب ذلك. و لا نسلم كون المتبادر من الوصف المأخوذ في المخصص المانعية حتى ينحل الشك إلى الشك في وجود المانع و يلزم منه التمسك بالمقتضى، بل الظاهر دخول نوع و خروج آخر، و ليس كون وصف الخارج مانعا أولى من كون عدمه جزءا للمقتضي، فتدبر. هذا غاية الكلام في هذا المرام، و الذي يترجح في النظر القاصر إنما هو الإدخال تحت العام للوجوه الماضية و إن كان خلاف ظاهر الأكثر، بل ربما يدعى اتفاقهم على الثاني. و لكن يمكن دعوى الإجماع على كون طريقة الأصحاب و طريقة الشرع على كون المشكوك فيه داخلا في العام. فإذا فكلما شك في صحته و فساده من الإيقاعات و العقود من باب الموضوع الصرف فيحكم بالصحة حتى يظهر فساده، فيكون مقتضى الأصل الصحة، و يثمر في الدعوى و غير ذلك. و على هذا الوجه الذي قررناه لا يفترق الحال بين صدور تلك المعاملة من مسلم أو كافر لو لم نقل ببطلان معاملات الكافر سنخا كما قد يتخيل لأن الميزان على ما قررناه صدق العمومات، و هو آت في الجميع. و هنا أصل آخر: و هو حمل فعل المسلم و قوله على الصحة، فلو صدر منه عقد أو إيقاع و شككنا في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فالأصل يقضي بالصحة و إن لم نقل بأصل الصحة في مطلق الموضوع الصرف، و هذا أصالة الصحة التي ينبهون عليها في مقام الدعوى و غيره أنه يقدم قول مدعي الصحة، و نحن في غنى عن ذلك، و لكنه مدلول عليه بالإجماع و الأخبار الكثيرة. و يأتي تأسيسها و ذكر أدلتها و رفع الأشكال الوارد عليها في عناوين الكفر و الإسلام إن شاء الله، فانتظر[6].
ملا محمد نراقی
[المشرق الأوّل] [في بيان ما يقتضيه الأصل في المعاملات من الصحّة أو الفساد]
مشرق: في بيان ما يقتضيه الأصل في المعاملات من الصحّة أو الفساد، و تعيين مواردهما و ما يتبع ذلك، و في هذا البحث تحقيق أمور:
الأوّل: ما يقتضيه الأصل الأوّلي من الصحة و البطلان في الشبهة الحكمية، سواء كان الشكّ في شرعية أصل المعاملة أو في شرائطها و موانعها.
الثاني: ما ثبت خروجه منه و انقلب إلى أصل ثانويّ شرعيّ، و فيه تحقيق معنى آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الثالث: ما يتحصّل من الأصلين، من لزوم الصيغة أو عدمه في العقود، و شرائط الصيغة فيما تحقّق لزومها، فهنا مطالب ثلاثة:
المطلب الأوّل: فيما يقتضيه الأصل الأوّلي الحكمي من الصحّة و الفساد في المعاملات.
فاعلم أنّه قد استمرّت بين الناس منذ استقرّت العادات و وضعت السياسات، معاملات بينهم في العقد و الحلّ و الربط و الفكّ فيما يحتاجون إليه في تمدّنهم و انتظام معاشهم، من التجارات و المناكحات و العطيّات و العهود و المواثيق و أشباهها، و أكثرها غير مختصّة بالشرائع و الديانات، فضلا عن شريعة الإسلام، بل تعمّ الأديان و العادات، و اختلف حكمها فيها في بعض الخصوصيات و الشرائط و أسباب الانعقاد و الآثار و الأحكام المترتّبة عليها، كالبيع الشائع في الكلّ المختلف أحواله فيها بالانعقاد بالصيغة أو بالصفقة أو بمثل الملامسة أو المنابذة أو الحصاة، و الاشتراط بعدم الغرر و عدمه و نحو ذلك، فمهيّات أمثال تلك العقود غير مخترعة و لا موضوعة بالأصل في شريعتنا، بل أمضاها الشارع بشرائط قرّرها. نعم، يختصّ بعضها بالشرائع أو بشريعتنا.
و جملة تلك المعاملات و العقود المعتبرة هي المعهودة المتداولة المدوّنة التي ضبطها الفقهاء سلفا و خلفا في كتبهم و مسفوراتهم، و وضعوا لها أبوابا و لها أسماء معروفة، كالبيع و الصلح و الرهن و الإجارة و المزارعة و المضاربة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النذر و الوقف و النكاح و الطلاق و الظهار و اللعان و غيرها.
ثم إنّ ماهيّات تلك المعاملات كيفيات خاصّة و روابط معهودة في الشرع و العرف و العادة متمايزة بأنفسها، سواء كانت متباينة بالآثار المترتبة عليها أيضا، كالبيع و الإجارة و النكاح و الطلاق، أو متناسبة بالعموم و الخصوص المطلقين، كالبيع و الصلح، أو من وجه كالصلح و الضمان، أو بالتساوي كالبيع و الهبة المعوّضة.
و يظهر ثمرة الفرق حينئذ بالاختلاف في بعض الأحكام المتفرّعة عليها، بل قد يتفق بحسب تعاهد المتعاقدين في القيود و الشروط توافق اثنين منها في فرد في جميع الآثار و الأحكام المترتّبة عليها، فتميّزها حينئذ بمجرّد نفس مفهوم المعنى المعهود من المعاملة الحاكي عنه اسم المعاملة المخصوص بها، بحيث لا يصحّ و لا ينعقد أحدهما بقصد معنى الآخر منه.
و من هذا ينقدح عدم كفاية قصد إنشاء مجرّد الآثار المترتّبة عليها بالألفاظ و القرائن الدالّة على تلك الآثار، بل يجب قصد مفهوم العقد المعهود ماهيّته. و حيث إنّ الدال على تلك الماهيّة هو اللفظ المخصوص الذي يسمّى به فينعقد به. و يظهر منه اختصاص انعقاده به، دون مطلق ما دلّ على ما يفيد أثره و أحكامه، من التجارات الغير المتداولة فيه و لو مع القرائن المنضمّة، و سيجيء تفصيله إن شاء اللّه تعالى.
ثم العقد إن علم صحّته شرعا فهو، و إن شك فيها سواء لم يعلم كونه مما تداول بين الناس، أو علم و لم يعلم كونه من الموظّفة الشرعية، أو علم و لم يعلم اشتراطه بما وقع فيه الشك، فمقتضى الأصل الأوّلي فساده بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود منه شرعا، لأنّ الصحّة من الأمور الشرعية المتوقفة على التوظيف الذي هو أمر حادث، ينفيه الأصل إلى أن يثبت بدليل.
و ما أفاده بعض المحققين من تصحيح المعاملة بأصل البراءة، باعتبار اقتضاء إباحة ما تعاقد عليه المتعاملان و إن لم يفد اللزوم، من الغرائب، فإنّ الإباحة الشرعية هنا فرع ترتّب الأثر شرعا المتوقف على الجعل الشرعي المسبوق بالعدم، و لو هو إمضاء الشارع ما تداول عليه عادة الناس في ترتّب الأثر عليه، و الاستصحاب يقتضي عدمه، و لا يعارضه أصل البراءة، لأنّ متعلّقه نفي السبب و متعلّقها ثبوت السبب، و الأوّل مزيل للثاني و مقدّم عليه، بل لا تعارض بينهما حقيقة كما حقّقناه في الأصول و يأتي الإشارة إليه هنا في بعض الفوائد، و عليه عمل الفقهاء و سيرتهم في الفقه حتى الفاضل القائل و إن خالفه قولا في أصوله.
و نظيره في الشك الموضوعي ما إذا شكّ في إذن المالك، فلا يجوز حينئذ تناول مال الغير بأصل الإباحة، أو شكّ في التطهير أو التذكية فلا يتناوله بأصل الطهارة أو البراءة.
و لا يتوهّم أنّ الإباحة الشرعية في كلّ مورد يتمسّك بها بالأصل حكم شرعي مسبوق بالعدم، فيعارضه الاستصحاب فلم يبق للأصل مورد أصلا، إذ ليس تعارض الاستصحاب لأصل البراءة بالمزيلية في جميع صور التعارض، كما إذا شك في الإباحة الاستقلالية الغير المترتّبة على حدوث سبب، فإنّ مقتضى الاستصحاب ليس هنا نفي السبب بل يمكن القول بكون الأصل حينئذ مزيلا للاستصحاب، نظرا إلى ثبوت التوظيف للإباحة الاستقلالية الظاهرية بمثل قوله عليه السّلام: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» و «الناس في سعة مما لا يعلمون» ، و غيرهما من أدلّة البراءة المقتضية للعلم الشرعيّ الرافع للاستصحاب كما بيّناه في مقامه.
المطلب الثاني: في بيان ما ثبت خروجه من الأصل الأوّلي و انقلب فيه بالأصل الثانوي المقتضى للصحّة.
فاعلم أنّ ظاهر أكثر الأصحاب بل المعروف منهم، انقلاب أصل الفساد في أغلب صور الشك في اشتراط شيء أو مانعيّته لمعاملة من المعاملات الموظفة، إلى أصل ثانوي اجتهادي يقتضي صحّة جميع ما صدق عليه اسم تلك المعاملة الموظفة عرفا، بل ربما يظهر من بعضهم أصالة الصحة عند الشك في شرعية أصل المعاملة و توظيفها بالخصوص أيضا، و بها يستدلّ على تأسيس عقد المعاوضة المطلقة بلفظ «عاوضت». و منشأ هذا الأصل في المشهور عموم قوله سبحانه في سورة المائدة:يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيستدلّون به على صحة العقود أو لزومها، و تداولوا عليه حتى قيل أنه المجمع عليه بينهم و قد يتأمّل فيه.
و جملة القول في الاستدلال بالآية أنّهم بين من يستدلّ بها على تأسيس العقود مطلقا، أي كلّما كان عقدا لغة و عرفا سواء كان من الموظفة الشرعية بخصوصها، كالعقود المدوّنة في كتب الفقه، أو غيرها فيتمسّك بها على ترتّب الأثر المقصود من وضعه عليه، و على تصحيح العقود الموظفة إذا شكّ في اشتراط شيء أو مانعيّته فيها إلّا ما ثبت فساده من أصل كالمغارسة أو لفقدان شرط معلوم كالرباء و المحاقلة و الشغار و مشاركة الأبدان و نحوها، و بين من يستدلّ بها على تصحيح الموظفة خاصّة حملا للعقود عليها، فيستدلّ بها على نفي اشتراط ما شكّ فيه، و بين من ترك الاستدلال بها على الصحّة مطلقا، سواء كان من الموظفة أم لا، زعما لإجمال العقود في الآية، و هو الظاهر من والدي العلّامة ، و يظهر منهم خلاف آخر في دلالتها على لزوم العقد و عدمه يأتي الإشارة إليه[7]
میرزا موسی تبریزی
[أصالة الصحة و مدركها من الأدلة الأربعة]
قوله على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة إلخ
اصاله الصحه در بیان کاشف الغطاء
ربّما يستدل على القاعدة بالأصل و هو يقرّر بوجهين أحدهما ما ذكر الشيخ الأجلّ فقيه عصره الشيخ جعفر قدّس سرّه قال في مقدمات كشف الغطاء إنّ الأصل فيما خلق اللّه تعالى من الأعيان من عرض و جوهر حيوان و غير حيوان صحّته و كذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما خلقت له و على وفق الطبيعة الّتي اتحدت به من مسلم مؤمن أو مخالف أو كافر كتابي أو غير كتابي فيبنى إخباره و دعاويه على الصّدق و أفعاله و عقوده و إيقاعاته على الصّحة حتّى يقوم شاهد على الخلاف إلاّ أن يكون في مقابله خصم و لا سيّما ما يتعلق بالمقاصد و نحوها و لا تتعلق به مشاهدة المشاهد فإنّه يصدق عليه و يجري الحكم على نحو الدّعوى فيه فمن ادعى القصد بإشارته دون العبث أو قصدا خاصا لعبادة خاصّة أو معاملة كذلك أو ادّعى العجز عن النّطق بألفاظ العبادات أو المعاملات أو عن الإتيان بها على وفق العربيّة فيما يشترط فيه كالطّلاق أو العجز عن القيام أو تحصيل الماء في صلاة النّيابة بطريق المعاوضة أو عن وطي المرأة بعد أربعة أشهر أو قصد النيابة أو الأصالة أو الإحياء أو الحيازة إلى غير ذلك فليس عليه سوى اليمين و تفصيل الحال أنّ الأصل في جميع الكائنات من جمادات و نباتات أو حيوانات أو عقود أو إيقاعات أو غيرها من إنشاءات أو إخبارات أن يكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التّمام في الذات و عدم النقص في الصّفات على طور ما وضعت له مبانيها و على وجه يترتب آثارها فيها على معانيها من صدق الأقوال و ترتّب الآثار على الأفعال ثم فرق بين حال المسلم و الكافر بوجوه أربعة يطول الكلام بنقلها و لم أجد أحدا قبله عمم القاعدة على نحو ما عممها و لازمه دعوى أصالة الحجّية في خبر الفاسق و أن نافي حجيّته يحتاج إلى إقامة البرهان عليه و أنت خبير بأنّه لم يساعده دليل و لا اقتضاه برهان من عقل أو نقل لأنّ غاية ما يمكن أن يقال في الأعيان أنها بحسب جبلتها و مقتضى نوعها أن تكون صحيحة ما لم يعرض لها ما يخرجها من مقتضى طبيعتها و وضع نوعها فإنّ الزّيادة و النقصان و سائر العوارض الخارجة من مقتضى الطّبيعة النوعية العارضة للإنسان و الحيوان و سائر الأعيان من النباتات و الجمادات إنّما هي من قبيل العوارض المانعة من عمل الطبائع مقتضاها فإذا شكّ خروج شيء من مقتضى نوعها فأصالة عدم عروض ما يخرجه من مقتضى الطّبيعة النّوعيّة تقتضي الحكم بصحّته و لذا ترى الفقهاء يكتفون بأصالة الصّحة عن الاختبار في الأشياء الّتي يفتقر في بيعها إلى اختبارها ممّا يشكل اختيارها حين البيع كالبيضة و ما يشابهها من الفواكه و نحوها و غاية الأمر أنّه بعد ظهور الفساد بالكليّة بعد العقد يحكم بفساده و في الجملة بأن لم يخرج بفساده من المالية يحكم بخيار الفسخ للمشتري و لكن ما لم يظهر فساده يحكم بصحّته و صحّة العقد في الظاهر بمقتضى الأصل المذكور و لكنك خبير بأن ذلك و إن تم في الأعيان إلاّ أنّه لا يتأتى في الأفعال و الأقوال لأنّ طبيعة القول و الفعل ليست ممّا يقتضي صدورهما عن الفاعل بحيث يترتب عليهما آثارهما من الصّدق في الأقوال و الآثار الشّرعية في الأفعال فإنا لم نجد فرقا بين صحيح العقد و فاسده من حيث اقتضاء طبيعة الألفاظ صدورها على وجه الصّحة بحيث يترتب عليها الآثار الشرعيّة و كذا بين فعل الصّلاة و أكل الرّبا من حيث كون مقتضى طبيعة الفعل كونه صادرا على وجه الصّحة إذ لا وضع و لا توظيف في الأقوال و الأفعال بحسب طبيعتهما النّوعيّة حتّى يقتضي صدورهما على هذا الوضع و التوظيف كما هو ظاهر كلامه بل الشّارع إنّما لاحظهما و رتب عليهما أحكاما شرعيّة على حسب ما لاحظ فيهما من المصالح و المفاسد لا أنّ طبيعتهما مقتضية لصدورهما على حسب ما رتب عليهما الشّارع من الآثار هذا إن أراد إثبات أصالة الصّحة في جميع الأشياء من الأعراض و الجواهر بحكم الاستصحاب و إن أراد إثباتها بحكم الغلبة في أفراد أنواعها إلحاقا للمشكوك فيه بالأعمّ الأغلب كما يشعر به قوله و نحو ما غلبت عليه طبيعتها ففيه مع تسليم الغلبة أنّه لا اعتبار بها على القول بالظنون الخاصّة سيّما في الموضوعات الخارجة الّتي لم يعمل بالظنون المطلقة فيها أربابها و أحسن الوجوه الّتي يمكن حمل كلامه عليه أنّ ذلك منه مبنيّ على الأدلّة المختلفة بحسب اختلاف الموارد فمستند الأصل المذكور في الأعيان و عوارضها القائمة بها ما قدّمناه من الاستصحاب و في أفعال المسلمين و أقوالهم ما أشار إليه المصنف رحمه الله من الآيات و الأخبار و في أفعال الكفار و أقوالهم ما دلّ على تقريرهم على مذهبهم و هكذا و قد ذكر في وجوه الفرق بين حال المسلم و الكافر أن أقوال الكافر و أفعاله تحمل على الصّحة على مذهبه و ليس مقصوده إثبات الكليّة بدليل واحد فتأمّل جيّدا،
و ثانيهما أن يقال إنّ الأصل في أفعال المسلمين و أقوالهم هي الصّحة لأنّ مقتضى التديّن بدين و التسلم لأحكام شريعة هو بناء هذا المتديّن في جميع أقواله و أفعاله على ما اقتضاه هذا الدّين لأنّه مقتضى التديّن به و التسلم له فيكون نفس التدين مقتضيا لذلك و تكون مخالفته ناشئة من الدّواعي الخارجة و في موارد الشكّ يدفع احتمال وجود الدّواعي الخارجة بالأصل فيكون الأصل في جميع أفعال المسلمين و أقوالهم صدورها على طبق شرع الإسلام و لعله لذا جنح ابن جنيد و الشيخ فيما حكي عنهما إلى أنّ الأصل في المؤمن العدالة[8]
ملا حبیب الله کاشانی
[كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد]
و منها: كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد إذا لأصل عدم ترتب الأثر عليه و قد قالوا: إن الأصل الأولي في المعاملات هو الفساد.
[كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثم شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فهو محكوم عليه بالصحة]
و منها: كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثم شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فهو محكوم عليه بالصحة لما تقدم من أن أفعال المسلمين و أقوالهم محمولة على الصحة[9].
شیخ محمد حسین کاشف الغطاء
6-: أصالة الصحة في العقود
و ينفع هذا الأصل أيضاً في الشبهة الحكمية و الموضوعية فلو شككنا ان عقد المغارسة أو المسابقة المستعمل عند العرف قديماً و حديثاً هل هو صحيح شرعاً أم فاسد اي أمضاه الشارع أم لا بنينا على صحته لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أمثالها و لو شككنا ان بيع زيد داره من عمرو كان صحيحاً أم فاسدا بنينا على صحته لأصالة الصحة، و لعل هذا الأصل يرجع الى أصل أوسع له و هو أصالة الصحة في عمل المسلم بل في عمل العقلاء فإن الأصل في كل عاقل ان لا يرتكب العمل الفاسد و ان لا يأتي إلا بالعمل الصحيح غايته ان الأصل في المسلم ان لا يعمل إلا الصحيح في دينه كما ان غيره يعمل الصحيح في عرفه و تقاليده و هذا الأصل مع انه أصل عقلائي قد أيدته الشريعة الإسلامية بالأحاديث الكثيرة المتضمنة لمثل (احمل أخاك على أحسن الوجوه و لا تظن به الا خيرا).
و يؤيده سيرة المسلمين المستمرة فإنهم لا يفتشون عن المعاملات الواقعة من المسلم في بيعه و شرائه و إجارته و زواجه و طلاقه و أمثالها سواء كانت مع مسلم أو غيره بل يبنون على صحتها و يرتبون آثار الصحة عليها أجمع إلا في مقام الخصومات فيرجع الأمر هناك الى الايمان و البينات. فهذا أصل واسع نافع يجري حتى في العبادات و الطاعات فضلا عن العقود و المعاملات و هو القاعدة السابعة[10]
سید حسن بجنوردی
[الثاني: أنّ مقتضى الأصل الأوّلي هو عدم ترتّب الأثر على كلّ عقد و عهد و معاملة]
الثاني: أنّ مقتضى الأصل الأوّلي هو عدم ترتّب الأثر على كلّ عقد و عهد و معاملة، و أيضا على كلّ إيقاع، و لعلّ هذا هو المراد من قولهم: إنّ الأصل في المعاملات الفساد، و لا مخرج عن هذا الأصل إلّا أن يأتي دليل على الصحّة و ترتيب الأثر.
فيقال: إنّ العقود و المعاملات المشروعة- و كذا الإيقاعات المشروعة- إذا كانت متعلّقة للقصد و الإرادة، بمعنى أنّ الآثار المترتّبة على ذلك العقد شرعا كانت مقصودة للعاقد، و قبول الطرف بذلك النهج، فالدليل الدالّ على صحّة ذلك العقد و تلك المعاملة يدلّ على لزوم ترتيب تلك الآثار.
و أمّا لو لم تكن مقصودة فيشكّ في لزوم ترتيب تلك الآثار، فمقتضى الأصل عدم لزوم ترتيب تلك الآثار، بل عدم جوازه.
و فيه: أنّ القصد و الإرادة إن كان دخيلا في تحقّق عنوان تلك المعاملة، فلا يشمله دليل الإمضاء، و ذلك لعدم تحقّق موضوعه، و هذا من أوضح الواضحات، و لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه. و إن لم يكن دخيلا فيه فأدلّة الإمضاء تشمله، و يجب ترتيب الأثر على ذلك العقد أو الإيقاع، سواء قصد أو لم يقصد[11].
شهید مطهری
آيا هر معاملۀ صحيحى بايد داخل در يكى از ابواب فقه باشد؟
از قديم اين مسأله مطرح بوده است- نه به خاطر بيمه، بلكه كسانى مطرح كردهاند كه هنوز مسأله بيمه برايشان مطرح نبوده، مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم يزدى و بعضى ديگر قديمتر از ايشان- كه آيا لازم است هر معاملهاى كه در خارج صورت مىگيرد، داخل باشد در يكى از ابوابى كه در فقه مطرح است؟ يا مانعى ندارد كه معاملهاى صحيح باشد بدون اينكه داخل در هيچيك از آنها باشد؟ جواب دادهاند كه ما هيچ دليلى نداريم كه همۀ معاملات صحيح بايد داخل باشد در يكى از معاملات متعارفى كه در فقه مطرح است. هيچ دليلى بر انحصار نداريم، بلكه اصول فقهى ما اقتضا مىكند اعم را. مىگويند ما يك سلسله عمومات داريم يعنى كليات، اصول اوليه، اصول كلى. اين عمومات كه به شكل عام و كلى طرح شده است، مىگويد هر معاملهاى و هر عقدى كه ميان دو نفر صورت بگيرد درست است الّا موارد خاص. و به تعبير ديگر: اصل در هر معاملهاى صحت است مگر آنكه فساد آن معامله به دليل خاصى روشن شود، چرا؟ مىگويند به دليل اينكه ما در قرآن اين اصل را به صورت كلى داريم: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عقود را همۀ مفسرين گفتهاند يعنى عهدها، پيمانها. به طور كلى و به طور عام فرموده است: به تمام پيمانهايى كه مىبنديد بايد وفادار باشيد و بايد بر طبق آنها عمل بكنيد؛ يعنى شرعاً بايد عمل بكنيد، حكم الهى است. در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هيچ قيد نشده كه آن عهد و پيمان شما به صورت صلح يا بيع يا اجاره و يا عقد ديگر باشد. اين اصل كلى مىگويد بايد به پيمان عمل كرد. همچنين حديثى است نبوى كه در فقه از مسلّمات است و مفاد آن هم همين مفاد است. پيغمبر اكرم فرمودهاند كه: الْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ.
شرط در اينجا يعنى قرارداد. مؤمنان پاى شرايط خودشان ايستادهاند. يعنى مؤمن هر شرطى و هر تعهدى و هر قرارى كه مىگذارد بايد روى آن بايستد، نبايد از آن تخلف كند.
اين اصل كلى صحت هرگونه پيمان و تعهد و قراردادى را كه ميان دو نفر بسته مىشود تضمين و تأمين كرده است[12].
سید محمد شیرازی
[كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد]
و منها: كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد، إذ الأصل، عدم ترتب الأثر عليه، و قد قالوا: إنّ الأصل الأولي في المعاملات هو الفساد.
و إن كان الأصل الثانوي الصحة كما ذكره الشيخ (قدس سره) في المكاسب[13].
ب) بطلان العباده بکل زیاده و نقیصه؛ لا تعاد
بطلان العباده بکل زیاده و نقیصه
صاحب عناوین
العنوان السادس عشر قاعدة بطلان العبادة بكل زيادة و نقيصة
عنوان 16 مقتضى القاعدة أن يكون كل زيادة و نقيصة في العبادة مبطلا لها، سواء كان في الطهارات أو الصلاة أو غيرها من العبادات، و لا يفترق الحال بين القول بأن أساميها موضوعة للصحيحة، أو للأعم منها و من الفاسدة. و تنقيح ذلك يتوقف على مقدمة، و هي: أن العبادات لا ريب في أن كلها مخترعة من قبل الشارع و لو بانضمام شروط و أجزاء إلى ما كانوا يعرفونها. و بعبارة اخرى: هذا المجموع المركب من حيث هو كذلك مما قد جعله الشارع و رتب عليه أحكاما كثيرة دنيوية و أخروية، و لا ريب أن انضمام الأمور المتعددة بعضها إلى بعض على نسق و ترتيب يلزمه هيئة خاصة قهرية، هي الجزء الصوري للمركب، و لا يمكن تحقق مركب من دون هيئة و إنما البحث في أن هذه الهيئة أيضا داخلة في الماهية المطلوبة، أو هي أمر قهري عارض للأجزاء المجعولة عند اجتماعها، و ليست هي مطلوبة. فنقول: الظاهر كون الهيئة داخلة في العبادة، و ليست عبارة عن مجرد الأجزاء المادية. و الدليل على ذلك: تبادر المعنى من ألفاظ العبادات، و سلب الاسم عما تغير فيه الهيئة في بعض الأفراد، كالفعل الكثير في الصلاة. فصار معلوما أن الهيئة مطلقا غير خارجة عن الماهية، بل هي جزء صوري للمأمور به. مضافا إلى أنا وجدنا في العبادات: أن الشارع جعل التقديم و التأخير و نحو ذلك منوعا للعبادة، و جعل لكل قسم منهما أحكاما برأسه، فكشف أن الهيئة لها مدخلية في الماهية. على أن الظاهر: أن الشارع في هذا التركيب جرى مجرى طريقة الحكمة المعروفة بين العقلاء، و لا ريب أن ما نراه من طريقة العقلاء في أحداث التراكيب المختلفة في أدوية و معاجين و أبنية و آلات و نحو ذلك مدخلية الصور و الهيئات في آثارها و ثمراتها و مطلوبيتها، و مع اختلال تلك الهيئة لا يرتبون تلك الثمرات عليه. مع أن كل موجود خارجي مما خلقه الله تعالى نرى أن لهيئته مدخلا في التسمية، بل الأسماء دائرة مدار الهيئات و الصور دون المواد، فمقتضى ذلك كون الهيئة داخلة في مسميات ألفاظ العبادة، و لازم ذلك عدم صدق اللفظ و عدم ترتب الثمرات بدونها، و هو معنى البطلان.
فإن قلت: إنا لا ننكر دخول الهيئة في الجملة في الماهية بل ذلك من الواضحات، و لكنه لا يلزم منه أن كل زيادة و نقيصة مبطل، لعدم تغير الهيئة بمطلق الزيادة و النقيصة.
قلت: هذا غفلة من المدعى، و بيان ذلك: أن الكلام تارة في أن هيئة العبادة أي شيء هو؟ بمعنى: أنا لا ندري مثلا أن القعود في أثناء الطواف مبطل أم لا؟ و نحو ذلك، و الكاشف عن ذلك أحد أمور: إما الصدق عند المتشرعة فيثبت بذلك أن الهيئة أحد الأمرين، أو الإجماع، أو الأخبار الدالة على الحكم. و هذا هو مقام إثبات أصل الماهية و الأجزاء و الشرائط و الهيئة بطرقها المقررة.
و المقام الثاني: أن بعد ثبوت أن الهيئة ذلك مثلا، كما لو ثبت أن الزائد عن سورة واحدة ليس من الصلاة، أو السورة الواحدة لازمة فيها بالنص، و لكن لا ندري أن الزائد يبطل أو لا؟ و لا ندري أن نقصان السورة مبطل كالركوع أم لا؟ مقتضى القاعدة: أن نقص كل شيء ثبت أنه داخل في الهيئة و زيادة كل شيء ثبت بالدليل الشرعي أنه ليس مما اعتبر في العبادة مبطل لها،
و الوجه في ذلك أمور:
أحدها: ما مر من أن الهيئة بعد ثبوتها داخلة فيما اعتبرها الشارع عبادة.
و صدق الاسم بدونها على مذهب من يقول بالأعم لا ينفع في شيء، إذ الأعم ليس مأمورا به بعد قيام دليل على الخصوصية، و لا ريب أن النقص مغير للهيئة، لأن الجزء اللاحق للمتروك يلحق الجزء السابق عنه، و هو هيئة مغايرة، و كذلك في الزيادة، لأن تخلل الزائد مغير لهيئة المتلاحقين، فيغير هيئة المجموع المركب، و ذلك واضح.
و ثانيها: قاعدة الاشتغال، المقررة على مذهب من يقول بكون الأسامي للصحيحة: بأن الشك في كون الزائد و الناقص مانعا يوجب الشك في صدق الاسم فلا يقع الامتثال، و على مذهب من يقول بالأعم: بأن المانع المشكوك و إن اندفع مانعيته، بمعنى: أن الجزء الناقص مثلا و إن نفينا كونه مبطلا بأصالة عدم المانعية، لكن مقتضى الارتباط النفس الأمري في أجزاء العبادات المركبة: أنه لو كان هذا الناقص مبطلا و جزءا مقوما للعمل فالاجزاء الباقية أيضا غير نافعة، لقضية الارتباط، فالبراءة و الامتثال لا يحصل إلا بإتيان الناقص و ترك الزائد حتى يحصل القطع بالامتثال بما علم ثبوت التكليف به.
و ثالثها: أن مقامنا هذا غير مرتبط بأصالة الجزئية و الشرطية و المانعية و نحو ذلك، إذ الفرض ليس أصل الجزئية في الناقص و عدمها في الزائد مشكوكا، بل هما معلومان، فإذا زاد أو نقص، فنقول: مع قطع النظر عن حكم العقل يحكم العرف بعدم كونه امتثالا للمأمور به، و هو معنى البطلان.
و رابعها: الإجماع المحكي على هذه القاعدة في كلام جماعة من أفاضل المتأخرين
و خامسها: الإجماع المحصل من تتبع كلمات الأصحاب في العبادات، فإنهم بعد ثبوت الزيادة و النقيصة يبنون على البطلان حتى يثبت دليل على عدم المانعية.
و سادسها: الصحيح المروي في كتاب الصلاة: (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا و هذه الرواية أخص من المدعى من وجهين: أحدهما: اشتماله على حكم الزيادة دون النقيصة. و ثانيهما: اختصاصه بالصلاة. لكن الظاهر عدم الفرق بين الزيادة و النقيصة إن لم يكن النقيصة أولى بالبطلان و أقوى في عدم صدق الامتثال عرفا. و لا فرق بين الصلاة و غيرها، لكون الكل توقيفية مبنية على هيئة خاصة متلقاة من الشارع. و الحاصل: الفرق بين الصلاة و غيرها في هذه الجهة غير واضح، بل منتف[14].
ملا حبیب الله کاشانی
الاولى الاصل في كل زيادة و نقيصة في العبادة بطلانها به
فصل هذه القاعدة ذكرها جماعة من اصحابنا من غير تعرض لنقل خلاف فيها و قد اشير اليها أيضا في عبارات كثير منهم و في بعض الكتب المتاخره نسب حكاية الاجماع عليها الى جماعة من افاضل المتاخرين و جعل هذا الاجماع المحكى من ادلة هذه القاعدة و استدل عليها أيضا بالإجماع المحصل عن تتبع كلمات الاصحاب في العبادات قال فانهم بعد ثبوت الزيادة و النقيصة يبنون على البطلان حتى يثبت دليل على عدم المانعية اه و الظاهر ان هذا الاصل بالنسبة الى النقيصة مسلم متفق عليه و قد برهنا على اثباته في البحث عن الركن و اما بالنسبة الى الزيادة فدعوى الاجماع عليه في غاية الاجماع شكال مع ان ما دل على بطلان العبادة بالنقيصة من عدم حصول الامتثال بالامر معها فيبقى تحت العهدة لا يجرى في الزيادة لصدق الامتثال معها عرفا الا ترى ان السيد اذا امر عبده بشيء فاتى به و بشيء اخر معه فلا ريب في انه امتثل و اتى بالمأمور به و ما اتى به مما لم يؤمر به لا يقدح في صدق الامتثال عرفا نعم لو كانت الزيادة مغيرة لصورة العبادة بحيث انمحت هيئتها التي لها مدخلية في صدق الاسم فلم يصدق عليها الاسم الموضوع لها فمقتضى الاصل بطلانها بها اذ المفروض ان ما اتى به ليس ما امر به فلا يحصل الامتثال و هذا لا يثبت الكلية المشار اليها من اصالة البطلان بكل زيادة و من هنا خص بعض من ابطل الصلاة بالفعل الكثير بما كان ماحيا لصورتها و القول بان كل زيادة مما يغير به الهيئة و ينمحى به الصورة من سقاط الكلام و شطاطه و قد يقال ان العبادات توقيفية يجب تلقيها من الشارع و الثابت منه هو ذو الهيئة الخاصة من دون زيادة و نقيصة فالهيئة داخلة في العبادة فانها ليست عبادة عن مجرد الاجزاء المادية قال في العناوين على ان الظاهر ان الشارع في هذا التركيب جرى مجرى طريقة الحكمة المعروفة بين العقلاء و لا ريب ان ما تراه من طريقة العقلاء في احداث التراكيب المختلفة في ادوية و معاجين و ابنية و آلات و نحو ذلك مدخلية الصور و الهيئات في آثارها و ثمراتها و مطلوبيتها مع ان كل موجود خارجي مما خلقه اللّه نرى ان لهيئتها مدخلا في التسمية بل الاسماء دائرة مدار الهيئات و الصور دون المواد فمقتضى ذلك كون الهيئة داخلة في مسميات الفاظ العبادة و لازم ذلك عدم صدق اللفظ و عدم ترتب الثمرات بدونها و هو معنى البطلان اه و فيه نظر فان صدق الاسم يكفي في حصول الامتثال كما في الامتثال بسائر الاطلاقات فقولهم يجب كون العبادة متلقاة من الشارع ان اريد به ما يشمل ما ذكرناه فقد حصل و الا فلا دليل عليه فالقول بان للهيئة مدخلية في العبادة ان اريد به ما يمحو به الصورة و ينتفى معه صدق الاسم فمسلم لما بيّناه و الا فلا ينبغى الالتفات اليه مع انا قاطعون بان كثيرا من الزيادات لا يقدح في العبادات من دون نص على الاستثناء مع ان الزيادات المنصوص على جوازها أيضا كثيرة فتدبر و عما ذكرناه اندفع الاستدلال على الاصل المشار اليه بقاعدة الاشتغال و كذا بنائه على القول بكون الالفاظ اسامى للمعانى الصحيحة نعم الاولى الاستدلال عليه بقوله ص صلوا كما رأيتموني اصلى فتدبر و بما يأتي أصل روي خ باسناده عن على بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن الصادق ع قال من زاد في صلاته فعليه الاعاده اه و روي الكليني في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير بن اعين عن ابي جعفر ع قال اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبه ركعة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا الا اذا كان استيقن يقينا اه فصل لعلّ عدم التعرض لذكر النقيصة لوضوح حكمها و موافقته للأصل السالف مع انه يمكن الاستدلال بحكم الزيادة على حكمها أيضا بالاولوية و الانصاف ان الاستدلال بالرواية الثانيه على اثبات هذا الاصل ليس كما ينبغى اذ موردها زيادة الركعة لا مطلق الزيادة نعم بعض من استدل بها عليه اسقط قوله ركعة و لكنه مذكور فيما عندنا من النسخ المعتبره و ربما يعترض أيضا باختصاص الروايتين بالصلاة فلا دليل علي جريان هذه القاعدة في سائر العبادات و دفعه في العناوين بانه لا فرق بين الصلاة و غيرها لكون الكل توقيفيا مبنيا على هيئته خاصة متلقاة من الشارع فالفرق بين الصلاة و غيرها في هذه الجهة غير واضح و فيه نظر[15]
سید مصطفی خمینی
المسألة الأُولىٰ حول الخلل العمدي بالزيادة و النقيصة
مقتضى القواعد الأوّلية في النقيصة
الاختلال العمدي بالزيادة يمكن ثبوتاً، و هكذا النقيصة، و مقتضى القواعد الأوّليّة بطلان الصلاة في الفرض الثاني، سواء كانت قليلة أو كثيرة، جزءً أو شرطاً، قيداً أو وصفاً، بالضرورة عقلًا و شرعاً.
و توهّم صحّتها حسب إطلاق «لا تعاد» لإمكانه، في غير محلّه- كما حرّرناه في الأُصول و في الرسالة الموسوعة لقاعدة «لا تعاد» و إن كان القائل المحتمل التقي العلّامة الشيرازي (رحمه اللّٰه) و المحقّق الوالد- مدّ ظلّه ، و العلّامة الأراكي (رحمه اللّٰه) بل يمكن دعوى انحلال دليل الصلاة، حسب مراتب صدق الصلاة إلّا بالنسبة إلىٰ مقدار لا يعدّ صلاة عرفاً أو شرعاً؛ كمثل الإخلال بالفاتحة و تكبيرة الافتتاح و ما يشبههما ممّا ورد في حقّه: «لا صلاة إلّا بكذا»أو بالنسبة إلىٰ الأركان مطلقاً أو الخمسة المذكورة في «لا تعاد» و لعلّ تفصيلًا زائداً يأتي من ذي قبل، إن شاء اللّٰه تعالىٰ.
و بالجملة: لو صحّ الانحلال المذكور لا حاجة إلىٰ القاعدة، كما حرّر في الأُصول
و أمّا الإجماع المحكي عن جماعة هنا و إن كان معلّلًا، فهو لا يكون دليلًا خاصّاً شرعيّاً على البطلان، فلا خير فيه؛ لكفاية درك العقل فسادها[16].
تذنيب: في عدم شمول قاعدة «لا تعاد» للزيادة و عدم شمول قاعدة «السنّة لا تنقض الفريضة» للنقيصة
قد عرفت وجه عدم شمول القاعدة للزيادة، بل لا يعقل ذلك في جانب المستثنىٰ، و مقتضاه عدم ثبوت الإطلاق للمستثنىٰ منه، و يكفينا الشكّ بعد وجود القرينة المتّصلة، هذا و لو فرضنا إمكان الزيادة فيها، و علىٰ هذا زيادة الأجزاء على الإطلاق، توجب الإعادة إلّا برجوعها إلىٰ شرطيّة العدم، أو إلىٰ مانعيّة الوجود، و مضادّته للطبيعة، و لكنّه خلاف الفرض، و هي الزيادة.
نعم، مقتضىٰ أنّ «السنّة لا تنقض الفريضة» صحّة الصلاة عند زيادة الأجزاء؛ لأنّها من السنّة بحسب الذات، لكونها معتبرة من الصلاة و لو أتى بها بعنوان الوجوب، و كلّ ذلك لأجل أنّ ترك مثل «التشهّد» و «القراءة» ليس من السنّة، كي لا تنقض الفريضة، بل المركّب ينتفي بانتفاءِ جزء منه عقلًا لا سنّة، فزيادة «القراءة» و «التشهّد» و أمثالهما ممّا يعدّان من الصلاة، لا تنقض الفريضة، و تركها لا توجب الإعادة، و هكذا كلّ شيء أمكن فرض الزيادة و النقيصة بالنسبة إليه في المركّب، حتّى في مثل الثوب المحرّم، بناء علىٰ أنّ المانع لا يقع مانعاً إلّا في صورة وقوعه في الصلاة عرفاً حتّى يضرّ بها.
و علىٰ هذا كلّ من القاعدتين يخصّ بجهة، فقاعدة «لا تعاد» لا تشمل الزيادة و قاعدة «لا تنقض» لا تشمل النقيصة[17].
لا تعاد
آقاضیاء عراقی
(و اما الجهة الثالثة)
فقد ورد اخبار كثيرة في باب الصلاة على عدم لزوم إعادتها بالإخلال السهوي بما عدى الخمسة المعروفة من اجزائها و شرائطها كقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود (و لا إشكال) في الحكم بالصحة فيها بمقتضى تلك للاخبار النافية للإعادة (نعم انما الكلام) في بيان مفاد هذه الاخبار و مقدار دلالتها من حيث الاختصاص بصورة الإخلال السهوي أو العموم لصورة الجهل بل العمد أيضا (فنقول و عليه التكلان) الذي يظهر من جماعة من الاعلام هو اختصاص مفاد تلك الاخبار بصورة الإخلال السهوي و عدم عمومه لما يشمل الجهل (بتقريب) ان الظاهر المستفاد من قوله عليه السلام لا تعاد انما هو نفي الإعادة في مورد لو لا هذا الدليل يكون المكلف مخاطبا بإيجاد المأمور به بعنوان الإعادة بمثل قوله أعد الصلاة، و هذا يختص بموارد السهو و النسيان (فانه) لما لا يمكن بقاء الأمر و التكليف بإيجاد المأمور به في حال النسيان يكون الأمر بإيجاده ممحضا بكونه بعنوان الإعادة «بخلاف موارد» الجهل و العمد، فان التكليف بإيجاد المأمور به يكون متحققا في ظرف الجهل و يكون وجوب الإعادة باقتضاء الأمر الأول الباقي في ظرف الجهل، لا انه بخطاب جديد متعلق بعنوان الإعادة كما في مورد السهو و النسيان «و بذلك» يختص لا تعاد بخصوص صورة الإخلال الناشئ عن السهو و النسيان، و لا يشمل صورة الجهل و العمد (و لكن فيه) ان إعادة الشيء في الطبائع الصرفة بعد ان كانت حقيقتها عبارة عن ثاني وجود الشيء على نحو يكون له وجود بعد وجود فلا شبهة في انه لا بد في صدق هذا العنوان و تحققه من ان يكون الشيء مفروض الوجود أولا اما حقيقية أو ادعاء و تخيلا ليكون الإيجاد الثاني تكرارا لوجود ذلك الشيء و إعادة له (و إلا فبدونه) لا يكاد يصدق هذا العنوان، فمهما فرض انه كان لصرف الطبيعي وجود مسبوقا كونه بوجود آخر له حقيقة أو تخيلا و زعما ينتزع منه عنوان الإعادة باعتبار كونه ثاني الوجود لما أتى أولا من المصداق الحقيقي أو الزعمي، كان تعلق الأمر بهذا الوجود الثاني بعنوان الإيجاد، أو بعنوان الإعادة
(و حينئذ نقول) انه كما ان في موارد الإخلال السهوي بالجزء يصدق هذا العنوان و ينتزع من الإيجاد الثاني عنوان الإعادة، كذلك يصدق العنوان المزبور في موارد الجهل بل العمد أيضا حيث انه ينتزع العقل من الإيجاد الثاني عنوان الإعادة باعتبار كونه إعادة لما أتى أولا من الفرد الفاسد «غاية الأمر» يكون وجوب هذا العنوان في موارد الجهل و العمد من جهة اقتضاء التكليف الأول الباقي في ظرف الجهل و في موارد السهو و النسيان بخطاب جديد (و لكن) هذا المقدار لا يوجب فرقا بينهما فيما نحن بصدده كي يوجب اختصاص لا تعاد من جهة اشتماله على لفظ الإعادة بموارد النسيان، بل ذلك كما يشمل السهو و النسيان، كذلك يشمل الجهل بل العمد أيضا (و يشهد لما ذكرنا) جملة من الاخبار المشتملة على لفظ الإعادة في مورد الجهل و العمد (منها) قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة الظاهر في العمد (و منها) قوله عليه السلام فيمن أجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر، أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة فان فعل ساهيا أولا يدي فلا شيء عليه و قد تمت صلاته (و منها) قوله عليه السلام فيمن صلى أربعا في السفر انه ان قرأ عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و ان لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه فان في هذه الاخبار دلالة على ما ذكرنا من عدم اختصاص مورد الأمر بعنوان الإعادة بصورة السهو و النسيان، بل في قوله عليه السلام فان فعل ساهيا أولا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته و كذا في قوله عليه السلام و ان لم يكن قرأت عليه إلخ شهادة على شمول لا تعاد لصورتي الجهل و النسيان، نظرا إلى ظهورها في كون الجميع على سياق واحد فتأمل (و حينئذ) لا قصور في إطلاق لا تعاد و شموله لمطلق الإخلال بما عدى الخمسية من الاجزاء و الشرائط نسيانا أو جهلا و عمدا (غير انه) بمقتضى الإجماع و النصوص الخاصة يرفع اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى خصوص العمد و يؤخذ به في صورتي النسيان و الجهل (اللهم) إلا ان يتشبث في تقييد إطلاقه بخصوص الإخلال السهوي بما في صحيح زرارة من قوله عليه السلام ان الله فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شيء عليه، و قوله عليه السلام في خبره الآخر و من نسي القراءة فقد تمت صلاته، بضميمة ما في ذيل لا تعاد في خبره الثالث من قوله عليه السلام القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة، فان قوله عليه السلام القراءة سنة بمنزلة التعليل لما ذكره أولا من نفي الإعادة (فكأنه قال عليه السلام) لا تعاد الصلاة بترك السنة و بعد تقييده بما في خبر زرارة من قوله عليه السلام فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شيء عليه يصير المتحصل هو اختصاص نفي الإعادة بصورة الإخلال السهوي بملاحظة اندراج الإخلال الجهلي في الإخلال العمدي لصدق الترك العمدي على الإخلال بالجزء عن جهل منه بالحكم أو الموضوع، كما لعله يشهد بذلك قضية المقابلة بين الترك العمدي و الترك السهوي في رواية زرارة المتقدمة بقوله عليه السلام فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من ترك ناسيا فلا شيء عليه فانه يستفاد من التقابل المزبور اندراج صورة الإخلال الجهلي خصوصا الجهل بالحكم بالإخلال العمدي الذي حكم فيه بالبطلان و وجوب الإعادة فتأمل (ثم لا يخفى) ان ما ذكرنا من اندراج الإخلال بالجزء عن جهل بالحكم أو الموضوع في الإخلال العمدي انما هو إذا لم يكن امر شرعي بالمضي في العمل (و اما إذا كان) هناك امر شرعي بوجوب المضي و عدم الاعتناء بالشك في إتيان الجزء فلا محالة يوجب ذلك خروج الإخلال المزبور عن الإخلال العمدي (لأن) المكلف حينئذ من جهة كونه مقهورا من طرف الشارع بوجوب المضي يكون مسلوب القدرة على الترك و لو بحكم العقل بوجوب الإطاعة، و بذلك يخرج الترك عن كونه عمديا فيندرج في عموم قوله عليه السلام لا تعاد (و عليه) يندفع ما ربما يتخيل من الإشكال في وجه الفرق، بين صورة الشك في إتيان الجزء بعد الدخول في غيره، و بين الشك فيه قبله في فرض مضيه في الصورتين و تبين عدم الإتيان به واقعا بعد الصلاة، من حيث بنائهم في الأول على الصحة و البطلان في الثاني و وجوب إعادة الصلاة، بدعوى ان ترك الجزء مع الشك المزبور ان صدق عليه الترك العمدي الموجب لاندراجه في قوله و من ترك السنة متعمدا أعاد الصلاة، فليكن كذلك في الصورتين، و ان لم يصدق عليه الترك العمدي فليكن كذلك أيضا في الصورتين و لا يجدي في الفرق بينهما مجرد حدوث الشك في إحدى الصورتين بعد مضي محله الشكي و في الأخرى قبله (وجه الاندفاع) ما عرفت من ان الفارق بينهما في الحكم المزبور انما هو امر الشارع بالمضي في الصورة الأولى الموجب لخروج ترك الجزء عن الترك العمدي الموجب لوجوب الإعادة، و عدم امره به في الصورة الثانية (و كيف كان) هذا كله فيما يتعلق بالمقام الأول و هي صورة الإخلال بالجزء من طرف النقيصة، و قد عرفت ان مقتضى القاعدة الأولية فيه هي الركنية و البطلان بالإخلال بالجزء (الا في) خصوص باب الصلاة، فكان مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من قوله لا تعاد فيها هو عدم الركنية فيما عدى الخمسة و عدم وجوب الإعادة بعد التذكر و زوال صفة النسيان[18]
امام خمینی
(القول في أنحاء الخلل)
فصل في الخلل العمدي
و هو على أقسام
«منها» ما يصدر عن علم و التفات بلا عذر يدعو اليه و لا إشكال في كونه مبطلا مطلقا بالزيادة كان أو بالنقيصة ركنا كان أو غيره مثل ترك الجزء أو الشرط أو إيجاد المبطل و في إمكان شمولحديث لا تعاد لمثله كلام يأتي التعرض له و على فرض إمكان الشمول لا شبهة في انصرافه عنه.
و منها ما وقع عن علم و عمد تقية و هي قد تكون عن خوف و اضطرار كما لو ضاق وقت الصلاة و اضطر بإتيانها على خلاف الواقع خوفا على نفسه مثلا و الظاهر صحة الصلاة عندئذ لوجوه أحدها
حديث رفع ما اضطروا إليه
فإن الظاهر منها تعلق الرفع بذوات العناوين المذكورة فيه و حيث إنها غير مرفوعة خارجا فلا بد من حمل الحديث على الحقيقة الادعائية و مصححها رفع جميع الآثار إذ مع ثبوت بعضها لا يصح الدعوى إلا إذا كان الأثر المرفوع مما تصح دعوى كونه جميعها كقوله يا أشباه الرجال و لا رجال و ليس المقام كذلك و لازم رفع الآثار صحتها مع إيجاد الزيادة و القواطع و الموانع كزيادة السجدة مع قراءة العزائم و التكتف و قول آمين و نحوها....
«ثانيها»حديث لا تعاد الصلاة فإنه يدل على الصحة فيما عدا الخمس فان قوله لا تعاد كناية عن صحتها في هذه الحالة و لو بقبول الناقصة مكان التامة هذا بناء على شموله للخلل العمدي و عدم انصرافه و سيأتي الكلام فيه.
«ثالثها» روايات التقية كصحيحة الفضلاء قالوا سمعنا أبا جعفر (ع) يقول التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله اللّه
فهي بعمومها تدل على الصحة في جميع موارد الاضطرار سواء كان من قبل حكام العامة و قضاتهم أو غيرهم و سواء كان في الأركان أو غيرها بعد حفظ صدق الصلاة على الباقي....
فصل في الخلل عن جهل
و هو اما عن الجهل بالحكم أو بالموضوع عن تقصير أو قصور كما في تخلف الاجتهاد و التقليد الصحيحين زيادة كان أو نقيصة ركنا أو غيره،
و يدل على الصحة في الجميع مع الغض عن المعارض الذي نتعرض له حديث الرفع ببيان قدمناه من ان ضم دليل الرفع الى دليل وجوب الصلاة ينتج كون المأمور به ما عدا المرفوع و عليه فالإتيان به موجب للصحة عقلا.
و قد يستشكل في شموله للشبهة الحكمية بلزوم المحال ضرورة أن اختصاص الحكم بالعام به دور صريح،
و فيه ان الوجه المصحح للدعوى ان كان رفع الآثار أو عدمها في جميع التسعة فلا يرد إشكال لأن الحكم باق و المرفوع آثاره فلا يلزم اختصاص الحكم بالعالم به و ان كان المرفوع فيما يمكن رفعه كالشبهة الحكمية نفس الحكم حقيقة و في ما لا يمكن فيه ذلك رفع العنوان ادعاء بلحاظ آثاره لا بمعنى استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي لما قررنا في محله من أن الاستعمال حتى في المجازات فضلا عن الاستعارات انما يكون في المعنى الحقيقي مع ان الاستعمال في أكثر من معنى جائز فلا ينبغي الإشكال فيه أيضا،
بل التصويب بالمعنى الذي ادعى قوم من مخالفينا معقول لا يلزم منه الدور كما قيل لإمكان كون الحكم الجدي أو الفعلي تابعا لاجتهاد المجتهد في الأحكام الإنشائية فما في الكتاب و السنة هي الأحكام الإنشائية مطلقا و يقتضي الأصل العقلائي الحمل على الجد إلا إذا دل الدليل على التخصيص و التقييد و عليه فلا مانع هناك من ان يكون حكم اللّه الواقعي تابعا لاجتهاد المجتهد في الأدلة الظاهرية فلا يلزم الدور، و في المقام يمكن ان تكون الجزئية و الشرطية و المانعية الإنشائية مشتركة بين العالم و الجاهل و مع تعلق العلم بالانشائيات منها تصير جديا أو فعليا فلا إشكال عقلي في المقام و إثبات الإجماع في المقام محل تأمل بعد احتمال استناد فتوى المعظم الى الأمر العقلي الذي تشبث به كثير من المحققين و لو ثبت إجماع على بطلان التصويب فإنما هو في التصويب الذي قال به غيرنا لا في مثل ما ذكرناه في المقام.
ثم ان مقتضى إطلاق حديث الرفع، الأخذ به في جميع موارد الجهل لكن لا ينبغي الإشكال في انصرافه عن الجاهل المقصر سواء علم إجمالا باشتمال الشريعة أو الصلاة على أحكام تكليفية و وضعية و أهمل أم لا.
اما على الأول فلعدم صدق «لا يعلم» عليه لفرض علمه و لو إجمالا بالتكليف و مع عدم شمول حديث الرفع له يجب عليه الإتيان بالواقع و لو بنحو الاحتياط.
و اما على الثاني فلان الظاهر و لو بالقرائن الخارجية و بضميمة سائر العناوين المأخوذة في الحديث ان الرفع إرفاق لمن ابتلى بأحد العناوين لا باختيار منه و بغير عذر فمن أوقع نفسه في الاضطرار إلى أكل الميتة لم يرفع عنه الحرمة و ان وجب عليه حفظ نفسه بارتكاب المحرم من دون أن يكون الاضطرار اليه عذرا له فيستحق العقوبة بارتكابه و من علم انه لو ذهب الى مكان كذا اكره على شرب الخمر فذهب اختيارا فابتلي بشربها عن إكراه لا إشكال في انه معاقب عليه فالجاهل غير المعذور عقلا الجريء على المولى لا يستحق الإرفاق و لم يرفع الحكم عنه و كيف كان الرواية منصرفة عن المقصر.
و اما القاصر فتشمله الرواية من غير فرق بين المجتهد المتخلف اجتهاده عن الواقع و المقلد المتخلف تقليده الصحيح عن الواقع و بين العامي القاصر و بتحكيمها على الأدلة الأولية تصير النتيجة كون الباقي تمام المأمور به و صحت صلاته فلا اعادة في الوقت فضلا عن القضاء فالتفصيل بين الشبهة الحكمية و الموضوعية معللا بلزوم الدور غير وجيه لما عرفت كما ان الإجماع غير ثابت.
ثم انه على ما ذكرناه من لزوم الأخذ بظاهر روايات البطلان بالزيادة لا إشكال في رفعها بالحديث.
و اما على مبني القوم من عدم معقولية البطلان بالزيادة و لزوم الإرجاع إلى اشتراط العدم فقد يقال بان الترك و العدم غير مشمولين له لأنه حديث رفع و لا يعقل رفع العدم و الترك و فيه انه بعد البناء على إمكان اشتراط العدم فلا ينبغي الإشكال في الشمول لأن شرطية عدم الزيادة المشكوك فيها في الشبهة الحكمية وجودية بل الترك أو عدم الزيادة لا بد و ان يكون لهما وجود اعتباري على الفرض بل لهما ثبوت إضافي و المفروض أن الرفع ادعائي لا حقيقي و عليه لا اشكال فيه.
ثم على الفرضين اى الرفع الحقيقي و الادعائي فكما لا توجب الإعادة و القضاء لا يجب الاستيناف لو علم بالواقعة في أثناء الفعل فلو زاد في صلاته أو ترك جزء أو شرطا و علم في الأثناء صحت صلاته و لا يجب الاستيناف بل لا يجوز قطعها.
بل لو كان محل الإتيان باقيا اى علم بترك الجزء قبل وروده في الركن لا يجب العود لان حال الجهل كان مرفوعا و الميزان مراعاة حاله لا حال العلم بل على فرض الرفع الحقيقي يعد الإتيان به و بما بعده زيادة في المكتوبة بل على غيره أيضا زيادة حكما.
و التفصيل في الفرق بين مؤدى الأمارات و الأصول و بيان ما هو مقتضى القاعدة من الاجزاء في الثاني دون الأول موكول الى محله هذا بحسب مقتضى الحديث مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة.
و تدل أيضا على الصحة مطلقا الا ما استثنى مع الغض عن سائر الأدلة
صحيحة زرارة المنقولة في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة
و قد رويت في غيره بلا ذكر ذيلها اى لا تنقض السنة إلخ و ما في الفقيه اجمع و احتمال الزيادة في الرواية سيما بمثل ذلك مقطوع البطلان و لا تعارض أصل عدمها أصالة عدم النقص كما لا يخفى.
و الظاهر من قوله لا تعاد مع الغض عن الذيل هو الإرشاد الى عدم البطلان في غير الخمس كما يظهر بالرجوع الى العرف في مثل ذلك و الى أشباهه و نظائره في الاخبار و بملاحظة ما في الذيل يكون كالصريح في ذلك فان التعليل بان عدم الإعادة لأجل عدم نقض السنة الفريضة كالنص في ان عدم الإعادة لعدم الابطال فالحكم به للإرشاد إلى الصحة و احتمال كونه حكما مولويا في غاية السقوط.
فلا يعتنى بالتقريب الذي أوردوه لعدم شمول الحديث للجهل من ان الظاهر من قوله لا تعاد نفى الإعادة في مورد لولا الحديث كانت الإعادة بعنوانها متعلقة للأمر و هذا ليس إلا في صورة السهو و النسيان اللذين لا يعقل معهما بقاء الأمر الأول و التكليف بالإتيان بالمأمور به فلا محالة يكون الأمر المولوي بوجوب الإعادة ممحضا فيهما و اما في صورة العمد و الجهل فيكون الحكم بها عقليا و الأمر بها إرشادا الى حكمه.
و بما ذكرناه من التقريب يظهر النظر في كلام بعض محققي العصر رحمه اللّه من الاتعاب لبيان صدق عنوان الإعادة على الوجود الثاني و لو وقع عن جهل أو عمد إذ لم يكن المدعى عدم صدق عنوان الإعادة في صورتي العمد و الجهل، بل كانت الدعوى عدم تعلق الأمر المولوي بها مع وضوح الحكم بها عقلا و كيف كان يرد عليه ما قدمناه من كونه إرشادا إلى البطلان و عدمه.
هذا مضافا الى ان الفرق بين الجهل و السهو لا يرجع الى محصل ضرورة ان توجه الخطاب الى الجاهل سيما المركب منه غير معقول كالتوجه إلى الناسي و الساهي و الإجماع على اشتراك الجاهل و العالم على فرض صحته لا يدفع الإشكال العقلي و التكليف بالمعنى الذي لا اشكال فيه عقلا يشترك فيه الناسي و الجاهل على السواء كما انهما مشتركان في مورد الامتناع.
بل قد ذكرنا في محله بطلان أساس الاشكال و الرد فإنهما مبتنيان على انحلال الخطابات العامة كل الى خطابات عديدة عدد المكلفين متوجهة إليهم باشخاصهم و لازمه تحقق مبادئ الخطاب في كل على حدة فكما لا يمكن توجه خطاب خاص إلى الناسي لعدم حصول مباديه كذلك لا يمكن خطابه في ضمن الخطاب العام المنحل الى الخطابات لعدم حصول مباديه.
إذ فيه مضافا الى ان لازمه عدم تكليف العاجز و النائم و الجاهل و غيرهم من ذوي الأعذار بل و العاصي المعلوم عدم رجوعه عنه فإن مبادي توجيه الخطاب اليه بخصوصه مفقودة لعدم إمكان الجد في بعث من لا ينبعث قطعا و من المقطوع عدم التزامهم بذلك ان قياس الخطابات العامة بالخطاب الخاص مع الفارق فإنه في الخطاب العام لا بد من حصول مباديه لا مبادي الخطاب الخاص.
فاذا علم الآمر بأن الجماعة المتوجه إليهم الخطاب فيهم جمع كثير ينبعثون عن امره و ينزجرون عن نهيه و ان فيهم من يخضع لأحكامه و لو الى حين صح منه الخطاب العام و لا يلاحظ فيه حال الأشخاص بخصوصهم الا ترى الخطيب يوجه خطابه الى الناس الحاضرين من غير تقييد و لا توجيه الى بعض دون بعض و احتمال كون بعضهم أصم لا يعتنى به بل العلم به لا يوجب تقييد الخطاب بل انحلال الخطاب أو الحكم حال صدوره بالنسبة إلى قاطبة المكلفين من الموجودين فعلا و من سيوجد في الأعصار اللاحقة مما يدفعه العقل ضرورة عدم إمكان خطاب المعدوم أو تعلق حكم به و الالتزام بانحلاله تدريجا و في كل عصر حال وجود المكلفين لا يرجع الى محصل.
و الحق ان التشريع في الشرع الأطهر و في غيره من المجالس العرفية ليس الا جعل الحكم على العناوين و الموضوعات ليعمل به كل من اطلع عليه في الحاضر و الغابر.
فالقرآن الكريم نزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و أبلغه الى معدود من أهل زمانه و هو حجة قاطعة علينا و على كل مكلف اطلع عليه من غير ان يكون الخطاب منحلا الى خطابات كثيرة حتى يلزم مراعاة أحوال كل مكلف و هو واضح.
فلا فرق بين العالم و الجاهل و الساهي و غيرهم بالنسبة إلى التكاليف الإلهية الأولية بعد تقييد المطلقات و تخصيص العمومات بما ورد في الكتاب و السنة كحديث الرفع و لا تعاد و غيرهما فالقول بسقوط الخطاب عن الساهي و الناسي خلاف التحقيق فيسقط ما يترتب عليه مما ورد في كلام المحققين من المتأخرين.
و ما قيل من ان تعذر جزء من المركب المأمور به يوجب سقوط امره و تعلق أمر آخر بالناقص فيما لو أراد الأمر تحققه عند تعذر التام مبني على مبان فاسدة قد أشرنا إليه قبلا و حققناه في غير المقام.
هذا مضافا الى ان العناوين المأخوذة في موضوع الخطابات و الأحكام سواء كانت من قبيل العمومات كقوله يا ايها الذين آمنوا و الطبائع و المطلقات كقوله من آمن و نحوه لا يعقل ان تكون حالية عن الطواري العارضة على المكلفين من العلم و النسيان و القدرة و العجز و غيرها.
ضرورة ان اللفظ الموضوع لمعنى لا يعقل ان يحكى عن غيره في مقام الدلالة إلا مع صارف و قرينة فقوله مثلا المؤمن يفي بنذره لا يحكى الا عن الطبيعة دون لواحقها الخارجية أو العقلية و كذا الحال في قوله يا أيها المؤمنون فإن دلالته على الإفراد ليست الا بمعنى الدلالة على المصاديق الذاتية لطبيعة المؤمن اى الإفراد بما هم مؤمنون لا على الأوصاف و الطواري الأخر إذ لا تحكي الطبيعة إلا عمن هو مصداق ذاتي لعنوانها و لا تكون آلات التكثير كالجمع المحلى و الكل إلا دالة على تكثير نفس العنوان و لا يعقل دلالتها على الخصوصيات الفردية فعموم الخطاب ليس في المثال إلا للمؤمنين.
فإذا ورد مثله في الكتاب العزيز يشمل كل مؤمن في كل عصر حال وجودهم و لكن ليس حجة عليهم الا بعد علمهم بالحكم فقبل تبليغ الرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لم يكن حجة على أحد الا على نفسه الكريمة و بعد التبليغ صار حجة على السامعين دون الغائبين و عند ما وصل إليهم صار حجة عليهم و بعد وجود المكلفين في الأعصار المتأخرة لم يكن حجة عليهم الأبعد علمهم به.
فالجاهل و العالم و الناسي و المتذكر و العاجز و القادر كلهم سواء في ثبوت الحكم عليهم و شمول العنوان لهم و اشتراك الأحكام بينهم و ان افترقوا في تمامية الحجة عليهم فذووا الاعذار مشتركون مع غيرهم في الحكم و شمول العنوان لهم و ان اختلفوا عن غيرهم في ثبوت الحجة عليهم.
و مما تقدم يظهر النظر في كلام شيخنا الأستاد أعلى اللّه مقامه في كتاب الصلاة و محصله دعوى انصراف الحديث الى الخلل الحاصل بالسهو و النسيان في الموضوع بدعوى ان ظاهره الصحة الواقعية و ان الناقص مصداق واقعي للمأمور به كما يشهد به
ما ورد في النسيان الحمد حتى ركع من انه تمت صلاته
فالناسي مخصوص بخطاب متعلق بالناقص و لا مانع من خطاب الناسي و صلاة الذاكر و الناسي كصلاة الحاضر و المسافر فما اتى به تمام المأمور به.
كما ان الظاهر منه ان الحكم بالصحة و التمامية انما هو فيما لو تذكر بعد الفراغ من الصلاة أو بعد المضي عن إمكان تدارك المنسي كما لو تذكر بعد دخوله في الركن فالعامد الملتفت و الشاك في الجزئية أو الشرطية و نحوهما خارجان عن مصبه و كذا غيرهما ممن يصح له الدخول لجهله المركب أو للأصول العقلائية فإنه أيضا خارج عن مصب الحديث لما أشرنا إليه من الدلالة على كون المأتي به تمام المأمور به إذ على هذا يلزم من شموله له التصويب المحال أو المجمع على بطلانه فغير الناسي و الساهي في الموضوع اما خارج عن مصب الرواية أو خارج بدليل عقلي أو شرعي.
وجه النظر مضافا الى ما تقدم من عدم بطلان التصويب عقلا حتى ما قال به المخالف للحق و عدم ثبوت الإجماع على بطلان التصويب بالمعنى الذي ذكرناه.
هو ان الحديث ظاهر كالصريح في ان المأتي به ليس تمام المأمور به لان التعليل الذي ورد فيه بأن السنة لا تنقض الفريضة دال على أن المصداق الذي اتى به المكلف واجدا للخمس و فاقدا للقراءة و التشهد مثلا انما لم يبطل لان المفقود سنة و هي لا تنقض الفريضة فكونه سنة أي مفروضا من قبل السنة لا الكتاب كان مفروغا عنه بحسب مفاده فلو كان الساهي مكلفا بخصوص الناقص فقط و لم يكن الجزء المنسي جزء في حقه لم يصدق عليه انه سنة لا تنقض الفريضة فعدم نقضها متفرع على فرض كون الجزء سنة لا على عدم كونه جزء و هو ظاهر كالصريح في جزئية المنسي حال النسيان.
بل ظاهر قوله لا تعاد الصلاة الا من خمس ان غير الخمس أيضا داخل في الصلاة لكن لا تعاد بتركه لا انه غير جزء لها فعدم الإعادة بنفي الموضوع خلاف الظاهر فلا ينبغي الإشكال في عموم الرواية لكل خلل بأي سبب.
بل لولا انصراف الدليل و بعد الالتزام بصحة الصلاة مع الترك العمدي و الدخول في الصلاة مريدا لترك القراءة و سائر الأذكار الواجبة و غيرها مما عدا الخمس لكان للقول بالشمول للعامد أيضا وجه لان الظاهر من التعليل ان الفريضة لها بناء و إتقان لا ينهدم بالسنة و التقييد بحال دون حال لعله مخالف للظهور في ان السنة بما هي لا تنقضها و حديث مخالفة جعل الجزئية مع الصحة حال العمد قد فرغنا عن بطلانه.
و كيف كان لو رفعنا اليد عنه بالنسبة إلى العامد العالم فلا وجه لرفع اليد عنه بالنسبة إلى الشاك الملتفت المتمسك بالبراءة العقلية و النقلية للدخول في الصلاة فضلا عن الساهي للحكم و الجاهل المركب و من له امارة على عدم الجزئية أو الشرطية فانكشف البطلان بعد الصلاة أو بعد مضى محل التدارك و الإجماع المدعى في المقام غير ثابت بعد تخلل الاجتهاد فيه كما لا يخفى.
و قد يقال بعد الاعتراف بالإطلاق بأنه يقيد بما في صحيحة زرارة ان اللّه تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شيء عليه فيقيد به رواية لا تعاد فان قوله فيها القراءة سنة بمنزلة التعليل فكأنه قال لا تعاد الصلاة بترك السنة و بعد تقييدها يصير المتحصل هو اختصاص نفى الإعادة بصورة الإخلال السهوي بملاحظة اندراج الإخلال الجهلى في العمدي لصدقه عليه.
كما لعله يشهد بذلك المقابلة بين الترك العمدي و السهوي في الرواية فإنه يستفاد منها اندراج الإخلال الجهلى خصوصا الجهلى بالحكم في الإخلال العمدي نعم إذا كان أمر شرعي بوجوب المضي يخرج عن العمد لان المكلف مقهور و مسلوب عنه القدرة على الترك و لو بحكم العقل على وجوب الطاعة انتهى ملخصا.
و أنت خبير بان هذا لا يفيد فإنه بعد تسليم المقدمة لا يستفاد منه الا التقييد بالنسبة إلى القراءة كما ان دعوى عدم صدق العمد مع وجود الأمر الشرعي بالمضي بدعوى أن المكلف مقهور عندئذ و مسلوب القدرة فيها ما فيها.
فالأولى في التقريب ان يقال ان قوله فمن ترك القراءة متعمدا متفرعا على قوله القراءة سنة يدل على ان في ترك القراءة لكونها سنة التفصيل بين العمد و النسيان فيسري الحكم الى مطلق السنة.
و تدل على المقصود أيضا رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (ع) انه قال: القراءة في الصلاة سنة و ليست من فرائض الصلاة فمن نسي القراءة فليست عليه اعادة و من تركها متعمدا لم تجزئه صلاته لأنه لا يجزى تعمد ترك السنة و ادنى ما يجب في الصلاة تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود من غير ان يتعمد ترك شيء مما يجب عليه من حدود الصلاة و من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شيء عليه
هذا غاية ما يقال في تقريب التقييد و اختصاص عدم الإعادة بالسهو لكن يرد عليه ان معنى التعمد عرفا و هو المستفاد من الكتاب و السنة أيضا هو إتيان الشيء أو تركه مع القصد الناشي عن العلم بعنوان الفعل و العمل فمن قتل مؤمنا زاعما أنه كافر مهدور الدم لا يصدق في حقه انه قتل مؤمنا متعمدا و ان صدق انه قتل شخصا متعمدا و لا ينطبق عليه قوله تعالى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ
و قد ورد في الاخبار ان من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام
و من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة
الى غير ذلك مما يشهد بان الترك متعمدا لا ينطبق الا مع العلم بأطراف العمل فمن قطع بان القراءة ليست جزء الصلاة فتركها لا يكون متعمدا في ترك القراءة في الصلاة و كذا من تركها مع قيام امارة على العدم أو حجة عليه من الأصل العقلي أو الشرعي فالترك التعمدى هو الترك مع العلم بالحكم و الموضوع و الا لم يكن متعمدا في ترك ما هو المفروض في صلاته.
و على هذا فمفهوم قوله ان كان متعمدا هو ان لم يكن كذلك الشامل للناسي و الساهي حكما و موضوعا و الجاهل بالموضوع و الحكم مركبا أو بسيطا بل و المتعمد التارك لعذر شرعي أو عقلي كما لو أكره أو اضطر الى الترك لانصراف المتعمد عن كل ما ذكر فالمفهوم دال على عدم الإعادة عليه.
و اما تخصيص النسيان بالذكر في الجملة الثانية مع انه من مصاديق المفهوم فلان الجهل بحكم القراءة و انها جزء الصلاة في زمان الصدور و من المخاطبين بتلك الروايات كان في غاية القلة فضلا عن العلم بالخلاف و اما النسيان فأمر يبتلى به عامة الناس نوعا فذكر مصداق من المفهوم في مثله متعارف.
و الدليل على كثرة الابتلاء به دون غيره الروايات الكثيرة جدا الواردة في باب التكبير و القراءة و الركوع و السجود و ذكرهما و غير ذلك فإنها سؤالا و جوابا على كثرتها لم تتعرض لغير النسيان الا نادرا كالروايتين الواردتين في الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام و اما الروايات الواردة في القراءة فكلها متعرضة للنسيان و في بعضها تصريح بان المراد بالتعمد الترك عن علم بالحكم و الموضوع
كقوله (ع):
في رواية قرب الاسناد ان يفعل ذلك متعمدا لعجلة
و ان شئت قلت بعد ظهور التعمد في الشيء في كونه عن علم و لو في العرف لا بد من الأخذ به و بمفهومه و مجرد مقابلة النسيان له لا توجب صرفه عن ظاهره بعد وجود نكتة ظاهرة في التخصيص بالذكر.
مصافا إلى انه مع الغض عما ذكر و تسليم المقدمات لا تدل الروايات الا على حكم القراءة التي يمكن ان تكون لها خصوصية فإنه لا صلاة الا بها كما في الحديث
و ما ذكرناه من التقريب للتسرية إلى غيرها اشعار لم يصل الى حد الدلالة حتى يمكن معه رفع اليد عن الظاهر الذي هو الحجة و رواية دعائم الإسلام و ان كانت ظاهرة بل صريحة في العموم لكنها لا يعتمد عليها و لا تصلح لتقييد إطلاق الحجة و مما تقدم ظهر حال الخلل عن نسيان أو سهو فان دليل الرفع حاكم بالصحة كما انه مشمول لحديث لا تعاد بل شموله لنسيان الموضوع متسالم عليه بينهم.
فصل هل يشمل الحديث للزيادة أو يختص بالنقيصة؟ و قد يقال: ان أكثر ما في المستثنى حيث كان مما لا يقبل الزيادة فهذا موجب لانصراف الدليل إلى النقيصة حتى في المستثنى منه فلا تعرض في الحديث للزيادة رأسا و فيه ما لا يخفى من الوهن ضرورة ان مجرد عدم كون بعض المصاديق قابلًا للزيادة لا يوجب الانصراف عنها.
و قد يقال ان المستثنى مفرغ و المقدر انه لا تعاد بشيء و هو أمر وجودي و العدم ليس بشيء فيختص بنقص ما اعتبر وجوده أو ينصرف اليه.
و فيه مضافا الى ان العدم لو فرض اعتباره في التشريع يكون له ثبوت
اعتباري و وجود تشريعي انه قد تقدم ان الزيادة بعنوانها موجبة للزوم الإعادة و ان الزيادة ناقضة جعلا مع ان الظاهر عرفا من مثل
قوله (ع): من زاد في صلاته فعليه الإعادة ان الزيادة بنفسها موجبة لذلك و إرجاع ذلك الى اشتراط العدم كما قالوا انما هو أمر عقلي يغفل عنه العرف المعيار في أمثال ذلك مع ان المقدر المناسب للحديث خصوصا بملاحظة التعليل في الذيل انه لا يعاد بإخلال فيعم كل ما يخل بالصحة.
نعم هنا وجه لدخول زيادة الركوع و السجود في المستثنى منه و عدم البطلان بزيادة الركن و هو التعليل بأن السنة لا تنقض الفريضة فإن الفريضة هو الخمسة و اما الاشتراط بعدم زيادة الركوع و السجود أو كون زيادتهما مبطلة فلا يدل عليهما إلا السنة كقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة فالحديث بحسب التعليل دال على عدم نقض ما فرضه اللّه بشيء ثبت بالسنة.
و يؤيده الروايات الدالة على انه
لو أتم الركوع و السجود فقد تمت صلاته
و قوله (ع): و ادنى ما يجب في الصلاة تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود من غير ان يتعمد ترك شيء مما يجب عليه من حدود الصلاة
فإن قلت ان قوله السنة لا تنقض الفريضة بمنزلة التعليل لما سبق و الفريضة هي ما أوجبه اللّه و السنة ما أوجبه رسول اللّه (ص) فهو دال على ان كل ما أوجبه النبي (ص) لا ينقض فريضة اللّه و من المعلوم ان ما أوجبه النبي (ص) هي الاجزاء و الشرائط المأخوذة في الصلاة و اما الموانع و القواطع و الزيادة فيها فهي خارجة عنه و حينئذ ان قلنا بأن العلة تعمم و تخصص تكون الرواية دالة على اختصاص عدم النقض بالواجبات و الفرائض النبوية و اما غيرها فناقض و ان لم نقل بالتخصيص فلا أقل من سكوتها عنها فلا يشمل المستثنى منه الا للنقيصة و كذا المستثنى.
قلت ان السنة في الرواية و الفريضة في قوله فرض اللّه السجود و الركوع ليستا بمعنى الواجبات المعروفة عندنا اى الواجبات التي يستحق المكلف العقاب على تركها.
ضرورة عدم تعلق الوجوب المولوي إلا بنفس طبيعة الصلاة من غير تعلق أمر مولوي بالاجزاء و الشرائط و لا ثبوت وجوب لها استقلالا و لا تبعا و لا انحلال وجوبها أوامرها الى وجوبات و أوامر و لا بسط الوجوب النفسي الى الاجزاء و الشرائط بحيث تصير واجبات تعبدية نفسية مولوية فان لازمه اشتمال الصلاة و كل مركب واجب الى تكاليف عديدة يعاقب بترك الصلاة عقابات عديدة عدد الاجزاء و الشرائط و هو ضروري البطلان.
و ما يتكرر في الألسن من الوجوب الضمني لا يرجع الى محصل الا ان يراد ان الصلاة واجبة بالذات و ينسب الوجوب الى الاجزاء بالعرض و المجاز و الا فأمر الشارع بالصلاة و كل مركب أمر واحد متعلق بطبيعة واحدة يفنى فيها الاجزاء و الشرائط عند تعلقه بها و ان كانت ملحوظة حين تقدير الاجزاء و اعتبارها في المركب فليس الملحوظ حال تعلق الأمر بالطبيعة الا نفسها لا الاجزاء ففي قوله أقم الصلاة لا يلاحظ الا طبيعتها و عند اللحاظ الثانوي يرى اشتمالها عليها فترك الجزء ليس مخالفة لأمر المولى و لا يكون المكلف معاقبا عليه بل العقاب على ترك الطبيعة و المركب الذي يكون بترك الجزء أو الشرط.
بل المراد بالفريضة في تلك الروايات هو ما قرره اللّه و قدره و عينه و حدده في كتابه و يستفاد اعتباره منه كقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ و قوله تعالى:إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ و قوله تعالى:وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ و قوله تعالى فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ فإن شيئا منها ليست فريضة بالمعنى المعروف بل بمعنى ما قدره و شرعه و حدده اللّه كما يستعمل في كتاب الإرث و يقال للإرث: إنه فرض اللّه و كقوله تعالى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اى قرره و حدده و قوله تعالى لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبٰادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً اى مقتطعا محدودا و بالسنة
ما سنه و شرعه رسول اللّه و سنته سيرته و طريقته و شريعته فالمراد من الحديث ان ما قرره و شرعه رسول اللّه لا ينقض الفريضة و المراد بالفريضة في الرواية مع الغض عن سائر الروايات هي الصلاة فتكون الفريضة بمعناها المعروف عندنا فكأنه قال لا تعاد الصلاة لأنها لا تنقض بالسنة و قد مر ان ما في بعض الروايات فرض اللّه الركوع و السجود ليس بمعنى أوجبهما و الأمر بهما إرشادي لا يطلق عليه الفرض و لا على متعلقة الفريضة.
و كيف كان لا ينبغي الإشكال في أن السنة في الرواية ليست بالمعنى المصطلح و لا بمعنى الواجب من قبل النبي (ص) بل بمعنى ما سنه و شرعه و ثبت بالسنة اى الأحاديث و هو أعم من الشروط و الاجزاء و الموانع و القواطع كالزيادة فيها فإطلاق المستثنى منه المنطبق على الجميع المؤيد بالتعليل في الذيل محكم.
و على فرض التنزل عن ذلك فلا ينبغي الإشكال في إلغاء الخصوصية عرفا بل يفهم من سياق الرواية ان الصلاة التي من الفريضة لا تنقضه شيء مطلقا الا الخمس من غير فرق بين الواجبات و غيرها كالموانع و القواطع و اما المستثنى فمختص بنقص الخمسة التي هي من فرض اللّه و الزيادة في الركوع و السجود داخلة في المستثنى منه كما لا ينبغي الإشكال في ان جميع ما يعتبر في الركوع و السجود من الذكر و الاستقرار بل و وضع ما عدا الجبهة على الأرض مما علم من السنة داخلة في المستثنى منه و لا تنقض الصلاة بها.
فما في بعض كلمات الأعلام من انه لا يستفاد ما ذكر من الرواية لاحتمال كون المراد بالسجود و الركوع ما قرره الشارع في الصلاة غير وجيه لما عرفت من وضوح استفادته من التعليل الذي كالصريح في ذلك[19].
ج) اصاله عدم التذکیه؛ اصاله الحل
اصاله عدم التذکیه
ملا احمد نراقی
عائدة (59) في بيان أصالة عدم التذكية
من الأصول المتكرّرة على ألسنة الفقهاء: أصالة عدم التذكية في الحيوانات، و لها ثلاثة معان نبيّنها في هذا المقام.
و لنقدّم لبيان تحقيق المقام فائدتين:
الاولى [الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحلية]
اعلم أنّ الأصل الابتدائي في كل حيوان مأكول اللحم حلّيّة أكل لحمه ما لم يدل دليل على حرمته، حيّا كان أو غير حيّ. و كذا الأصل في كل حيوان طاهر العين غير مأكول اللحم طهارته ما لم يدل دليل على عروض النجاسة له، حيّا كان أو غير حيّ، لأصالة الحل الثابت للأشياء قبل الشرع و بعده، و إطلاقات ما دل على حلية الحيوان الفلاني، و لأصالة الطهارة الثابتة كذلك و استصحابها.
و لكن ثبت بالإجماع القطعي و الأخبار المتكثرة حرمة الأجزاء المبانة من الحي في غير السمك و الجراد، و كذا نجاستها من ذوات النفوس، كما بيّن في موضعه.
و كذا ثبت بالإجماع، بل الضرورة، و بالكتاب و السنة المتواترة حرمة الميتة من جميع الحيوانات، و نجاستها من ذوات النفوس السائلة، كما بيّن في موضعه. و هذا أصل طارئ على الأصل الأول، ثابت بالإجماع و الكتاب و السنة[20].
سید محمدکاظم مصطفوی
قاعدة عدم التذكية
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الأصل عند الشكّ في لحوم الحيوانات هو عدم التذكية، و عليه إذا وجد لحم أو جلد من الحيوانات و شكّ في كونه مذكّى أو غير مذكّى فالأصل هو عدم التذكية.
و من المعلوم أنّ حدوث الشكّ إنّما يكون عند فقدان الأمارة (السوق) و إلّا فلا مجال للشكّ بل تحرز الذكاة بالأمارة، و أمّا بالنسبة إلى قاعدة الطهارة و الحل فتكون القاعدة حاكمة عليهما، كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه: أن قاعدتي الحل و الطهارة محكومتان لأصالة عدم التذكية و الأمر كما ذكره.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ إلى قوله:
وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ فهذه الآية تفيد الإطلاق للتحريم (حرمت) إلّا أن تحرز التذكية، فإذا شكّ في التذكية كان المرجع هو الإطلاق (التحريم) الذي منشأه عدم التذكية.
2- الأصل: و هو استصحاب عدم التذكية فإذا شكّ في تحقق التذكية بالنسبة
إلى اللحوم و الجلود يستصحب عدم التذكية و يترتب عليه الأثر الشرعي من الحرمة و النجاسة و غيرهما.
قال سيّدنا الأستاذ: إذا شككنا في لحم أو جلد أنّه ميتة أو مذكّى فإنه على تقدير أنّ الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذكّ يحكم بنجاسته و حرمة أكله و غيرهما من الأحكام باستصحاب عدم تذكيته- إلى أن قال:- أنّ حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة حكمان مترتبان على عنوان غير المذكّى؛ و ذلك لقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ و موثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها: فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و ألبانه و شعره و روثه و كل شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي و قد ذكّاه الذبح و موثقة سماعة المتقدمة: إذا رميت و سمّيت فانتفع بها أي إذا ذكيتها، و عليه إذا شككنا في تذكية لحم أو جلد و نحوهما نستصحب عدم التذكية و نحكم بحرمة أكله و الأمر كما أفاده.
2- الروايات: قال الفاضل النراقي رحمه اللّٰه: من الأصول المتكررة على ألسنة الفقهاء أصالة عدم التذكية في الحيوانات، و استدل على اعتبارها بالاستصحاب، ثم قال: و يدل على ذلك الأصل، و الأخبار المعتبرة المستفيضة بل المتواترة
منها صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها؟ قال: «إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل» دلّت على أنّ التذكية تحتاج إلى الإحراز و يستفاد منها أنّ في مقام الشكّ يكون الأصل عدم التذكية.
فرعان
الأوّل: لا شكّ في أنّ حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة من آثار أصالة عدم
التذكية و أمّا النجاسة فقد اختلفت كلمات الأصحاب، قد يقال كما عن سيّدنا الأستاذ: أنّ الميتة (ما مات بسبب غير شرعي) عنوان وجودي و عدم التذكية عنوان عدمي فلا يثبت استصحاب عدم التذكية عنوان الميتة إلّا على القول بالأصل المثبت.
و التحقيق: أنّ الميتة و عدم المذكّى بما أنّهما متلازمان جليّا يكفي ثبوت أحدهما لثبوت الآخر فيترتب جميع الآثار من الحرمة و النجاسة و غيرهما على أصالة عدم التذكية، كما أنّ السيّد الحكيم رحمه اللّٰه يقول نقلا عن الفقهاء: أنّ الميتة تكون بمعنى ما لم يذكّ ذكاة شرعيّة فقال: و بهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة و الحرمة و سائر الأحكام و لا يهمّ تحقق ذلك (معنى الميتة) فإنّ ما ليس بمذكّى بحكم الميتة شرعا إجماعا و نصوصا سواء كان من معاني الميتة أم لا و الأمر كما ذكره.
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: ما كان الشكّ فيه من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه للشك في تحقق الذبح، أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط، مثل كون الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة، مع العلم بكون الحيوان قابلًا للتذكية. فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية و يترتّب عليها حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة فيه؛ لأن غير المذكّى قد أخذ مانعا عن الصلاة[21]
اصاله الحل
صاحب مدارک
قوله: (الأولى لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و لو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ).
(1) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، و أخبارهم به ناطقة. فروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الميتة، قال: «لا تصل في شيء منه و لا شسع»
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن جلد الميتة أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: «لا و لو دبغ سبعين مرة»
و عن علي بن المغيرة قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال: «لا»
و ذكر جمع من الأصحاب: أنّ الصلاة كما تبطل في الجلد مع العلم بكونه ميتة أو في يد كافر كذا تبطل مع الشك في تذكيته، لأصالة عدم التذكية.
و قد بينا فيما سبق أن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم، لأن ما ثبت جاز أن يدوم و جاز أن لا يدوم، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت.
و بالجملة فالفارق بين الجلد و الدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم، و مع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا، لأصالة عدم التكليف باجتنابهما و عدم نجاسة الملاقي لهما.
و قد ورد في عدة أخبار الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة و هو مؤيد لما ذكرناه.
و يكفي في الحكم بذكاة الجلد الذي لا يعلم كونه ميتة وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين، سواء أخبر ذو اليد بالتذكية أم لا، و سواء كان ممن يستحل الميتة بالدبغ أو ذباحة أهل الكتاب أم لا، و هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر
و منع العلامة في التذكرة و المنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ و إن أخبر بالتذكية، لأصالة العدم و استقرب الشهيد في الذكرى و البيان القبول إن أخبر بالتذكية لكونه زائدا عليه، فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس و المعتمد جواز استعماله مطلقا إلا أن يخبر ذو اليد بعدم التذكية.
لنا: إنّ الأصل في الأشياء كلها الطهارة، و النجاسة متوقفة على الدليل، و مع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: «اشتر و صلّ فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه»
و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري أ يصلي فيه؟ قال: «نعم أنا أشتري الخف من السوق، و يصنع لي، و أصلي فيه، و ليس عليكم المسألة»
و في رواية أخرى له عنه عليه السلام أنه قال بعد ذلك: «إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك»
و ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري: إنه سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية، أ يصلي فيها؟ فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك»
و في الحسن عن جعفر بن محمد بن يونس: إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو و الخف ألبسه و أصلي فيه و لا أعلم أنه ذكي، فكتب: «لا بأس به»
و هذه الروايات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال، و شاملة للأخذ من المستحل و غيره، و هي مع صحة سندها معتضدة بأصالة الطهارة السالمة من المعارض، و مؤيدة بعمل الأصحاب و فتواهم بمضمونها، فالعمل بها متعين.
و لا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال: «كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فيقول: إنّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، و يزعمون أن دباغه ذكاته»
و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: «لا، و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية» قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال: «استحلال أهل العراق للميتة، و زعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله»
لأنا نجيب عنهما أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على عدة من الضعفاء، منهم محمد بن سليمان الديلمي، و قال النجاشي: إنه ضعيف جدا لا يعول عليه في شيء و قال في ترجمة أبيه: و قيل كان غاليا كذابا و كذلك ابنه محمد لا يعمل بما انفردا به من الرواية و بأن في طريق الثانية عدة من المجاهيل.
و ثانيا بعدم الدلالة على ما ينافي الأخبار السابقة.
إما الرواية الأولى، فلأن أقصى ما تدل عليه: أنه عليه السلام كان ينزع عنه فرو العراق حال الصلاة، و جاز أن يكون على سبيل الاستحباب، بل لبسها في غير الصلاة يقتضي كونها ليست ميتة، و إلا لامتنع لبسها مطلقا.
و أما الثانية، فلأنها إنما تضمّنت النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي، و نحن نقول بموجبه، و نمنع دلالته على تحريم الاستعمال.
و اعلم أنّ مقتضى كلام المصنف في المعتبر و العلامة في المنتهى و غيرهما اختصاص المنع بميتة ذي النفس، و هو كذلك، للأصل و انتفاء ما يدل على عموم المنع.
و لا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا، بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس أيضا، لقوله عليه السلام: «لا تصل في شيء منه و لا شسع[22]»
سید حسین بروجردی
فرع لو شك في جلد انه من الميتة أم المذكى،
فهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟ و حيث ان المسألة ممّا يعمّ بها البلوى فلا بد من بيانها إن شاء اللّٰه تعالى تفصيلا.
فنقول: (تارة) يبحث في مقتضى الأصل الاولى، و (اخرى) يبحث في الأصل الثانوي المأخوذ من الشرع.
[المراد من الميتة]
امّا الأوّل: فهل الأصل في المشكوك الحكم بكونها ميتة أم مذكى؟
وجهان مبنيّان على ان ما به الامتياز بينهما- بعد اشتراكهما في زهوق الروح من الحيوان- هل هو أمر وجودي في خصوص المذكى فيرجع الأمر في المذكى خصوصية بها يصدق ان الحيوان مذكى، أم الميتة لها خصوصية لا تكون في المذكى؟(و بعبارة أخرى): هل التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة أم تقابل التضاد،
و على التقديرين هل الذكية عبارة عن خصوصية كشف عنها الشرع من كونها في غير الإبل من الحيوانات البرية الذبح و فيه النحر و في الحيوان البحري إخراجه من الماء حيا، أم هي عبارة عن أمر عرفي معروف معلوم عندهم كما كان قبل الإسلام، غاية الأمر جعل الشارع له حدودا و قيودا و شرائط؟
اما الأوّل: فنقول: الظاهر هو الأوّل، فإن الميتة معناها اللغوي عبارة عن حيوان خرج منه الروح بأيّ سبب كان قتلا كان أو غيره، غاية الأمر استثنى الشرع بعض افرادها و حكم بحليتها كالمذكى مثلا.و لم يظهر من أدلة حرمة الميتة و حلية المذكى آية و رواية خصوصية وجودية، و يؤيّده انه لم ينقل لنا ان المسلمين عقيب نزول آية تحريم الميتة قد سألوا النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن بيان المراد من(الميتة) أو (المذكى) بل ظاهر خطاب قوله تعالى إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ ان مفهوم المذكى موكول الى المخاطبين.
و الظاهر انه استثناء من قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لا من قوله تعالى وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ فقط، كما ان الظاهر ان قوله تعالى وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ- الى قوله- وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ من افراد الميتة و ذكرها بالخصوص- بعد ذكر العموم- لخصوصية كانت فيها قبل نزول الآية الكريمة فإنهم يرتبون عليها حكم التذكية.
و بالجملة ان الخصوصية الوجودية انما تكون في المذكى لا في الميتة، فإذا شك في وجود تلك الخصوصية فالأصل عدمها فيصير مقتضى الأصل الاوّلى عدم التذكية إلّا ما ثبت خلافه.
و يؤيّد ما ذكرناه الأخبار الواردة في الصيد إذا غاب عن نظر الصائد، إذا شك في انه هل خرج روحه بسبب نفس التصيد و آلته أم بسبب أمر آخر فإنه قد حكم في تلك الاخبار بحرمته
و كذا إذا أرسل المسلم كلبه و أرسل المجوسي كلبه أيضا فأخذ صيدا و شك في انه مات بأخذ الكلب المسلم أو المجوسي
و كذا إذا رمى فشك في انّه هل اصابه به فمات بالإصابة أم بسبب أمر آخر فإنه قد حكم بحرمة أكل لحمه و انه ميتة
[المراد من المذكّى]
و اما الثاني: فقد يظهر من بعض كلمات شيخنا الأنصاري (قده) ان التذكية عبارة عن أمر واقعي له واقعية فإنه (قدّه) قد حكم في الحيوان المشكوك كونه قابلا للتذكية و عدمها باستصحاب عدمها، معللا بالشك فيها من حيث الشك في قابلية الحيوان لها، فيستصحب عدمها.
لكنه خلاف التحقيق فان الظاهر انها ليست بأمر واقعي الذي قد كشف عنه الشارع بحيث لو لا كشفه لما يفهمه أهل العرف، بل هي أمر عرفي و هو كونها عبارة عن الذبح الذي هو معناها اللغوي كما سمعت من القاموس، غاية الأمر قد حدّدها الشرع بأمور أخر جعلها شرطا لحلية المذكى كالتسمية و الاستقبال و فرى الأوداج المخصوصة بحديد و كون الذابح مسلما و غيرها من الشرائط.
و الدليل عليه قوله تعالى إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ حيث ان الشارع القى معنى التذكية إلى المخاطبين من دون بيان معناها، و من دون سؤالهم منه عن المراد منها، فحينئذ يكون كلّ حيوان قابلا للتذكية إلّا ما خرج.
نعم يقع البحث في ان الشارع هل حكم بطهارة كلّ مذكى غير نجس العين لعدم تأثيرها فيه قطعا أم حكم بعروض النجاسة كما في سائر الميتات، فإذا شك في طهارة المسوخ و الحشرات إذا فرض ان لها نفسا سائلة بعد القطع بتحقيق التذكية فيرجع الى استصحاب بقاء الطهارة.
(لا يقال): ان الموضوع في الأوّل الحيوان الحي، و في الثاني الميت فلا يستصحب لعدم بقاء الموضوع حينئذ.
(لأنّه يقال): الحياة و الموت من حالات الموضوع لا من قيوده فإنّ البدن محل تدبير الروح و هو لا يتّصف بالمذكى و الميتة.
و على تقدير عدم جريان الاستصحاب لبعض الإشكالات يكون المرجع قاعدة الطهارة.
إذا عرفت هذا فاعلم انه لا اشكال و لا خلاف في عدم كون الأصل الأوّل متبعا في جميع الموارد بحيث لو لم يعلم بالذبح حكم بكون المشكوك ميتة، بل السيرة المستمرة القطعية المنتهية إلى زمن الأئمة عليهم السلام بل الصادع بالشرع صلى اللّٰه عليه و آله على خلافه.
و من هنا ذهب صاحب المدارك و جماعة الى أن الأصل التذكية في اللحم المشكوك حتى يثبت خلافه.
و بالجملة الخروج عن مقتضى الأصل الأوّلي مقطوع به.
هذا مضافا الى روايات تدل على ان المناط حصول العلم بكونه ميتة و هي على أقسام:
(منها): ما ورد في ان الجلود و اللحوم التي تشترى من السوق حلال ما لم يعلم كونها ميتة، مثل ما رواه الشيخ رحمه اللّٰه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحلبي قال:سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال:اشتر و صلّ فيها حتى تعلم أنه ميتة
و ظاهرها انه ما لم يعلم تفصيلا كونه ميتة لا بأس به، فإذا علم تفصيلا ذلك يجب الاجتناب.
و هل المراد من قول السائل: (عن الخفاف التي تباع في السوق) بيان مناط شكه بمعنى انى لا اعلم بتفصيل الجلود التي تباع أعم من ان يكون في السوق أم غيره، غاية الأمر ذكر (السوق) لكون المتعارففي البيع و الشراء هو ما كان فيه، أم يكون للسوق بما هو سوق مدخليّة في الحكم؟
(فعلى الأوّل): يشمل السؤال و الجواب كل جلد يكون مشكوكا في تذكيته مثلا، سواء كان في خصوص السوق يبيع فيه ذلك، أم مطلق أسواق بلاد الإسلام، أم عام لها و لأسواق الكفار، سواء كان الغالب عليهم المسلمين أم لا، بل يشمل ما إذا كان الغالب الكفّار.
(و على الثاني): يحمل على الأسواق المتعارفة و هي أسواق دار الإسلام بمعنى ان سياسة تلك بيد رئيس الإسلام و ان كان غالب الافراد كفارا كما ربما كان بعض الممالك في زمن الصادق عليه السلام كإيران فإنه كان كذلك في زمن غلبة الإسلام عليه، لكثرة المجوس في ذلك الزمان في إيران، بل الظاهر ان مدن مازندران و الجيلان لم يكن في ذلك الزمان تحت الرئاسة الإسلامية إلى زمن الرضا عليه السلام بل بعده،
و نحوها في الاحتمالات ما رواه الشيخ رحمه اللّٰه، عن محمد بن علي (يعني ابن محبوب) عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أ ذكية أم غير ذكية أ يصلّي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك. و رواه الصدوق رحمه اللّٰه بإسناده، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام
و رواية سليمان بن جعفر عن موسى بن جعفر و ان كان بعيدا فإنه يروى نوعا و غالبا عن الرضا عليه السلام الّا انه من الممكن روايته عنه أيضا.
و بإسناده، عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه، و هو لا يدرى أ يصلي فيه؟ قال: نعم انا اشترى الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة
و قريب منها ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّٰه، عن على عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: اعترض السوق فاشترى خفا لا أدرى أ ذكي هو أم لا؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلك، قلت: انّى أضيق من هذا، قال: أ ترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟
و هذه الروايات الخمسة مشتركة في ان السؤال كان بالنسبة إلى خصوص السوق فامّا ان تحمل عليه بقرينة السؤال و اما ان تنفى الموارد و تحمل على العموم كما احتملناه.
(و منها) ما يدلّ على جواز الصلاة في المشكوك من دون اعتبار ان يكون مشتريا من السوق.
مثل ما رواه الشيخ، عن احمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد اللّٰه ابن المغيرة، عن على بن أبي حمزة: اين رجلا سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام و انا عنده، عن رجل يتقلّد السيف و يصلّى فيه؟ قال: نعم فقال الرجل: ان فيه الكيمخت، قال: و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت ان فيه الميتة فلا تصلّ فيه
و هذه الرواية عامّة شاملة لما يكون في السوق أو في غيره، فإن السؤال عن كون الجلد مشكوك التذكية مطلقا فأجاب عليه السلام بعدم البأس من غير استفصال.
و لا يخفى انها ممّا يؤيّد ما ذكرنا سابقا من كون الحيوانات غير النجسة غير قابلة للتذكية فإن المراد من قوله: (منه ما يكون ذكيا، الى آخره) ان بعضه يذكى بشرائط التذكية و بعضه لا يذكى.
و ما رواه الصدوق بإسناده، عن سماعة بن مهران، انّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة و فيه الفراء و الكيمخت فقال: لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة
و ما رواه أيضا بإسناده، عن جعفر بن محمد بن يونس انّ أباه كتب الى أبي الحسن عليه السلام، يسأله عن الفرو و الخف ألبسه و أصلّي فيه و لا اعلم انّه ذكي، فكتب: لا بأس به
و ما رواه محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوّم ما فيها ثم يؤكل، لأنها تفسد و ليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسيّ؟ فقال: هم في سعة حتّى يعلموا
و هذه الرواية أعمّ من الجميع، لان المفروض ان السفرة وجدت في الطريق، و هي ليست مختصّة بكونها للمسلمين فقطّ، بل هي مشتركة بينهم و بين غيرهم من سائر الكفّار، و تخصيص المجوسي بالذكر في الرواية لعلّه باعتبار أنّ اسراء إيران في زمن أمير المؤمنين عليه السلام كانوا منهم، و كان المجوس في ذلك الزمان كثيرا و لا سيّما في مملكة إيران حيث كان أكثرهم قبل فتح الإسلام مجوسيا.
[حكم ما يؤخد من بلاد المسلمين و يدهم]
و كيف كان، هذه الرواية أيضا حاكمة على الأصل الأوّليّ، نعم لا يبعد ان يكون ظاهرها بالطريق التي في بلاد الإسلام عنى بلادا تكون تحت حكومة الإسلام و سياسته ففي زمان أصالة عدم التذكية لم تكن مرجعا عند الشك و لم يكن التكليف منحصرا بصورة حصول العلم.
و لذا استدلّ صاحب المدارك و جماعة به على انقلاب الأصل الأوّلي الى أصالة التذكية حتّى يعلم أنّه ميتة.
و لكن مقتضى الجمع بين الروايات هو خلاف ما ذكره، كما سنذكره إن شاء اللّٰه تعالى.
و هي أيضا على أقسام:
(منها): ما يدلّ على حليّة التصرف في جلد مأخوذ من يد المسلمين، مثل ما رواه الشيخ رحمه اللّٰه بإسناده عن احمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل (الجيل، خ ل) يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليه السلام: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه
و المراد باسواق الجبل (الجيل، خ ل) يحتمل ان يكون أسواق البلاد التي تكون في أرض يكون الجبال فيها أغلب بالنسبة إلى الحجاز كالبلاد التي تكون في أوائل عقبة حلوان إلى أواخر الري و غيرها.
و الظاهر ان منشأ سؤال الراوي عن جلود هذه البلاد وجود الكفار كاليهود و النصارى و لا سيّما المجوس حيث كانوا- في ذلك الزمان- كثيرين في بعض بلاد إيران بل أغلبها، فإن مذهب كثير من أهل إيران كان مذهب المجوس.
و يستفاد من سؤال الراوي أمور ثلاثة:
(الأوّل): إطلاق لفظة (الذكاة) على كل جزء من أجزاء الحيوان.
(الثاني): المفروغيّة عن عدم لزوم السؤال إذا كان المسلم عارفا بالإمامة.
(الثالث): كون أخبار المسئول عنه حجّة على تقدير وجوب السؤال بقرينة تقرير الامام عليه السلام.
و امّا ما يستفاد من الجواب: (فتارة) يتكلّم في دلالة مقدار منطوقها (و اخرى) في مفهوما.
اما الأوّل: فالظاهر انه عليه السلام أجاب سؤال الراوي مع الزيادة و حاصله ان المناط في وجوب السؤال و عدمه هو كون البائع مشركا و عدمه لا كونه عارفا أو غيره، فإذا كان البائع للجلد مشركا لزم السؤال عنه لا التفحّص عن غيره ليعلم الحال كما توهّم لعدم مدخلية الفحص عن الغير في إحراز كون هذا الجلد الذي يبيعه البائع مذكى كما لا يخفى.
و ان كان البائع يصلّى فيه فلا بأس بالشراء منه بدون السؤال.
و الظاهر ان الصلاة فيه كناية عن كون البائع مسلما لا أنّ لخصوص الصلاة خصوصيّة فيصير المعنى ان البائع ان كان مسلما فلا بأس به، غاية الأمر لو فرض الشك في إسلامه فالصلاة فيه علامة لإسلامه.
و بالجملة بقرينة جعل المصلّين مقابلين للمشركين يكون المراد منهم المسلمين.
نعم لو قيل: ان مفهوم قوله عليه السلام: و ان كانوا يصلّون، إلخ أنهم لو لم يصلّوا فيه بالخصوص مع فرض دخالة الصلاة فيه فلا تشتر فاللازم حمل قوله عليه السلام: (عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين، الى آخره) على بيان أحد الفردين و يبقى الفرد الآخر
- و هو المسلم الغير المصلّى- مسكوتا عنه.
ثم انه لا دلالة في هذه الرواية على كون يد المسلم مطلقا امارة على التذكية، فإن جماعة من المسلمين قد خالفونا في أمور متعددة لا تلتزم بها في مذهبنا كاستحلال الميتة بالدباغ و استحلال ذبائح أهل الكتاب و تجويز الصيد بغير الكلب المعلّم مثل الفهد.
فلا وجه لحمل الرواية على كون يد المسلم امارة على التذكية، بل الظاهر انها دالة على جريان أصالة التذكية إذا كان مأخوذا من يد المسلم لكون الاجتناب عن الجلود التي في يد المسلم حرجا شديدا على الشيعة.
و لا فرق بمقتضى القاعدة بين الشراء الذي هو أحد الأسباب المجوزة للتصرف و بين غيره من أسباب جواز الاستعمال من الهبة و الصلح و غيرهما، و لا بين بلاد الإسلام و غيرها إذا كان البائع مسلما.
كما لا فرق في عدم جواز ترتيب آثار التذكية إذا كان البائع مشركا بين أرض الإسلام و غيرها، كان الغالب عليها المسلمون (المسلمين خ ل) أو الكفار أم تساووا عددا.
نعم من كان في بلاد الإسلام و دارها و كان مشكوكا إسلامه يكون محكوما به، فيترتب عليه آثاره من حلية ذبيحته و محفوظية نفسه و عرضه و ماله و وجوب غسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه.
فحاصل الرواية انه من كان مسلما أو محكوما بالإسلام لا يجب السؤال عن خصوصيات الذبح عند شراء اللحم أو الجلد منه.
(و اما الثاني): أعني مقدار دلالة مفهومها فالظاهر حجية اخبار المشرك بالنسبة إلى التذكية الشرعية، و الّا لزم لغوية السؤال و عدم
جواز الأخذ بدونه أو معه مع عدم الاستناد الى يد المسلم.
(و منها): ما يدلّ على حلية اللحم المشتري من سوق المسلمين مثل ما رواه: محمد بن يعقوب الكليني، عن على بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل و زرارة و محمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصّابون؟ فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، و لا تسأل عنه
و هل المراد من سوق المسلمين دار الإسلام؟ بمعنى ان اللحم المشتري من دار تكون حكومة الإسلام محكوم بكونه مذكى و لو كان الافراد الساكنين فيها كفارا، أو أغلبهم كذلك، و هو بعيد.
أو المراد سوق يكون الساكنون فيه المسلمون و لو كان خصوص القصابين غير مسلمين، و هذا المعنى يستلزم دخالة إسلام أمثال الخياط و النجار مثلا ممن يكونون في سوق المسلمين في جواز شراء اللحم من غير المسلم، و هو أبعد.
أو المراد كون البائع بالخصوص مسلما و لو لم يكن السوق للمسلمين و هذا غير بعيد.
و عليه فيلغى اعتبار خصوصية السوق و يكون المعنى حينئذ ان البلاد التي يكون تشكيل السوق فيها نوعا بيد المسلمين، فاللحم المشتري منه محكوم بالحلّية و جواز الأكل.
و المراد من قوله عليه السلام: (كلّ إذا كان، إلخ) ترتيب جميع آثار التذكية لا خصوص جواز الأكل، فيحكم بطهارته و عدم تنجس ملاقيه
و مفهومه أيضا كون قول غير المسلم متبعا في صورة عدم كون البائع مسلما و أخبر بأخذه من مسلم.
و إطلاقها يشمل ما إذا كان البائع في سوق المسلمين، و لكن كان مجهول الحال بالنسبة إلى الإسلام و كذا يشمل ما إذا كان البائع في دار الكفر مع كونه مسلما، لوجود المناط أعني إسلام البائع.
نعم شمولها لمعلوم الكفر، معلوم العدم، لأنّ اعتبار سوق المسلمين لإثبات إسلام البائع ليجري أصالة التذكية في ذبيحته.
(و منها): ما يدلّ على اعتبار ما صنع بأرض الإسلام بحيث يكون المصنوعية في أرض الإسلام امارة على كون الجلد مصنوعا بيده، مثل ما رواه الشيخ رحمه اللّٰه بإسناده، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليه السلام قال:لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت:فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس،
و الظاهر ان المراد من قوله عليه السلام: (إذا كان الغالب، الى آخره) هو الغلبة بمعنى الحكومة و السلطنة، فإذا كانت الأرض تحت حكومة الإسلام و سياسته يقال: ان الغالب على الأرض تحت حكومة الإسلام و سياسته يقال: ان الغالب على الأرض المسلمون، لا انه إذا كان المسلمون أكثر عددا من الكفار كما عن الشهيد الثاني عليه الرحمة، و عن جماعة، لعدم ملاءمة هذا المعنى لما في الخارج، فإن افراد المسلمين في زمان صدور هذا الكلام لم تكن أكثر من افراد الكفار حتى في أراضي الإسلام، و لا سيّما في البلاد التي كانت قريبة بالنسبة الى فتح الإسلام.
و لا يرد على ما ذكرنا ان اللازم من ذلك كون الجلد الذي يكون في أرض يكون أهلها كلا أو غالبا مسلمين محكوما بالميتة إذا كان الحاكم عليهم كافرا.
لان المتعارف في الأراضي التي يكون الحاكم عليهم مسلم كون الافراد الساكنين فيها (عليها، خ ل) أيضا مسلمين، و كذا العكس في طرف العكس كما لا يخفى.
و الظاهر منها ان الجلود التي تؤخذ من البائع محكومة بالتذكية إذا صنعت في أرض الإسلام، سواء كان مأخوذا من يد المسلم أم لا؟
و سواء كان في البلد أم في الفلاة.
نعم لو لم تكن مصنوعة في أرض الإسلام لم يحكم بها و لو كان مأخوذا من يد المسلم كما انه لو صنع في أرض الإسلام يحكم بالتذكية و لو كان مأخوذا من يد الكافر.
نعم إحراز مصنوعية الجلد في أرض المسلمين يحتاج إلى أمارة فإن كان البائع مسلما لا حاجة الى شيء آخر من مثل السؤال أو الفحص و ان كان كافرا يلزم السؤال.
و بالجملة يستفاد من هذه الاخبار الثلاثة أمور ثلاثة يرجع بعضها الى بعض بعد التأمّل:
(أحدها): ماخوذيّتها من يد المسلم كما في رواية إسماعيل و سعد.
(ثانيها): ماخوذيتها من أسواق المسلمين كما في رواية الفضلاء.
(ثالثها): مصنوعيتها في أرض الإسلام بالمعنى الذي ذكرناه كما في رواية إسحاق بن عمّار.
و هذه الأمور قريبة المناسبة بعضها مع بعض، لمدخليّة الإسلام في كلها يدا أو سوقا أو أرضا.
و لا معارضة بينهما فان منطوق الاوّلى مدخلية يد المسلم و لا مفهوم لها بالنسبة إلى السوق أو الأرض نفيا و إثباتا كي يقال: ان مفهومها انه إذا لم يكن من يده يكون ميتة سواء كان مأخوذا من يد المسلمين أم لا و سواء صنع بأرض الإسلام فيعارض الأخيرتين، و منطوق الثانية دخالة سوق المسلمين و لا مفهوم بالنسبة إلى يد المسلم الذي يكون في غير سوق المسلمين.
بل الظاهر- كما بيّناه- اعتبار السوق لكونه امارة على يد المسلم و كذا اعتبار المصنوعيّة في أرض الإسلام لكونها أيضا امارة على يده فيرجع بالأخرة إلى يد المسلم أو من كان محكوما بالإسلام كما لو كان في أرض الإسلام.
فتحصّل ان الأصل التذكية إذا كان مأخوذا من يد المسلم أو من بحكمه بمقتضى هذه الروايات الثلاثة.
و مقتضى الروايات المتقدمة جريان أصالة التذكية مطلقا حتى يعلم أنه ميتة فيتعارضان، لان الموضوع في تلك الروايات المشكوك بما هو مشكوك، و الموضوع في هذه الروايات المشكوك الذي في يد المسلم أو من بحكمه.
فيدور الأمر بين العمل بالأوّلى و طرح دخالة هذه الخصوصية و بين العكس، و حيث ان ظهور هذه الروايات في دخالة القيد أقوى من ظهور تلك في تمام الموضوعيّة فالمتعيّن هو العمل بالمقيد.
و يؤيّد ما ذكرنا- من عدم كون المشكوك تمام الموضوع- اخبار الصيد المشار إليها سابقا، حيث انها تدلّ أيضا على ان الموضوع ليس هو المشكوك بما هو هو و ان كان بين ما نحن فيه و اخبار الصيد فرق من جهة أخرى، فإن المقام فيما إذا كان منشأ الشك فعل الغير من حيث التذكية، و الشك في اخبار الصيد انما هو في تحقق ما اعتبره الشارع في الحكم بالحلّية بفعل نفسه من اصابة الرمي أو الصيد أو الكلب كما لا يخفى.
نعم هنا روايات قد يتوهم معارضتها لإطلاق ما استفدنا من الروايات الثلاثة، مثل ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّٰه، عن على بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: تكره الصلاة في الفراء الّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة
و الذي يمكن ان يكون في وجه التخصيص بأرض الحجاز، انه في مقابل العراق باعتبار ان أهل العراق يستحلّون الميتة و لكن دلالة لفظة (الكراهة) على عدم الجواز محل نظر لعدم ظهورها في الحرمة و ان لم تكن ظاهرة أيضا في الكراهة المصطلحة.
و عن على بن محمد (خال الكليني، ثقة) عن عبد اللّٰه بن إسحاق العلوي (مجهول) عن الحسن بن على (مجهول في هذا الطريق) عن محمد بن سليمان الديلمي (ضعّفوه) عن عثيم بن أسلم النجاشي (مجهول) عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال:: كان عليّ بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و القى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك؟ فقال عليه السلام: ان أهل العراق يستحلّون لباس جلود و يزعمون ان دباغه ذكاته
و هذه الرواية- مع مجهولية أكثر رواتها و ضعف سندها- مخالفة فإنّه ان كان لا يجوز الصلاة فيه فلا يجوز لبسه أيضا، و الا فلا مانع من الصلاة فيه، فالمتعيّن حمله على الكراهة بالنسبة إلى الصلاة.
و بالإسناد، عن الحسن بن على، عن محمد بن عبد اللّٰه بن هلال (مجهول)، عن عبد الرحمن بن الحجاج (ثقة) قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: انى ادخل سوق المسلمين اعنى هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، و هل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية؟
فقال: لا و لكن لا بأس ان تبيعها و تقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية، قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق الميتة و زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله
و هذه أيضا كالسابقة- مع ضعف السند- مخالفة للقواعد فإنّها ان كانت في حكم الذكية يجوز بيعها على انّها ذكية و الّا فلا يجوز مطلقا فالتفصيل غير وجيه، فلا يرفع اليد عن الإطلاقات السابقة.
فعلم ان الجلد المأخوذ من يد المسلم يحكم بتذكيته و ان كان مستحلا للميتة، لإطلاق الدليل، مضافا الى تصريح روايةإسماعيل بن عيسى بعدم لزوم السؤال و لو كان المسلم غير عارف.
فتحصّل ان الحيوان و أجزائه من الجلد و اللحم و الشحم محكومة بالتذكية إذا أخذت من يد المسلم أو سوق المسلمين أو كانت فيها آثار مصنوعيتها في بلاد الإسلام من غير فرق بين المسلم الشيعي أو سوق الشيعة أو أرضها و بين غيرهم من المخالفين مع اختلاف فرقهم عدا الفرق المحكوم بكفرهم كالغلاة و النواصب و الخوارج و غيرهم، و من غير الفرق المستحلّة لجلد الميتة بالدباغ و غيره[23].
٢. الابطال/ بقدر الضروره
الابطال…
مفسدیّت شرط فاسد
علامه حلی
الفصل الثامن عشر في الشروط
مسألة: البيع إذا تضمن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط: يبطل الشرط خاصة دون البيع و به قال ابن الجنيد، و ابن البرّاج.
و المعتمد عندي بطلان العقد و الشرط معا.
لنا: أنّ للشرط قسطا من الثمن، فإنّه قد يزيد باعتباره و قد ينقص، و إذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن و هو غير معلوم، فتطرقت الجهالة إلى الثمن فيبطل البيع، و أيضا البائع إنّما رضي بنقل سلعة بهذا الثمن المعيّن على تقدير سلامة الشرط له، و كذا المشتري إنّما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة الشرط له، فاذا لم يسلّم لكلّ منهما ما شرطه كان البيع باطلا، لأنّه لا يكون تجارة عن تراض.
احتج بقوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و هذا بيع فيكون صحيحا، و الشرط باطل، لأنّه مخالف للكتاب و السنة. و بما روي عن عائشة أنّها اشترت بريرة بشرط العتق، و يكون ولاؤها لمواليها، فأجاز النبي- صلّى اللّه عليه و آله- البيع و أبطل الشرط، و صعد على المنبر و قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه، و كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل، و كتاب اللّه أحق و شرطه أوثق
و الجواب عن الأوّل: أنّ البيع انّما يكون حلالا لو وقع على الوجه المشروع، و نحن نمنع من شرعيته،
و عن الثاني من وجوه:
الأوّل: الطعن في السند.
الثاني: أنّ الحديث ورد هكذا: قالت عائشة: جائتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كلّ عام أوقية فاعتقيني، فقالت: أن أحبّ أهلك أن أعدّها لهم عدّة و يكون ولاؤك لي، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم و رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- جالس، فقالت: إنّي عرضت عليهم فأبوا ألّا يكون الولاء إلّا لهم، فسمع النبي- صلّى اللّه عليه و آله- [فسألني] فأخبرته، فقال: خذيها و اشترطي لهم الولاء، فإنّما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثمَّ قام رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فحمد اللّه و أثنى عليه، ثمَّ قال: أمّا بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه، ما كان كلّ شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل، و ان كان مائة شرط فقضاء اللّه أحقّ و شرط اللّه أوثق، و انّما الولاء لمن أعتق و هذا ينافي ما ذكره الشيخ، و استدلّ به عليه، لأنّ بريرة أخبرت بأنّها قد كوتبت و طلبت الإعانة من عائشة فسقط الاستدلال به بالكلّية.
الثالث: أنّ المراد بقوله- عليه السلام-: «اشترطي لهم الولاء» أي عليهم، لأنّه- عليه السلام- أمرها به و لا يأمرها بفاسد، و كيف يتأتى من الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- مع تحريم خائنة الأعين- و هو الغمز بها- و صنع حيلة لا تتم[24]؟
صاحب عناوین
العنوان الخمسون في بيان أن الشرط الفاسد مفسد للعقد
عنوان 50 من جملة المبطلات للعقود: اشتراط الشرط الفاسد فيها، فإنه مفسد للعقد. و الشرط الفاسد: هو المنافي لمقتضى العقد، أو المؤدي إلى جهالة العوضين، أو المخالف للكتاب و السنة، أو شرط حرم حلالا أو أحل حراما، و قد مر بيان هذه الأقسام في بحث الشروط و وجه دفع الأشكال عن معانيها و تحقيق موردها. و ما عدا ذلك فهو سائغ.
و الغرض هنا: بيان أن العقد متى اشترط فيه شرط فاسد، فهل يبطل العقد بفساد الشرط أو يفسد الشرط فقط دون العقد؟ و المحكي عن أكثر الأصحاب بطلان العقد أيضا، و ذهب بعضهم إلى بطلان الشرط خاصة و الحق ما ذهب إليه الأكثر، نظرا إلى أن المقرر في العناوين السابقة: أن العقد تابع للقصد بالتحقيق الذي مضى في محله و لا ريب أن الشرط المأخوذ في ضمن العقد بمنزلة الجزء من العوضين و قيد به العوضان و تعلق القصد بالمقيد، و قد مر في بحث الشروط: أن المراد بالشرط الواقع في ضمن العقد ربط المعاملة به، لا التزام خارجي لنفسه، فمتى تحقق الربط و فسد الشرط فما وقع عليه القصد من المركب لم يقع، و المطلق لم يتعلق به القصد فلا وجه لوقوعه. و ليس العقد دالا على وقوع المعاملة و إن انتفى الشرط، بل هو دال على عدمه بدونه، فالتمسك بعموم أوفوا بالعقود لا ينفع في بقاء الصحة، لأن هذا العقد المخصوص كان مقتضيا للأثر بهذا القيد، و مقتضاه عدمه عند عدم القيد، فيمكن دعوى: أن عموم أوفوا بالعقود و (المؤمنون عند شروطهم يدل على البطلان، لا الصحة بأحد الاعتبارات، فتدبر. و لو فرض أن العقد بظاهره اقتضى الوقوع بدون الشرط أيضا نقول: لا وجه لبقاء الصحة، لعدم القصد على ذلك. و لو كان قاصدا للوقوع بدون الشرط أيضا لا يصح، لعدم الدال حينئذ عليه، و القصد الخالي عن الدال قد مر أنه لا عبرة به، و اللفظ بعد التقييد بالشرط دال على الربط، فتدبر. و قد تمسك بهذه القاعدة كثير من الفقهاء في كثير من الأبواب، كشرط عدم إشاعة الحصة في المزارعة أو في المساقاة أو في المضاربة، أو شرط عدم التزويج عليها في النكاح، أو شرط عدم التصرف في المبيع، و نظائر ذلك، و كلها مبنية على إبطال الشرط الفاسد للعقد، و قد عرفت الوجه في ذلك. و الشرط الفاسد لا يخلو من أحد الأقسام الأربعة، فكل مقام حكم الفقهاء ببطلان شرط في العقود لا بد من إرجاعه إلى أحد الأمور الأربعة حتى يوجب البطلان في نفسه في العقد، لما ذكرناه. و قد مر الوجه في وجه فساد هذه الأربعة في نفسها مستوفى، فراجع
و هذه القاعدة قد تنخرم في بعض المقامات لدليل خاص من الشرع، كما ورد في النكاح في بعض المقامات: أن الشرط يبطل و العقد لا يبطل و أفتى به بعض الأصحاب و بالجملة: كل ما حكمنا بفساد الشرط لأحد الأمور الأربعة حكمنا بفساد العقد، إلا بدليل دل عليه. و يمكن الاستدلال على البطلان مضافا إلى ما مر بأن بطلان الشرط يوجب جهالة في أحد العوضين، لأن له قسطا من العوض، و لازمه البطلان، و من ثم لا يجري في النكاح، لأنه ليس معاوضة صرفة، فتدبر[25].
بقدر الضروره
سید محمد کاظم یزدی
سؤال ۳۵۷ [فساد عقد بر اثر شرط فاسد]
شرط فاسد در ضمن عقود را مفسد مىدانيد يا نه؟
جواب: اقوى اين است كه مفسد نيست. و مما يمكن أن يستدل به على ذلك منا يتضمنه صحيح زرارة و محمد بن مسلم في مسألة الفرار من الزكاة إذا وهب ما عنده قبل حلول الحول في حديث طويل، قال زرارة قلت له
: رجل كانت له مائتا درهم، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال:" إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة"، قلت: فإذا حدث فيها قبل الحول، قال:" جائز ذلك له"، قلت: إنه فر بها من الزكاة، قال:" ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها"، فقلت له: إنه يقدر عليها، قال: فقال:" و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت عن ملكه". قلت: فإنه دفعها إليه على شرط، فقال:" إنه إذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة". قلت له: و كيف يسقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن الزكاة؟ فقال:" هذا شرط فاسد، و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة لازمة عقوبة له[26]
دلالت نهی بر فساد
الابطال
شهید اول
قاعدة- 57 النهي في العبادات مفسد و إن كان بوصف خارج، كالطهارة بالماء المغصوب، و الصلاة في المكان المغصوب.
و في غيرها مفسد إذا كان عن نفس الماهية، لا لأمر خارج، فالبيع المشتمل على الرّبا فاسد لا يملك المساوي و لا الزائد، و البيع وقت النداء صحيح، لأن النهي في الأول لنفس ماهية البيع، و في الثاني لوصف خارج.
و في ذبح الأضحية و الهدي بآلة مغصوبة، نظر[27].
شهید ثانی
قاعدة «42» النهي في العبادات يدل على الفساد مطلقا، و كذا في المعاملات، إلا أن يرجع النهي إلى أمر مقارن للعقد، غير لازم له، بل منفك عنه، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة، لا لخصوص البيع، إذ الأعمال كلها كذلك، و التفويت غير لازم لماهية البيع.
و في المسألة أقوال أخر:
أحدها: لا يدل عليه مطلقا، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء و الآمدي عن المحققين
و الثاني: يدل عليه مطلقا، صححه ابن الحاجب
و الثالث: يدل في العبادات دون المعاملات، اختاره في المحصول
و حيث قلنا: يدل على الفساد فقيل: يدل من جهة اللغة ، و قيل: من جهة الشرع و هو الأظهر.
و إذا قلنا: لا يدل على الفساد، لا يدل على الصحة بطريق أولى. و بالغ أبو حنيفة و تلميذه محمد فقالا: يدل على الصحة، لأن التعبير به يقتضي انصرافه إلى الصحيح، إذ يستحيل النهي عن المستحيل
إذا تقرر ذلك ففروع القاعدة كثيرة جدا لا تخفى، كالطهارة بالماء المغصوب، و الصلاة في المكان المغصوب، و الصوم الواجب سفرا عدا ما استثني، و الحج المندوب بدون إذن الزوج و المولى، و بيع الرّبا و الغرر و غيرها.
و من هذا الباب ما لو ترك المتوضئ غسل رجليه في موضع التقية، أو مسح خفيه كذلك، و إن أتى بالهيئة المشروعة عنده، لأن العبادة المأمور بها حينئذ هي الغسل و المسح، و العدول عنهما منهي عنه، و الواقع بدلهما جزء من العبادة منهي عنه، فيقع فاسدا. بخلاف ما لو ترك التكتف أو التأمين في موضعهما، فإنهما أمران خارجان عن ماهية العبادة فلا يقدحان في صحّتها.
و قد اختلف فيما لو صلى مستصحبا لشيء مغصوب غير مستتر به، هل تصح صلاته أم لا؟ و مقتضى القاعدة الصحة، إذ النهي خارج عن ذات الصلاة و شرطها، و هو اختيار المحقق و المشهور الفساد نظرا إلى صورة النهي الواقع في العبادة، و لا يخفى ضعفه.
و من هذا الباب الصلاة مع سعة الوقت بعد وجوب أداء الحق المضيق من دين مطالب به، أو حق يجب أداؤه على الفور، لأن المستحق في قوة المطالب.و قد تقدم الكلام فيه[28]
شیخ جعفر کاشف الغطاء
البحث التاسع عشر [حرمة العمل مقتضية لفساد العبادة على وجه اللزوم واقعاً.]
في أنّ حرمة العمل أصليّة واقعيّة، لنفسه أو لغيره، من داخل أو خارج، لازم أو مفارق، مستفادة من عقل أو نقل مقتضية لفساد العبادة على وجه اللزوم واقعاً. و ما دلّ على التحريم ظاهراً ظاهراً في كتاب أو سنّة أو كلام فقيه، بصيغة نهي أو نفي أو غيرهما.
و كذا ما تعلّق بالأجزاء، و ما كان من العبادات من شروط أو لوازم لها إن جعلنا الفساد مخالفة الأمر. و إن جعل عدم إسقاط القضاء فالاقتضاء ظاهريّ فقط؛ لظهور (عدم) الإجزاء منه، و لا ملازمة عقليّة فيه.
و تخصيص مسألة النهي في كلامهم لبيان اقتضاء نفس الصيغة أو لقصد المثال و إذا تعلّق بالمقارن، فإن قيّد بالعبادة قضى ظاهر الخطاب بفسادها دون العقل، كما إذا قيل لا تتكلّم و لا تضحك في الصلاة، و لا ترتمس في الصيام.
و إن لم يقيّد بها، بل تعلّق به التحريم العام و لم يتّحد بها و لا بجزئها كالنظر إلى الأجنبيّة، و استماع الغناء و الملاهي، و الحسد و الحقد و نحوها، فلا يقضي بالفساد.
و المعاملة على نحو العبادة لا فرق بينهما، غير أنّ الاقتضاء فيها لا يستند إلى عقل و لا إلى لفظ على وجه اللزوم؛ لأنّه لا منافاة بين تحريم المعاملة و صحّتها و ترتّب أثرها كالظهار و نحوه، و الفساد بالنسبة إلى الآخرة قد يكون عين صلاح الدنيا.
و الدلالة على التحريم لا تستلزم الدلالة على الفساد و لا تقتضيه إلا لأمر خارجيّ، و هو ظهور إرادة عدم ترتّب الأثر، و هو الأُخرويّ في العبادة و الدنيويّ في المعاملة، و ذلك مستتبع للفساد، فتكون الدلالة في العبادة على الفساد من وجوه، و في المعاملة من وجهين، و ينكشف الحال بالنظر إلى النواهي الصادرة من كلّ مطاعٍ إلى مطيع.
و في استدلال الأئمّة عليهم السلام و أصحابهم بما في الكتاب أو الكتب السابقة، أو كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم أو باقي الأنبياء عليهم السلام بما دلّ على النهي على الفساد كفاية في إثبات المطلوب.
فلا حاجة إلى الرجوع فيه إلى الإجماع على الحمل عليه ما لم يكن منافٍ له، و لا إلى الشكّ في دخوله تحت العمومات، و لا إلى الخروج عمّا اشتمل على لفظ التحليل و نحوه في بعض الأقسام.
و لا إلى لزوم منافاة الغرض؛ لأنّ الصحّة ترغّب إلى فعل المعصية، و لا إلى أنّ المقام من المطالب اللغويّة، فيكفي قول الفقيه الواحد، كما يكتفى بقول اللغويّ الواحد، لأنّ القائلين منهم من أئمّة اللغة.
و الحاصل أنّ الأحكام الثلاثة، من التحريم، و الكراهة بمعناها الحقيقي و الإباحة، تنافي بذاتها صحّة العبادة، و الدالّ عليها بأيّ عبارة كان مفيد لفسادها.
بخلاف المعاملة، فإنّه لا ينافيها شيء منها، لكن ما دلّ على النهي عنها بأيّ عبارة كان يفيد فسادها ظاهراً.
و إذا تعلّق ما دلّ على الإباحة و الكراهة بالعبادة أفاد صحّتها؛ لأنّها لا يجوز الإتيان بها إلا مع الصحّة، للزوم التشريع مع عدمها.
ثمّ الظاهر من شرطيّة الشرط و مانعيّة المانع وجوديّتهما لا علميّتهما، من غير فرق بين الوضع و الخطاب، و من الأمر بشيء، و النهي عن شيء، في عبادة أو معاملة، الشرطيّة و المانعيّة، دون مجرّد الوجوب و التحريم[29].
بقدر الضروره
صاحب عناوین
العنوان الثاني و الخمسون تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها
عنوان 52 من جملة المبطلات للمعاملة: تعلق نهي الشارع بها.
و قد تمسك بذلك كثير من الأصحاب في كثير من المقامات، و المسألة محررة في الأصول، لكن البحث في الأصول من جهة دلالة النهي على الفساد و عدمها، و ما نحن فيه أعم من ذلك، و الغرض: إثبات أن المعاملة المنهي عنها فاسدة، سواء كان ذلك من دلالة النهي على الفساد أو من جهة قرينة أخرى، أو قاعدة شرعية، كما نقررها في تحرير الأدلة.
و المشهور بين الأصوليين: أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات، و ذهب المرتضى و جماعة إلى أن النهي يدل عليه و ظاهر جمع من فقهائنا: التفصيل بين النهي المتعلق بأركان المعاملة و بين غيره، فيدل الأول على الفساد دون الثاني، و هنا مذاهب آخر لا حاجة لنا إلى ذكرها، و قد نبه على ذلك التفصيل المحقق الثاني رحمه الله في حاشية القواعد، حيث ذكر جملة من المعاملات المحرمة في أول المكاسب إلى أن قال-: و هذه المعاملات كلها فاسدة، لرجوع النهي إما إلى أحد العوضين، أو أحد المتعاقدين و هذا التعليل يشير إلى هذا التفصيل و إن كان العبارة أعم.
و بالجملة: الظاهر من تتبع طريقة الفقهاء: حكمهم بالفساد بتعلق النهي إلى أحد الأركان كيف كان. و قد يمنعون أيضا الفساد في بعض المقامات تمسكا بأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد.
ثم إن النهي قد يتعلق بالمعاملة لنفسها، و قد يتعلق لجزئها، و قد يتعلق لوصفها اللازم، و قد يتعلق لوصفها المفارق، و قد يتعلق لأمر خارج، و المسألة مبسوطة في كتب الأصول لا غرض لنا في ذكرها، و العمدة بيان الوجه في الفساد في المحل المقصود.
فنقول لفظ (النهي) بنفسه من دون ملاحظة أمر خارجي لا يدل على فساد المعاملة بأي نحو تعلق، لا بالمطابقة و لا بالتضمن، و الوجه واضح، و لا بالالتزام، لعدم اللزوم، و مدلول النهي إنما هو التحريم في المنهي عنه و العقاب على فعله، و ترتب الأثر لا دخل له في ذلك، لجواز ترتبه على أمر نهي عنه أيضا كما في صورة النهي لأمر خارج، كالبيع وقت النداء فإنه حرام موجب للعقاب بالنهي، و مع ذلك ذهب المشهور بل الكل على عدم فساد البيع بذلك. و بالجملة: لا ملازمة بين التحريم و الفساد، فلا دلالة، لأنها فرع اللزوم. نعم، نقول: بأن النهي متى ما تعلق يصير المعاملة فاسدة إذا كان النهي متعلقا بأحد الأركان لوجوه:
الأول: مصير معظم الأصحاب عليه، بل لم يزل الفقهاء كافة يستدلون في أبواب الفقه بالنهي على الفساد
كما ذكره المرتضى رحمه الله و هو واضح لمن تتبع، و لا نقول بأنه دال على الفساد شرعا كما ادعاه المرتضى حتى يستلزم النقل
مدلول النهى، بل الظاهر أنه على معناه اللغوي و العرفي، لكن هذا التمسك [و الإجماع] كاشف إما عن وجود قرينة عندهم على ذلك، أو وجود دليل دال على كون المنهي عنه فاسدا، فيكون النهي أمارة محققة للموضوع، و يجيء الفساد من نفس القاعدة المقررة. و قد وجدنا الفقهاء في صورة تعلق النهي بالأركان متسالمين على هذا المعنى و إن منعوا في صورة تعلق النهي لأمر خارج، فعليك بالتتبع.
الثاني: الإجماع
الذي نقله المرتضى رحمه الله و غيره على ذلك كما هو مذكور في علم الأصول و جعله حجة على الدلالة شرعا، مع اعتضاده بفتوى كثير من الأصحاب متقدما عليه و متأخرا عنه.
الثالث: الاستقراء
، فإنا قد وجدنا كثيرا من المعاملات المنهي عنها لركنها فاسدة، بحيث علم فسادها من إجماع أو شيء آخر بحيث لم يبق لنا بحث في فسادها، فإذا صار الغالب فيها ذلك يحمل المشكوك فيه على الغالب من الفساد و إن لم يدل فيه شيء على فساده.
الرابع: ما ورد في الرواية في نكاح العبد بغير إذن سيده أنه يصح
لأنه ما عصى الله بل عصى سيده و هذا التعليل يدل على أن العقد لو كان فيه معصية الله لكان فاسدا. لا يقال: إن معصية السيد أيضا معصية الله تعالى، فينبغي على هذا أيضا أن يكون فاسدا. لأنا نقول: إن الظاهر من الرواية: أن معصية الله ابتداء مبطلة بمعنى: أنه لو كان العقد محرما بأصل الشرع لوقع فاسدا، بخلاف ما لو كان التحريم لأمر خارج، فإنه غير مبطل، و هذا يدل على التفصيل الذي أشرنا إليه: من أن التحريم إن كان ناشئا عن أصل المعاملة بمعنى كون سببه أحد أركان العقد لزمه الفساد و إن كان من أمر خارج فلا، و نكاح العبد بغير إذن سيده ليس فيه تحريم من جهة نفس العقد و لا من أجزائه و أركانه، و إنما هو لمخالفة المولى. فإن قلت: إن هذه الرواية تدل على كون العقد المنذور تركه أيضا باطلا كما لو حلف أن لا يبيع أو نذر و نحو ذلك، لأن العقد حينئذ معصية الله. قلت: ليس كذلك، بل الظاهر من الرواية كون نفس العقد معصية لله لو خلي و نفسه من دون انضمام أمر خارج إليه، و ليس النذر و العهد بالنسبة إلى العقد إلا كإذن المولى في العبد، و إن كان المنع في النذر عن الله تعالى، لكن بواسطة إلزام العبد نفسه به، كما أن منع الشارع عن عقد العبد بواسطة منع سيده. و بالجملة: ظاهر الخبر: أن كون العقد بنفسه معصية لله يوجب بطلانه. و المناقشة في سند الرواية أو في حجيتها في المقام خالية عن الوجه، لأن سندها معتبر و حجيتها في المقام لا ريب فيها، إذ ليس الغرض إلا تأسيس قاعدة شرعية في أن المعاملة المنهي عنها فاسدة، و ليست المسألة أصولية، لأنا لا نتكلم في دلالة النهي على الفساد، بل نجعله أمارة محققة للموضوع، فتدبر. و لا يعارضه ظهور النواهي في الأعمية عن البطلان و العدم، لعدم التنافي. نعم، لو ادعينا دلالة الرواية على أن النهي يقضي بالفساد للزم هذا المحذور. و لو سلم المنافاة و المعارضة، فنقول: ورود الخبر على مدلول النواهي و رجحانه عليها واضح، و ليس إلا كما لو قال المولى لعبده: (كل ما نهيتك عنه لو فعلته كان فاسدا، بلا ثمرة) بعد صدور نواه كثيرة عنه، و قد مر نظير هذا الكلام في تأسيس أصالة التعبد في الأوامر، فراجع و في الخبر أبحاث كثيرة موكولة إلى ما حرر في الأصول، و هذا المقدار كاف فيما نحن بصدده بعد وضوح المرام.
الخامس: أن النهي و إن لم يدل على الفساد بالوضع
، و لكن تعلق المنع بأحد الأركان يقتضي كون المراد به الفساد، فيكون بمنزلة القرينة، نظرا إلى أن الأمر أو النهي المتعلق بشيء ينساق منه إلى الذهن جهته المقصودة بالذات، و لا ريب أن المقصود الذاتي في المعاملات ترتب الآثار عليها، و أما الإباحة و التحريم فهما من التكاليف التي لا ربط لها بالمعاملة من حيث هي كذلك، فإذا تعلق النهي بها يدل على عدم وجود ما هو المقصود من المعاملة فيه، و هو ترتب الأثر، لا عدم الثواب أو وجود العقاب. و بالجملة: تعلق نهي الشارع على شيء يدل على أن الآثار المطلوبة منه من حيث هو كذلك غير مترتبة عليه و هو الفساد، و لا فرق في ذلك بين العبادة و المعاملة. و ما يقال: إنه على هذا لا يختص بصورة التعلق بالأركان، بل يعم المنهي عنه كيف كان، مدفوع بوجود الفرق، إذ لو كان التعلق بأحد الأركان فيكون المعاملة منهيا عنها. و أما لو كان لغير ذلك كان المنهي عنه أمرا خارجيا، و إن وجد في ضمن المعاملة فلا يصير الحيثية المذكورة آتية فيه، بل يلاحظ فيه حيثية أخرى، فلا تذهل.
السادس: أن وظيفة الشرع إنما هو الإرشاد إلى ما هو المصلحة و المفسدة
، كأوامر الطبيب في وجه، و هما يلاحظان من جهات شتى، و ظاهر النهي كون الشيء ذا مفسدة مطلقا، و منها عدم ترتب الآثار، و إن أمكن أن يقال: يكفي في ذلك وجود المفسدة الكامنة الموجبة للعقاب و إن لم يكن المفسدة هو عدم ترتب الأثر. لكن يمكن القول بأن الشيء الذي فيه مفسدة ذاتية توجب العقاب لا يجوز على الشارع الحكيم إمضاء آثاره و لوازمه المقصودة منه، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. و فيه نظر، إلا أنه [فيه] نوع تأييد، و لعله إلى ما ذكرنا ينظر قول من قال: إن المنهي عنه لو كان صحيحا لزم من صحته حكمة تدل عليها الصحة و من تحريمه حكمة يدل عليها النهي، و هما إما متساويان أو أحدهما يزيد على الأخر، فيلزم ارتفاعهما على الأول أو الصحة، إذ بعد التساقط يبقى على أصالة الإباحة كسائر المعاملات و على الثاني يلزم ارتفاع الناقص بصورتيه و المقصود: أن الصحة و ترتب الأثر كاشف عن مصلحة فيه و التحريم كاشف عن مفسدة، فإما أن يتكافئا فيلزم الصحة، و إما أن يختلفا فاللازم عدم الصحة لو رجحت المفسدة و عدم التحريم لو رجحت المصلحة. و هذا كلام جيد جدا و إن زيفه كثير من الأصوليين. و ما يقال: إن هذا لا يدل على الفساد إذ غايته دوران الأمر بين بقاء الصحة أو التحريم، و لعل التحريم مرتفع خطأ محض، إذ لو فرض ارتفاع التحريم خرج عن محل البحث، إذ الفرض كونها معاملة منهيا عنها، و متى ثبت التحريم لزم البطلان، لعدم إمكان الاجتماع. و هنا كلام في النقض و الحل موكول إلى ما حرر في الأصول في بحث النهي في العبادات و اجتماع الأمر و النهي.
السابع: ما ورد في الروايات عن الأئمة عليهم السلام في بيان بطلان بعض المعاملات من التمسك بالنهي كما في (حرم الربا) و (نهى النبي صلى الله عليه و آله عن الغرر) و نظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع، فإن ظاهر هذه الأخبار أن المنهي عنه فاسد، و ذلك واضح.
و الثامن: ما ذكره بعضهم: من أن النهي متى ما دل على التحريم خصص ما دل على صحة العقود
من قبيل: أحل الله البيع و (الصلح جائز) و أوفوا بالعقود) و (النكاح من سنتي) و نحو ذلك، للتعارض بينهما بالعموم و الخصوص المطلقين، فيخرج المنهي عنه عن عموم أدلة الجواز و الإباحة. و الصحة و إن كانت من الأحكام الوضعية، لكنها تابعة في هذه الأدلة للحكم التكليفي، بمعنى: أن الصحة قد استفيدت من أدلة الإباحة و لزوم الوفاء، فمتى ما زال الحل بالنهي فلا وجه لبقاء الصحة، و ذلك نظير تبعية المفهوم للمنطوق، إذ لو جاء ما يعارض المنطوق و أسقطه عن الاعتبار فلا يلتفت بعد ذلك إلى المفهوم. و بالجملة: المنهي عنه بخروجه عن أدلة الصحة يرجع إلى أصالة الفساد الأولية، و لذلك نقول: إن المنهي عنه فاسد، لا أن النهي يدل على الفساد. و ما يقال: إن هذا الكلام يتجه فيما لو كان دليل الصحة منحصرا في العمومات التكليفية، و أما العمومات الوضعية: كقوله: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا و نحو ذلك فلا يتخصص بالنهي، و يكفي ذلك في إثبات الصحة مع عدم المنافاة بينها و بين التحريم فتدبر مدفوع بأن الأدلة الوضعية مع عدم وجودها في كثير من الأبواب و أخصيتها من المدعى لو كانت إنما هي مسوقة لبيان حكم آخر، و لا دلالة فيها على إثبات الصحة حتى يتمسك بها في مقابل النهي. و بالجملة المعاملة المنهي عنها لركنها فاسدة بما مر من الوجوه، و عليه طريقة الأصحاب في كل باب[30].
شیخ محمدحسین کاشف الغطاء
(54) النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا و في المعاملات في الجملة
اما وجه دلالته على الفساد في العبادة فواضح ضرورة ان العبادة روحها القربة و ان يكون العمل مقربا و النهي يقتضي كونه مبغوضا و المبغوض لا يصلح ان يكون مقربا. اما في المعاملات فالنهي لا يخلو اما ان يكون لذات المعاملة أو لركنها أو غير ركن من أجزائها أو لو صفها اللازم أو لوصفها المفارق أو لأمر خارج عنها اما النهي لذاته فمثل قوله (ع) (لا تبع ما ليس عندك). و (لا بيع إلا في ملك)، و اما لأركانها فمثل قوله ثمن (الكلب سحت) فان الثمن و المثمن ركنا المعاملة، و اما لأجزائها الغير الركنية فمثل النهي عن بيع غير البالغ فإن البائع و المشتري و ان لم يكونا أركانا في المعاملة و لكنهما من جهة لزوم رضاهما جزءان لها، و اما النهي عن أوصافها اللازمة فمثل النهي عن ملك الرجل عموديه و محارمه فإن الملكية من آثار البيع اللازمة، و اما لوصفها المفارق فمثل المنع من لزوم المعاملة بخيار أو فسخ فان اللزوم وصف مفارق لها، و اما ما كان لأمر خارج فمثل النهي عن البيع وقت النداء بقوله تعالى. (فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ)، و مثل هذا النهي لا يقتضي الفساد قطعا كما ان النهي عن الأركان يقتضيه اتفاقا و اما الباقي فمحل خلاف و الحق ان المقامات تختلف و يلزم النظر في دليل كل مورد بخصوصه حتى يستظهر منه ان المراد من النهي هو الفساد و الحكم الوضعي أو محض الحرمة و الحكم التكليفي فمثل حديث نهي النبي (ص) عن بيع الغرر حيث ان الغرر هو الجهالة و الاقدام على الخطر و هي ترجع الى الثمن أو المثمن و هما ركنان فلا ريب في انه يدل على الفساد. و لكن مثل لا يملك الرجل عموديه يحتمل الحرمة و يحتمل الفساد و يلزم في مثله التأمل و الاستعانة بالقرائن لتحصيل الحقيقة و هي من وظائف المجتهد المطلق و باقي البحث موكول الى محله[31]
شیخ محمدجواد مغنیه
النهي عن المعاملات:
اشتهر على الألسن ان النهي عن العبادات يدل على الفساد، دون المعاملات، و الحق أن النهي يدل بالمطابقة على التحريم فقط، و لا يدل بنفسه على الفساد، لا في العبادات، و لا في المعاملات، فإذا قال لك الشارع: لا تزل النجاسة بالماء المغصوب، و لا تذبح شاة الغير، و لا تقطع رأس الذبيحة حين الذبح، ثم خالفت، فغسلت النجاسة بالمغصوب، و ذبحت شاة الغير، و قطعت رأس الذبيحة عند الذبح، فان الثوب يطهر، و لحم الشاة لا يحرم، و ان كنت آثما بالعصيان، و تعرضت لغضب اللّه و عقابه، و إذا لم يدل النهي على الفساد من غير قرينة في مورد واحد فلا يدل عليه في كل مورد بلا قرينة، عبادة كان أو غيرها.
أجل، ان تحريم الشيء، أي شيء يستدعي أن يكون مكروها و مرغوبا عنه، و لا يصح عقلا التعبد للّه سبحانه بما يكره و يبغض، لأنه جل و عز لا يطاع من حيث يعصى و عليه فلا تكن العبادة المنهي عنها مقبولة لديه تعالى، و لا معنى لفساد العبادة إلّا هذا. و منه يتضح ان دلالة النهي على فساد العبادة جاءت بتوسط العقل، و حكمه بأن المبغوض لا يمكن التقرب به إلى اللّه، أمّا النهي عن المعاملة فلا يدل على الفساد لا بنفسه و لا بالواسطة، و لعل هذا مراد من قال: ان النهي عن العبادات يدل على الفساد، دون المعاملات.
غير أن الشارع كثيرا ما ينهى عن المعاملة إرشادا إلى أنّها غير مشروعة من الأساس، كبيع الحصاة أو إلى أنّها تفقد شرطا من الشروط، كبيع المجنون، و الصبي غير المميز، أو إلى أن العين ليست أهلا للتمليك و التملك، كالخمر و الخنزير، و ما إلى ذاك مما لا يترتب عليه الأثر، لعدم استيفاء الشروط و توافرها.
و بتعبير ثان ان الشارع قد ينهى عن المعاملة الفاسدة التي نشأ فسادها من أمر آخر غير النهي، و لذا اتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن المعاملة التي تتوافر فيها جميع الشروط تؤثر أثرها، و لا يتخلف عنها حكم من أحكامها، حتى و لو نهى عنها الشارع لسبب خارجي، كالنهي عن البيع حين النداء لصلاة الجمعة، أجل، يكون المباشر عاصيا مستحقّا للوم و العقاب، لمخالفة النهي.
و بالاختصار ان صيغة النهي من حيث هي لا تدل إلّا على التحريم و القبح و معصية من خالف، و لم يمتثل، و هذا شيء، و سلب التأثير عن الفعل أو القول شيء آخر، و لكن لما كان تحريم الشيء يمنع من التقرب به إلى اللّه سبحانه بطلت العبادة المنهي عنها لذلك، لا لأن النهي عنها دل على بطلانها بالذات، أما المعاملة فليس الغرض منها التقرب إلى اللّه، و لذا تبقى سببا للتأثير و الإفادة حين النهي، كما كانت قبله[32].
میرزا علی مشکینی
النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا؟
وقع البحث بين الأصوليين في أن تعلق النهي بشيء هل يقتضي فساده أم لا.
و ليعلم أولا أن مورد الكلام هي الأفعال القابلة لأن تتصف بالصحة بمعنى كونها تامة واجدة للآثار المطلوبة منها، و أن تتصف بالفساد بمعنى كونها ناقصة فاقدة لتلك الآثار، و ذلك كالغسل و الصلاة و سائر العبادات و صيغ العقود و الإيقاعات و كالاصطياد و الذبح و نحوهما من الموضوعات، فإن لها أفرادا جامعة لما له دخل في كمالها فيترتب عليها الآثار المطلوبة منها، و أفرادا فاقدة للكمال و الآثار.
و حينئذ نقول إذا تعلق نهي تحريمي بفعل من تلك الأفعال فيقع الكلام تارة في أنه هل يحكم العقل بالملازمة بين المبغوضية و الفساد فيحكم بفساد المنهي عنه و عدم ترتب الآثار على متعلقه أم لا فالمسألة حينئذ عقلية، و أخرى في أنه هل يدل لفظ النهي على عدم ترتب الآثار على متعلقه أم لا فالمسألة حينئذ لفظية.
و أخصر البيان في تحرير المسألة أن نقول إن كان متعلق النهي عبادة كالصلاة المزاحمة للإزالة و النافلة الواقعة في وقت الفريضة مثلا. فالأظهر القول بالبطلان و عدم الأثر عقلا لكن لا من جهة دلالة اللفظ، و ذلك لحكم العقل بعدم اجتماع المبغوضية المستفادة من النهي مع المقربية التي هي قوام العبادة و إذ لا صحة فلا يترتب أثرها من سقوط التكليف و استحقاق الأجر عليها و كونها وفاء للنذر و نحوها من الآثار، هذا إن كان متعلق النهي عبادة.
و إن كان غير عبادة فلا وجه للحكم بالفساد حينئذ لعدم دلالة النهي إلا على مبغوضية الفعل و عدم وجود الملازمة بين المبغوضية و عدم ترتب الآثار عقلا.
فلو غسل ثوبه النجس بالماء المغصوب أو ذبح الحيوان المغصوب أو باع ماله وقت النداء أو اصطاد ما نذر عدم صيده لم تقع تلك الأمور فاسدة و إن وقعت محرمة و في المسألة أقوال أغمضنا عن ذكرها روما للاختصار[33].
معامله سفیه؛ معامله سفهی
صاحب عناوین
العنوان الحادي و الخمسون في بطلان المعاملة السفهية، و بيان المراد منها
عنوان 51 من جملة ما ينبغي أن يجعل قاعدة كلية مخرجة عن قاعدة أصالة الصحة المتقدمة قاضية بالبطلان ابتداء: كون المعاملة سفهية. و قد أشار إلى هذه القاعدة الشهيد رحمه الله في اللمعة، قال: (و لا حجر في زيادة الثمن و نقصانه ما لم يؤد الى السفه و هذه العبارة دالة على أن السفهية من جملة المبطلات الابتدائية. و البحث هنا يقع في مقامات، باعتبار بيان موضوع السفهية، و مواردها، و الوجه الدال على بطلان المعاملة بها.
الأول: في بيان معنى كون المعاملة سفهية،
فنقول: لا ريب أن السفه في المعاملات أو في مطلق العقد ليس عبارة عن كون المتعاقدين سفيهين أو أحدهما سفيها، بل المراد كون المعاملة من شأنها أن تصدر من سفيه، و حيث إن المسألة تتفرع على بيان أصل معنى (السفه) المقابل للرشد، يتوقف معرفتها على ما نبينه في الشرائط العامة إن شاء الله، و لكن حيث إن السفه عبارة عن نقصان العقل المخرج أفعال صاحبه عن طريقة العقلاء و ما عليه عادة أغلب الناس و إن كان توضيح هذا المطلب يحتاج إلى بسط فتكون المعاملة السفهية عبارة عن نوع لا يصدر عن غالب الناس، و لا يقع عند العقلاء عادة بحيث لو صدر عن واحد منهم يعلم أن هذا على خلاف طريقة العقلاء.
و ربما يستفاد من بعض العبائر: أن المعاملة السفهية ما دل على سفه فاعله، فتكون السفهية عبارة عن كون فاعله سفيها، و يكون وجه الامتياز بين المقام و بين عموم أدلة اعتبار الرشد في الماليات: أن المتعاقدين مرة يعلم سفههما أو سفه أحدهما قبل المعاملة بطرق الاختبار، ثم تصدر عنهما المعاملة، فهذه معاملة سفيه تتوقف على إجازة الولي على المشهور المنصور. و مرة يعلم سفههما بنفس المعاملة، بمعنى: أن بصدور مثل هذه المعاملة يعلم كونهما سفيهين و إن لم يكونا سفيهين قبل ذلك، فلا يرد عليه: أن هذه المعاملة لو كانت معاملة سفيه انكشف سفهه بهذه المعاملة، فلا وجه للتقييد في زيادة الثمن و نقصانه بعدم أدائه إلى السفه، فإن اشتراط الرشد من الأمور الواضحة المذكورة في أول الشرائط، فينبغي أن يقال: إلا أن يكون المتعاقدان أو أحدهما سفيها و وجه الدفع ما ذكرناه من الفرق بين كون السفه معلوما قبل المعاملة أو بنفس المعاملة.
و لكن هذا الكلام مختل النظام، لوجوه واضحة: أحدها: أن معاملة السفيه لا تقع باطلة، بل يمكن أن تكون صحيحة بإذن الولي، لأن عبارة السفيه ليست [كعبارة] المجنون و الطفل، و لهذا يجوز أن يكون وكيلا عن الغير. نعم، هو محجور عن التصرف في ماله، فإذا اذن الولي في تصرف خاص يكون كالوكيل عن الغير أو الفضولي مع الإجازة، و لا مانع من صحته. بخلاف المقام، فإن المعاملة السفهية باطلة بالمرة من أصلها، و ليس له وجه صحة مطلقا، فإدراج المقام تحت معاملة السفيه لا وجه له. ...
الثاني أن السفهية و إن فرض في كلام الشهيد رحمه الله و غيره في البيع، لكنه لا [يختص به] يختص به، بل يعم سائر المعاوضات: من إجارة و صلح و نكاح و مسابقة و جعالة و مزارعة و مساقاة و مضاربة و نحو ذلك، بل يعم غير ما فيه المعاوضة أيضا كالوكالة و نحوها، ...
الثالث أن الوجه في بطلان هذه المعاملة:
أن عمدة العماد في إثبات الصحة الرافعة لأصالة الفساد إنما هو جريان المعاملات في زمن الشارع على هذا المنوال و عدم تعرضه في ذلك بالقدح و البطلان، فيكون تقريرا منه في ذلك كما بيناه و لا ريب أن تقريره لا يكون إلا بما هو معتاد أغلب الناس، و هو لا يكون سفهية. و لو فرض أن في ذلك الزمان كان يصدر منهم أيضا معاملات غير مقصودة للعقلاء كما هو المتعارف بين الجهال و الأراذل في زماننا أيضا فلا نسلم اطلاع المعصوم عليها في ذلك الوقت، و ليس صدور الفعل عادة كافيا في التقرير، بل المعتبر صدور الفعل بمرأى منه و مسمع، و لا ريب أن أمثال هذه الأمور لا يؤتى بها في حضور المعصوم عليه السلام و لو فرض الاطلاع عليها فنمنع التمكن في ذلك الوقت عن الردع، و لو سلم ذلك كله فنمنع عدم الردع. و إطباق الأصحاب على البطلان مع أنه حجة برأسه في هذا المقام كاشف عن صدور الردع و المنع عن ذلك كله.
مضافا إلى أن عموم قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ شامل لذلك، لأن الباطل في العرف ليس إلا ما لا نفع فيه، و الإطلاق منزل على العرف، و لا يراد منه الباطل شرعا، للزوم الدور، فتأمل، و لأن إثبات البطلان شرعا إنما يتحقق بهذه الآية في غير المستثنى، فكيف يعقل إرادة الباطل شرعا مع أن البطلان ليس له حقيقة شرعية جزما حتى يحمل عليها اللفظ؟ و يكشف عن ذلك تمسك الأصحاب به في إبطال أكثر المعاملات الفاسدة، و لو أريد منه الباطل شرعا فلا وجه للتمسك به، مع أن استثناء (تجارة عن تراض) يدل على أن ما عدا ذلك محكوم ببطلانه و داخل تحت أكل المال بالباطل، و ما نحن فيه ليس من باب (تجارة عن تراض). فإن قلت: إن البحث في صورة المعاوضة، فيكون داخلا تحت (تجارة عن تراض) فهذا يدل على صحته، لا فساده. قلت: أما أولا: إن التجارة يراد بها ما هو و صلة إلى تحصيل المال، و لا ريب أن المعاملة إذا كانت سفهية، فإما أن يكون طرفاه أو أحدهما مما لا يعد مالا كالحشرات و نحوها، أو مما يعد مالا لكنه لا فائدة فيه، بل هو محض تضييع للمال، و على التقديرين فهو خارج عن اسم التجارة. و لو سلم شمول لفظ (التجارة) على مطلق المعاوضة أي نحو كانت بحسب الوضع اللغوي، نقول: إن لفظ (التجارة) هنا ليس عاما حتى يندرج فيه مطلق الأفراد، بل هو مطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة المعتادة، و لا ريب أن السفهية خارجة عن المعتاد الغالب فلا تدخل تحت المستثنى، فتبقى تحت عموم الأكل بالباطل، و لازمه الفساد. و أما عموم أوفوا بالعقود و (المؤمنون عند شروطهم) و نحو ذلك من العمومات، كأحل الله البيع و (الصلح جائز) و غير ذلك من الأدلة المطلقة في أبواب الفقه التي يتمسك بها في إثبات الصحة فغير شامل للمقام، نظرا إلى انصرافها أيضا إلى المتعارف الشائع و ما عليه طريقة الناس، و ما لا يقصد للعقلاء غير مندرج تحت ذلك، مضافا إلى أن المعلوم من طريق الشرع المنع عما لا يعتد به دينا و دنيا، و ما نحن فيه من ذلك القبيل. و مما يؤيد المقام بل يكون حجة في الباب: أدلة حجر السفيه عن التصرف المالي، إذ ليس الحجر عليه إلا من جهة صدور مثل هذه المعاملة عنه غالبا، و هو مما لا يرضى الشارع به، و هو من أقوى الأمارات على أن هذه المعاملة غير مرضي عنها عند الشارع و غير ممضاة في نظره. فإن قلت: إن المعاملة السفهية تكون نافعة في أحد طرفيها و إن لم يكن فيها نفع بالنسبة إلى الجانب الأخر كما علم ذلك من الأمثلة، فبالنسبة إلى أحد الجانبين تدخل تحت أدلة التجارة و العقود و يتم في الجانب الأخر أيضا بعدم إمكان التفكيك. قلت أولا: إن خروجه عن الأدلة قد مر أنه لأجل عدم التعارف و كون أحد الجانبين ينتفع به لا يجعله متعارفا.
و ثانيا نقول: إنا نثبت البطلان بالنسبة إلى الجانب الغير المنتفع، و يثبت البطلان في الجانب الأخر بعدم التفكيك، مع أن الدخول تحت دليل التجارة بمجرد ذلك محل نظر، لأن التجارة ما قصد فيه الانتفاع من الجانبين، و ما نحن فيه ليس من هذا الباب على كل حال.
تنبيهان:
أحدهما: أن السفهية تختلف باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأجناس و الأعواض و غير ذلك
، مثلا شراء الماء على الشط من دون مانع عن تناول الماء عقلا و عرفا سفه و في الفلاة ليس كذلك، و إعطاء الأجرة على شيء يستظل به في الشتاء مع البرد الشديد المحوج إلى الشمس سفه، و استئجار الدابة للركوب في السفينة كذلك. و الحاصل: للخصوصيات مدخلية في المقام و إن كان بعض أنواع المعاملة كما مثلنا بها سفها على كل حال، لكن لا ينحصر في ذلك، بل المعاملات المعتادة نوعا قد تكون سفها في خصوص زمان أو مكان، أو بالنسبة إلى شخص خاص، فتدبر.
و ثانيهما: أن المعاملة السفهية نوعا [قد تخرج عن السفهية]
كإعطاء كرور بدرهم قد تخرج عن السفهية إذا تعلق بها غرض صحيح هو من مقاصد العقلاء، و لا بد من كون الغرض بحيث لا يحصل بدونها، و ليس مطلق الغرض المعتد به مخرجا عن السفهية. و كلام الشهيد الثاني رحمه الله في الباب حيث قال: (و يرتفع السفه بتعلق غرض صحيح)منزل على ذلك، بل يمكن دعوى: أن الغرض معناه: ما لا يحصل في نظر الفاعل إلا به، و ما أمكن حصوله بدونه أو بأقل منه لا يعد غرضا لذلك، و يوضحه ما مثل به بقوله: (كالصبر بدين حال و نحوه فتبصر[34].
اشتراط بلوغ
الابطال
اشتراط بلوغ در معاملات
صاحب عناوین
العنوان الخامس و الثمانون البلوغ شرط في صحة العقود و الإيقاعات
عنوان 85 عبارة الصبي ملغاة في العقود و الإيقاعات كافة، و بعبارة اخرى: البلوغ شرط مطلقا، سواء كان العقد و الإيقاع لنفسه أو لغيره، و لا فرق بين كونه محجورا عليه في المتعلق و عدمه، و بين كونه في مقام الاختبار و الامتحان و عدمه، و بين كونه مأذونا من الولي و عدمه، و بين البالغ عشرا في الذكر و عدمه، على ما نراه من عدم كونه بلوغا، و على القول بكون البلوغ هو العشر فيصير النزاع في الموضوع دون الحكم من حيث هو،
و الوجه في ذلك أمور: أحدها: الإجماع المحصل من الأصحاب الظاهر بالتتبع في كلامهم، حيث إنهم يشترطون ذلك في جميع العقود و الإيقاعات، و هو الحجة. و مخالفة من يذكر بعد ذلك من الأصحاب غير قادحة في الإجماع. و جريان السيرة على معاملة الصبي لا ينافي الإجماع على بطلان عقده، للفرق بينه و بين المعاطاة، مع ما نذكر فيه من الوجوه الأخر.
و ثانيها: منقول الإجماع حد الاستفاضة كما حكي عن ابن حمزة و العلامةمع تأيده بشهرة محققة و محكية، و بما يذكر بعد ذلك من الأدلة.
و ربما يناقش فيه بأن الفاضل مع نقله الإجماع قال: (و الوجه عندي البطلان و لو كان هذا إجماعا لم يكن لقوله: (و الوجه) وجه، و يمكن دفعه بأن كلامه يمكن كونه في قبال رواية ضعيفة أو في قبال فتوى العامة و نحو ذلك، فلا يدل على التردد.
و ثالثها: أن الأصل في العقود أولا هو الفساد، و كذا الإيقاع، و ما ثبت من الأدلة صحته إنما هو في غير عقد الصبي، فإن العمومات لا تشمله، و سيأتي توضيحه.
و رابعها: أن الصبي محجور عليه في التصرفات مسلوب الأهلية، و العقد أيضا من جملة ذلك، و إن كان يرد عليه: أن محض العقد ليس بتصرف. و ينتقض بالسفيه، فإنه محجور عليه مع أن عبارته ليست مسلوبة، فيصح بالتوكيل و الاستئذان.
و خامسها: أن صحة العقد تستلزم ترتب الآثار و الأحكام، و اللوازم من الأمور الواجبة و المحرمة، و هذه الأحكام لا تثبت للصبي لرفع القلم عنه، و نفي اللوازم نفي للملزومات، و يشكل باحتمال القول بالصحة بإذن الولي أو إجازته مع كون المكلف بترتيب الأحكام هو الولي و لا محذور.
و سادسها: الأخبار المستفيضة الدالة على عدم صحة معاملات الصبي و عقوده، المنجبر ضعف أسانيدها بما مر من الفتوى و العمل. منها: أن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع، و أقيمت عليها الحدود التامة، و أخذ لها بها. و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك . و منها: الخبر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: و ما أشده؟ قال: احتلامه
و منها: الخبر الأخر: إذا بلغ الغلام أشده جاز له كل شيء، إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها و وجه الاستدلال: أن جواز الأمر عبارة عن النفوذ و الصحة، و الشراء و البيع حقيقة في العقد و التمليك، و قد علق في هذه الأخبار على البلوغ، و مفاهيمها تدل على عدم الجواز و النفوذ قبل البلوغ، و هو المدعى. و قد يقال: إن المتبادر منها: كون الحجر و المنع من التصرف في ماله، و أما كونه عبارة مسلوبة و لو بالوكالة و الإذن، فلا. و لكن الظاهر من الخبر كون الصغر مانعا عن صحة المعاملات، و لا مدخلية لماله أو غيره في ذلك، مضافا إلى عدم القول بالفرق بين ماله و مال غيره. و لو قيل: إن المتبادر من النصوص جواز الأمر على الاستقلال فلا يدل على عدم الصحة مع إذن الولي. قلنا: إن كان المراد من جواز أمره في البيع و الشراء: نفاذه و صحته كما ذكرناه فنقول: هو أعم من إذن الولي و عدمه، و ليس فيه انصراف إطلاق، خصوصا مع كون الغالب في معاملات الأطفال رضاء الأولياء. و إن كان المراد من جواز الأمر: جواز أمر الولي له في البيع، فوجه الدلالة واضح، لأن مفهومه أن الولي لا يجوز له أن يرخصه في المعاملة ما لم يبلغ، و ليس إلا لعدم أهليته، فتدبر. و أما اختصاصها باليتيم، فلا إشكال فيه، لعموم الخبر الأخير، و عدم القول بالفرق بين اليتيم و غيره، و ظهور كون العلة الصغر لا اليتم، و لا المجموع المركب، فتأمل.
و ليس في الباب خلاف إلا من الشيخ رحمه الله و نسب إلى بعض أيضا أن من بلغ عشرا يجوز بيعه و نحو ذلك من تصرفاته مع كونه عاقلا فإن كان مستنده في ذلك المرسلة الدالة على جواز تصرف الصبي إذا بلغ عشرا كما روى فهو ضعيف السند مخالف للشهرة، بل الإجماع كما ذكرناه، مخالف للأصول، و مع ذلك فلا دلالة فيه، لأن جواز التصرف غير جواز كل تصرف، خصوصا البيع. و لعلنا نقول ببعض التصرفات للنص، غايته: إطلاق لا ينصرف إلى مثل العقود و الإيقاعات. مع إمكان حمله على الأنثى فإنها في العشر بالغة، أو على مقارنة بلوغه العشر لبلوغه الحقيقي باحتلام و نحوه. و لو سلم كل ذلك، فنقول: الخبر يكون من جملة الأخبار الدالة على أن البلوغ يصير بالعشر و لا نقول به، و هو نزاع آخر. و إن كان المستند ما رواه الصدوق و الكليني في الصحيح إلى صفوان، عن موسى بن بكر و هو واقفي غير موثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز في ماله ما أعتق، أو تصدق، أو أوصى على أحد في معروف فهو جائز. و صحيحة جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام قال:
(يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم و ما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، و صحيحة أبي أيوب في الغلام ابن عشر
سنين يوصي؟ قال: (إذا أصاب موضع الوصية جازت . مع ما في رواية زرارة و موثقة محمد بن مسلم من التأييد لهما و مرسلة ابن أبي عمير الدالة على جواز طلاق من بلغ عشر سنين و الرواية الضعيفة الدالة على جواز عتقه فنقول: إن كل ذلك من أدلة القول بحصول البلوغ في العشرة، و لا نقول به. و لو سلم فهذه الأخبار بعضها ضعيفة، مع عدم شهرة جابرة، و الصحيح منها [مهجور] معارض بما هو أقوى منه، مضافا إلى ما مر من الأدلة هنا. و مع ذلك كله فالقياس باطل، فلعلنا نقتصر على جواز الوصية و الصدقة و الطلاق، و لا نتسرى إلى الغير. و بالجملة: هذه الأخبار مع وجود المعارض القوي و عدم شهرة العمل بمضمونها لا يعتمد عليها. نعم، ذهب بعض المتأخرين و أظن أنه المولى المقدس الأردبيلي إلى جواز معاملات الصبي المميز مطلقا، و له على ذلك ضروب من الأدلة الأول: ما دل على صحة العقود من العمومات أجناسا و أنواعا، فإن العقد و البيع و الإجارة و نحو ذلك يصدق على عقد الصبي فيصح، و ليس هنا ما يخرجه عن العموم. و الثاني: أن جوازه في الوصية و التدبير و الصدقات كما هو مقتضى الأخبار السابقة مع كونها مجانية يقضي بجوازه في المعاوضات بطريق أولى.
و الثالث: قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فإنه أمر بامتحان الأيتام قبل البلوغ بالمعاملات، و لا يكون إلا بصحة معاملاتهم، و منشأه الاحتراز عن تأخير الدفع مع وجود الاستحقاق، فيكون الدفع عند البلوغ مع كون الابتداء قبله. و الرابع: أنا نعلم: أن الحجر على الصبي في التصرفات إنما هو من جهة أنه يتلفه و لا يصلحه، و متى ما علم أنه لا يتلف كما نراه في كثير من الصبيان في زماننا، فإنهم أشد مداقة و مماكسة من البالغين فلا ضرر فيه، و يرشد إلى هذه العلة الأمر بالدفع مع الرشد، و ليس معناه إلا ملكة الإصلاح للمال. و الخامس: جريان السيرة على معاملة الصبيان في كل مصر و زمان و لو كان هذا باطلا لمنع منه في كل عصر. و الجواب: بأن العمومات المسوقة مساق التكاليف كد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و نحو ذلك لا تشمل الصبيان، لعدم صلاحيتهم للتكليف و خروجهم عن ذلك بما دل على شرطية البلوغ في التكليف....
و هنا بحثان:
و ثانيهما: أنه نفرض صدور العقد من بالغ و صبي فنتمسك بالعموم من طرف البالغ و نثبت بذلك الصحة من جانب الصبي
بعدم إمكان التفكيك، ثم نثبت صحة العقد الواقع بين الصغيرين أيضا بالإجماع المركب. أو نفرض صدور عقود مترتبة على عقد الصغير من البالغين الكاملين بعد وقوع العقد من الصغير فتتمسك في العقود المترتبة اللاحقة بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و نثبت بذلك عقد الصغير، لعدم إمكان الصحة اللاحقة بدونه. و الجواب: بمنع شمولها للبالغ العاقد للصبي أولا، و بأن الواجب الوفاء بالعقد و أما الوفاء بنفس الإيجاب أو بنفس القبول فلم يدل على ذلك دليل إلا في ضمن الوفاء بالعقد، فلو كان العقد واجب الوفاء فيكون الإيجاب أيضا كذلك و كذا القبول، و هنا لم يثبت لزوم الوفاء بالمجموع المركب، إذ لا معنى لوفاء أحد الطرفين بمجموع الإيجابين. و لو سلم ذلك، فنقول: الظاهر أن المتبادر من العموم هو الارتباط، بمعنى: أن الوفاء من جانب يتوقف على الوفاء من آخر، و ليس تعبديا محضا و قد مر تحقيق هذا المطلب في بحث أصالة الصحة، و في بحث كون الإقالة على القاعدة فمتى كان المدلول الارتباط و علمنا عدم لزوم الوفاء على الصبي قطعا فلا يمكن القول بلزوم الوفاء على البالغ، فنقول: لا يجب الوفاء على الصبي بالإجماع على عدم تكليفه، فكذا البالغ، لعدم إمكان الفرق، و من ذلك يظهر جواب باقي الإيراد، و هنا كلام يظهر بعد التأمل لا نطيل بذكره. و أما العمومات الوضعية: فإنها مسوقة لبيان حكم آخر، و لا عموم فيها حتى يشمل المقام، و الظاهر انصرافها إلى الأفراد المتعارفة التي نشك في كون المقام منها، مضافا إلى أن العموم لو سلم فيخصص بما ذكرناه من النصوص و الإجماع.
مع أن تصحيح العقد يوجب التصرف في مال اليتيم لو أقبضه حال العقد و هو غير سائغ، أو لزوم الضرر الكثير غالبا لو التزم بالصبر إلى البلوغ فتأمل مع أن ظاهر من قال بالتجويز عدم لزوم الصبر. و عن الأولوية: بأن المقيس عليه ممنوع أولا، و القياس باطل ثانيا، و الأولوية المدعاة فاسدة جدا ثالثا، لوجود الفارق في البين من استتباع البيع أحكاما ليس الصبي محلها، بخلاف ذلك مع كون هذه الأمور المجانية معلومة الإتلاف قد أقدم فيه المالك على الإتلاف، و أما سائر المعاوضات فهي غير مبنية على البذل، بل مبنية على المغابنة و الصبي ليس أهلا لها، فيؤول الأمر إلى خلو المال عن العوض دينا و دنيا، فتأمل. و عن الآية: بأنها أخص من المدعى لاختصاصها باليتامى. و لا يمكن التعميم بعدم القول بالفرق، لوجود القائل بالفرق على ما حكي و لأن المناط المنقح غير محقق. و بأنها ظاهرة في الابتلاء بعد البلوغ، أو محمولة على الاختبار بصور المعاملات مع كون حقيقتها من الولي، أو محمولة على الامتحان بغير أموالهم و إن أتلفوها، أو بالحيازة و نحوها، أو بالإباحة، أو بالسؤال و الفحص و البحث، أو بما جاز لهم من الوصية و نحوها. أو تحمل على اختبار نفس البلوغ، بل هو الظاهر من خبر أبي الجارود الوارد في تفسير الآية: (فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال و اشهد عليه، فإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فليمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله و لو سلم كل ذلك فلا يعارض ما ذكرناه من الأدلة. و عن العلة: بمنع ثبوت عليتها، إذ ليست منصوصة و لا قطعية، و المستنبطة ليست حجة عندنا. و على فرض كون العلة عدم الإتلاف، فنمنع حصول الاطمئنان بعدم كونه متلفا ما لم يبلغ.
و عن الخامس: بأن ما قام عليه السيرة أما المحقرات مطلقا، أو المحقرات المتقاربة القيم الغير المحتملة للغرر، أو ما يعد الصبي فيه كالالة مع العلم أو الظن برضاء الولي و لو فقيها أو مطلق المتكفل، و نحن نسلم الصحة مع اجتماع هذه القيود و لكن لا يكون ذلك من باب العقود، بل يمكن كونه إباحة بعوض مع دلالة شاهد الحال، أو معاوضة مستقلة أو معاطاة، أو كون البالغ متوليا للمعاملة من الطرفين و كون الصغير كالالة و نحو ذلك، و هذا لا يدل على صحة معاملات الصبي و إيقاعاته. و هنا أبحاث تركناها اقتصارا على ما هو الأهم للمقصود [35].
بقدر الضروره
عدم اشتراط احکام وضعیه به بلوغ
شهید اول
قاعدة- 168 الحجر على الصبي و السفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية، كالاحتطاب و الاحتشاش، (فيملكان بهما) بخلاف الأسباب القولية، كالبيع و غيره؛ لأن الأسباب الفعلية فوائد محضة غالبا، بخلاف القولية، فإنها من باب المكايسة و المغابنة، و عقلهما قاصر عن ذلك.
و على هذا: لو وطئ السفيه أمته، فأحبلها، صارت أم ولد، و يكون وطؤه مباحا و إن استعقب العتق، و لو أعتقها باللفظ لم يصح؛ لأن الطبع و تحصين الفرج يدعوه إلى الوطء، فلا يمنع خوفا من نقص الثمن أو البدن، فإذا أبيح الوطء ترتب عليه مسببه. و لهذا قيل:السبب الفعلي أقوى؛ لنفوذه من السفيه، بخلاف القولي. و قيل: بل للقولي أقوى؛ لأن مسببها يتعقبها بلا فصل، كما في العتق، بخلاف الفعلي[36].
صاحب عناوین
العنوان الثالث و الثمانون عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ
عنوان 83 لا شبهة في عدم شرطية البلوغ في جل الأحكام، فإن المواريث و الديات و الضمان في الغصب و الإتلاف و الالتقاط و نحو ذلك يجري على الصبي كالبالغ. و الوجه فيه: عموم الأدلة، و عدم وجود المخصص، فإن قوله: (من أحيى أرضا ميتة فهي له) أو (من حاز شيئا من المباحات فقد ملكه) أو (على اليد ما أخذت) أو (من أتلف شيئا من مال أو نفس ضمنه) و نحو ذلك كلها عامة للصبي كالبالغ، من دون فرق، فلذا نقول: إنه يملك بالاحتطاب و الاصطياد، و يضمن بسبب إتلاف أو جناية. و دعوى: أن هذه الأدلة إنما تنصرف إلى البالغين لأنها أيضا مسوقة كسوق سائر التكاليف الغير المتعلقة بغير البالغين ممنوعة، فإن اللفظ لا ريب في عمومه لغة و عرفا، مضافا إلى فهم العلية من هذه الأدلة الموجبة لإلغاء جهة المباشر، القاضية بثبوت الحكم في أي مورد كان. و لو قيل: إن الحكم الوضعي مستلزم لحكم تكليفي غالبا أو مطلقا، و الحكم التكليفي من وجوب دفع أو من تحريم أخذ أو نحو ذلك لا يتعلق بالصبي كما سيحقق و نفي اللازم قاض بنفي الملزوم. قلنا: استلزام الوضعي للتكليف إن كان في الجملة أعم من الإطلاق و التقييد-
فهو مسلم، فإن ضمان المتلف يقضي بوجوب الدفع إلى المالك مع المطالبة لكن مع اجتماع شرائط التكليف، و هذا لا مانع منه في الطفل، فإنه ضامن بالفعل يجب عليه دفعه إذا اجتمع فيه شرائط التكليف. و إن كان خصوص الحكم المطلق المنجز، فاستلزام الحكم الوضعي للتكليف بهذا المعنى ممنوع كما أشرنا إليه. مضافا إلى أن عدم وجود الضمان في الصبي إلى حال البلوغ يوجب عدمه بعده أيضا، لبراءة ذمته في آن البلوغ، و لا سبب بعد ذلك، و كون الإتلاف حال الصبي سببا للضمان حال البلوغ خلاف ظاهر الدليل. و تظهر الثمرة في صحة الإبراء و غير ذلك مما لا يخفى. و من هذا الباب سائر الأسباب، فإن أسباب الوضوء و الغسل موجب في الصبي أيضا لهما عند تعلق التكليف، و الوطي مثلا سبب للتحريم في المصاهرة و لواحقها في الصبي كالبالغ، و على هذا النحو غيره[37].
صحّت عبادات صبی
صاحب عناوین
العنوان الرابع و الثمانون صحة عبادات الصبي المميز و عدمها
عنوان 84 اختلفوا في شرطية البلوغ لشرعية العبادات و صحتها، بعد اتفاقهم على شرطية التمييز و شرطية البلوغ في الوجوب و التحريم بمعنى عدم العقاب على الصبي في فعله و تركه على أقوال:
أحدها: أن هذه العبادات من الأطفال تمرينية صرفة، بمعنى عدم ترتب أجر و ثواب من الله تعالى على عمل الصبي و إن كان لوليه ثواب التمرين لذلك.
و ثانيها: أن عباداته شرعية كالبالغين، و معنى الشرعية: كونها مندوبة للصبي مطلوبة من الشارع بحيث يستحق عليها الأجر و الثواب الأخروي، سواء كان فعل واجب أو مندوب، أو ترك محرم أو مكروه. و بعبارة اخرى: خطاب الندب و الكراهة متعلق بأفعاله و الواجب في حكم المندوب و الحرام في حكم المكروه بعد رفع العقاب عنه و إن كان أمر الولي له بذلك تمرينا له على العمل، لأن كون ثواب التمرين للولي غير مناف لكون الفعل مما فيه ثواب للطفل.
و ثالثها: أن عبادات الصبي شرعية تمرينية، لا أنها شرعية أصلية، و المراد بذلك: أن إتيان الصبي لهذه الأفعال و تركه لهذه التروك مطلوب للشارع لا لأنفسها، بل لحصول التعود و التمرن على العمل بعد البلوغ. فصلاة الصبي فيها جهتان: جهة كونها صلاة، و هذه الجهة ملغاة في الصبي، لا فرق بين كونها صلاة أو قياما أو نوما أو نحو ذلك في عدم رجحان أصلي فيها بالنسبة إليه و عدم وجود أجر في ذلك من جهة الصلاتية. و جهة كونها تعودا على شيء يكون مطلوبا بعد البلوغ و إن كان لا غيا الان في حد ذاته، و هذه الجهة مطلوبة للشارع يثاب عليها. و بعبارة اخرى: التمرن مستحب دون الصلاة و الصوم، فتدبر.
و الثمرة بين القول الأول و الأخيرين تظهر في حصول الأجر للصبي و عدمه، فعلى الأول: لا أجر له، بخلاف الأخيرين. و بين الأخيرين تظهر في تعيين الأجر، فإن القول بالشرعية يقتضي حصول ثواب الصلاة و الصوم بالنسبة إليه كالبالغ من دون فرق، و القول الثالث يستلزم حصول ثواب التمرن، لا الصلاة و الصوم، لعدم كونهما راجحين للصبي، بل الراجح هو التمرن و الاعتياد. و تظهر أيضا في نية العبادات الواجبة، فعلى التمرين ينوي الوجوب. و في جواز نيابة الصبي عن ميت أو حي بأجرة أو بدونها، فعلى القول بالتمرين الصرف واضح الفساد، لعدم كونه قابلا للنيابة و عدم وجود الفائدة الموجبة للصحة. و على القول بالشرعية فهي جائزة كالبالغ من دون فرق، فيكون نائبا و يكون منوبا عنه أيضا. و على القول الثالث لا يجوز أيضا، لأنه رجحان تمرن لا يكون قابلا للنيابة، لعدم إمكان حصول المراد إلا بالمباشرة و هي غير مورد الوكالة و النيابة، و لعدم وجود ثواب في أصل الفعل قابل للرجوع إلى شخص آخر حتى ينوى عنه، بل الأجر على نفس التمرن، و كونه للغير فرع كونه منويا عن الغير، و هو غير ممكن، لمنافاة مفهومه لذلك. و المحكي عن مشهور الأصحاب القول بالشرعية و عن بعض علمائنا القول بالتمرين و جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني رحمه الله و جملة من المعاصرين القول بالشرعية التمرينية و ربما يظهر من بعضهم تنزيل كلام الأصحاب أيضا على ذلك لا الشرعية بالمعنى الثاني فتدبر.
و أما الأدلة:
فللقائلين بالتمرين: أصالة عدم ترتب الثواب إلا بالدليل، و هو منتف، و عدم شمول ما دل على الأحكام التكليفية من الأوامر و النواهي على الصبي، لانصرافها إلى البالغين العاقلين. و تقيد بعض الأحكام قطعا بالبلوغ كالواجبات و المحرمات من حيث كونها واجبا و محرما و لا فرق بينهما و بين غيرهما في جهة العملية و المطلوبية و إن كان هناك فرق في العقاب و عدمه. و حديث (رفع القلم عن الصبي و المجنون المعتمد عليه عند العامة و الخاصة، و ظاهر معناه: أن القلم الجاري على البالغين العاقلين فهو مرفوع عن غيرهما، و لا ريب أن القلم أعم من الواجب و المندوب و المحرم و المكروه، بل المباح أيضا، فيصير المعنى: أن الحكم الجاري على البالغ العاقل لا يجري على الصبي و المجنون بقول مطلق، فلا يتحقق طلب لأفعاله و لو ندبا حتى يكون شرعيا. ...
و الكلمة الجامعة بين القولين الأخيرين النافية لهذا القول أمور: أحدها: أن ما دل من العمومات على ترتب الثواب على الأفعال شامل للصبي كالبالغ كما لا يخفى على من تتبع الآثار و الأخبار و الآيات و انصرافها إلى البالغين ممنوع، بل ليس المقام إلا كباب الأسباب و الضمانات، فكما أن ما دل فيها من الأدلة عام للصبي و البالغ، فكذا المقام من دون فرق، إلا إذا دل دليل على التخصيص. و ثانيها: أن المستقلات العقلية كحسن الإحسان ورد الوديعة و نحو ذلك لا ريب في كون من امتثل بها مستحقا للثواب في نظر العقل، من دون فرق بين البالغ و الصبي، و العقل لا يقبل التخصيص، و الجزاء لا ينفك عن العمل الحسن عقلا و نقلا، فكيف يعقل القول بعدم ترتب الثواب على ذلك مع تسليم هذه المقدمات؟ و دعوى: عدم حكم العقل بحسن رد الوديعة أو الإحسان في الصبي، مما ينكره الوجدان و ينفيه العيان، و لا فرق بين ما يستقل به العقل و غيره.
و ثالثها: أن بعد حكم الشرع بمطلوبية الأفعال الواجبة و المندوبة علمنا بوجود مصلحة أو مفسدة في فعله أو تركه يوجب المطلوبية على ما تقرر عندنا من تبعية الأحكام للمصالح و لازم ذلك كونه مطلوبا من الصبيان أيضا، إذ لا تتخلف المصلحة الكامنة. نعم، للمباشر و الحالات مدخلية في المصلحة تتغير بتغيرها و لكن الكاشف عن ذلك الدليل، و حيث إن الطلب و الثواب تعلق بماهية قراءة القرآن مثلا و لم يدل دليل إلا على خروج الجنب و الحائض مثلا في وجه، يعلم من ذلك أن الصبي و البلوغ لا مدخلية له في المصلحة.
و رابعها: أن قضية اللطف عدم خلو هذا العمل الصادر عن الصبي من الثواب، فإن من أتى بعمل حسن قاصدا به وجه الرب الكريم فحرمانه عن الجزاء و الثواب مناف للطف و ما دل من الكتاب و السنة على أنه تعالى يقدم ذراعا على من أقدم عليه شبرا فتدبر.
و خامسها: الاعتبار العقلي، فإن من البعيد الفرق بين ما قبل البلوغ بساعة و ما بعده، فإن المراهق المقارب للبلوغ جدا لا ريب في أنه بمكان من الإخلاص و العبودية لله تعالى كما بعد البلوغ، بل في الحالة الأولى ربما يكون أشد من الحالة الثانية، فيبعد كونه مأجورا على الثانية دون الاولى.
و سادسها: ما ورد من الأخبار على أن (لكل كبد حرى أجر فإنه عام للصبي و البالغ، بل مشير إلى أن العلة إنما هي حرارة الكبد، و لا ريب في احتراق كبد الصبيان في بعض الأوقات و الأفراد شوقا إلى الله تبارك و تعالى أزيد من كثير من البالغين.
و سابعها: لزوم ترجيح المرجوح، فإنا لو فرضنا أن المراهق أتى بعبادة مشتملة على الإخلاص و الشرائط و الأجزاء و أتى غيره بهذا العمل، أو أتى به ذلك أيضا بعد بلوغه غير مستجمع لتلك الصفات الكمالية، فجعل الثواب للثاني دون الأول ترجيح للمرجوح على الراجح. إلا أن يقال: إن الصبي لو كان معتقدا لحصول الثواب فهو خارج عن محل البحث و النزاع، إذ البحث في الحكم الواقعي و في أنه هل هناك ثواب أم لا؟ و بعد عدم ثبوت خطاب الشارع له فلا ثمرة في جمع الشرائط و الأجزاء، فتأمل.
و ثامنها: أنه قد ورد الأمر على الأولياء أن يأمروا الأطفال بالعبادة، كقوله صلى الله عليه و آله: (مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع و لا ريب أن الأمر بالأمر أمر بالثالث على العمل عرفا، كما إذا قال زيد لعمرو: قل لبكر أن يفعل كذا، فإنه أمر لبكر بذلك، بحيث لو أطلع بكر على كلام زيد من دون أمر عمرو بل من خارج لزمه الامتثال، و لو خالف لاستحق العقاب، و ليس معناه: أن بكرا مأمور من عمرو، لا من زيد، و ذلك في العرف واضح. و مثله قوله تعالى وَ قُلْ لِعِبٰادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإن ذلك أمر للعباد من الله تعالى و المسألة محررة في الأصول و يكون الصبيان أيضا مأمورين من الشارع بالعمل، و لازمه الثواب، و هو معنى الشرعية[38].
[1] الرسائل الفقهية (للوحيد البهبهاني)؛ ص: 295-٣٠۶
[2] الرسائل الفقهیة(للوحید البهبهانی)، ص ٣١٠-٣١۴
[3] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج1، ص: 266-٢۶٩
[4] رسائل الميرزا القمي؛ ج1، ص: 456-۴۶٠
[5] العناوین، ج ٢، ص ۵-٢۵
[6] العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 27-٣۴
[7] مشارق الأحكام؛ ص: 11-١۵
[8] قاعدة الضرر، اليد، التجاوز و الصحة (أوثق الوسائل)؛ ص: 560-۵۶١
[9] تسهيل المسالك إلى المدارك؛ ص: 26
[10] تحرير المجلة؛ ج1قسم1، ص: 68-۶٩
[11] القواعد الفقهية (للبجنوردي، السيد حسن)؛ ج3، ص: 141-١۴٢
[12] فقه و حقوق (مجموعه آثار)؛ ج20، ص: 362-٣۶٣
[13] الفقه، القواعد الفقهية؛ ص: 194
[14] العناوين الفقهية؛ ج1، ص: 439-۴۴٣
[15] مستقصى مدارك القواعد؛ ص: 197-١٩٩
[16] الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ص: 7-٩
[17] الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)؛ ص: 271-٢٧٢
[18] نهاية الأفكار ؛ ج3 ؛ ص433-۴٣۶
[19] كتاب الخلل في الصلاة، ص: 5-٢٢
[20] عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 599
[21] مائة قاعدة فقهية، ص: 162-١۶۴
[22] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج3، ص: 157-١۶١
[23] تقرير بحث السيد البروجردي؛ ج1، ص: 101-١١٩
[24] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج5، ص: 298-٣٠٠
[25] العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 361-٣۶۴
[26] سؤال و جواب (للسيد اليزدي)؛ ص: 211-٢١٢
[27] القواعد و الفوائد؛ ج1، ص: 199
[28] تمهيد القواعد الأصولية و العربية؛ ص: 140-١۴١
[29] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج1، ص: 171-١٧
[30] العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 375-٣٨٢
[31] تحرير المجلة؛ ج1قسم1، ص: 94-٩۵
[32] فقه الإمام الصادق عليه السلام؛ ج3، ص: 138-١٣٩
[33] اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها؛ ص: 273-٢٧۴
[34] العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 365-٣٧٣
[35] العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 673-۶٧٩
[36] القواعد و الفوائد؛ ج2، ص: 71-٧٢
[37] العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 659-۶۶١
[38] العناوين الفقهية، ج2، ص: 663-۶۶٩
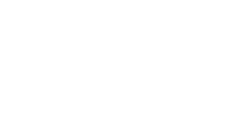
بدون نظر