فصل سوم: منطق موضوع محوری؛ منطق فازی
در یادداشت ها
[ شاید اگر از روز اول خاستگاه منطق حوزه علوم انسانی بود، منطق به این صورت تدوین نمی شد . قیاس و استقراء و تمثیل، سه پیکره صورت فکر هستند اما تشابک شواهد و موضوع محوری در استنتاج جای معینی ندارند.[1]]
الف) منطق فازی؛ مکمّل منطق ارسطویی
[معمولاً میگویند بگو ببینم، یا این یا آن. اصلاً اینطور نیست. من مکرر عرض کردم. منطق تشکیک که امروزه میگویند با منطق دو ارزشی ارسطویی[2] ، این ها با همدیگر مکمل هماند. نه اینکه معارض همدیگر باشند، یا تو یا من. نه، حوزههایی دارند هر کدام، و اتفاقاً پیکره منطق تشکیکی به منطق دو ارزشی است[3]. یعنی اگر ما منطق دو ارزشی نداشته باشیم، تشکیکی هم نخواهیم داشت. اساس او را منطق دو ارزشی تشکیل میدهد. اما این طور نیست که تنها و تنها دو ارزشی باشد. ما یک حوزهای داریم که آن حوزه، کیانش تشکیکی است و ما آنجا با آن دو ارزشی برخورد میکنیم. [4]]
اشکالات استرآبادی به منطق ارسطویی
استادی داشتیم که برای ما شرح لمعه میگفت. ایشان میگفت: به عقیده من، این که شیخ انصاری در اول رسائل در بحث قطع حدود ۲ – ۳ صفحه رسائل را از سخنان امینالدین استرآبادی در ردّ حکمت مشّاء و تناقضاتشان و ردّ منطق ارسطویی گرفتند[5]- امینالدین خیلی محکم منطق ارسطویی را رد کرده بود[6]، شیخ هم این همه، همه حرفهای ایشان را آوردند و بخشی از آن را جوابی هم نمیدهند- ایشان میگفت که به عقیده من شیخ این را قبول هم داشت که میدیده اینها حرفهایی است که به منطق ارسطویی وارد است.
اتّفاقاً حرف این استاد ما در اوائل طلبگی برای ذهن من خیلی خوب بود، یعنی ایشان تذکر داد که شیخ مرتضی آورده است. امینالدّین هم دارد اساسِ منطق ارسطو را با تبر تکه میکند. یک تبری به وسط کمر منطق ارسطویی میزند. او این را میگفت و ما را به فکر انداخت. خب حالا راست میگوید یا نمیگوید؟ ما نه طرفدار او هستیم نه او، مباحثه هم میکنیم،ما توفیق خیلی مباحثه ها نداشتیم اما همین طور مکرّر در مکرر منطق مباحثه کردیم، دورههای متعدّد، هر باری هم که مباحثه میکردیم فکر نو میکردیم. بعد انسان میبیند که این کمبودها هست.
ب )عناصر فازی در منطق ارسطویی
در منطق ارسطویی در بخش مواد اقیسه شما بگردید، ببینید چقدر چیزها در المنطق، بخش مواد اقیسه پیدا میکنید که اصلاً ریختش ریخت یک و صفر نیست، یعنی بسیاری از مفاهیمی که عرف عقلاء با آن کار دارند و شارع هم بسیار در کار خودش به کار گرفته است، این حالت را دارد که قوی میشود، قوی میشود، تا اطمینان بشود. یعنی شواهد را در نظر میگیرد و از مجموع شواهد مطمئن میشود. مطمئن میشود نه یعنی آن حالت صفر و یک میشود یعنی مثلاً تواتر.
مثال : تواتر
مبنای تواتر به صورت روشن همین است و لذا هم آن کسانی که بعداً تواتر را قطعی میدانستند -اوائل چقدر بحث کردند- بحثهای قبلی ها را کنار میگذارند. شما در تاریخ نگاه کنید تواتر به چند نفر حاصل میشود؟ تاریخش را ببیینید[7].
- بعضیها گفتند ۵۰، بعضیها گفتند ۱۰۰، بعضیها گفتند عدد خاصی ملاک نیست[8].
حالا برای تواتر در حدیث دیدم خیلیهایشان میگویند اگر ۱۰ تا صحابی نقل کرده باشند[9] کافی است و میگوییم حدیث متواتر است. تا ۱۰ تا را هم متواتر میدانند و حال آن که شما میبینید چه ۵۰ تا چه ۱۰۰ تا اینها آن چیزی که تعریف منطق ارسطویی از تواتر است نتیجه نمیدهد. تعریف چیست؟ «ما یمتنع تواطئهم علی الکذب»[10] زیر یمتنع خط بکشید. ممتنع است. کِی ممتنع میشود؟ آخر این امتناع یک امتناعی نیست که با محاسبه و برهان شما بیاورید، این «یمتنع» از دید خود شخص است، احتمالات را در نظر میگیرد و میگوید حالا دیگر «یمتنع». حالا دیگر «یمتنع« یعنی من به احتمالات دیگر اعتناء نمیکنم، نه این که احتمال نیست. میگوید منِ عاقل که اینها را در نظر میگیرم، دیگر اعتناء نمیکنم.
- امتناع عقلایی است.[11]
بله. [12]]
تواتر؛ عنصر منطق فازی
[در منطق به ما گفتند متواتر، تعریف کنید متواتر چیست؟ متواتر این است که «ما یمتنع تبانیهم علی الکذب». چند تا؟ میگویند ما دیگر چه کار داریم. بعضی گفتند ۴۰ تا، بعضی گفتند ۱۰ تا. خب این امتناع چه زمانی میآید؟ چه زمانی محال میشود؟ اگر دقت کنید این امتناع عقلی هیچ وقت نمیآید، و لذا آقای صدر در بحثهای اصول که آوردند خوب گفتند. گفتند: اصلاً مبنای تواتر بر حساب احتمالات است که به امتناع عقلی هیچ وقت نمیرسد، میل به صفر میکند، نه اینکه بشود صفر.[13]و حال آنکه امتناع یعنی صفر. چه زمانی صفر میشود؟ ۵ نفر بودند هنوز احتمال هست، خب شدند ۶ تا، احتمال هست یا نیست؟ شدند ۱۰ تا، شدند ۴۰ تا.
به تعبیر آقای صدر میگویند: یک یقین ذاتی داریم، یک یقین ریاضی.[14] به یقین ریاضی به امتناع هیچ وقت نمیرسد. به امتناع روانی میرسد، یعنی ما در روان خودمان دیگر آن احتمال را کنار میاندازیم. میگوییم محال است، یعنی من اعتنا نمیکنم. در منطق مجبور شدند بگویند یمتنع. چرا؟ چون اساس منطق دو ارزشی بود. و حال آنکه ریخت مفهوم تواتر، تشکیکی است. این هاست که مشکلساز شده است. یعنی یک مفهومی که ریختش تشکیکی است، آمدند و در قالب امتناع و امکان ریختند و دو ارزشیاش کردند. اینها باید عوض بشود. یعنی ما باید بگوییم تواتر اصلاً برای امتناع و امکان نیست. تواتر ریختش برای تشکیک است. ببریدش آنجا. یک منطق دیگری نیاز است، این برای آنجاست. «و له ذیل طویل» به عهده شما که جوانید و حوصلهاش را دارید[15].]
[قطعی که از تواتر حاصل می شود، قطع صد در صد نیست. اصلاً ریخت مفهومیِ تواتر، منطق تشکیکی است نه صفر و یک.
لذا تعریف تواتر در منطق با واقعیتِ تواتر موافق نیست. می گفتند: امتنع تواطئهم علی الکذب. امتنع، یک مفهوم عقلانیِ دو ارزشی است ولی تواتر اینگونه نیست. چون هر چه هم ناقل ها زیاد شوند، امتناع و استحاله ی کذب حاصل نمی شود[16]]
مراتب در تواتر
[تواتر یا هست یا نیست؟ اگر تواتر هست، قطعی است. اگر نیست، نیست. تواتر یا هست و یا نیست.
ولی خب معلوم است ریخت تواتر، ریخت فازی و تشکیکی است. و لذا هم علماء چقدر بحث کردند. تواتر ده تاست، ۴۰ تاست، کذا کذا. برای چیست؟[17] برای این است که تواتر دارد دانه دانه بالا میرود. یک جایی میرسد که دیگر از حیث حساب احتمالات میل به صفر میکند. احتمال کذبِ او و ارزش صدق او، میل به یک میکند. میل به یک ذاتی، نفسانی و عقلائی؟ یا میل به یک واقعاً ریاضی اما ریاضیاً، میل به یک میکند، نه صرف عدم اعتناء باشد؟
این جهت هم خیلی مهم است. گاهی است احتمال در ذهن عُقلاء هست ولی اعتنا نمیکنند. گاهی اصلاً نیست؛ ولو ریاضیاً هست. احتمال در ذهن عقلاء نیست، نمیآید؛ نه اینکه بیاید و اعتنا نکنند و اعتناء را غیر عقلایی ببینند، اصلاً نمیآید، ولی ریاضیاً هست. مثل تواتر همینطور است. وقتی تواتر رسید به ۱۰ تا، ۱۵ تا، یعنی در مراحل اوّلیه تواتر، احتمالش برای عقلاء هست، ولی اعتناء نمیکنند، یعنی یک نحو قطع ذاتی -به تعبیر مرحوم آقای صدر- قطع عملی دارند[18]، اطمینان دارند؛ اما وقتی تواتر میرسد به یک میلیارد، باز احتمال ریاضیاش جایی نرفته، امتناع نیامده، اصلاً احتمالش در ذهن مردم نیست، نه اینکه احتمال هست و اعتناء نکنند، اصلاً نیست. اینها مبانی مختلف توضیح تواتر است. بنابراین اینطور به ذهن میآید که دو نگاه به حجیّت میشود بکنند. هر دو نگاهش هم آثار خاص خودش را دارد.[19]]
[در فضای تحقیقات تاریخی همان طور که متواتر داریم و خود متواتر، درجات دارد، از اعلی درجه ی تواتر تا تواترِ درجه ی پایین.
شیخ ناصر البانی در سلسلة الاحادیث الصحیحة می گوید: حدیث «من کنت مولاه»، از درجات بالای تواتر برخوردار است.[20]معلوم می شود تواتر قابل شدت و ضعف است.
اگر تواتر درجات دارد، موضوعات تاریخی هم و لو به حد تواتر نرسد اما مراتبِ دونِ تواترش هم مرتبه دارد. یعنی اگر تواتر را 90 درصد بگیریم، چیزی که به 90 درصد نمی رسد اما از 60 درصد به 80 درصد می رسانَد، خیلی به درد تحقیق علمی می خورد. یعنی محقق می بیند فلان مطلب پارسال برایش 60 درصد راست بود ولی امسال و بعد از تحقیق، 80 درصد راست است. همین 20 درصد خیلی ارزش دارد. چون مطالب تاریخی به هم کمک می کنند برای رسیدن به نتیجه مطلوب. [21]]
سیر و سفر تواتر در کتب شهید صدر
[آقای صدر در فلسفتنا بدیهیات منطق را میگویند: «شبهةٌ فی مقابل البدیهة»[22]. ۱۲ سال بعد اسس المنطقیه را که نوشتند[23] کتاب خوبی است، همانهایی را که ۱۲ سال قبلش «شبهةٌ فی مقابل البدیهة» میگفتند، تحلیل منطقی میکنند[24]. «الاسس المنطقیة للاستقراء» خیلی هم خوب شده است[25].
یعنی این ها کارهایی است که ما انجام میدهیم، اما در منطق ارسطو میگوییم تواتر بدیهی است و دیگر حرف نزن.در بدیهی بخواهی شبهه کنی، خدشه کنی،«شبهةٌ فی مقابل البدیهة» اینها نقص این منطق بوده است. [26]]
[آقای صدر «فلسفتنا» را در عنفوان جوانی در آن نبوغی که این مرحوم داشتند که نادر در روزگاراند، «فلسفتُنا» را نوشتند، جایی که بحث به بدیهی میرسد میگویند «هذا شبهة فی قبال البدیهه»، وقتی بدیهی است دیگر نمیتوانیم جلوتر برویم و بخواهیم بدیهیات را دستکاری کنیم. ۱۲ سال بعد «الاسس المنطقیة للاستقراء» را نوشتند. اصلاً کلّ کتابشان تحلیل بدیهیات است. یعنی ذهن آقای صدر بعد ۱۲ سال از آن کار، دیدند نمیشود به بدیهیات برسیم و حرفی نزنیم. آخر بدیهیات چرا بدیهی هستند؟
آنجاست در آن کتاب حساب احتمالات را میآورند و خیلی از بدیهیات را تحلیل میکنند. مثلاً متواترات، بدیهیاتِ دو ارزشی منطق ارسطویی نیست. متواترات جوهرهاش با حساب احتمالات است. اما شما المنطق را تدریس میکنید در کلاس برای شاگردها چه میگویید؟ الآن هم در اصول. میگویید متواتر چیست؟ «هو الذی یمتنع….» ممتنع است، محال است «تواطئهم علی الکذب». یک نفر خبر آورد، محال است دروغ باشد؟ نه.
-امتناع عقلایی منظور است[27].
امتناع عقلایی داشت، یعنی چه؟
-یعنی درصدش اینقدر پایین است که عقلاء به آن اعتنا نمیکنند.
«درصد»؟ اگر زمانی که کلمه «درصد» نبود، میخواستید بگویید چه میگفتید؟
- احتمالِ خیلی کم.
احتمال خیلی کم، قضیه صادقه است یا کاذبه؟
- صادقه است.
صادقه است با اینکه احتمال خلافش هست؟! «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» پس چه بود؟! یک احتمالِ ریز میآمد برهان خراب بود دیگر. اصلاً ریختِ منطق دو ارزشی با ریخت منطق فازی، دو ریخت است.
من عقیدهام این است که اگر این دید شروع شد، از سراپای کتب اصول و فقه میتوانید برای آن شواهد بیاورید، ولو اینکه اسمش نیامده باشد[28]. [29]]
[1] یادداشتهای استاد
[2] منطق دو ارزشی
منطق دو ارزشی : در این منطق که از آن به منطق کلاسیک یا منطق ارسطویی تعبیر می شود،ارزش گزاره ها همواره یا راست است یا دروغ و حالت سومی وجود ندارد.
بر این اساس هیچ گزاره ایی نمی تواند در یک زمان هم درست و هم نادرست باشد.(اصل محال بودن ارتفاع نقیضین) و به علاوه هیچ گزاره ایی هم نمی تواند در آن واحد نه درست باشد و نه نادرست(اصل محال بودن ارتفاع نقیضین).(سایت تنویر)
منطق کلاسیک اشاره به گونههایی از منطق صوری دارد که بیش از همه انواع دیگر مورد مطالعه قرار گرفتهاند و بهکار میروند. این گونههای منطق در مجموعهای از ویژگیها با یکدیگر اشتراک دارند، از جمله:
قاعدهٔ استحاله اجتماع نقیضین: یک گزاره نمیتواند هم اثبات شود هم رد.
قاعدهٔ استحاله ارتفاع نقیضین: مدعی بر اینست که یک گزاره نمیتواند هم اثبات نشود و هم رد نشود.
قاعدهٔ اصل طرد شق وسط یا طرد شق ثالث: یک گزاره یا اثبات میشود یا رد، حالت سومی ندارد (که البته اخیراً دانشمندان بر روی گزارههای دو ارزشی تحقیقها و پیشرفتهایی داشتهاند).(سایت ویکی پدیا)
توسعه منطق تا قرن بیستم، چه از دید ریاضی و چه از نگاه فلسفی با این عقیده همراه بوده است که ارزش هر گزاره یا راست است و یا دروغ است و نه هر دو. این موضوع را در منطق به اصلِ «دو ارزشی بودن»(principle of bivalence) میشناسند و البته با اصل طرد شق ثالث فرق دارد. اصل طرد شق ثالث سومین اصل از اصول سه گانه تفکر است که افلاطون و شاگردش ارسطو آنها را بیان کردهاند، میباشد. صورتبندی منطقی این اصول که تا حدودی نشان دهنده روش تفکر و استنتاج یکسان اکثریت انسان هاست، به این شکل است:
١.اصل این همانی: هر چیزی برابر خودش است
٢. اصل امتناع تناقض: گزارههای متناقض در آن واحد با همدیگر ارزش راست ندارند.
٣. اصل طرد شق ثالث: از هر دو گزاره متناقض، یکی راست و یکی دروغ است و شق ثالثی متصور نیست.(مجله منطق پژوهی، مقاله تأملی بر منطقهای چندارزشی گزاره ای، ص ۶٢)
منطق چندارزشی
به طور کلی منطق چندارزشی، حوزه ای از منطق ریاضی است که درآن علاوه بر ارزش های پذیرفته شده در منطق دو ارزشی یعنی «صدق» و «کذب»، معانی دیگری از صدق نیز پذیرفته می شود ، به گونه ای که «صدق» و «کذب» سنتی، تنها موارد خاصی از این ارزش ها به حساب می آیند. اما گاهی منظور از منطق چندارزشی، منطقی است که اولاً شامل اصل طرد شق ثالث نمی شود و ثانیاً دارای عملکردهای موجه هم نیست.
نخستین منطق چند ارزشی، منطق سه ارزشی بود که در سال ۱۹۲۰ توسط لوکاسیه ویچ طراحی شد. یان لوکاسیه ویچ در ۲۱ دسامبر ۱۸۷۸ در شهر «لووف» لهستان به دنیا آمد و در ۱۳ نوامبر ۱۹۵۶ در دوبلین وفات یافت. وی پایه گذار تحقیقات ریاضی و منطق در لهستان و یکی از پیشگامان مکتب لووف- ورشو است.
او به عنوان ارزش سوم صدق گزاره، ارزشی را به کار گرفت که با واژه هایی از قبیل «امکان پذیراست» و «خنثی است»، نشان داده می شد،چنان که درباره هر گزاره ای بتوان گفت: «این گزاره یا صادق است ، یا کاذب و یا خنثی».لوکاسیه ویچ بر مبنای منطق سه ارزشی، نظامی از منطق موجهات را ساخت که در آن عملیات منطقی روی گزاره ها یی صورت می گیرد که دارای ارزش های «ممکن» ، «غیر ممکن» و غیره هستند. همانند منطق دو ارزشی،منطق سه ارزشی نیز دارای دو بخش منطق گزاره ها و منطق محمولها است. درسال ۱۹۵۴ ، لوکاسیه ویچ سیستم منطق ۴ ارزشی را ساخت و بالاخره در نهایت منطق دارای بی نهایت ارزش را طراحی کرد. در حال حاضر منطق های چند ارزشی طراحی شده اند که در آنها هر گونه مجموعه متناهی یا نا متناهی از ارزش های صدق به گزاره ها نسبت داده می شود.(مقاله منطق چندارزشی، تاملی بر اصول مکتب منطقی لهستان، نشریه ایران فرهنگی، تاریخ ٢٠ مرداد ١٣٨٩ ) امکان دانلود مقاله در این سایت موجود است.
تاریخ تفصیلی و انواع منطق های چند ارزشی را می توان در مقاله تأملی بر منطقهای چندارزشی گزاره ای،مشاهده کرد.
منطق فازی
منطق فازی (به انگلیسی: fuzzy logic) شکلی از منطقهای چندارزشی بوده که در آن ارزش منطقی متغیرها میتواند هر عدد حقیقی بین ۰ و ۱ و خود آنها باشد. این منطق به منظور بهکارگیری مفهوم درستی جزئی بهکارگیری میشود، به طوری که میزان درستی میتواند هر مقداری بین کاملاً درست و کاملاً غلط باشد. اصطلاح منطق فازی اولین بار در پی تنظیم نظریهٔ مجموعههای فازی به وسیلهٔ لطفی زاده (۱۹۶۵ م) در صحنهٔ محاسبات نو ظاهر شد.واژهٔ فازی به معنای غیردقیق، ناواضح و مبهم (شناور) است.
کاربرد این منطق در علوم نرمافزاری را میتوان بهطور ساده اینگونه تعریف کرد: منطق فازی از منطق ارزشهای «صفر و یک» نرمافزارهای کلاسیک فراتر رفته و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرمافزاری و رایانهها میگشاید، زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق و استدلالهای خود به کار برده و به چالش میکشد. منطق فازی از فضای بین دو ارزش «برویم» یا «نرویم»، ارزشهای جدید «شاید برویم» یا «میرویم اگر» یا حتی «احتمال دارد برویم» را استخراج کرده و به کار میگیرد. بدین ترتیب به عنوان مثال مدیر بانک پس از بررسی رایانهای بیلان اقتصادی یک بازرگان میتواند فراتر از منطق «وام میدهیم» یا «وام نمیدهیم» رفته و بگوید: «وام میدهیم اگر…» یا «وام نمیدهیم ولی…».
تاریخچه
منطق فازی بیش از بیست سال پس از ۱۹۶۵ از درگاه دانشگاهها به بیرون راه نیافت زیرا کمتر کسی معنای آن را درک کرده بود. در اواسط دهه ۸۰ میلادی قرن گذشته صنعتگران ژاپنی معنا و ارزش صنعتی این علم را دریافته و منطق فازی را به کار گرفتند. اولین پروژه آنها طرح هدایت و کنترل تمام خودکار قطار زیرزمینی شهر سندای بود که توسط شرکت هیتاچی برنامهریزی و ساخته شد. نتیجهٔ این طرح موفق و چشمگیر ژاپنیها بهطور ساده اینگونه خلاصه میشود: آغاز حرکت نامحسوس (تکانهای ضربهای) قطار، شتابگرفتن نامحسوس، ترمز و ایستادن نامحسوس و صرفه جویی در مصرف برق. از این پس منطق فازی بسیار سریع در تکنولوژی دستگاههای صوتی و تصویری ژاپنیها راه یافت (از جمله نلرزیدن تصویر فیلم دیجیتال ضمن لرزیدن دست فیلمبردار). اروپاییها بسیار دیر، یعنی در اواسط دههٔ ۱۹۹۰ میلادی، پس از خوابیدن موج بحثهای علمی در رابطه با منطق فازی استفادهٔ صنعتی از آن را آغاز کردند.
دانش مورد نیاز برای بسیاری از مسائل مورد مطالعه به دو صورت متمایز ظاهر میشود:
۱. دانش عینی مثل مدلها و معادلات و فرمولهای ریاضی که از پیش تنظیم شده و برای حل و فصل مسائل معمولی فیزیک، شیمی، یا مهندسی مورد استفاده قرار میگیرد.
۲. دانش شخصی مثل دانستنیهایی که تا حدودی قابل توصیف و بیان زبانشناختی بوده، ولی امکان کمّی کردن آنها با کمک ریاضیات سنتی معمولاً وجود ندارد. به این نوع دانش، دانش ضمنی یا دانش تلویحی گفته میشود.
از آن جا که در بسیاری از موارد هر دو نوع دانش مورد نیاز است، منطق فازی میکوشد آنها را به صورتی منظم، منطقی و به کمک یک مدل ریاضی بایکدیگر هماهنگ گرداند. (سایت ویکی پدیا)
مدلها و سیستم های فازی:
در زندگی روزانه ما کلمات و مفاهیمی به کار میروند که مراتب و درجات دارند و نسبی هستند و نمیتوان بهصورت منطق دو ارزشی که فقط حکم «هست و نیست» را صادر میکند، با آنها رفتار کرد. مثلاً اگر چراغی بهصورت کم نور روشن بود بهطوریکه نمیتوان حکمِ روشن بودنِ طبیعی را برای آن صادر کرد، عرف عبارتِ«چراغ تا حدودی روشن است » یا عبارات مشابهی را برای انتقال موقعیت به کار میبرد.
یعنی احساس ناخودآگاهی به فرد دست میدهد که نه میتواند حکم به خاموش بودن چراغ کند و نه میتواند حکم به روشن بودن آن بکند، یا مثلاً زیبایی یک تصویر،به احساس فردی که درباره آن قضاوت میکند و به میزان زیبایی که اشیایی که با آن مقایسه میشود، بستگی دارد. ممکن است این تصویر در دید ناظری که تابلوها و تصاویری با دقت و ظرافت برتری دیده است، زیبایی کمی داشته باشد و ممکن است در دید ناظری دیگر،زیبایی فراوان و خیره کننده داشته باشد.
مفاهیمی که دارای مراتب و درجات هستند همگی بسته به مبدأ سنجش و موقعیتهای مربوط به آنها تغییر و تحول دارند. یک مرد چهل ساله در یک اردو که شرکتکنندگان آن غالباً پیرمردان هستند، جوان تلقی میشود درحالیکه همین فرد در میان فارغ التحصیلان دبیرستان دیگر حالت جوانی قبل را نخواهد داشت. مثالی که تبدیل به مبنای مفهومی برای این بحث شده است، مثال رنگ خاکستری است. رنگ خاکستری، سفید است یا سیاه؟ رنگ خاکستری، تا حدودی سفید است و تتا حدودی سیاه است و هر چه میزان سیاهی افزایش یابد خاکستری پررنگ تر حاصل میشود. برای قضاوت درباره رنگ خاکستری در فضای سیاه و سفید، باید از درصد استفاده کرد: مثلاً ٢٠ درصد سفید و ٨٠درصد سیاه.
وقتی از دیدِ خرد و جزء گرا به دیدِ کلان و کل گرا منتقل میشویم و میخواهیم راجع به مجموعهای حکم صادر کنیم، مفهوم درصد، درجه، مرتبه،طیف،نسبتاً ، تا حدودی، کموبیش و… به میان میآیند…
تلاش برای تبیین دقیق موقعیتهای موجود در دنیای واقعی که بهدلیل تشکیکی بودن، دارای مراتب و درجات هستند و منحصر به دو حالت بود و نبود نیستند، سبب تولد منطق و تفکری به نام «فازی» شد. تفکر فازی، بهدنبال توصیف مجموعهها و پدیدههای غیرقطعی و نامشخص و طیف دار هستند.
منطق فازی با متغیرهای زبانی سر و کار دارد. دنیای ما بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان پدیدههای آن را با یک توصیف ساده و تعریف کاملاً مشخص، شناخت. …«درجات و مراتب» کلمات حیاتیِ تفکر فازی هستند. منطق فازی، جهان را آن گونه که هست به تصویر میکشد.(نگرش سیستمی به دین، ص ٢۴١-٢۴۴)
برخی تفاوتهای عمده منطق فازی با منطق کلاسیک عبارتاند از :
در منطق فازی ارزش راستی یک گزاره، عددی بین ٠ و ١ است، ولی در منطق کلاسیک یا ٠ است یا ١.
در منطق فازی، محمول گزارهها کاملاً مشخص و معین نیستند و دارای درجات هستند مانند بزرگ، بلند، عجول و… ولی در منطق کلاسیک، محمول ها باید کاملاً معین باشند مانند بزرگتر از ۵، ایستاده، فانی و…
در منطق فازی با سورهای نامعین مانند اکثر،اغلب،قلیل،بهندرت،خیلی زیادو… سرو کار داریم.
در منطق کلاسیک، تنها قیدی که معنای گزاره و ارزش آن را عوض میکند، قید نفی است؛ درحالیکه در منطق فازی با قیدهای متعددی مانند خیلی، نسبتاً کم،کموبیش میتوان معنی و ارزش گزاره را تغییر داد.
در منطق فازی، با الگوهای فکری بشری که اغلب شهودی و احساسی است و در قالب کلمات غیردقیقی که نمیتوان مرز مشخصی برای مفاهیم آن یافت، سر و کار داریم مثلاً یک تپه شن که نمیتوان بهطور قطعی گفت که منظور چه مقدار شن است و چنانچه عدد دقیقی بدهیم ایا اگر یک دانه شن از آن عدد کمتر بود نمیتوان عنوانِ «تپه شن» را به کار برد؟ (نگرش سیستمی به دین، پاورقی ص 244)
برای مطالعه بیشتر در این زمینه به مقاله روششناسی کاربرد منطق فازی در بینش اسلامی و ادامه همین مبحث در کتاب نگرش سیستمی به دین مراجعه فرمایید.
[3] جهان، قطعی است اما بهصورت فازی؛ نه اینکه امور، نسبی است و قطعیتی در کار نیست.(تفکر فازی نوشته بارت کاسکو، ص ٨٠ به نقل از کتاب نگرش سیستمی به دین، پاورقی ص ٢۴۴)
این عبارت نیز گرچه با مطلب بالا متفاوت است، اما در تبیین بهتر مسئله کارساز است:
آیا همه ما یک منطق را به کار می بریم یا افراد می توانند منطق های مختلف داشته باشند؟ در اینجا کمی اختلاف نظر است. من قول کسانی را می پسندم که می گویند تمام ما منطق مشترک داریم. یک قول این است که همه ما یک منطق داریم و آن منطق کلاسیک است؛ همان منطق دوارزشی است و ما اختیاری در انتخاب آن نداریم و ناچاریم آن را به کار ببریم. من هم معتقدم که این درست است؛ یعنی شما هر منطقی را بخواهید پایه گذاری کنید، منطق سه ارزشی، چندین ارزشی، منطق موجهات و...تمام این ها از منطق کلاسیک استفاده می کنند. منطق شهودی که مقابل منطق جدید ایستاده و بعضی قواعدش را قبول ندارد، تمام استدلال های آن بر منطق کلاسیک مبتنی است. یعنی همان وقتی که می گویند p یا p را به عنوان کلّی قبول نداریم، از همین در پایهگذاری منطق استفاده میکند.(نشریه ترنم حکمت،شماره ١،صفحه ۵٩، مقاله منطق و عقلانیت مشترک، دکتر ضیاء موحد)
در این زمینه همچنین به مقاله گردآوری«بایستگی های حوزوی در عصر حاضر: فصل ششم علوم و خلأهای موجود» مراجعه فرمایید.
[4] جلسه درس خارج فقه، بهجة الفقیه، تاریخ ٢۴/ ١٠/ ١٣٩٢
[5] فقد عثرت - بعد ما ذكرت هذا - على كلام يحكى عن المحدث الاسترآبادي في فوائده المدنية، قال - في عداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضروريات قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار، والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة أو من جهة المادة، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء، لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة، والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم، لقرب المواد فيها إلى الإحساس.
وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق، ومن ثم وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعية، وبين
علماء الإسلام في أصول الفقه والمسائل الفقهية وعلم الكلام، وغير ذلك
والسبب في ذلك: أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة، لا من جهة المادة ، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من الأقسام، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك.
ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره، وقال بعد ذلك:
فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات، والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين وفي الفروع الفقهية.
قلت: إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية
ومن الموضحات لما ذكرناه - من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر -: أن المشائيين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين، وعلى هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولي، والإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول وإنما انعدمت صفة من صفاته، وهو الاتصال.
ثم قال:إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة، فنقول:
إن تمسكنا بكلامهم (عليهم السلام) فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نعصم عنه انتهى كلامه.
والمستفاد من كلامه: عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات وما تكون مبادئه قريبة من الإحساس.
وقد استحسن ما ذكره - إذا لم يتوافق عليه العقول غير واحد ممن تأخر عنه، منهم السيد المحدث الجزائري (قدس سره) في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه. قال بعد ذكر كلام المحدث المتقدم بطوله:
وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه. فإن قلت: قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول والفروع، فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟
قلت: أما البديهيات فهي له وحده، وهو الحاكم فيها. وأما النظريات: فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قدم حكمه على النقل وحده، وأما لو تعارض هو والنقلي فلا شك عندنا في ترجيح النقل وعدم الالتفات إلى ما حكم به العقل.
قال: وهذا أصل يبتنى عليه مسائل كثيرة، ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة
أقول: لا يحضرني شرح التهذيب حتى الاحظ ما فرع على ذلك، فليت شعري! إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشئ، كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي عل خلافه؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي، كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع؟ (فرائد الاصول، ج1، ص 52-54)
[6] و الدليل التاسع: مبنيّ على دقيقة شريفة تفطّنت لها بتوفيق اللّه تعالى، و هي أنّ العلوم النظرية قسمان:
قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس، و من هذا القسم علم الهندسة و الحساب و أكثر أبواب المنطق، و هذا القسم لا يقع فيه الاختلاف بين العلماء و الخطأ في نتائج الأفكار. و السبب فيه: أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة و إمّا من جهة المادّة، و الخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء، لأنّ معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الأذهان المستقيمة، و لأنّهم عارفون بالقواعد المنطقية و هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة. و الخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر في هذه العلوم لقرب مادّة الموادّ فيها إلى الاحساس.
و قسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس، و من هذا القسم الحكمة الإلهية و الطبيعية و علم الكلام و علم اصول الفقه و المسائل النظرية الفقهية و بعض القواعد المذكورة في كتب المنطق، كقولهم: «الماهيّة لا يتركّب من أمرين متساويين» و قولهم:
«نقيض المتساويين متساويان» و من ثمّ وقع الاختلاف و المشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية و الطبيعية و بين علماء الإسلام في اصول الفقه و المسائل الفقهية و علم الكلام و غير ذلك من غير فيصل. و السبب في ذلك ما ذكرناه: من أنّ القواعد
المنطقية إنّما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادّة، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب موادّ الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلّي إلى أقسام، و ليست في المنطق قاعدة بها نعلم أنّ كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من تلك الأقسام، بل من المعلوم عند اولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك.
و ممّا يوضح ما ذكرناه من جهة النقل الأحاديث المتواترة معنى الناطقة بأنّ اللّه تعالى أخذ ضغثا من الحقّ و ضغثا من الباطل فمغثهما ثمّ أخرجهما إلى الناس، ثمّ بعث أنبياءه يفرّقون بينهما ففرقتهما الأنبياء و الأوصياء، فبعث اللّه الأنبياء ليفرّقوا[6]ذلك، و جعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضّل اللّه و من يختصّ، و لو كان الحقّ على حدة و الباطل على حدة كلّ واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج الناس إلى نبيّ و لا وصيّ، و لكنّ اللّه عزّ و جلّ خلطهما و جعل تفريقهما إلى الأنبياء و الأئمّة من عباده.
و ممّا يوضحه من جهة العقل ما في شرح العضدي للمختصر الحاجبي، حيث قال في مقام ذكر الضروريات القطعية:
منها: المشاهدات الباطنية، و هي ما لا يفتقر إلى العقل كالجوع و الألم.
و منها: الأوّليات، و هي ما يحصل بمجرّد العقل كعلمك بوجودك و أنّ النقيضين يصدق أحدهما.
و منها: المحسوسات، و هي ما يحصل بالحسّ.
و منها: التجربيات، و هي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهل و الإسكار.
و منها: المتواترات، و هي ما يحصل بالأخبار تواترا كبغداد و مكّة.
و حيث قال في مقام ذكر الضروريات الظنّية: إنّها أنواع:
الحدسيّات، كما نشاهد نور القمر يزداد و ينقص بقربه و بعده من الشمس فنظنّ أنّه مستفاد منها.
و المشهورات، كحسن الصدق و العدل و قبح الكذب و الظلم، و كالتجربيات الناقصة و كالمحسوسات الناقصة.
و الوهميات: ما يتخيّل بمجرّد الفطرة بدون نظر العقل أنّه من الأوّليات، مثل كلّ موجود متحيّز.
و المسلّمات: ما يتسلّمه الناظر من غيره.
و حيث قال في مقام ذكر أصناف الخطأ في مادّة البرهان: الثالث جعل الاعتقاديات و الحدسيات و التجربيات الناقصة و الظنّيات و الوهميات ممّا ليس بقطعي كالقطعي و إجراؤها مجراه، و ذلك كثير.
و حيث قال في مبحث الإجماع: و الجواب أنّ إجماع الفلاسفة على قدم العالم عن نظر عقلي و تعارض الشبه و اشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير، و أمّا في الشرعيات
فالفرق بين القاطع و الظنّي بيّن لا يشتبه على أهل المعرفة و التمييزنتهى كلامه.
فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليات و الشرعيات، و الشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في الأصوليين و في الفروع الفقهية.
قلت: إنّما نشاهدذلك من ضمّ مقدّمة عقلية باطلة بالمقدّمة النقلية الظنّية أو القطعية.
و من الموضحات لما ذكرناه من أنّه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادّة الفكر: أن المشّائيّين ادّعوا البداهة في أنّ تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه و إحداث لشخصين آخرين، و على هذه المقدّمة بنوا إثبات الهيولي.
و الاشراقيّين ادّعوا البداهة في أنّه ليس إعداما للشخص الأوّل و في أنّ الشخص الأوّل باق، و إنّما انعدمت صفة من صفاته و هو الاتّصال.
و من الموضحات لما ذكرناه: أنّه لو كان المنطق عاصما عن الخطأ من جهة المادّة لم يقع بين فحول العلماء العارفين بالمنطق اختلاف، و لم يقع غلط في الحكمة الإلهية و في الحكمة الطبيعية و في علم الكلام و علم اصول الفقه [و الفقه] كما لم يقع في علم الحساب و في علم الهندسة.
إذا عرفت ما مهّدنا من الدقيقة الشريفة، فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا عن الخطأ و إن تمسّكنا بغيره لم نعصم عنه، و من المعلوم أنّ العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب شرعا و عقلا.( الفوائد المدنیة (و بذیله الشواهد المکیة في مداحض حجج الخیالات المدنیة)، صفحه:۲۵۶- ۲۵۹)
[7][٩٧٩] اعلم، وفقك الله، أن لأهل التواتر الذين يقع العلم بصدقهم ضرورة أوصاف إذا اجتمعت ثبت العلم الضروري، وإن اختل واحد منهما لم يثبت العلم الضروري في مجرى العادة، فأحد الأوصاف: أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا عنه. والثاني: أن يكونوا مضطرين إلى العلم الحاصل لهم، مخبرين عن علمهم الضروري. والثالث: أن يزيد عددهم على الأربع، فلو كانوا أربعا فما دونه لم يقع العلم الضروري بأخبارهم.
فهذه هي الأوصاف المشروطة.(كتاب التلخيص في أصول الفقه ج ۲، ص287-۲۸۸)
[١٠٠٣] ما ارتضاه أهل الحق أن أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى معرفته وضبطه، وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذكره أن الأربع فما دونه ليسوا عدد التواتر، فأما فوق الأربع فلا نشير إلى عدد فنفى عنه كونه اقل التواتر، وكذلك لا نشير إلى عدد محصور فنزعم أنه الأقل.
[١٠٠٤] فإن قيل: فلو اتفق أن يخبرنا خمسة عن مشاهدة فيضطر إلى العلم بما اخبروه، فهل يقطع عند اتفاق ذلك أن أقل عدد التواتر خمسة؟
قيل: لو اتفق ذلك كما وصفتموه لقطعنا القول بما ذكرتموه بيد أن ذلك لم يتفق على استمرار العادة
[١٠٠٥] فإن قيل: إذا أخبرونا خمسة فلم يقع العلم الضروري بصدقهم ووجب القطع بأنهم ليسوا عدد التواتر؟
قلنا: ليس الأمر كذلك فإنا نقطع بأن عدم حصول العلم مرتب على نقصان العدد غير أنا نجوز أن يكون ذلك لكاذب فيهم أو مقلد مخمن، فإذا كنا نجوز أيضا ما قلتموه وإذا أخبرنا عشرة مثلا واضطررنا إلى صدقهم وجب أن يقطع بكونهم أقل العدد. قلنا: لا سبيل إلى ذلك، فإنا نجوز أن يحصل العلم بأخبار عدد دونهم. فخرج مما قدمناه أن أقل عدد التواتر مما لا ينضبط، ولا يدل على عدد بعينه دلالة عقلية ولا دلالة سمعية وقد أوضحنا فساد كل تقدير قال به أحد العلماء، فلم يبق إلا المصير إلى ما ذكرناه.(كتاب التلخيص في أصول الفقه، ج ۲،ص306 – ۳۰۷)
فأما ما ذهب إليه قوم من تخصيص عدد التواتر بالأربعين، أخذًا بعدد الجمعة، وبالسبعين، أخذًا من قوله تعالى: {واختار موسى قومَه سَبعين رجلاً لميقاتنا} (الأعراف: الآية 155) وبثلاثمائة وبضعة عشر، أخذًا بعدد أهل بدر، فكل ذلك تحكمات فاسدة، لا تُناسب الغرض، ولا تدل عليه.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إن الأربعة ناقصة عن العدد الكامل، لأنها بينة شرعية تحصل بها غلبة الظن، ولا يُطلب الظن فيما يعلم ضرورة، قال: والخمسة لا تَوَقُّف فيها.( جامع الأصول، ج 1، ص 12۳)
وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت- بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد- فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.
ومنهم من عينه في الأربعة.
وقيل: في الخمسة.
وقيل: في السبعة.
وقيل: في العشرة.
وقيل: في الاثني عشر.
وقيل: في الأربعين.
وقيل: في السبعين.
وقيل غير ذلك.
وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد؛ فأفاد العلم. (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلی، ص ۳۷-۳۸)
الحديث المتواتر: هو الذي رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى انتهاء السند، وكان مستندهم الحسن.
فقولهم: "جمع كثير" أي من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب. وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة.
ومال بعض العلماء إلى تعيين العدد، فقيل: إذا بلغوا سبعين كان متواترا، لقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا} . وقيل أربعين. وقيل: اثني عشر. وقيل بأقل من ذلك حتى قيل بالأربعة اعتبارا بالشهادة على الزنا. لكن المختار أن ليس في شيء من ذلك مقنع، إنما العبرة بحصول العلم اليقيني بصدق الخبر.( منهج النقد في علوم الحديث، ص: 404)
شروط الحديث المتواتر
هذا التعريف الذي يحمل في طياته الشروط التي لا بد من توافرها في الحديث المتواتر، ونجمل هذه الشروط -كما ذكر ابن حجر وغيره- فيما يلي:
الشرط الأول: العدد الكثير:
بمعنى أن يجتمع في كل حلقة من حلقات الإسناد عدد كثير من الرواة.
وقد ذهب العلماء في تحديد هذا العدد مذاهب شتى؛ تبعًا لاعتبارات متعددة؛
فبعضهم قال: إنهم أربعة؛ قياسًا على شهود الزنا الذين تثبت بهم جريمة الزنا ويقام الحد على فاعله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (النور: 4) وحاول أصحاب هذا الرقم أن يضيفوا إليه بعض الأدلة الأخرى بأن يقولوا مثلًا: بأن الخلفاء الأربعة أو الأئمة الأربعة لو اجتمعوا على شيء فإن القول قولهم والرأي رأيهم؛ يسوقون مثل هذه الأقوال تأييدًا لرأيهم الذي ذهبوا إليه من اشتراط أربعة على الأقل في الخبر المتواتر.
القاضي أبو بكر الباقلاني مثلًا -كما نقل عنه العلماء- لم يقتنع بهذا العدد في إثبات التواتر؛ بل قال: أتوقف في الخمسة، والخمسة هذه قالها بعضهم قياسًا على الصلوات الخمس وغيرها من الأرقام التي حملت خمسة في الأحكام الشرعية الإسلامية.
ومن العلماء من اشترط سبعة؛ لاشتمالها على العدد المطلوب في كل نوع من أنواع الشهادات، وهي: الأربعة، والاثنان، والواحد.
ومنهم من اعتبر أقل عدد التواتر عشرة؛ وذلك لقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (البقرة: 196) ووصفها بالكمال، ولأنها أول جموع الكثرة، واختار ذلك السيوطي -رحمه الله تعالى- وسار عليه في كتابه الذي جمع فيه الأحاديث المتواترة (الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواتر)؛ فقال -رحمه الله تعالى-: كل حديث رواه عشرة من الصحابة؛ فهو متواتر عندنا معشر أهل الحديث.
وهناك من قال: يشترط في العدد أن يكون اثني عشر مثل نقباء بني إسرائيل: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} (المائدة: 12).
ومنهم من قال: عشرون؛ لقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} (الأنفال: 65).
ومنهم من قال: أربعون؛ لأن عند هذه السن يُبعث الأنبياء، وهي تدل على اكتمال العقل والأشد عند الإنسان؛ فمتى بلغ الإنسان أربعين سنة فقد كمل نضجه العقلي والبدني: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ} (الأحقاف: 15).
ومنهم من قال: يشترط في العدد أن يكون سبعين، مثل من اختارهم موسى -عليه السلام- لميقات ربه: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا} (الأعراف: 155).
ومنهم من قال: ثلاثمائة، مثل أهل بدر ومن كانوا مع طالوت ... إلى غير ذلك.
اعتبارات متعددة في اشتراط العدد كلها تبحث عن العدد الذي يطمئن القلب والعقل معًا إلى صدقهم وإلى عدم وقوع الكذب منهم ولو اتفاقًا.
إنما هناك من ذهب إلى أن العدد لا يُحصَر برقم معين؛ وإنما متى تحقق الاطمئنان إلى أن هذا الجمع يستحيل أن يتواطأ على الكذب وألا يقع منهم ذلك ولو من قبيل المصادفة، وأن نتأكد من عدم وجود الداعي عندهم للكذب أو وجود أسباب له؛ فقد تحقق التواتر، وقد يتحقق بعشرة، وقد لا يتحقق بملايين يُجمِعون على الكذب، وهذا يحدث في زماننا كثيرًا؛ فقد ينقل الأعداء مثلًا أخبارًا تتعلق بالإسلام وأهله أو بمصادره وهي كاذبة، وينشرونها بين الناس ويتناقلونها بالملايين.
إذن، اشتراط العدد المحدد قد لا يكون ضرورة بقدر التركيز على اطمئناننا إلى صدقهم وعدالتهم وأنه يستحيل أن يقع منهم الكذب.
ولعل هذا ما ذهب إليه بعض محققي أهل الحديث -وفي الحقيقة عدد كبير منهم- يقول الكتاني في (النظم المتناثر في الحديث المتواتر) -رحمه الله تعالى- نقلًا عن كتاب (ظفر الأماني): والتحقيق الذي ذهب إليه جمع من المحدّثين: هو أنه لا يشترط للتواتر عدد؛ وإنما العبرة بحصول العلم القطعي؛ فإن رواه جمعٌ غفير ولا يحصل العلم به لا يكون متواترًا، وإن رواه جمع قليل وحصل العلم الضروري به يكون متواترًا ألبتة.
وعلى كلٍّ نستطيع أن نقول: إن الخلاف هنا ليس خطيرًا حقيقة، ولا كبيرًا، الكل يبحث عن عدد يطمئن القلب والعقل إلى صدقهم ... من الممكن لنا ألا نحصره في عدد معين -كما ذهب إليه كثير من محققي الحديث- أو إذا اشترطنا عددًا؛ لعل اختيار السيوطي هو أن يرويه عشرة من الصحابة.
وفي الحقيقة؛ فإن الذي يتتبع عمل العلماء في إحصائهم للحديث المتواتر يكاد يلمح إلى أنه قد استقر اصطلاحهم على هذا الأمر؛ فيُبحث عن التواتر من ناحية الصحابة؛ فإذا وُجد عشرة من الصحابة رووا الحديث وكانت الطرق إليهم صحيحة أو حسنة؛ حُكم على الحديث بأنه متواتر ... كل من جمعوا الأحاديث المتواترة مثل (لقط اللآلئ المتناثرة) ومثل كتاب الكتاني وغيره، كلهم اتبعوا هذه القاعدة: يحسبون العدد من ناحية الصحابة وأحيانًا يخرّجون الأحاديث، يقولون: حديث أبو هريرة مثلًا رواه فلان وهو من أصحاب الكتب ... حديث أنس رواه فلان، إلى أن يكتمل عندهم عشرة من طرق صحيحة أو حسنة يطمئنون إلى التواتر ويذكرونه في كتابهم على أنه من بين الأحاديث المتواترة.
نستطيع أن نقول: تقريبًا هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، مع ملاحظة أن العدد لا يُبحث عنه في الحلقات التالية للصحابة على الأعم الأغلب؛ باعتبار أن كل صحابي قد روى عنه مجموعة من التابعين، وكل واحد من هؤلاء التابعين قد روى عنه تلامذته ... وهكذا تتواصل الحلقات وتتكاثر بحيث يستحيل أن نحصي العدد بدقة في كل حلقة؛ لكن يطمئنون إلى أنه متى ثبت لدينا أن عشرة من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- قد رووه فيطمئنون إلى صدقه وإلى صحته ويعتبرونه من المتواتر الذي يفيد العلم الضروري.( الدفاع عن السنة - جامعة المدينة (بكالوريوس)، ص: 205-۲۰۹)
[8] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[9] (وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة) بأن يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب، (عن مثلهم من أوله) أي الإسناد (إلى آخره) ؛ ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله، ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح.
قال القاضي الباقلاني: ولا يكفي الأربعة، وما فوقها صالح، وتوقف في الخمسة.
وقال الإصطخري: أقله عشرة، وهو المختار، لأنه أول جموع الكثرة.(كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،ص627 )
عنه صلى الله عليه وسلم كذا، وأن الحديث الفلاني متواتر.
فهذا الحد للمتواتر غلط على السنة، لأنهم قالوا: ما رواه جماعة عن جماعة، ثم ذكروا خلافا في حد الجماعة، والذي يستقر عليه كثير منهم هو: العشرة أو ما يقاربهم فعلى طريقتهم، لا يصير الحديث متواترا إلا إذا رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة عشرة، ورواه عن كل صحابي عشرة، فيكون العدد في التابعين مائة، ورواه عن كل واحد من هؤلاء المائة عشرة، فتكون الطبقة الثالثة ألفا من الرواة، ومثل هذا لا ترى له مثالا في السنة، وإن فرض له مثال فهو يسير جدا.(كتاب شرح العقيدة الطحاوية يوسف الغفيص، ص5 )
وهذا –فيما يبدو- هو الذي حدا بالسيوطي إلى أنه لم يكتف بتصحيح الحديث، حتى عده في الأحاديث المتواترة، وذلك بناء على قاعدته وهي أن كل حديث رواه عشرة من الصحابة فهو متواتر، وقد جرى على هذه القاعدة في كتابه "الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" تلخيص كتابه "الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة. حيث جمع فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعدا".(كتاب سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي، ص430)
ومنهم من اعتبر أقل عدد التواتر عشرة؛ وذلك لقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} (البقرة: ١٩٦) ووصفها بالكمال، ولأنها أول جموع الكثرة، واختار ذلك السيوطي -رحمه الله تعالى- وسار عليه في كتابه الذي جمع فيه الأحاديث المتواترة (الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواتر)؛ فقال -رحمه الله تعالى-: كل حديث رواه عشرة من الصحابة؛ فهو متواتر عندنا معشر أهل الحديث.(كتاب الدفاع عن السنة جامعة المدينة بكالوريوس ،ص206)
الآن شيخكم يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه»، حديث متواتر عندي، أنت يا حزبي هل عندك متواتر؟ لا, ليه؟ لأن التواتر يشترط عند أهل العلم أن يتسلسل في كل طبقة؛ يعني حديث رواه أبو بكر الصديق وحده رواه عنه مليون شخص هذا حديث آحاد، مليون من الصحابة رووا حديثا نقله إلينا واحد هذا حديث آحاد؛ إذا لازم هذا التواتر، نخفف العدد أشوية لا يكون خياليا يكون واقعيا؛ حديث رواه عشرة من الصحابة، وعنه عشرة من التابعين، وعنه عشرة من أتباع التابعين، وهكذا إلى أن سطر هذا الحديث في عشرات كتب السنة بهذا التسلسل؛ عشرة من الصحابة، عشرة من التابعين إلى آخره، يجيء تقي الدين النبهاني وجد لهذا الحديث عشرة طرق صار عنده قناعة يقينية أن هذا الحديث قطعي قاله الرسول عليه السلام, وهذا واقع لكن حينما يقوله لحزبه: هذا الحديث المتواتر، فكل حزبي يصبح عنده الحديث حديث آحاد ليه؟ لأن الذي نقل له التواتر هو واحد انتبه الحزبي، يمكن يقول: هذا حديث متواتر عندي- عند حزب التحرير-، وهذا لا وجود له عنده ولاعند غيره من الأحزاب، في عندهم عشرة من المتخصصين في علم الحديث؛ الشيخ تقي الدين والشيخ أحمد ومحمد وعبد الرحيم وعبد الرحمن إلى آخرة عشرة، كل واحد بحث في هذا الحديث ووجده متواترا، العشرة هذول يعلنون على الملأ- حزب التحرير- أن الحديث الفلاني حديث متواتر، حينئذ يصبح هذا الحديث عند كل الأفراد حديثا متواترا ليش؟! لأن الذي نقل التواتر هو متواتر هو عشرة أشخاص، لكن هذا لا وجود له هذا لا وجود له.(كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة موسوعة العقيدة، ص389 -388)
الحديث يقسمونه باعتبار كثرة الرواة إلى قسمين: متواتر وآحاد، المتواتر: هو ما نقله جمع كثير عن جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، ومثال ذلك: حديث ينقله عشرة عن عشرة عن عشرة وينتشر، مثل حديث: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)
(كتاب شرح القصيدة اللامية لابن تيمية عبد الرحيم السلمي ،ص15 )
الأزهر الشريف الآن، الأزهر الذي يسموه شريف يقرر على الطلاب الذي يوزعوهم في العالم الإسلامية للدعوة للإسلام أن الحديث الصحيح لا يحتج به في العقيدة إلا إذا كان متواترا، ما معنى متواتر؟ يعني: يكون جاء من طرق عديدة، يعني: يكون رواه في عشرة من الصحابة، وعشرة من التابعين عن عشرة من الصحابة ... وهكذا.(كتاب جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة موسوعة العقيدة ،ص715 )
فهب أن المتواتر ما رواه عشرة ابتداء؛ فعليه: لا يكون الحديث متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رواه من الصحابة عشرة، ورواه عن كل واحد من العشرة عشرة، فيكون العدد في الطبقة الثانية مائة، ورواه عن كل واحد من المائة عشرة، فيكون العدد في الطبقة الثالثة ألفا، فهذا هو المتواتر، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يكون آحادا.(كتاب شرح لمعة الاعتقاد يوسف الغفيص، ص3)
[10] ٤ ـ المتواترات
وهي قضايا تسکن اليها النفس سکونا يزول معه الشک ويحصل الجزم القاطع. وذلک بواسطة اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الکذب ويمتنع اتفاق خطأهم في فهم الحادثة کعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها وبنزول القرآن الکريم على النبي محمد صلي الله عليه وآله وبوجود بعض الأمم السالفة او الاشخاص. وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر في عدد معين. وهو خطأ فان المدار انما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعلم امتناع التواطؤ على الکذب وامتناع خطأ الجميع. ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقصان. (المنطق، ج1، ص 333-334)
التخاطب عن فرقة تواطؤ الكذب أي على الكذب امتنع فهذا الامتناع هو المعتبر لا عدد مخصوص كالأربعين فالمتواترات عند ذا تقع كالحكم بوجود مكة و حاتم.(شرح المنظومه، تعلیقات حسن زاده، ج1، ص326)
و القضية المتواترة هي الصنف الثالث من القضايا اليقينية الأولية في رأي المنطق الأرسطي، فتصديقنا بوجود الأشخاص أو الحوادث التي تواتر نقلها، يعتبر - في المنطق الأرسطي - تصديقا أوليا. و يعرّف المنطق الأرسطي التواتر بأنه «إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب».(الاسس المنطقیه للاستقراء، ص 387)
الثاني إن كان الحكم فيه حاصلا بإخبار جماعة ممتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب فهي «المتواترات» (الحاشیه علی التهذیب للمنطق تفتازانی، ص111)
الخامس: المتواترات و هي قضايا يصدّق بها لإخبار جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، كقولنا: أنّ مكّة موجودة، و إنّ بالمغرب بلادا(برهان طباطبایی، ص 56)
فان كان حس السمع فهى المتواترات و هى قضايا يحكم العقل بها بواسطة السماع من جمع كثير أحال العقل تواطؤهم على الكذب كالحكم بوجود مكة و بغداد و مبلغ الشهادات غير منحصر في عدد بل الحاكم بكمال العدد حصول اليقين و من الناس من عين عدد المتواترات و ليس بشيء. (شروح الشمسیه، ص 249)
4 - المتواترات: و هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة إخبار عدد كبير يمتنع تواطؤهم على الكذب، كالعلم بوجود البلاد البعيدة التي لم نشاهدها، أو الأمم و الأشخاص الذين لم نعاصرهم.(الاسس المنطقیه للاستقراء، ص 376)
[11] کلام یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[12] جلسه درس خارج فقه، بهجة الفقیه، تاریخ ١٩/ ١٠/ ١٣٩٠
[13] الخبر المتواتر:
كل خبر حسي يحتمل في شأنه - بما هو خبر - الموافقة للواقع والمخالفة له، واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر، أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة، فإذا تعدد الاخبار عن محور واحد، تضاءل احتمال المخالفة للواقع، لان احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة، لان درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة إحتماله في المخبر الآخر، وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر، تضاءل الاحتمال، لان قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد، فقيمة الاحتمال هي أو أو أي كسر آخر من هذا القبيل، وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة كما هو واضح. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب بعدد اخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا، ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا، بل واقعيا لضالته، وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا. ويسمى حينئذ ذلك العدد من الاخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا بالتواتر، ويسمى الخبر بالخبر المتواتر.
و لا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك. لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين، و مدى وثاقتهم و نباهتهم و سائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال.
و بهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات.(دروس فی علم الاصول، ج1، ص 241-242)
ایشان در الاسس المنطقیة للاستقراء نیز اینگونه می فرمایند:
«و القضية المتواترة هي الصنف الثالث من القضايا اليقينية الأولية في رأي المنطق الأرسطي، فتصديقنا بوجود الأشخاص أو الحوادث التي تواتر نقلها، يعتبر - في المنطق الأرسطي - تصديقا أوليا. و يعرّف المنطق الأرسطي التواتر بأنه «إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب».
و كأن المنطق الأرسطي يفترض تصديقا أوليا بامتناع اتفاق عدد كبير من الناس على الكذب، و هذا التصديق هو الذي يشكل الأساس لثقتنا اليقينية بتلك الحوادث، و هو يشابه تماما التصديق بأن الاتفاق لا يكون دائميا، الذي جعله المنطق الأرسطي أساسا للقضايا التجريبية و الحدسية، فكما لا يكون الاتفاق دائميا كذلك لا يكون الكذب دائميا. فإذا أطرد الاخبار عن شيء معين من عدد كبير من المخبرين، عرفنا أن القضية التي اتفقوا على الاخبار عنها صادقة.
فلو اشترك عدد كبير من الناس في احتفال، و بعد انتهائه سألنا كل واحد منهم عن الشخص الذي حاضر في ذلك الاحتفال، فجاءت الأجوبة كلها تؤكد أن فلانا هو الذي ألقى محاضرة في ذلك الحفل، كانت هذه القضية متواترة و يقينية الصدق في رأي المنطق الأرسطي، لأن الكذب لا يكون دائميا.
و موقفنا من التصديق بأن الكذب لا يكون دائميا - أو التصديق بامتناع اتفاق عدد كبير من الناس على الكذب - هو موقفنا من التصديق بأن الاتفاق (الصدفة النسبية) لا يكون دائميا، فهو في الحقيقة تصديق استقرائي و ليس تصديقا عقليا أوليا. و يكفي لنفي كونه تصديقا عقليا أوليا نفس الحجج و المناقشات التي أثرناها في القسم الأول من هذا الكتاب ضد الطابع العقلي القبلي المزعوم للقضية القائلة: بأن الاتفاق لا يكون دائميا.
و القضية المتواترة في رأينا ليست إلا قضية استقرائية تقوم على أساس المناهج الاستقرائية في الاستدلال، كالقضايا التجريبية و الحدسية، فهي نتيجة للدليل الاستقرائي.
و نحن نواجه في القضية المتواترة الحالة الأولى من حالات الشكل الثاني للاستدلال الاستقرائي. فقد عرفنا سابقا أن للاستدلال الاستقرائي شكلين:
أحدهما يتجه إلى إثبات سببية (أ) ل (ب)، حيث نعلم بأن (أ) موجودة مع عدد كبير من الباءات، و نشك في علاقة السببية بين ماهية (أ) و ماهية (ب).
و الآخر يتجه إلى إثبات وجود (أ) و اقترانه بالباءات، حيث نعلم بأن بين ماهية (أ) و ماهية (ب) علاقة السببية، و نشك في وجود (أ) فعلا. كما عرفنا أيضا أن الشكل الثاني للدليل الاستقرائي - الذي يثبت وجود (أ) - له حالات، و الحالة الأولى منها أن يكون بديل (أ) المحتمل كونه سببا ل (ب) مجموعة مكونة من (ج د ه) مثلا.
و القضية المتواترة هي مثال من أمثلة هذه الحالة. لأن اتفاق العدد الكبير من المحتفلين على جواب واحد، عند السؤال منهم عن نوع الشخص المحاضر في الحفلة، يعبّر عن باءات عديدة بعدد الاخبارات الصادرة منهم. و كون الشخص الذي اتفقوا على ذكره هو المحاضر حقا يعبر عن (أ)، لأنه إذا كان هو المحاضر حقا فهذا وحده يكفي - تقريبا - لكي يفسر لنا كل الباءات، و ما هو البديل ل (أ) هو أن نفترض توفر دواع مصلحية لدى كل المخبرين دعتهم إلى الكذب بطريقة واحدة، و هذا البديل يشتمل على افتراضات عديدة مستقلة. و يمكّننا ذلك من تشكيل علم إجمالي يستوعب احتمالات تلك الافتراضات، و هي ثمانية حتى نفرض ثلاثة مخبرين، إذ يحتمل أن يكون واحد فقط من الثلاثة يتوفر لديه دافع مصلحي إلى الاخبار بتلك الطريقة عن خطيب الحفل، و يحتمل أن يكون إثنان فقط يتوفر لديهما ذلك، و يحتمل توفر الدافع المصلحي لديهم جميعا، كما يحتمل عدم وجوده لدى أي واحد منهم.
و الاحتمال الأول له ثلاثة فروض هي عدد توافيق واحد في ثلاثة، و الاحتمال الثاني له ثلاثة فروض أيضا هي عدد توافيق اثنين في ثلاثة، و الاحتمالان الآخران لكل منهما فرض واحد. فتكون مجموع الفروض التي يستوعبها العلم الاجمالي في حالة وجود ثلاثة مخبرين ثمانية، و سبعة من هذه الفروض تتضمن أن واحدا على الأقل من الثلاثة ليس لديه أي دافع مصلحي يبرر إخباره، و هي لذلك تعتبر في صالح صدق القضية المخبر عنها. و فرض واحد - و هو الفرض الذي يتضمن توفر الدافع المصلحي لدى الجميع - حيادي تجاه صدق القضية و كذبها.
فإذا كانت قيمة احتمال وجود الدافع المصلحي الباعث على الاخبار لدى كل مخبر بصورة مستقلة ، ففي حالة ثلاثة مخبرين سوف تكون من قيم العلم الاجمالي متضمنة لاثبات (أ)، و نفي البديل المحتمل ل (أ)، أي لاثبات صدق القضية. و في حالة أربعة مخبرين ترتفع القيم المثبتة إلى و هكذا حتى تصبح قيمة احتمال عدم ثبوت القضية المخبر بها متمثلة في كسر ضئيل جدا.
و عندئذ تبدأ المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي - على النحو الذي تقدم في القضايا التجريبية - فيفنى ذلك الكسر الضئيل و يتحول التصديق بالقضية المتواترة إلى يقين، لأن الشرط الأساس للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي متوفر، و هو أن لا يعني إفناء الكسر الضئيل الممثل لقيمة الاحتمال المضاد للمطلوب: إفناء العلم لاحدى قيمه الاحتمالية المتساوية بدون مرجح.»( الأسس المنطقیة للاستقراء، صفحه: ۳۸۷-۳۹۰ )
[14] اليقين المنطقي و الموضوعي و الذاتي
و لكي ندرس ذلك يجب أن نحدد معنى اليقين الذي نتحدث عنه، حينما نتساءل عن تحول القيمة الاحتمالية الكبيرة إلى يقين في مرحلة تالية من الدليل الاستقرائي.
فإنا يجب أن نميز بين ثلاثة معان لليقين:
1 - اليقين المنطقي «أو الرياضي»، و هو المعنى الذي يقصده منطق البرهان الأرسطي بكلمة «اليقين»، و يعني اليقين المنطقي: العلم بقضية معينة، و العلم بأن من المستحيل أن لا تكون القضية بالشكل الذي علم. فاليقين المنطقي مركب من علمين، و ما لم ينضم العلم الثاني إلى العلم الأول لا يعتبر يقينا في منطق البرهان، فإذا فرضنا - مثلا - تلازما منطقيا بين قضيتين على أساس تضمن إحداهما للأخرى من قبيل «زيد انسان»، «زيد انسان عالم» فنحن نعلم بأن زيدا إذا كان إنسانا عالما فهو انسان، أي نعلم بأن القضية الثانية إذا كانت صادقة فالقضية الأولى صادقة، و هذا العلم يقين منطقي لأنه يستبطن العلم بأن من المستحيل أن لا يكون الأمر كذلك.
و كما يمكن أن ينصب اليقين المنطقي - من وجهة نظر منطق البرهان - على العلاقة بين قضيتين بوصفها علاقة ضرورة من المستحيل أن لا تكون قائمة بينهما، كذلك يمكن أن ينصب على قضية واحدة حين يكون ثبوت محمولها لموضوعها ضروريا. فعلمنا مثلا بأن الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين، يعتبر - من وجهة نظر المنطق الأرسطي للبرهان - يقينا لأننا نعلم بأن من المستحيل أن لا يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين.
و أما اليقين الرياضي فهو يندرج في اليقين المنطقي بمفهومه الذي رأيناه في منطق البرهان الأرسطي، لأن اليقين الرياضي يعني: تضمن إحدى القضيتين للأخرى. فإذا كانت هناك دالة قضية تعتبر متضمنة في دالة قضية أخرى من قبيل: (س) إنسان، مع (س) إنسان عالم، قيل من وجهة نظر رياضية: إن دالة القضية الأولى تعتبر يقينية من حيث علاقتها بدالة القضية الثانية.
فاليقين الرياضي يستمد معناه من تضمن إحدى الدالتين في الأخرى، بينما اليقين المنطقي في منطق البرهان يستمد معناه من اقتران العلم بثبوت شيء لشيء بالعلم باستحالة أن لا يكون هذا الشيء ثابتا لذاك، سواء كانت هذه الاستحالة من أجل تضمن أحدهما في الآخر، أو لأن أحدهما من لوازم الآخر.
2 - اليقين الذاتي، و هو يعني: جزم الانسان بقضية من القضايا بشكل لا يراوده أي شك أو احتمال للخلاف فيها.
و ليس من الضروري في اليقين الذاتي أن يستبطن أي فكرة عن استحالة الوضع المخالف لما علم، فالانسان قد يرى رؤيا مزعجة في نومه فيجزم بأن وفاته قريبة، و قد يرى خطأ شديد الشبه بما يعهده من خط رفيق له فيجزم بأن هذا هو خطه، و لكنه في نفس الوقت لا يرى أي استحالة في أن يبقى حيا، أو في أن يكون هذا الخط لشخص آخر، رغم أنه لا يحتمل ذلك، لأن كونه غير محتمل لا يعني أنه مستحيل.
3 - اليقين الموضوعي: و في سبيل توضيح هذا المعنى لليقين يجب أن نميز في اليقين - أي يقين - بين ناحيتين: إحداهما القضية التي تعلق بها اليقين.
و الأخرى درجة التصديق التي يمثلها اليقين. فحين يوجد في نفسك يقين بأن جارك قد مات، تواجه قضية تعلق بها اليقين: و هي: أن فلانا مات، و تواجه درجة معينة من التصديق يمثلها هذا اليقين، لأن التصديق له درجات تتراوح من أدنى درجة للاحتمال إلى الجزم، و اليقين بمثل أعلى تلك الدرجات، و هي درجة الجزم الذي لا يوجد في إطاره أي احتمال للخلاف.
و إذا ميزنا بين القضية التي تعلق بها اليقين و درجة التصديق التي يمثلها ذلك اليقين، أمكننا أن نلاحظ أن هناك نوعين ممكنين من الحقيقة و الخطأ في المعرفة البشرية:
أحدهما: الحقيقة و الخطأ في اليقين من الناحية الأولى، أي من ناحية القضية التي تعلّق بها. و الحقيقة و الخطأ من هذه الناحية مردهما إلى تطابق القضية التي تعلق بها اليقين مع الواقع و عدم تطابقها، فإذا كانت متطابقة فاليقين صادق في الكشف عن الحقيقة، و إلا فهو مخطىء.
و الآخر: الحقيقة و الخطأ في اليقين من الناحية الثانية، أي من ناحية الدرجة التي يمثلها من درجات التصديق، فقد يكون اليقين مصيبا و كاشفا عن الحقيقة من الناحية الأولى و لكنه مخطىء في درجة التصديق التي يمثلها. فإذا تسرع شخص و هو يلقي قطعة النقد، فجزم بأنها سوف تبرز وجه الصورة نتيجة لرغبته النفسية في ذلك، و برز وجه الصورة فعلا، فإن هذا الجزم و اليقين المسبق يعتبر صحيحا و صادقا من ناحية القضية التي تعلّق بها، لأن هذه القضية طابقت الواقع، و لكنه رغم ذلك يعتبر يقينا خاطئا من ناحية درجة التصديق التي اتخذها بصورة مسبقة، إذ لم يكن من حقه أن يعطي درجة للتصديق بالقضية «إن وجه الصورة سوف يظهر» أكبر من الدرجة التي يعطيها للتصديق بالقضية الأخرى «إن وجه الكتابة سوف يظهر».
و ما دمنا قد افترضنا إمكانية الخطأ في درجة التصديق، فهذا يعني:
افتراض أن للتصديق درجة محددة في الواقع طبق مبررات موضوعية، و أن معنى كون اليقين مخطئا أو مصيبا في درجة التصديق: أن درجة التصديق التي اتخذها اليقين في نفس المتيقن تطابق أو لا تطابق الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية للتصديق.
و لنأخذ مثالا: آخر: نفترض أننا دخلنا إلى مكتبة ضخمة تضم مائة ألف كتاب، و قيل لنا: إن كتابا واحدا فقط من مجموعة هذه الكتب قد وقع نقص في أوراقه، و لم يعين لنا هذا الكتاب. ففي هذه الحالة إذا ألقينا نظرة على كتاب معين من تلك المجموعة فسوف نستبعد جدا أن يكون هو الكتاب الناقص، لأن قيمة احتمال أن يكون هو ذاك هي: ، و لكن إذا افترضنا أن شخصا ما تسرع و جزم - على أساس هذا الاستبعاد - بأن هذا الكتاب ليس هو الكتاب الناقص، فهذا يعني: أن اليقين الذاتي قد وجد لديه، و لكننا نستطيع أن نقول بأنه مخطىء في يقينه هذا، و حتى إذا لم يكن هذا الكتاب هو الكتاب الناقص حقا فإن ذلك لا يقلل من أهمية الخطأ الذي تورط فيه هذا الشخص. و سوف يكون بإمكاننا أن نحاجّه: قائلين: و ما رأيك في الكتاب الآخر و في الكتاب الثالث... و هكذا؟ فإن أكد جزمه و يقينه الذاتي بأن الكتاب الآخر ليس هو الناقص أيضا، و كذلك الثالث...
و هكذا، فسوف يناقض نفسه، لأنه يعترف فعلا بأن هناك كتابا ناقصا في مجموعة الكتب. و إن لم يسرع إلى الجزم في الكتاب الثاني أو الثالث طالبناه بالفرق بين الكتاب الأول و الثاني... و هكذا، حتى نغير موقفه من الكتاب الأول، و نجعل درجة تصديقه بعدم نقصانه لا تتجاوز القدر المعقول لها، فلا تصل إلى اليقين و الجزم.
فهناك - إذن - تطابقان في كل يقين: تطابق القضية التي تعلّق اليقين بها مع الواقع، و تطابق درجة التصديق التي يمثلها اليقين مع الدرجة التي تحددها المبررات الموضوعية.
و من هنا نصل إلى فكرة التمييز بين اليقين الذاتي و اليقين الموضوعي، فاليقين الذاتي هو التصديق بأعلى درجة ممكنة سواء كان هناك مبررات موضوعية لهذه الدرجة أم لا، و اليقين الموضوعي هو التصديق بأعلى درجة ممكنة على أن تكون هذه الدرجة متطابقة مع الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية. أو بتعبير آخر: إن اليقين الموضوعي هو أن تصل الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية إلى الجزم.
و على هذا الأساس قد يوجد يقين ذاتي و لا يقين موضوعي كما في يقين ذلك الشخص الذي يرمي قطعة النقد و يجزم مسبقا بأن وجه الصورة سوف يبرز، و قد يوجد يقين موضوعي و لا يقين ذاتي، أي تكون الدرجة الجديرة وفق المبررات الموضوعية هي درجة الجزم و لكن انسانا معينا لا يجزم فعلا، نظرا إلى ظرف غير طبيعي يمر به.
و هكذا نعرف: أن اليقين الموضوعي له طابع موضوعي مستقل عن الحالة النفسية و المحتوى السيكولوجي الذي يعيشه هذا الانسان أو ذاك فعلا. و أما اليقين الذاتي فهو يمثل الجانب السيكولوجي من المعرفة.
و كما يوجد يقين موضوعي بهذا المعنى في مقابل اليقين الذاتي، كذلك يوجد احتمال موضوعي في مقابل الاحتمال الذاتي. فالاحتمال الموضوعي يعبّر عن درجة محددة من التصديق الاحتمالي و هي الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية، فيكون الاحتمال موضوعيا إذا كانت درجته تتطابق مع الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية. و الاحتمال الذاتي يعبّر عن الدرجة الاحتمالية الموجودة فعلا في نفس شخص معين سواء كانت متطابقة مع تلك المبررات أم لا.
و سوف نعبّر بكلمة التصديق الموضوعي عن اليقين الموضوعي و الاحتمال الموضوعي بدرجاته المتفاوتة، و نعبر بكلمة التصديق الذاتي عن اليقين الذاتي و الاحتمال الذاتي بدرجاته المتفاوتة أيضا
بقي علينا أن نعرف ما هي المبررات الموضوعية التي تحدد درجة التصديق، و كيف يمكن أن نحدد الدرجة الموضوعية لتصديقاتنا؟
إن الدرجة الموضوعية للتصديق هي: تلك الدرجة التي يمكن استنباطها من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة، فكما أن قضية من قضايا الرياضة أو المنطق تستنبط من قضايا أخرى كذلك الدرجات الموضوعية للتصديقات تستنبط من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة. و كما يجب في مجال استنباط القضايا بعضها من بعض أن نفترض بداية غير مستنبطة و لا مندرجة ضمن قانون أعم و أشمل منها - كمصادرات الرياضة البحتة التي تشكل البداية و القاعدة الاستنباط كل القضايا النظرية في هذا الميدان -، كذلك يجب، في مجال استنباط لدرجة الموضوعية للتصديق، أن نفترض بداية تحتوي على عدد من الدرجات لتصديقات معينة، و تكون هذه الدرجات موضوعية و معطاة عطاء مباشرا في نفس الوقت، أي أنها لا تستمد موضوعيتها و صحتها من درجات سابقة. و هذا يعني: أن الدرجات الموضوعية للتصديق على قسمين: أحدهما:
الدرجة التي يمكن البرهنة على موضوعيتها - أي على صحتها - عن طريق درجات صحيحة لتصديقات سابقة. و الآخر: الدرجة التي تكون موضوعيتها - أي صحتها - أولية و معطاة بصورة مباشرة.
و في هذا الضوء نعرف: أن أي تقييم موضوعي لدرجة التصديق يجب أن يفترض مصادرة مفادها: أن هناك درجات و تقييمات بديهية أولية و غير مستنبطة، إذ ما لم تكن هناك درجات تتمتع بالصحة الموضوعية بصورة مباشرة، لا يمكن أن توجد درجات مستنبطة.
كما نعرف في هذا الضوء أيضا أن هناك خطين للاستنباط في المعرفة البشرية: أحدهما: خط استنباط القضايا التي يتعلق بها التصديق بعضها من بعض، و الآخر: خط استنباط درجات التصديق المتعددة بعضها من بعض، فاستنباط القضية القائلة: «إن زوايا المثلث تساوي قائمتين» من مصادرات الهندسة الاقليدية ينتمي إلى الخط الأول، و أما استنباط درجة التصديق الموضوعي بأن قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة من درجة التصديق الموضوعي بأن قطعة النقد سوف تواجه إحدى حالتين فقط، فهو من الخط الثاني، لأن الاستنباط هنا ليس استنباط قضية من أخرى، إذ أن القضية القائلة: «إن قطعة النقد سوف تبرز وجه الصورة» لا يمكن استنباطها من القضية القائلة: «إن قطعة النقد سوف تواجه إحدى حالتين فقط»، و إنما ينصب الاستنباط هنا على درجة التصديق، فتحدد درجة التصديق بالقضية الأولى بأنها: 1/2، و تستنبط هذه الدرجة من الدرجة المحددة للتصديق بالقضية الثانية وفق نظرية الاحتمال.
و على أساس ما حصلنا عليه حتى الآن من تمييز بين اليقين المنطقي و اليقين الذاتي و اليقين الموضوعي، نطرح من جديد السؤال الذي أثرناه في بداية البحث: هل أن القيمة الاحتمالية الكبيرة التي يحققها الدليل الاستقرائي في مرحلته الأولى الاستنباطية تتحول إلى يقين في مرحلة تالية من هذا الدليل أو لا؟ ( الأسس المنطقیة للاستقراء، صفحه: ۳۲۲- ۳۲۷ و الاسس المنطقیة للاستقراء(مع تعلیقات الاستاذ یحیی محمد)، ص ۲۹۲-۲۹۷)
و ثالثة يحكم العقل باستحالة الانفكاك بين شيئين ضمن ظروف يفترض فيها مقارنة تلك الظروف لملزومها اتّفاقاً و ليس دائماً و لا غالباً، كما في استلزام الرطوبة لأكثر دول الخليج، و هذا ما سمّوه بالملازمة الاتّفاقيّة، إذن، فالملازمة دائماً عقليّة.
كما أنّ الصحيح أنّه لا يوجد ملازمة حتى في التواتر ما بين الخبر المتواتر و ما بين القضيّة المخبر عنها؛ لأنّ كلّ خبر في المقام يحتمل نشوؤه من مناشئ محفوظة حتى مع كذب الخبر، و إنّما استكشاف القضيّة بالتواتر مبنيّ على حساب الاحتمال، كما برهنّا عليه في الأسس المنطقيّة للاستقراء، فإنّه إذا أخبرك شخص واحد أنّه رأى شخصاً يموت في المكان الفلانيّ، فإنّنا حينئذٍ نحتمل صدقه و كذبه بالتساوي، فيكون احتمال موته نصفاً، فلو أخبر شخص ثانٍ نفس الخبر، و كان احتمال الصدق فيه أيضاً النصف، حينئذٍ: سوف يزداد احتمال الصدق، و هكذا إذا أخبرنا شخص ثالث نفس الخبر، فيتضاءل احتمال كذب المجموع إلى أن تحصل درجة عالية جدّاً بحسب الاحتمالات لصدق هذا القضيّة، و هكذا حتى توشك أن تصبح يقيناً، و إن بقي كسر رياضيّ بالنسبة للكذب، لكنّه ضئيل جدّاً، و هو عبارة عن ضعف احتمال الكذب، و هكذا، و عبر قوانين معيّنة في حساب الاحتمالات يتحوّل هذا الكسر الضئيل إلى حجمٍ أصغر حتى يصبح يقيناً.
و لكن مع هذا فنحن لسنا بحاجة إلّا إلى الوجدان؛ إذ بحسب الوجدان ينطفئ الاحتمال الضئيل، إذن، فاستنتاج القضيّة من التواتر يخضع لحساب الاحتمالات.( بحوث في علم الأصول ؛ ج9 ؛ ص432)
[15] جلسه درس خارج فقه، بهجة الفقیه، تاریخ ٢۴/ ١٠/ ١٣٩٢
[16] تقریر جلسه تفسیر سوره مبارکه ق، تاریخ 18/2/92
[17]لكن هذه الكثرة، ليس بالإمكان تحديدها في رقم معين، كأن يقال: إذا شهد مائة، أو أقل، أو أكثر، و نحو ذلك، كما حاولوا في الكتب وضع تحديدات كمية للتواتر حتى سمّاها الشهيد الثانيبسخف القول، فذهب بعضهم إلى أنّ عدد الشهود ينبغي أن يكون ثلاثمائة و ثلاثة عشر شاهداً ناقلًا، و ذهب الآخر إلى أنه ينبغي أن يكون عددهم اثني عشر شاهداً ناقلًا، و ذهب الآخر إلى أنه ينبغي أن يكون عددهم سبعين شاهداً ناقلًا، و ذهب آخرون إلى أكثر من أربعة لئلا تدخل البينة على الزنى في التواتر، كما أنّ الأعداد السابقة كانت لاعتبارات، و النكتة في جميعها أنه بها تكون الحجة، كما أقيمت بها الحجة على الكفار من قبل الأنبياء (ع)، و أنت ترى أنّ هذه الأقوال لم تصنع ميزاناً معيناً و إنما هي من فنون الجزافات، و ما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر في القرآن، ثم قال (قده): إنّ الميزان إنما هو إفادة العلم، فالعدد الذي يفيد العلم هو التواتر، انتهى كلام الشهيد (قده) (بحوث في علم الأصول ؛ ج10 ؛ ص24)
و أما حصر بعضهم عدد التواتر في خمسة و بعضهم في اثني عشر و أخر في عشرين و أخر في أربعين و أخر في سبعين و أخر في ثلاثمائة و ثلاثة عشر (حاشية فرائد الأصول ؛ ج1 ؛ ص409)
و الكثرة العدديّة هي جوهر التواتر و لكنه ليس بالإمكان تحديدها في رقم معين كما حاوله بعض الفقهاء فحددها بتحديدات مضحكة، وصفها الشهيد الثاني (قده) بسخف القول من قبيل التحديد بأنها 313 بعدد شهداء بدر أو 12 بعدد نقباء بني إسرائيل أو سبعين بعدد أصحاب موسى الذين ذهبوا لميقات ربّهم أو انَّه أكثر من أربعة لئلا تكون البيّنة في بعض الأبواب الفقهية التي يشترط فيها أربعة شهود تواتراً و نحو ذلك. و قد أفاد الشهيد بأنَّ الميزان إفادة العلم و هذا أيضا كما ترى من تفسير الشيء بنفسه كتفسير الماء بالماء.( بحوث في علم الأصول ؛ ج4 ؛ ص332)
[18] اليقين المنطقي «أو الرياضي»، و هو المعنى الذي يقصده منطق البرهان الأرسطي بكلمة «اليقين»، و يعني اليقين المنطقي: العلم بقضية معينة، و العلم بأن من المستحيل أن لا تكون القضية بالشكل الذي علم. فاليقين المنطقي مركب من علمين، و ما لم ينضم العلم الثاني إلى العلم الأول لا يعتبر يقينا في منطق البرهان، فإذا فرضنا - مثلا - تلازما منطقيا بين قضيتين على أساس تضمن إحداهما للأخرى من قبيل «زيد انسان»، «زيد انسان عالم» فنحن نعلم بأن زيدا إذا كان إنسانا عالما فهو انسان، أي نعلم بأن القضية الثانية إذا كانت صادقة فالقضية الأولى صادقة، و هذا العلم يقين منطقي لأنه يستبطن العلم بأن من المستحيل أن لا يكون الأمر كذلك. و كما يمكن أن ينصب اليقين المنطقي - من وجهة نظر منطق البرهان - على العلاقة بين قضيتين بوصفها علاقة ضرورة من المستحيل أن لا تكون قائمة بينهما، كذلك يمكن أن ينصب على قضية واحدة حين يكون ثبوت محمولها لموضوعها ضروريا. فعلمنا مثلا بأن الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين، يعتبر - من وجهة نظر المنطق الأرسطي للبرهان - يقينا لأننا نعلم بأن من المستحيل أن لا يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين. و أما اليقين الرياضي فهو يندرج في اليقين المنطقي بمفهومه الذي رأيناه في منطق البرهان الأرسطي، لأن اليقين الرياضي يعني: تضمن إحدى القضيتين للأخرى. فإذا كانت هناك دالة قضية تعتبر متضمنة في دالة قضية أخرى من قبيل: (س) إنسان، مع (س) إنسان عالم، قيل من وجهة نظر رياضية: إن دالة القضية الأولى تعتبر يقينية من حيث علاقتها بدالة القضية الثانية. فاليقين الرياضي يستمد معناه من تضمن إحدى الدالتين في الأخرى، بينما اليقين المنطقي في منطق البرهان يستمد معناه من اقتران العلم بثبوت شيء لشيء بالعلم باستحالة أن لا يكون هذا الشيء ثابتا لذاك، سواء كانت هذه الاستحالة من أجل تضمن أحدهما في الآخر، أو لأن أحدهما من لوازم الآخر. 2 - اليقين الذاتي، و هو يعني: جزم الانسان بقضية من القضايا بشكل لا يراوده أي شك أو احتمال للخلاف فيها. و ليس من الضروري في اليقين الذاتي أن يستبطن أي فكرة عن استحالة الوضع المخالف لما علم، فالانسان قد يرى رؤيا مزعجة في نومه فيجزم بأن وفاته قريبة، و قد يرى خطأ شديد الشبه بما يعهده من خط رفيق له فيجزم بأن هذا هو خطه، و لكنه في نفس الوقت لا يرى أي استحالة في أن يبقى حيا، أو في أن يكون هذا الخط لشخص آخر، رغم أنه لا يحتمل ذلك، لأن كونه غير محتمل لا يعني أنه مستحيل. (الاسس المنطقیة للاستقراء، ص 322-323)
[19] جلسه درس خارج فقه، تاریخ ١/ ١٠/ ١٣٩۸
[20] و للحديث طرق أخرى كثيرة جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في " المجمع " (٩ / ١٠٣ - ١٠٨) وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا، وإلا فهي كثيرة جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، قال الحافظ ابن حجر: منها صحاح ومنها حسان. وجملة القول أن حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه، بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما ظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه، وما ذكرت منها كفاية. وأما قوله في الطريق الخامسة من حديث علي رضي الله عنه: " وانصر من نصره واخذل من خذله " ففي ثبوته عندي وقفة لعدم ورود ما يجبر ضعفه، وكأنه رواية بالمعنى للشطرالآخر من الحديث: " اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه ". ومثله قول عمر لعلي: " أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ". لا يصح أيضا لتفرد علي بن زيد به كما تقدم. إذا عرفت هذا، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام بن تيمية، قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأماالشطر الآخر، فزعم أنه كذب ! وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها. والله المستعان.(سلسلة الاحادیث الصحیحة و شی ء من فقهها و قوائدها، ج 4، ص 343-۳۴۴)
" وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز ". على أن الحديث قد جاء مفرقا من طرق أخرى ليس فيها شيعي. أما قوله: " إن عليا مني وأنا منه ". فهو ثابت في " صحيح البخاري " ( ٢٦٩٩) من حديث البراء بن عازب في قصة اختصام علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: " أنت مني وأنا منك ". وروي من حديث حبشي بن جنادة، وقد سبق تخريجه تحت الحديث (١٩٨٠) . وأما قوله: "وهو ولي كل مؤمن بعدي ". فقد جاء من حديث ابن عباس، فقال الطيالسي (٢٧٥٢) :حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: " أنت ولي كل مؤمن بعدي ". وأخرجه أحمد (١ / ٣٣٠ - ٣٣١) ومن طريقه الحاكم (٣ / ١٣٢ - ١٣٣) وقال: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا. وهو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " من كنت مولاه فعلي مولاه.. " وقد صح من طرق كما تقدم بيانه في المجلد الرابع برقم (١٧٥٠) .
فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في " منهاج السنة " (٤ / ١٠٤) كما فعل بالحديث المتقدم هناك، مع تقريره رحمه الله أحسن تقرير أن الموالاة هنا ضد المعاداة وهو حكم ثابت لكل مؤمن، وعلي رضي الله عنه من كبارهم، يتولاهم ويتولونه. ففيه رد على الخوارج والنواصب، لكن ليس في الحديث أنه ليس للمؤمنين مولى سواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقريش والأنصار موالي دون الناس، ليس لهم مولى دون الله ورسوله ". فالحديث ليس فيه دليل البتة على أن عليا رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة من الشيخين كما تزعم الشيعة لأن الموالاة غير الولاية التي هي بمعنى الإمارة، فإنما يقال فيها: والي كل مؤمن. هذا كله من بيان شيخ الإسلام وهو قوي متين كما ترى، فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة، غفر الله لنا وله.( كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ج 5، ص26۴-265)
در این زمینه همچنین به صفحه مرتبط با تواتر حدیث غدیر از منظر البانی در سایت فدکیه مراجعه فرمایید.
[21] تقریر جلسه تفسیر سوره مبارکه ق، تاریخ 18/2/92
[22] ایشان در تحلیل مبدأ علیت میفرمایند و اینکه آیا قانون ان لکل حادثة سببا تجربی است یا عقلی میفرمایند:
« إنّ النظريات العلمية في مختلف ميادين التجربة والمشاهدة، تتوقّف بصورة عامّة على مبدأ العلّية وقوانينها توقّفاً أساسياً. وإذا سقطت العلّية ونظامها الخاصّ من حساب الكون، يصبح من المتعذّر تماماً تكوين نظرية علمية في أيّ حقل من الحقول. وليتّضح هذا نجد من الضروري أن نشير إلى عدّة قوانين من المجموعة الفلسفية للعلّية التي يرتكز عليها العلم، وهي كما يلي:
أ - مبدأ العلّية القائل: إنّ لكلّ حادثة سبباً.
ب - قانون الحتمية القائل: إنّ كلّ سبب يولّد النتيجة الطبيعية له بصورة ضرورية، ولا يمكن للنتائج أن تنفصل عن أسبابها.
ج - قانون التناسب بين الأسباب والنتائج، القائل: إنّ كلّ مجموعة متّفقة في حقيقتها من مجاميع الطبيعة، يلزم أن تتّفق - أيضاً - في الأسباب والنتائج.
...
ولنعد الآن - بعد أن عرفنا الفقرات الرئيسية الثلاث: العلّية، والحتمية، والتناسب - إلى العلوم والنظريات العلمية، فإنّنا سوف نجد بكلّ وضوح: أنّ جميع النظريات والقوانين التي تزخر بها العلوم، مرتكزة في الحقيقة على اساس تلك الفقرات الرئيسية، وقائمة على مبدأ العلّية وقوانينها. فلو لم يؤخذ هذا المبدأ كحقيقة فلسفية ثابتة، لما أمكن أن تقام نظرية، ويشاد قانون علمي له صفة العموم والشمول؛ ذلك أنّ التجربة التي يقوم بها العالم الطبيعي في مختبره، لا يمكن أن تستوعب جميع جزئيات الطبيعة، وإنّما تتناول عدّة جزئيات محدودة متّفقة في حقيقتها، فتكشف عن اشتراكها في ظاهرة معيّنة، وحيث يتأكّد العالم من صحّة التجربة ودقّتها وموضوعيتها، يضع فوراً نظريته أو قانونه العام الشامل لجميع ما يماثل موضوع تجربته من أجزاء الطبيعة. وهذا التعميم الذي هو شرط أساسي لإقامة علم طبيعي، لا مبرّر له إلّاقوانين العلّية بصورة عامّة، وقانون التناسب منها بصورة خاصّة، القائل: إنّ كلّ مجموعة متّفقة في حقيقتها، يجب أن تتّفق - أيضاً - في العلل والآثار، فلو لم تكن في الكون علل وآثار، وكانت الأشياء تجري على حسب الاتّفاق البحت، لما أمكن للعالم الطبيعي القول: إنّ ما صحّ في مختبره الخاصّ، يصحّ على كلّ جزء من الطبيعة على الإطلاق.
ولنأخذ لذلك مثالاً بسيطاً، مثال العالم الطبيعي الذي أثبت بالتجربة أنّ الأجسام تتمدّد حال حرارتها، فإنّه لم يحط بتجاربه جميع الأجسام التي يحتويها الكون طبعاً، وإنّما أجرى تجاربه على عدّة أجسام متنوّعة، كعجلات العربة الخشبية التي توضع عليها إطارات حديدية أصغر منها، حال سخونتها، فتنكمش الإطارات إذا بردت وتشتدّ على الخشب، ولنفرض أ نّه كرّر التجربة عدّة مرّات على أجسام اخرى، فلن ينجو في نهاية المطاف التجريبي عن مواجهة هذا السؤال: ما دمتَ لم تستقصِ جميع الجزئيات، فكيف يمكنك أن تؤمن بأنّ إطارات جديدة اخرى غير التي جرّبتها، تتمدّد هي الاُخرى - أيضاً - بالحرارة.
والجواب الوحيد على هذا السؤال هو: مبدأ العلّية وقوانينها. فالعقل حيث إنّه لا يقبل الصدفة والاتّفاق، وإنّما يفسّر الكون بالعلّية وقوانينها من الحتمية والتناسب، يجد في التجارب المحدودة الكفاية للإيمان بالنظرية العامة القائلة بتمدّد الأجسام بالحرارة؛ لأنّ هذا التمدّد الذي كشفت عنه التجربة لم يكن صدفة، وإنّما كان حصيلة الحرارة ومعلولاً لها، وحيث أنّ قانون التناسب في العلّية ينصّ على أنّ المجموعة الواحدة من الطبيعة تتّفق في أسبابها ونتائجها وعللها وآثارها، فلا غرو أن تحصل كلّ المبرّرات - حينئذٍ - للتأكيد على شمول ظاهرة التمدّد لسائر الأجسام.
وهكذا نعرف أنّ وضع النظرية العامّة لم يكن ميسوراً دون الانطلاق من مبدأ العلّية. فمبدأ العلّية هو الأساس الأوّل لجميع العلوم والنظريات التجريبية.
وبتلخيص: أنّ النظريات التجريبية لا تكتسب صفة علمية ما لم تعمّم لمجالات أوسع من حدود التجربة الخاصّة، وتقدّم كحقيقة عامّة. ولا يمكن تقديمها كذلك إلّاعلى ضوء مبدأ العلّية وقوانينها، فلا بدّ للعلوم عامّة أن تعتبر مبدأ العلّية وما إليها من قانوني الحتمية والتناسب، مسلّمات أساسية، وتسلم بها بصورة سابقة على جميع نظريّاتها وقوانينها التجريبية.( موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۳۳۶-۳۳۸)
با این عنایت ایشان قاعده الاتفاق لا یکون دائمیا و لا اکثریا در مثل مجربات را قاعدهای عقلی و سابق بر تجربه میدانند. در تعلیقه کتاب تذکر داده شده است که این مبنا در الاسس المنطقیة دستخوش تغییر شده است:
ولكنّه رحمه الله جدّد النظر حول مشكلة التعميمات الاستقرائيّة في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» وأثبت عجز المذهب العقلي للمعرفة - بما فيه من مبدأ العلّيّة وقوانينها - عن حلّ تلك المشكلة، كما أنّ المذهب التجريبي للمعرفة عاجز عن ذلك أيضاً، وانتهى إلى أنّ الحلّ الوحيد لمشكلة التعميمات الاستقرائيّة يتمّ في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة، من دون حاجة إلى الإيمان المسبق بمبدأ العلّيّة وقوانينها. (لجنة التحقيق)(همان، ص ۳۳۷)
در مورد محسوسات و تحلیل آن ها نیز شهید صدر خود در بحوث به بیان سیر تطور فکری خود در این باره می پردازد. ایشان می فرماید گرچه در کتاب فلسفتنا تلاش کردیم که با ارجاع محسوسات به اصل علیت، مشکل را حل کنیم اما در کتاب الاسس المنطقیة به پاسخ صحیح این مطلب که همان یقین حساب احتمالاتی است رهنمون شدیم:
و توضيح ذلك ان القضايا الحسية على قسمين:
1- أن يكون واقع المحسوس فيها امرا وجدانيا كالإحساس بالجوع و الألم، و هذا لا إشكال في أوليته و لا يقوم على أساس حساب الاحتمالات و الطريقة الاستقرائية، لأن الإدراك في هذا النوع يتصل بالمدرك بصورة مباشرة حيث يكون المدرك بنفسه ثابتا في النفس لا انه أمر موضوعي خارجي له انعكاس على النفس ليراد الكشف عن مدى مطابقة ذلك الانعكاس مع واقعه.
2- الإحساس بالواقع الموضوعي خارج عالم النفس كاحساسك بالسرير الذي تنام عليه و صديقك الذي تجلس عنده و حرمك الذي تسكن إليها، و هذا هو الذي لا يتعلق إحساسنا به مباشرة فكيف يمكن إثبات واقعيته من مجرد انطباع حاصل في النفس أو الذهن و كيف نثبت مطابقة ذلك الانطباق للخارج؟ و هذه المسألة من ألغاز الفلسفة.
و الاتجاه المتعارف عند فلاسفتنا في حلها ان المحسوسات قضايا أولية و ان كانت المسألة غير معنونة بهذا الشكل و انما عنونت كذلك عند فلاسفة الغرب، و قد ظهر لدى بعض المحدثين [فی التعلیقة:السید الطباطبائی قدسسره فی روش رئالیسم]عندنا ان معرفتنا بالحسيات لا يمكن أن تكون أولية لوقوع الخطأ فيها مع انه لا خطأ في الأوليات، و لكنه عاد و زعم ان معرفتنا الحسية بالواقع الخارجي إجمالا أولية و ان كانت معرفتنا بالتفاصيل ليست كذلك، فكان هذا اتجاه يفصل في المعرفة الحسية بين الإيمان بأصل الواقع الموضوعي في الجملة و بين الإيمان بتفاصيل المعرفة الحسية.
و نحن في كتاب فلسفتنا حاولنا إرجاع المعرفة الحسية إلى معارف مستنبطة بقانون العلية لأن الصورة الحسية حادثة لا بد لها من علة و قانون العلية قضية أولية أو مستنبطة من قضية أولية. و في قبال هذه الاتجاهات الثلاثة المثاليون الذين أنكروا الواقع موضوعي رأسا. و كل هذه الاتجاهات الأربعة التي تذبذب الفكر الفلسفي بينهما غير صحيحة و انما الصحيح بناء على ما اكتشفناه من الأسس المنطقية للاستقراء ان معرفتنا بالواقع الموضوعي جملة و تفصيلا في المدركات الحسية قائمة على أساس حساب الاحتمال الذي يشتغل بالفطرة لدى الإنسان و بعقل رزقه الله له سميناه بالعقل الثالث قبال العقلين الأول و الثاني.( بحوث في علم الأصول ؛ ج4 ؛ ص131)
[23] مرحوم شهید صدر در مورد زمان تألیف کتاب فلسفتنا و مدت آن در مقدمه میفرمایند:
هذا هو الكتاب في مخطّط إجمالي عامّ، تجده الآن بين يديك نتيجة جهود متظافرة طيلة عشرة أشهر، أدّت إلى إخراجه كما ترى. وكلُّ أملي أن يكون قد أدّىٰ شيئاً من الرسالة المقدّسة بأمان وإخلاص.
وأرجو من القارئ العزيز أن يدرس بحوث الكتاب دراسة موضوعية بكلّ إمعان وتدبُّر، تاركاً الحكم له أو عليه إلى ما يملك من المقاييس الفلسفية والعلمية الدقيقة، لا إلى الرغبة والعاطفة. ولا احبّ له أن يطالع الكتاب كما يطالع كتاباً روائيّاً، أو لوناً من ألوان الترف العقلي والأدبي، فليس الكتاب رواية ولا أدباً أو ترفاً عقليّاً، وإنّما هو في الصميم من مشاكل الإنسانية المفكِّرة.
وما توفيقي إلّاباللّٰه عليه توكّلت وإليه انيب.
محمّد باقر الصدر
النجف الأشرف
٢٩ ربيع الثاني ١٣٧٩ ه(فلسفتنا، ص ۱۵)
ومن جملة الكتب التي شملتها الجهود التحقيقيّة المذكورة كتاب (فلسفتنا) ، وهو من جملة آثاره القيّمة التي ألّفها في أواسط العقد الثالث من عمره الشریف (فلسفتنا، ص ۱۰)
نشر کتاب فلسفتنا للسید محمد باقر الصدر بطبعته الاولی عام ۱۳۷۹ه/۱۹۵۹ و عمر الصدر وقت تألیفه الکتاب ست و عشرین سنة…و قضی الصدر فی تألیفه للکتاب مدة عشرة اشهر کما اشار فی مقدمة الکتاب(مقاله المحاضرات: قراءة فی کتاب «فلسفتنا» سید محمد باقر الصدر (قدس الله سره))
چند نکته در مورد تألیف کتاب الاسس المنطقیة للاستقراء و سیر شکلگیری آن در ذهن شهید صدر :
۱. بذر شکلگیری این فکر و طرح آن از سال ۱۳۸۴ شمسی:
في شهر رمضان من هذا العام ألقى السيد الصدر سلسلة محاضرات حاول فيها التأسيس للمنطق الذاتي الذي ظهر فيما بعد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء). وقد التي حول هذا الموضوع سنة عشر درسا تاریخ ۱۲,۱۰،۹،۸،۷،۶،۵ ۱۳ ۱۴ ۲۰۱۷ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ رمضان ١٣٨٤ هـ، وتقع جميعا في (١٤٨) صفحة ، وقد ورد مصطلح (المنطق الذاتي) في هذه المحاضرات. (محمد باقر الصدر السیرة و المسیرة، ج ۲، ص ۱۸)
۲. آمادهسازی کتاب در طول هفت سال:
في هذه الفترة كان السيد الصدر منشغلاً بدراسة الأسس المعرفية بعد أن كان قد توقف عندها عام ١٣٨٣ هـ لدى وصوله إلى مبحث (القطع) في دورته الأصولية الأولى. وقد كان في معيته تلميذه السيد كاظم الحائري، الذي كان - على ما في بعض رسائله - يشارك أستاذه معاناة اكتشاف الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستقراء.
وقد استمرت هذه الرحلة على ما نقل عن السيد الصدر سبع سنوات . [در تعلیقه: حدكني السيد على أكبر الحائري نقلا عن الشيخ علي أصغر المسلمي أنه سأل السيد الصدرة عن مدة تأليفه كتاب الأسس المنطقية للاستقراء فأجاب : سبع سنوات، وسأله عن فترة تأليف (الحلقات)، فأجاب : سبعة أشهر فسأله الشيخ المسلمي عن سر هذه المفارقة فأجاب عندما كنت منشغلا بتأليف الأسس المنطقية للاستقراء، كان معي السيد كاظم الحائري الذي كان يشكل على بالإشكال تلو الآخر، فكنت أصرف الوقت في التفكير للإجابة عن إشكالاته، أما خلال تأليف الحلقات، فلم يكن معي.
وحدكني الشيخ حسان سويدان العاملي بتاريخ ٢٠٠٤٫١١٫٢٦م نقلا عن السيد حيدر الموسوي نقلا عن الشهيد السيد عباس الموسوي نقلا عن السيد الصدر أنه يعتبر السيد كاظم الحائري شريكا له في تأليف (الأسس) كما ذكر لي السيد عبد الهادي الشاهرودي بتاريخ ٢٠٠٤٫١١٫٢٧م أن إشكالات السيد كاظم الحائري هي التي انضجت البحث في الأسس المنطقية. وينقل الشيخ محمد مراد قول السيد الصدر: إن أقدر من يدرس الأسس المنطقية من الذين درسوا الأسى عندي هو السيد كاظم الحائري (مقابلة مع الشيخ محمد مراد )
وقد ذاكر السيد محمد الغروي أن السيد الصدر كان يعبر عن السيد كاظم الحائري بالعقل المحض لأنه كان يتناول كل مسألة علمية وسياسية واجتماعية وتربوية من المنظار العقلي ويدرسه، (مع علماء النجف الأشرف، ٢ ، ۳۰۰) ولكن أخبرني بعض تلامذة السيد الصدرة - الذين يحترمون السيد الحائري - أن السيد الصدر كان ياخذ على السيد الحائري تعامله مع مختلف الأمور بهذه الدقة العقلية حتى في الأمور الاجتماعية، وهو ما لم يكن يرتضيه السيد الصدر]
وكان لا بد للسيد الصدر وهو يبحث في الاستقراء أن يقف عند نظرية الاحتمال في جانبها الرياضي، وهذا ما دفعه إلى التخصص في مجال الرياضيات بعد أن لم تكن دراسته المدرسية تخوله ذلك لأنه كان قد ترك المدرسة باكرا.
ومن هنا فقد اتفق مع بعض الأساتذة في بغداد على تدريسه الرياضيات، قدأب يقصد بغداد أيام الخميس والجمعة وأيام العطل لهذا الغرض. وبعد فترة قصيرة قالوا له: «الآن نعطيك بحسب لغتكم إجازة اجتهاد في الرياضيات.» وفي الأيام الأولى من بداية تأليفه الكتاب، كان يجمع تلامذته ويلقي عليهم جملة من المسائل الفلسفية لمناقشتها معه .
وكان السيد الصدر يعتمد في الأيام الأولى على ما جاء في الفصل الثامن والعشرين من كتاب المنطق الوضعي للدكتور زكي نجيب محمود تحت عنوان الاحتمالات وحسابها"، إلا أن هذا المقدار لم يكن كافياً بالنسبة له.
وقد أراد الاطلاع على آراء عالم الاقتصاد جون مينار كينز من خلال كتابه (مقال في الاحتمال) فرغب في أن يترجم، ولكن تبين له - من خلال الدكتور زكي نجيب محمود على ما يبدو - أن ترجمة كتاب (كينز) تكتنفها الصعوبات، فتحول إلى ترجمة الفصل الخامس من كتاب المعرفة الإنسانية.. مداها وحدودها البرتراند رسل - وهو القسم الذي تناول فيه رسل النظرية الاحتمال وتعرض فيه إلى أراء كبير وغيره وطرح فيه رؤيته - وكان الدكتور زكي نجيب محمود هو الذي أشار عليه بذلك.
ومن هنا، فقد طلب السيد الصدر من السيد مرتضى الرضوي التفاوض مع الدكتور محمود من أجل تحصيل مترجم موثوق به الترجمة هذا القسم من كتاب برتراند رسل .
وعلى ضوء ذلك، تم الاتفاق مع الدكتور كريم متي - وكان أستاذاً في جامعة بغداد - على المبلغ اللازم مقابل الترجمة.
وبعد أن تمت ترجمة الموضوع قام الأستاذ أحمد عبد الأمير بتقديمه إلى السيد الصدر الذي طالعه جيدا، وقد تبين للسيد الصدر وجود خطأ في معادلة رياضية، فطلب مراجعة المترجم الذي أقر بذلك واعترف بوجود خطأ. وهذا إن دل على شيء.. فإنما يدل على مدى تعمق السيد الصدر في الرياضيات . كما استعان السيد الصدر ببعض الكتب الفارسية المدونة حول هذا الموضوع "، ولم يتعب على كتاب من كتبه كما تعب على كتاب (الأسس)).
هذا، وقد سأل السيد الغروي أستاذه السيد الصدر أثناء توجههما إلى الكوفة عن دواعي تأليف هذا الكتاب فأجابه: لكي أثبت للملحدين أنه إما عليهم الإيمان بالله تعالى والعلوم الطبيعية وإما رفض الاثنين معاً، وأقفلت في وجه الكافر باب الخضوع أمام العلم والتمرد على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقال أيضاً حول ذلك: إن مرحلة الاستيراد في العالم الإسلامي من الغرب يجب أن تنتهي وعلينا أن تصدر إبداعنا إلى الغرب .
وقد عرض السيد الصدر مسودات كتاب (الأسس) على مجموعة من تلامذته لمناقشتها، وبعد أن أتم الكتاب شرع في تدريسه الكوكبة منهم.
ولو أتيحت للسيد الصدرية فرصة الاطلاع على ما جاء في كتاب (الأسس المنطقية للاحتمال) الرد ولف كرتاب وبما جاء في كتابات كارل بوبر المختلفة، لكان النزال الفكري - المحض - أكثر ثراء وخصوبة . (همان، ص ۵۵-۵۸)
۳. چاپ کتاب در سال ۱۳۹۱ قمری:
عندما فرغ السيد الصدر من كتابة الأسس المنطقية للاستقراء، أراد إرساله إلى الطبع فاحتاج إلى تبييضه بخط جيد.
وفي هذه الفترة كان الشيخ محمد رضا النعماني يدرس عند السيد محمد الغروي الذي كان يطلب من تلامذته امتحانات كتبية، وكان معجبا بخط الشيخ النعماني.
عندها أشار السيد الغروي على السيد الصدرة بأن خط الشيخ النعماني جيد، فأرسل السيد الصدرية وراء الشيخ إلى بيته لاختبار خطه، فأعطاه ورقة وقال له: أكتب، فكتب (بسم الله الرحمن الرحیم فلما رآه قال له زین.(همان، ص ۴۲۳)
حوالی شهر رمضان المبارک ۱۳۹۱ ارسل السید الصدر تلمیذه السید محمد علی الباقری الی لبنان من اجل متابعة طباعة کتاب الاسس المنطقیة للاستقراء فی دار الفکر(همان، ص ۴۳۴)
في شهر ذي القعدة - ذي الحجة ١٣٩١ هـ صدر كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وهو دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله تبارك وتعالى "، وقد اتخذ في هذا الكتاب من دراسة الدليل الاستقرائي ومعالجة مشكلة التعميمات الاستقرائية أساساً لمحاولة إعادة بناء نظرية المعرفة ودراسة نقاطها الأساسية في ضوء يختلف عما تعرض له في كتاب (فلسفتنا). وقد أمر السيد الصدرة بطباعة (١٠٠٠) نسخة منه فقط
وقد تولت طباعته (دار الفكر) في بيروت، وكان سعر النسخة الواحدة عشر ليرات لبنانية . وبعد أن اكتملت طباعته أرسلت خمس نسخ إلى السيد الصدر، فأهدى واحدة منها إلى السيد كاظم الحائري الذي ذكر أن عنوان الكتاب اشتمل في طبعته الأولى على خطأ مطبعي حيث جاء الأس المنطقية للاستقراء بدل (الأسس المنطقية للاستقراء)، فقام السيد الصدر بتصحيح ذلك في الطبعة اللاحقة .
ويبدو لي أن السيد الصدر اختار اسم الكتاب في وقت متأخر جداً، وكان حتى الآونة الأخيرة قبل طباعته يعبر عنه بكتاب (المنطق الذاتي). ومن البعيد أن يكون قد استفاد العنوان من كتاب ودولف كرتاب (الأسس المنطقية للاحتمال). (همان، ص ۴۳۶)
[24]امتیاز طبع اخیر کتاب الاسس المنطقیة للاستقراء به دست پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، این است که در آن مقایسهای تطبیقی بین دو کتاب فلسفتنا و الاسس صورت گرفته است:
ومن أهمّ ما قامت به اللجنة المذكورة في تحقيق هذا الكتاب المقارنة الدقيقة بين النظريّات الفلسفيّة التي تبنّاها المؤلّف قدس سره في هذا الكتاب، وبين ما انتهى إليه نظره بعد اثنتي عشرة سنة في كتابه القيّم «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» حيث إنّه قدس سره كان قد أ لّف كتاب «فلسفتنا» في ضوء الأفكار الفلسفيّة السائدة عند فلاسفة المسلمين والتي تعتمد في الغالب على منطق «أرسطو» والمذهب العقلي في نظريّة المعرفة، ولكنّه استطاع بعد ذلك أن يتوصّل إلى نظريّات فلسفيّة جديدة سواء في بحث نظريّة المعرفة أو في بحث فلسفة الوجود ممّا أثبت جلّها في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء»، ووضع بذلك الجذور الأوّليّة لفلسفة جديدة تختلف تماماً عن الفلسفة السائدة. ولهذا رأينا من المناسب جدّاً أن يشار في كتاب «فلسفتنا» إلى جميع النقاط التي تغيّر فيها رأي المؤلّف رحمه الله في كتابه الآخر بعد ردحٍ غير قصير من الزمان. وهذا ما صنعته لجنة التحقيق بقدر ما حالفها التوفيق والسداد من اللّٰه تبارك وتعالى.( موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۱۱)
موارد اختلاف ذکر شده در کتاب عبارتاند از :
الف) مبدأ و ریشه معارف بشری:
در فلسفتنا ریشه همه علوم به دو مبنای تجربهگرایی و عقل گرایی برمیگردد درحالیکه در الاسس سخن از ریشه سومی با عنوان المذهب الذاتی میرود که با هر دو مسیر سابق متفاوت است:
وفي هذه المسألة عدّة مذاهب فلسفية، نتناول بالدرس منها المذهب العقلي والمذهب التجريبي. فالأوّل هو المذهب الذي ترتكز عليه الفلسفة الإسلامية، وطريقة التفكير الإسلامي بصورة عامّة. والثاني هو الرأي السائد في عدّة مدارس للمادّية ومنها المدرسة الماركسية(موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۸۳)
در تعلیقه آمده است: «وقد توصّل المؤلّف قدس سره بعد تأليفه لهذا الكتاب إلى مذهب ثالث للمعرفة عرضه في كتابه القيّم «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» وسمّاه بالمذهب الذاتي للمعرفة تمييزاً له عن المذهبين الآخرين، وهذا المذهب يتّفق مع المذهب العقلي في الإيمان بوجود قضايا ومعارف يدركها الإنسان بصورة قبليّة ومستقلّة عن الحسّ والتجربة، وأنّ هذه القضايا تشكّل الأساس للمعرفة البشريّة، خلافاً للمذهب التجريبي الذي يؤمن بأنّ التجربة والخبرة الحسّيّة هي المصدر الوحيد للمعرفة، فلا توجد لدى الإنسان أيّ معرفة قبليّة بصورة مستقلّة عن الحسّ والتجربة، ففي هذه النقطة يتّفق المذهب الذاتي للمعرفة مع المذهب العقلي، ولكنّه يختلف معه اختلافاً أساسيّاً في تفسير نموّ المعرفة، بمعنى أنّ هذه المعارف القبليّة الأوّليّة كيف يمكن أن تنشأ منها معارف جديدة؟ فالمذهب العقلي لا يعترف عادةً إلّابطريقةٍ واحدة لنموّ المعرفة، وهي طريقة التوالد الموضوعي التي تعتمد على التلازم بين الواقع الموضوعي للمعارف القبليّة والواقع الموضوعي للمعرفة الجديدة، بينما يؤمن المذهب الذاتي بوجود طريقة اخرى أيضاً لنموّ المعرفة، وهي طريقة التوالد الذاتي التي تعني نشوء معرفةٍ من معارف اخرى قبليّة لا على أساس التلازم بين الواقع الموضوعي لتلك المعارف القبليّة والواقع الموضوعي للمعرفة الجديدة، بل على أساس التلازم بين ذات تلك المعارف القبليّة بوصفها اعتقادات ذهنيّة وذات المعرفة الجديدة بوصفها كذلك، من دون ضرورة التلازم بين الموضوعات الواقعيّة لتلك المعارف في خارج الذهن والموضوع الواقعي للمعرفة الجديدة في خارج الذهن أيضاً، ويعتقد هذا المذهب أنّ الجزء الأكبر من معارفنا يمكن تفسيره على هذا الأساس»(همان)
این عبارات از فلسفتنا نیز در همان فضای اولیه صادر شده است:« الحجر الأساسي للعلم هو: المعلومات العقلية الأوّلية »(همان، ص ۸۳)
المقياس الأوّل للتفكير البشري بصورة عامّة هو: المعارف العقلية الضرورية، فهي الركيزة الأساسية التي لا يستغنى عنها في كلّ مجال، ويجب أن تقاس صحّة كلّ فكرة وخطأها على ضوئها(همان، ص ۸۷)
وأمّا في ضوء المذهب العقلي والإيمان بمعارف قبلية، فالفلسفة ترتكز على قواعد أساسية ثابتة، وهي: تلك المعارف العقلية القبلية الثابتة بصورة مطلقة ومستقلّة عن التجربة(همان، ص ۱۲۰)
مردّ المعارف التصديقية جميعاً إلى معارف أساسية ضرورية، لا يمكن إثبات ضرورتها بدليل أو البرهنة على صحّتها، وإنّما يشعر العقل بضرورة التسليم بها والاعتقاد بصحّتها(همان، ص ۱۸۲)
وإنّما يجب علينا أن ننطلق من المذهب العقلي، لنشيد على أساسه المفهوم الواقعي للحسّ والتجربة، فنؤمن بوجود مبادئ تصديقية ضرورية في العقل، وعلى ضوء تلك المبادئ نثبت موضوعية أحاسيسنا وتجاربنا.(همان، ص ۱۹۰)
من غير الممكن إعطاء مفهوم صحيح للفلسفة الواقعية، والاعتقاد بواقعية الحسّ والتجربة إلّاعلى أساس المذهب العقلي القائل بوجود مبادئ عقلية ضرورية مستقلّة عن التجربة(همان، ص ۱۹۵)
ب) جایگاه قیاس و استقراء
در «فلسفتنا» مسیر صحیح استدلال از منظر رویکرد عقل گرایانه، مسیر قیاس است و رسیدن از کلی به جزئی در مقابل رویکرد استقرایی تجربه گرایان؛ این در حالی است که در «الاسس» جایگاه استقرا مستحکم می شود و از آن به عنوان یکی از طرق استدلال یاد می شود:
إنّ السير الفكري في رأي العقليين يتدرّج من القضايا العامّة إلى قضايا أخصّ منها، من الكلّيات إلى الجزئيات، وحتّى في المجال التجريبي الذي يبدو لأوّل وهلة أنّ الذهن ينتقل فيه من موضوعات تجريبية جزئية إلى قواعد وقوانين عامّة، يكون الانتقال والسير فيه من العامّ إلى الخاصّ(همان، ص ۸۷)
در تعلیقه کتاب آمده است:
هذا من جملة ما اختلف فيه رأي المؤلّف قدس سره بعد تأليفه لهذا الكتاب، حيث انتهى رحمه الله - في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة الذي طرحه في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» - إلى أنّ المجالات الفكريّة التي ينتقل فيها الذهن من استقراء الموضوعات الجزئيّة إلى قواعد وقوانين عامّة يكون السير الفكري فيها - حقّاً - من الخاصّ إلى العامّ، ولا حاجة فيها إلى ضمّ كبرى كليّة عقليّة مسبقة ليتحوّل السير الفكري فيها من العامّ إلى الخاصّ كما يدّعيه أصحاب المذهب العقلي للمعرفة.(همان)
عبارات دیگر فلسفتنا:
فبينما كان المذهب العقلي يؤمن بأنّ الفكر يسير - دائماً - من العامّ إلى الخاصّ، يقرّر التجريبيون أ نّه يسير من الخاصّ إلى العامّ(همان، ص ۹۰)
استنتاج نتيجة علمية من التجربة يتوقّف - دائماً - على الاستدلال القياسي، الذي يسير فيه الذهن البشري من العامّ إلى الخاصّ ومن الكلّي إلى الجزئي كما يرى المذهب العقلي تماماً(همان، ص ۹۸)
نستطيع أن نطمئنّ إلى إمكانات الفكر الإنساني، وقدرته على درس القضايا الفلسفية، وبحثها في ضوء تلك المعارف القبلية على طريقة القياس والهبوط من العامّ إلى الخاصّ(همان، ص ۱۱۴)
ج) اصل علیّت
در «فلسفتنا» اثبات علیّت از طریق تجربه به چالش کشیده می شود و به عقل و گزاره های بدیهی عقلی مانند «الاتّفاق لا یکون دائماً و لا اکثریّاً» استناد داده می شود، لکن در «الاسس» بسیاری از قضایای یقینیة مانند محسوسات و مجرّبات و متواترات و ... به تجربه و استقراء اما با مبنای متأخر شهید حل می شود:
وأمّا سببية إحدى الظاهرتين للاُخرى والضرورة القائمة بينهما فهي ممّا لا تكشفها وسائل التجربة مهما كانت دقيقة ومهما كرّرنا استعمالها (همان، ص ۹۴)
در تعلیقه آمده است:
وقد أكّد المؤلّف قدس سره في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» أنّ مبدأ العليّة وسائر قضايا السببيّة التي تتضمّن معنى الضرورة واستحالة الانفكاك وإن كانت لا تخضع لوسائل التجربة مهما كانت دقيقة، ولهذا يعجز المذهب التجريبي عن إثباتها، ولكن يمكن إثباتها بالاستقراء في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة، وهذا لا يعني رفض المصدر العقلي القبلي لهذه القضايا، بل يعني أ نّا حتّى لو استبعدنا العلم العقلي القبلي بهذه القضايا يظلّ بالإمكان إثباتها في عالم الطبيعة عن طريق الاستقراء، وهذا ما أشار إليه في مناقشته للاتّجاه الأوّل من اتّجاهات المذهب التجريبي في الكتاب المذكور، كما أ نّه مشمول أيضاً لما أكّد عليه - في القسم الرابع من نفس الكتاب - من إمكان الاستدلال استقرائيّاً على جميع القضايا الأوّليّة والفطريّة عدا ما استثناه، فراجع(همان)
دیگر عبارات در این زمینه:
أنّ مردّ المعارف التصديقية جميعاً إلى معارف أساسية ضرورية، لا يمكن إثبات ضرورتها بدليل أو البرهنة على صحّتها، وإنّما يشعر العقل بضرورة التسليم بها والاعتقاد بصحّتها، كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلّية والمبادئ الرياضية الأوّلية(همان، ص ۱۸۲)
ويتّضح لنا على ضوء ما سبق: أنّ استنتاج نتيجة علمية من التجربة يتوقّف - دائماً - على الاستدلال القياسي، الذي يسير فيه الذهن البشري من العامّ إلى الخاصّ ومن الكلّي إلى الجزئي كما يرى المذهب العقلي تماماً، فإنّ العالم تمّ له استنتاج النتيجة في المثال الذي ذكرناه بالسير من المبادئ الأوّلية الثلاثة التي عرضنا: (مبدأ العلّية) (مبدأ الانسجام) (مبدأ عدم التناقض)، إلى تلك النتيجة الخاصّة على طريقة القياس(همان، ص ۹۸)
ويستعين العالم الطبيعي في هذه المرحلة بمبدأ من المبادئ الضرورية العقلية، وهو المبدأ القائل: (باستحالة انفصال الشيء عن سببه)(همان، ص ۱۸۳)
إنّ من أوّليات ما يدركه البشر في حياته الاعتيادية، (مبدأ العلّية) القائل:إنّ لكلّ شيء سبباً. وهو من المبادئ العقلية الضرورية(همان، ص ۳۳۱)
والجواب الوحيد على هذا السؤال هو: مبدأ العلّية وقوانينها. فالعقل حيث إنّه لا يقبل الصدفة والاتّفاق، وإنّما يفسّر الكون بالعلّية وقوانينها من الحتمية والتناسب، يجد في التجارب المحدودة الكفاية للإيمان بالنظرية العامة القائلة بتمدّد الأجسام بالحرارة... . فمبدأ العلّية هو الأساس الأوّل لجميع العلوم والنظريات التجريبية(همان، ص ۳۳۷-۳۳۸)
در میان عبارات ذکر شده از کتاب فلسفتنا، این عبارت هم قابل توجه است؛ عبارتی که برای تجربه در کشف مسائل متافیزیکی جایگاه قائل میشود و محققین کتاب آن را بذری برای مطالب بعدی شهید معرّفی میکنند:
ثالثاً - في المجالات غير التجريبية - كما في مسائل الميتافيزيقا - ترتكز النظرية الفلسفية على تطبيق المبادئ الضرورية على تلك المجالات، ولكن هذا التطبيق قد يتمّ فيها بصورة مستقلّة عن التجربة: ففي مسألة إثبات العلّة الاُولى للعالم - مثلاً - يجب على العقل أن يقوم بمحاولة تطبيق مبادئه الضرورية على هذه المسألة؛ حتّى يضع بموجبها نظريّته الإيجابية أو السلبية، وما دامت المسألة ليست تجريبية فالتطبيق يحصل بعملية تفكير واستنباط عقلي بحت بصورة مستقلّة عن التجربة.وبهذا تختلف مسائل الميتافيزيقا عن العلم الطبيعي في كثير من مجالاتها.
ونقول (في كثير من مجالاتها)؛ لأنّ استنتاج النظرية الفلسفية أو الميتافيزيقية من المبادئ الضرورية في بعض الأحايين يتوقّف على التجربة أيضاً ، فيكون للنظرية الفلسفية - حينئذٍ - نفس ما للنظريات العلمية من قيمة ودرجة.(همان، ص ۱۸۲)
در تعلیقه آمده است:
الظاهر أنّ هذا الكلام يعبّر عن الجذور الأوّليّة التي نمت وترعرعت في ذهن السيّد المؤلّف رحمه الله بعد تأليفه لهذا الكتاب حتّى انتهت إلى القول بإمكان تفسير الجزء الأكبر من معارفنا - بما فيها القضايا الميتافيزيقيّة - بالطريقة الاستقرائيّة المتّبعة في القضايا الطبيعيّة، وهي طريقة التوالد الذاتي التي يؤمن بها المذهب الذاتي للمعرفة. وقد وضّح ذلك بالتفصيل في القسم الرابع من كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء»(همان)
برای مطالعه تفصیلی در اینباره به پیوست شماره ۱ مراجعه فرمایید.
[25] ولم يتعب على كتاب من كتبه كما تعب على كتاب (الأسس). هذا، وقد سأل السيد الغروي أستاذه السيد الصدر أثناء توجههما إلى الكوفة عن دواعي تأليف هذا الكتاب فأجابه: لكي أثبت للملحدين أنه إما عليهم الإيمان بالله تعالى والعلوم الطبيعية وإما رفض الاثنين معاً، وأقفلت في وجه الكافر باب الخضوع أمام العلم والتمرد على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقال أيضاً حول ذلك: إن مرحلة الاستيراد في العالم الإسلامي من الغرب يجب أن تنتهي وعلينا أن تصدر إبداعنا إلى الغرب . (السید محمد باقر الصدر السیرة و المسیرة، ج ۲، ص ۵۵-۵۸)
كان السيد الصدر يعتز كثيراً بهذا الكتاب من بين كتبه الأخرى ويراه معبراً عن مستواه العلمي والفكري وحصيلة لجهود علمية مكثفة، وكان يعبر عنه بـ ( حصيلة العمر)
…ويقول الدكتور زكي نجيب محمود في هذا الكتاب أرغب أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية لكي يطلع الإنجليز على فضائحهم ، إنه من الكتب التي ينبغي أن تترجم إلى اللغة الإنجليزية لتعرف أوروبا أن لدينا فلاسفة أصليين يملكون العمق الفلسفي والفكر المستقل. إن فلاسفة الإنجليز سيقرأون فكراً جديداً إذا أتيح لهم أن يقرأوا ترجمة الأسس المنطقية للاستقراء ، هو فكر جديد لم يسمع به الإنجليز من قبل.
ويقول فيه الدكتور زكريا إبراهيم: لو ترجم كتاب الأسس المنطقية للاستقراء الذي ألفه الشهيد إلى الإنجليزية وقرأه الإنجليز لما يقي منهم من يتجه اتجاهاً مادياً .
ويعتقد السيد عمار أبو رغيف أن هذا الكتاب قد نقلنا مع بعض وجوه مشكلات الاستقراء ونظرية الاحتمال ما يقرب من ثلاثة قرون، وأنه اختزل المسافات الزمنية التي تفصلنا عما عليه الوضع في غرب القارة في وجوه أخرى أكثر من قرن.
وقال فيه الشيخ محمد مهدي شمس الدين : هو كتاب أعتقد أنه لم يكتشف حتى الآن .
بينما يعتقد الدكتور شبلي الملاط أن السيد الصدر له قد تخوّض في مجال المنطق، ومن هنا كان (الأسس) أقل إنجازاته نجاحاً لأنه لم يكن مهياً على نحو جيد للخوض في مثل هذا الفرع الملغز من فروع المعرفة .
وعلى أية حال، فإن هذا الكتاب لم يأخذ موقعه الذي أراده له السيد الصدر داخل الحوزة حتى أنه قد بدا عليه الهم في إحدى المرات بعد الفراغ من درسه، فسأله السيد كمال الحيدري عن سبب حزنه، فأجابه : أشعر أن كتاب الأسس المنطقية للاستقراء سيضيع في الحوزة.
وفي مرة أخرى كان السيد الصدر متوجها بعد درس الأصول من مسجد الجواهري إلى مسجد الطوسي حيث أقيم مجلس فاتحة، وكان السيد كمال الحيدري يسير معه ويوجه إليه بعض الأسئلة حول كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، فقال له السيد الصدر بحسرة: لقد كتبت كتاب الأسس حتى يتدارسه الطلاب ولا ينهمكوا في دراسة الحاشية [حاشية الملا عبد الله ].(همان، ص ۴۳۸-۴۳۹)
[26]جلسه درس خارج فقه، بهجة الفقیه، تاریخ ١٩/ ١٠/ ١٣٩٠
[27] کلمات یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[28] فرمایش شهید صدر ره را می توان این گونه خلاصه کرد که ما با دو نوع یقین مواجهیم:
١.یقین در فضای منطق دو ارزشی یاارسطویی که در ادبیات شهید صدر با عنوان یقین منطقی یا ریاضی از آن یاد می شود و معنای آن علم به قضیه و علم به امتناع طرف مقابل آن است: اليقين المنطقي «أو الرياضي»، و هو المعنى الذي يقصده منطق البرهان الأرسطي بكلمة «اليقين»، و يعني اليقين المنطقي: العلم بقضية معينة، و العلم بأن من المستحيل أن لا تكون القضية بالشكل الذي علم. فاليقين المنطقي مركب من علمين، و ما لم ينضم العلم الثاني إلى العلم الأول لا يعتبر يقينا في منطق البرهان، فإذا فرضنا - مثلا - تلازما منطقيا بين قضيتين على أساس تضمن إحداهما للأخرى من قبيل «زيد انسان»، «زيد انسان عالم» فنحن نعلم بأن زيدا إذا كان إنسانا عالما فهو انسان، أي نعلم بأن القضية الثانية إذا كانت صادقة فالقضية الأولى صادقة، و هذا العلم يقين منطقي لأنه يستبطن العلم بأن من المستحيل أن لا يكون الأمر كذلك (الاسس المنطقیه للاستقراء،ص٣٢٢)
٢. یقین حساب احتمالاتی و در فضای منطق تشکیک که شهید صدر از آن با عنوان یقین موضوعی یاد می کنند. در این یقین، برخلاف مورد قبل با امتناع طرف مقابل مواجه نیستیم: و إذا درسنا الدليل الاستقرائي في ضوء ذلك كله نجد أن درجة التصديق للقضية الاستقرائية التي يحدّدها في مرحلته الاستنباطية: هي درجة موضوعية، لأنها مستنبطة دائما من درجات موضوعية أخرى للتصديق. غير أن هذه الدرجة هي أقل من اليقين دائما، لأن درجة التصديق بالقضية الاستقرائية المستنبطة من الدرجات الأخرى للتصديق وفق المرحلة الاستنباطية للدليل الاستقرائي لا يمكن أن تبلغ أعلى درجة للتصديق و هي الجزم و اليقين، لأن هناك قيمة احتمالية صغيرة دائما تمثل الخلاف، فلا يمكن - إذن - أن يحصل التصديق الاستقرائي على أعلى درجة بوصفها درجة موضوعية مستنبطة.(همان،٣٣١) .
تفکیک بین این دو نوع در مثال متواترات و اولیات به روشنی خود را نشان می دهد.مرحوم شهید صدر ابتدا کتاب فلسفتنا را نوشتند و در آن بحث تواتر را به همان مبنای ارسطو حل کردند با یک کلمه؛ اما بعد از 12 سال کتاب الاسس المنطقیه نوشتند و مفصل برسر این مسئله بحث کردند.(همان،٣٨٨)
تفاوت بین دو قسم یقین، تفاوت در برهان هر یک از دو قسم را نتیجه خواهد داد. در رابطه با این قسم از یقین و نحوه برهان بر آن به القسم الثالث و القسم الرابع از کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء مراجعه فرمایید.
جالب اینجاست که تطوّر فکری مرحوم شهید از تأمل بر مباحث قطع اصول و توجه به اشکالات امین الدین استرآبادی فراهم شده است:
و قد أشكل على هذا المقدار في كلمات المحدث الأسترآبادي بان علم المنطق انما يعصم من ناحية الصورة و كيفية الاستدلال لا المادة و القضايا التي تدخل في الأقيسة.
و أجيب عن هذا الإشكال: بان الخطأ لا بد و أن ينتهي إلى الصورة لا المادة بعد معرفة طريقة تولد المعارف البشرية- حسبما يصورها المنطق الصوري- حيث ان الفكر يسير دائما من معارف أولية ضرورية هي أساس المعرفة البشرية إلى استنباط معارف نظرية جديدة بطريقة البرهان و القياس التي يحدد صورتها علم المنطق، فأي خطأ يفترض ان كان في الصورة فعلم المنطق هو العاصم منه، و ان كان في مادة القياس فان كانت تلك المادة أولية فلا مجال لوقوع الخطأ فيها. و ان كانت ثانوية مستنتجة فلا محالة تكون مستنتجة من برهان و قياس فينقل الكلام إليه حتى ينتهي إلى خطأ يكون في الصورة لأن المعارف الأولية لا خطأ فيها بحسب الفرض لكونها ضرورية. و قد اصطلح على المعارف الأولية في الفكر البشري بمدركات العقل الأول و على المعارف المستنتجة منها بمدركات العقل الثاني. و نحن تارة نسلم بهذا التصنيف للمعارف البشرية و طريقة سير الفكر البشري فيها و أخرى لا نسلم به.
اما لو سلمنا بذلك فيمكن مع ذلك الانتصار للمحدثين في المقام بان قواعد علم المنطق اما أن تكون جميعها ضرورية كبرى و تطبيقا أو بعضها ليس ضروريا. اما الأول فواضح البطلان إذ لو كانت كذلك لما وقع خطأ خارجا إذ لا يوجد من يخالف البديهة و الضرورة و لا خطأ فيها بحسب فرض هذا المنهج. و على الثاني فان قيل بعدم البداهة في الكبريات فسوف يقع الخطأ في نفس العاصم لا محالة، و ان قيل بعدم البداهة في التطبيق احتجنا إلى عاصم في مرحلة التطبيق و لم تكف مراعاة الكبريات المنطقية في عصمة الذهن عن الخطأ و علم المنطق لا يعطي إلا الكبريات و هذا الكلام أفضل مما ذكره المحدث الأسترآبادي بناء على التصور المدرسي للمعرفة البشرية و طريقة التوالد فيها.
إلا ان هذا التصور أساسا غير صحيح على ما شرحناه مفصلا في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، فان هذا البحث كان منشأ لانتقالنا إلى نظرية جديدة للمعرفة البشرية استطاعت أن تملأ فراغا كبيرا في نظرية المعرفة البشرية لم يستطع الفكر الفلسفي أن يملأه خلال ألفين سنة.( بحوث في علم الأصول ؛ ج4 ؛ ص129-۱۳۰)
در نگاه ایشان یقین موجود درعمده مواد اقیسه مانند محسوسات، مجربات، متواترات و حدسیات از سنخ یقین حساب احتمالاتی است و این تنها اولیات و فطریات هستند که دارای یقین ریاضی میباشند:
الأولى- فيما يتعلق بالعقل الأول و مدركاته. و هي المدركات التي حددها المنطق الصوري في قضايا ست اعتبرتها مواد البرهان في كل معرفة بشرية و هي الأوليات و الفطريات و التجربيات و المتواترات و الحدسيات و الحسيات.
و قد ادعى المنطق الصوري ان هذه القضايا كلها بديهية و نحن نسلم معهم في اثنين منها هما الأوليات- كاستحالة اجتماع النقيضين- و الفطريات و هي التي قياساتها معها و لم نقل برجوعها إلى الأوليات على ما هو التحقيق- فهاتان قضيتان قبليتان و اما غيرهما أي القضايا الأربع الباقية فليست المعرفة البشرية فيها قبلية بل بعدية أي تثبت بحساب الاحتمالات و بالطريقة الاستقرائية التي يسير فيها الفكر من الخاص إلى العام حسب قوانين و أسس شرحناها مفصلا في ذلك الكتاب بعد إبطال ما حاوله المنطق الصوري من تطبيق قياس خفي فيها بمناقشات عديدة مشروحة في محلها.
و قد أثبتنا هنالك انه حتى المحسوسات التي هي أبده القضايا الأربعة الباقية تخضع للأسس المنطقية للدليل الاستقرائي( بحوث في علم الأصول ؛ ج4 ؛ ص130-۱۳۱)
مجربات :
« و تتميز القضية التجريبية عن القضايا النظرية الثانوية - رغم أنها جميعا مستدلة - بأن الاستدلال في القضية التجريبية احتمالي، فهي دائما مستنتجة بدرجة أقل من اليقين، فأي درجة من التصديق بالقضية التجريبية أقل من اليقين، بالامكان أن تكون مستنتجة. و أما درجة اليقين فهي ليست مستنتجة، كما عرفنا في دراستنا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي.
و على هذا الأساس يمكننا أن نعتبر القضية التجريبية ثانوية و مستدلة - وفقا للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي - ما دمنا نتكلم عن درجة من التصديق أقل من اليقين. و أما اليقين بالقضية التجريبية فهو ليس مستدلا و لا مستنتجا استدلالا و استنتاجا منطقيا من تصديقات سابقة، و إنما هو وليد تراكم الاحتمالات في محور واحد وفقا للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي، فهو تصديق أولي من الناحية المنطقية، و لكنه يتوقف في نفس الوقت على افتراض كل التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية المؤدية إلى تراكم الاحتمالات، و إن لم يكن مستنتجا منها منطقيا.»(الأسس المنطقیة للاستقراء، صفحه: ۳۸۶)
همچنین در مورد حدسیات:
« و رأينا في القضية الحدسية هو رأينا المتقدم في القضية التجريبية.فالقضية الحدسية قضية ثانوية مستدلة، و هي بكامل مدلولها مستنتجة من القضايا الجزئية التي تكوّن منها الاستقراء لصالح تلك القضية الحدسية، و لكن بدرجة من الاستنتاج و الاثبات أقل من اليقين، وفقا للمرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي.
و أما اليقين بالقضية الحدسية فهو ليس مستدلا، و لا مستنبطا من القضايا الجزئية التي كونت الاستقراء، و لا مستنتجا من قضية عقلية قبلية، كما زعم المنطق الأرسطي في أحد موقفيه. بل اليقين بالقضية الحدسية - كاليقين بالقضية التجريبية - درجة أولية من التصديق، بمعنى أننا لا يمكننا أن نبرهن على درجة اليقين بها بتصديقات سابقة، و لكننا في نفس الوقت لا يمكننا الحصول على هذا اليقين إلا نتيجة لتراكم الاحتمالات في محور واحد. و هذا التراكم يفترض كل التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي.
فاليقين بالقضايا الحدسية و التجريبية يتوقف - إذن - على افتراض تصديقات سابقة، و لكنه ليس مستنبطا منها. و على عكس ذلك درجات التصديق التي تقل عن اليقين، فإنها مستنبطة من تلك التصديقات التي تتطلبها المرحلة الاستنباطية للاستقراء.»(الأسس المنطقیة للاستقراء، صفحه: ۳۸۷)
متواترات:
« و هكذا نعرف أن القضية المتواترة قضية استقرائية مستدلة، بنفس الطريقة التي يعالج بها الدليل الاستقرائي أي قضية استقرائية أخرى عبر مرحلتين، على أساس حساب الاحتمال و تراكم القيم الاحتمالية في محور واحد.»(الأسس المنطقیة للاستقراء، صفحه: ۳۹۳)
محسوسات:
«و الحقيقة أن افتراض موضوعية الحادثة ليس افتراضا دون مبرّر كما تقول المثالية، و ليس أيضا افتراضا أوليا و معرفة أولية كما يقول المنطق الأرسطي، بل هو افتراض مستدل و مستنتج حسب مناهج الدليل الاستقرائي، كالقضايا التجريبية و الحدسية و المتواترة تماما. فالتصديق الموضوعي بالواقع يقوم على أساس تراكم القيم الاحتمالية في محور معين، وفقا للطريقة العامة التي فسرنا بها المرحلة الأولى الاستنباطية من الدليل الاستقرائي، و يتحول هذا التراكم إلى اليقين عند توفر الشروط اللازمة، وفقا للمرحلة الثانية الذاتية من الدليل الاستقرائي.(الأسس المنطقیة للاستقراء، صفحه: ۴۱۶)
[29] جلسه درس فقه العقود، تاریخ ٧/ ١٢/ ١٣٩٧
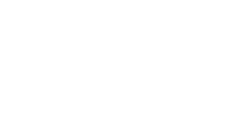
بدون نظر