پیوست شماره ۱: مقایسه تطبیقی دو کتاب «فلسفتنا» و «الاسس المنطقیة للاستقراء»
کلام لجنة التحقیق
ومن أهمّ ما قامت به اللجنة المذكورة في تحقيق هذا الكتاب المقارنة الدقيقة بين النظريّات الفلسفيّة التي تبنّاها المؤلّف قدس سره في هذا الكتاب، وبين ما انتهى إليه نظره بعد اثنتي عشرة سنة في كتابه القيّم «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» حيث إنّه قدس سره كان قد أ لّف كتاب «فلسفتنا» في ضوء الأفكار الفلسفيّة السائدة عند فلاسفة المسلمين والتي تعتمد في الغالب على منطق «أرسطو» والمذهب العقلي في نظريّة المعرفة، ولكنّه استطاع بعد ذلك أن يتوصّل إلى نظريّات فلسفيّة جديدة سواء في بحث نظريّة المعرفة أو في بحث فلسفة الوجود ممّا أثبت جلّها في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء»، ووضع بذلك الجذور الأوّليّة لفلسفة جديدة تختلف تماماً عن الفلسفة السائدة. ولهذا رأينا من المناسب جدّاً أن يشار في كتاب «فلسفتنا» إلى جميع النقاط التي تغيّر فيها رأي المؤلّف رحمه الله في كتابه الآخر بعد ردحٍ غير قصير من الزمان. وهذا ما صنعته لجنة التحقيق بقدر ما حالفها التوفيق والسداد من اللّٰه تبارك وتعالى. هذا.[1]
الف) اصل المعرفه التصدیقیه
والمشكلة التي تواجهنا هي مشكلة أصل المعرفة التصديقية والركائز الأساسية التي يقوم عليها صرح العلم الإنساني، فما هي الخيوط الأوّلية التي نسجت منها تلك المجموعة الكبيرة من الأحكام والعلوم؟ وما هو المبدأ الذي تنتهي إليه المعارف البشرية في التعليل، ويعتبر مقياساً أوّلياً عامّاً لتمييز الحقيقة عن غيرها؟
وفي هذه المسألة عدّة مذاهب فلسفية، نتناول بالدرس منها المذهب العقلي والمذهب التجريبي. فالأوّل هو المذهب الذي ترتكز عليه الفلسفة الإسلامية، وطريقة التفكير الإسلامي بصورة عامّة. والثاني هو الرأي السائد في عدّة مدارس للمادّية ومنها المدرسة الماركسية[2].[3]
فالمذهب العقلي يوضح أنّ الحجر الأساسي للعلم هو: المعلومات العقلية الأوّلية، وعلى ذلك الأساس تقوم البنيات الفوقية للفكر الإنساني التي تُسمَّى بالمعلومات الثانوية.[4]
وهناك شيء واحد يمكن أن تقوله الوضعية في هذا المجال، وهو: أنّ استنتاج المضمون الفكري للقضية الفلسفية من المعطيات الحسّية لا يقوم على أساس تجريبي، وإنّما يقوم على اسس عقلية، بمعنى: أنّ المعارف العقلية هي التي تحتّم تفسير المعطيات الحسّية بافتراض علّة اولى، لا أنّ التجربة تبرهن على استحالة وجود هذه المعطيات بدون العلّة الاُولى، وما لم تبرهن التجربة على ذلك لا يمكن أن تعتبر تلك المعطيات عطاءً للقضية الفلسفية ولو بصورة غير مباشرة.
وهذا القول ليس إلّاتكراراً من جديد للمذهب التجريبي، وما دمنا قد عرفنا سابقاً أنّ استنتاج المفاهيم العلمية العامّة من المعطيات الحسّية مدين لمعارف عقلية قبلية، فلا جناح على القضية الفلسفية إذا ارتبطت مع معطياتها الحسّية بروابط عقلية وفي ضوء معارف قبلية.[5]
وقد نشأ هذا من خطأ الماركسية في نظرية المعرفة وإيمانها بالتجربة وحدها. وأمّا في ضوء المذهب العقلي والإيمان بمعارف قبلية، فالفلسفة ترتكز على قواعد أساسية ثابتة، وهي: تلك المعارف العقلية القبلية الثابتة بصورة مطلقة ومستقلّة عن التجربة، ولأجل ذلك لا يكون من الحتم أن يتغيّر المحتوى الفلسفي باستمرار تبعاً للاكتشافات التجريبية.
ونحن لا نعني بذلك انقطاع الصلة بين الفلسفة والعلم، فإنّ الترابط بينهما وثيق؛ لأنّ العلم يقدّم في بعض الأحايين الحقائق الخاصّة إلى الفلسفة لتطبّق عليها مبادئها المطلقة، فتخرج بنتائج فلسفية جديدة[6] ، كما أنّ الفلسفة تنجد الاُسلوب التجريبي في العلوم بمبادئ وقواعد عقلية يستخدمها العالم في سبيل الارتقاء من التجارب المباشرة إلى قانون علمي عامّ[7]. فالعلاقة بين الفلسفة والعلم قويّة[8] ، غير أنّ الفلسفة بالرغم من ذلك قد لا تحتاج في بعض الأحيان إلى تجربة إطلاقاً، بل تستخلص النظرية الفلسفية من المعارف العقلية القبلية[9] ؛ ولأجل هذا قلنا: ليس من الحتم أن يتغيّر المحتوى الفلسفي باستمرار تبعاً للتجربة، ولا من الضروري أن يواكب [الركب[10]] الفلسفي قطار العلم في سيره المتدرّج.[11]
نظرية المعرفة في فلسفتنا
والآن نستطيع أن نستخلص - من دراسة المذاهب السابقة ونقدها - الخطوط العريضة لمذهبنا في الموضوع، وتتلخّص فيما يأتي:
الخطّ الأوّل - أنّ الإدراك البشري على قسمين: أحدهما التصوّر، والآخر التصديق. وليس للتصوّر بمختلف ألوانه قيمة موضوعية؛ لأنّه عبارة عن وجود الشيء في مداركنا، وهو لا يبرهن - إذا جرّد عن كلّ إضافة - على وجود الشيء موضوعياً خارج الإدراك، وإنّما الذي يملك خاصّة الكشف الذاتي عن الواقع الموضوعي هو التصديق أو المعرفة التصديقية. فالتصديق هو الذي يكشف عن وجود واقع موضوعي للتصوّر.
الخطّ الثاني - أنّ مردّ المعارف التصديقية جميعاً إلى معارف أساسية ضرورية، لا يمكن إثبات ضرورتها بدليل أو البرهنة على صحّتها، وإنّما يشعر العقل بضرورة التسليم بها والاعتقاد بصحّتها، كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلّية والمبادئ الرياضية الأوّلية[12] ، فهي الأضواء العقلية الاُولى، وعلى هدي تلك الأضواء يجب أن تقام سائر المعارف والتصديقات، وكلّما كان الفكر أدقّ في تطبيق تلك الأضواء وتسليطها، كان أبعد عن الخطأ. فقيمة المعرفة تتبع مقدار ارتكازها على تلك الاُسس ومدى استنباطها منها، ولذلك كان من الممكن استحصال معارف صحيحة في كلّ من الميتافيزيقا والرياضيات والطبيعيات على ضوء تلك الاُسس، وإن اختلفت الطبيعيات في شيء، وهو: أنّ الحصول على معارف طبيعية بتطبيق الاُسس الأوّلية يتوقّف على التجربة التيتهيّئ للإنسان شروط التطبيق، وأمّا الميتافيزيقا والرياضيات فالتطبيق فيها قد لا يحتاج إلى تجربة خارجية.
وهذا هو السبب في أنّ نتائج الميتافيزيقا والرياضيات نتائج قطعية في الغالب، دون النتائج العلمية في الطبيعيات؛ فإنّ تطبيق الاُسس الأوّلية في الطبيعيات لمّا كان محتاجاً إلى تجربة تهيّئ شروط التطبيق، وكانت التجربة في الغالب ناقصة وقاصرة عن كشف جميع الشروط، فلا تكون النتيجة القائمة على أساسها قطعية.[13]
وعلى هذا نعرف:
أوّلاً - أنّ المبادئ العقلية الضرورية هي الأساس العامّ لجميع الحقائق العلمية، كما سبق في الجزء الأوّل من المسألة.
ثانياً - أنّ قيمة النظريات والنتائج العلمية في المجالات التجريبية، موقوفة على مدى دقّتها في تطبيق تلك المبادئ الضرورية على مجموعة التجارب التي أمكن الحصول عليها. ولذا فلا يمكن إعطاء نظرية علمية بشكل قاطع إلّاإذا استوعبت التجربة كلّ إمكانيات المسألة، وبلغت إلى درجة من السعة والدقّة بحيث أمكن تطبيق المبادئ الضرورية عليها، وإقامة استنتاج علمي موحّد على أساس ذلك التطبيق.
ثالثاً - في المجالات غير التجريبية - كما في مسائل الميتافيزيقا - ترتكز النظرية الفلسفية على تطبيق المبادئ الضرورية على تلك المجالات، ولكن هذا التطبيق قد يتمّ فيها بصورة مستقلّة عن التجربة: ففي مسألة إثبات العلّة الاُولى للعالم - مثلاً - يجب على العقل أن يقوم بمحاولة تطبيق مبادئه الضرورية على هذه المسألة؛ حتّى يضع بموجبها نظريّته الإيجابية أو السلبية، وما دامت المسألة ليست تجريبية فالتطبيق يحصل بعملية تفكير واستنباط عقلي بحت بصورة مستقلّة عن التجربة.
وبهذا تختلف مسائل الميتافيزيقا عن العلم الطبيعي في كثير من مجالاتها.
ونقول (في كثير من مجالاتها)؛ لأنّ استنتاج النظرية الفلسفية أو الميتافيزيقية من المبادئ الضرورية في بعض الأحايين يتوقّف على التجربة أيضاً[14] ، فيكون للنظرية الفلسفية - حينئذٍ - نفس ما للنظريات العلمية من قيمة ودرجة.[15]
التجربة والمثالية:
قال أنجلز عن المثالية:
«إنّ أقوى تفنيد لهذا الوهم الفلسفي ولكلّ وهم فلسفي آخر هو: العمل والتجربة والصناعة بوجه خاصّ. فإذا استطعنا أن نبرهن على صحّة فهمنا لظاهرة طبيعية ما، بخلقنا هذه الظاهرة بأنفسنا، وإحداثنا لها بواسطة توفّر شروطها نفسها، وفوق ذلك إذا استطعنا استخدامها في تحقيق أغراضنا، كان في ذلك القضاء المبرم على مفهوم الشيء في ذاته العصيّ على الإدراك الذي أتى به (كانت)»[16].
وقال ماركس:
«إنّ مسألة معرفة ما إذا كان بوسع الفكر الإنساني أن ينتهي إلى حقيقة موضوعية، ليس بمسألة نظرية، بل إنّها مسألة عملية؛ ذلك أ نّه ينبغي للإنسان أن يقيم الدليل في مجال الممارسة على حقيقة فكره»[17].
وواضح من هذه النصوص: أنّ الماركسية تحاول أن تبرهن على الواقع الموضوعي بالتجربة، وتحلّ المشكلة الأساسية الكبرى في الفلسفة - مشكلة المثالية والواقعية - بالأساليب العلمية.
وهذا مظهر واحد من مظاهر عديدة وقع فيها الخلط بين الفلسفة والعلوم؛ فإنّ كثيراً من القضايا الفلسفية حاول بعضٌ دراستها بالأساليب العلمية، كما إنّ عدّة من قضايا العلم درسها بعض المفكّرين دراسة فلسفية، فوقع الخطأ في هذه وتلك.
والمشكلة التي يتصارع حولها المثاليون والواقعيون هي من تلك المشاكل التي لا يمكن اعتبار التجربة المرجع الأعلى فيها، ولا إعطاؤها الصفة العلمية؛ لأنّ المسألة التي يرتكز عليها البحث فيها هي مسألة وجود واقع موضوعي للحسّ التجريبي. فالمثالي يزعم أنّ الأشياء لا توجد إلّافي حسّنا وإدراكاتنا التجريبية، والواقعي يعتقد بوجود واقع خارجي مستقلّ للحسّ والتجربة.
ومن البديهي: أنّ هذه المسألة تضع الحسّ التجريبي بالذات موضع الامتحان والاختبار، فلايمكن أن يبرهن على موضوعية التجربة والحسّ بالتجربة والحسّ نفسهما، ولا الردّ على المثالية بها، مع أ نّها هي موضع النقاش والبحث بين الفريقين (المثاليين والواقعيين).
فكلّ مشكلة موضوعية إنّما يمكن اعتبارها علمية، وحلّها بأساليب العلم التجريبية، فيما إذا كان من المعترَف به سلفاً صدق التجربة العلمية وموضوعيّتها.
فمشكلة حجم القمر، أو بُعد الشمس عن الأرض، أو بنية الذرّة، أو تركيب النبات، أو عدد العناصر البسيطة، يمكن انتهاج الطرق العلمية في دراستها وحلّها. وأمّا إذا طُرِحت نفس التجربة على بساط البحث، وثار النقاش حول قيمتها الموضوعية، فلا موضع للاستدلال العلمي في هذا المجال على صدق التجربة وقيمتها الموضوعية بالتجربة نفسها.
فواقعية الحسّ والتجربة - إذن - هي الأساس الذي يتوقّف عليه كيان العلوم جميعاً، ولا تتمّ دراسة أو معالجة علمية إلّابناءً عليه، فيجب أن يعالج هذا الأساس معالجة فلسفية خالصة قبل الأخذ بأيّ حقيقة علمية.
وإذا درسنا المسألة دراسة فلسفية نجد أنّ الإحساس التجريبي لا يعدو أن يكون لوناً من ألوان التصوّر، فمجموعة التجارب مهما تنوّعت إنّما تموّن الإنسان بإدراكات حسّية متنوّعة. وقد مرّ بنا التحدّث عن الإحساسات في دراستنا للمثالية، وقلنا: إنّها ما دامت مجرّد تصوّرات فلا تبرهن على الواقع الموضوعي ودحض المفهوم المثالي.
وإنّما يجب علينا أن ننطلق من المذهب العقلي، لنشيد على أساسه المفهوم الواقعي للحسّ والتجربة، فنؤمن بوجود مبادئ تصديقية ضرورية في العقل، وعلى ضوء تلك المبادئ نثبت موضوعية أحاسيسنا وتجاربنا.
ولنأخذ لذلك مثالاً: مبدأ العلّية الذي هو من تلك المبادئ الضرورية، فإنّ هذا المبدأ يحكم بأنّ لكلّ حادثة سبباً خارجاً عنه، وعلى أساسه نتأكّد من وجود واقع موضوعي للإحساسات والمشاعر التي تحدث في نفوسنا؛ لأنّها بحاجة إلى سبب تنبثق عنه، وهذا السبب هو الواقع الموضوعي.
وهكذا نستطيع أن نبرهن على موضوعية الحسّ والتجربة بمبدأ العلّية.
فهل يمكن للماركسية أن تتّخذ هذا الاُسلوب؟ طبعاً لا؛ وذلك:
أوّلاً - لأنّها لا تؤمن بمبادئ ضرورية عقلية، فليس مبدأ العلّية في عرفها إلّا مبدأً تجريبياً تدلّ عليه التجربة، فلا يصحّ أن يعتبر أساساً لصدق التجربة وموضوعيتها.
وثانياً - أنّ الديالكتيك يفسِّر تطوّرات المادّة وحوادثها بالتناقضات المحتواة في داخلها. وليست الحوادث الطبيعية في تفسيره محتاجة إلى سبب خارجي، كما سندرس ذلك بكلّ تفصيل في المسألة الثانية. فإذا كان هذا التفسير الديالكتي كافياً لتبرير وجود الحوادث الطبيعية، فلماذا نذهب بعيداً؟! ولماذا نضطرّ إلى افتراض سبب خارجي وواقع موضوعي لكلّ ما يثور في نفوسنا من إدراك؟! بل يصبح من الجائز أن تقول المثالية في ظواهر الإدراك والحسّ ما قاله الديالكتيك عن الطبيعة تماماً، وتزعم أنّ هذه الظواهر في حدوثها وتعاقبها محكومة لقانون نقض النقض الذي يضع رصيد التغيّر والتطوّر في المحتوى الداخلي.
وبهذا نعرف أنّ الديالكتيك لا يحجبنا عن سبب خارج الطبيعة فحسب، بل يحجبنا بالتالي عن هذه الطبيعة بالذات، وعن كلّ شيء خارج دنيا الشعور والإدراك[18].
ولنعرض شيئاً من النصوص الماركسية التي حاولت معالجة المشكلة بما لا يتّفق مع طبيعتها وطابعها الفلسفي:
أ - قال (روجيه غارودي):
«تُعلّمنا العلوم أنّ الإنسان ظهر على وجه الأرض في زمن متأخّر جدّاً، وكذلك الفكر معه. ولكي نؤكّد أنّ الفكر كان موجوداً متقدّماً على الأرض (على المادّة)، يجب - إذن - التأكيد بأنّ هذا الفكر لم يكن فكر الإنسان. إنّ المثالية في جميع أشكالها لا تستطيع أن تنجو من اللاهوت»[19].
«لقد وجدت الأرض حتّى قبل كلّ كائن ذي حساسية، قبل كلّ كائن حيّ. وما كان لأيّة مادّة عضوية أن توجد على الكرة الأرضية في أوّل مراحل وجودها.
فالمادّة غير العضوية سبقت الحياة إذن، وكان على الحياة أن تنمو وتتطوّر خلال آلاف آلاف السنين قبل أن يظهر الإنسان ومعه المعرفة. العلوم تقودنا - إذن - إلى التأكيد بأنّ العالم قد وجد في حالات لم يكن فيها أيّ شكل من أشكال الحياة أو الحسّاسية ممكناً»[20].
هكذا يعتبر (روجيه) الحقيقة العلمية - القائلة بضرورة تقدّم نشأة المادّة غير العضوية على المادّة العضوية - دليلاً على وجود العالم الموضوعي؛ لأنّ المادّة العضوية ما دامت نتاجاً لتطوّر طويل ومرحلة متأخّرة من مراحل نموّ المادّة، فلا يمكن أن تكون المادّة مخلوقة للوعي البشري، الذي هو متأخّر بدوره عن وجود كائنات عضوية حيّة ذات جهاز عصبي ممركز، فكأ نّه افترض مقدّماً أنّ المثالية تسلّم بوجود المادّة العضوية، فشاد على ذلك استدلاله، ولكنّ هذا الافتراض لا مبرّر له؛ لأنّ المادّة بمختلف ألوانها وأقسامها - من العضوية وغيرها - ليست في المفهوم المثالي إلّاصوراً ذهنية، نخلقها في إدراكاتنا وتصوّراتنا. فالاستدلال الذي يقدّمه لنا (روجيه) ينطوي على مصادرة، وينطلق من نقطة لا تعترف بها المثالية.
ب - قال لينين:
«إذا أردنا طرح المسألة من وجهة النظر التي هي وحدها صحيحة - يعني من وجهة النظر الديالكتيكية المادّية - ينبغي أن نتساءل: هل الكهارب والأثير... موجودة خارج الذهن البشري، وهل لها حقيقة موضوعية أم لا؟ عن هذا السؤال ينبغي أن يجيب علماء التأريخ الطبيعي. وهم يجيبون دائماً ودون تردّد بالإيجاب؛ نظراً لأنّهم لا يتردّدون بالتسليم بوجود الطبيعة وجوداً سبق وجود الإنسان، ووجود المادّة العضوية»[21].
ونلاحظ في هذا النصّ نفس المصادرة التي استعملها (روجيه)، مع التشدّق بالعلم واعتباره الفاصل النهائي في المسألة. فما دام علم التأريخ الطبيعي قد أثبت وجود العالم قبل ظهور الشعور والإدراك، فما على المثاليين إلّاأن يركعوا أمام الحقائق العلمية ويأخذوا بها. ولكنّ علم التأريخ الطبيعي ما هو إلّالون من ألوان الإدراك البشري. والمثالية تنفي الواقع الموضوعي لكلّ إدراك مهما كان لونه، فليس العلم في مفهومها إلّافكراً ذاتياً خالصاً، أفليس العلم حصيلة التجارب المتنوّعة؟! أوَ ليست هذه التجارب والإحساسات التجريبية هي موضع النقاش الدائر حول ما إذا كانت تملك واقعاً موضوعياً أو لا؟! فكيف يكون للعلم كلمته الفاصلة في الموضوع؟!
ج - قال جورج بوليتزير:
«ليس هناك مَن يشكّ في أنّ الحياة المادّية للمجتمع توجد مستقلّة عن وعي الناس؛ إذ ليس ثمّة من يتمنّى الأزمة الاقتصادية، سواءٌ كان رأسمالياً أو بروليتارياً، رغم أنّ هذه الأزمة تحدث حتماً»[22].
وهذا لون جديد يتّخذه الماركسيون للردّ على المثالية، ف (جورج) لا يستند في هذا النصّ إلى حقائق علمية، وإنّما يركّز استدلاله على حقائق وجدانية، نظراً إلى أنّ كلّ واحد منّا يشعر بوجدانه أ نّه لا يتمنّى كثيراً من الحوادث التي تحدث، ولا يرغب في وجودها، ومع ذلك هي تحدث وتوجد خلافاً لرغبته، فلا بدّ - إذن - أن يكون للحوادث وتسلسلها المطّرد واقع موضوعي مستقلّ.
وليست هذه المحاولة الجديدة بأدنى إلى التوفيق من المحاولات السابقة؛ لأنّ المفهوم المثالي - الذي ترجع فيه الأشياء جميعاً إلى مشاعر وإدراكات - لا يزعم أنّ هذه المشاعر والإدراكات تنبثق عن اختيار الناس وإراداتهم المطلقة، ولا تتحكّم فيها قوانين ومبادئ عامّة، بل المثالية والواقعية متّفقتان على أنّ العالم يسير طبقاً لقوانين ومبادئ تجري عليه وتتحكّم فيه، وإنّما يختلفان في تفسير هذا العالم واعتباره ذاتياً موضوعياً.
والنتيجة التي نؤكّد عليها مرّة اخرى هي: أنّ من غير الممكن إعطاء مفهوم صحيح للفلسفة الواقعية، والاعتقاد بواقعية الحسّ والتجربة إلّاعلى أساس المذهب العقلي القائل بوجود مبادئ عقلية ضرورية مستقلّة عن التجربة. وأمّا إذا بدأنا البحث في مسألة المثالية والواقعية من التجربة أو الحسّ - اللذين هما مورد النزاع الفلسفي بين المثاليين والواقعيين -، فسوف ندور في حلقة مفرغة، ولا يمكن أن نخرج منها بنتيجة في صالح الواقعية الفلسفية[23].[24]
ب) دور القیاس و الاستقراء
وهذه العلل الاُولى للمعرفة على نحوين: أحدهما ما كان شرطاً أساسياً لكلّ معرفة إنسانية بصورة عامّة. والآخر ما كان سبباً لقسم من المعلومات.
والأوّل هو: مبدأ عدم التناقض، فإنّ هذا المبدأ لازم لكلّ معرفة، وبدونه لا يمكن التأكّد من أنّ قضية مّا ليست كاذبة مهما أقمنا من الأدلّة على صدقها وصحّتها؛ لأنّ التناقض إذا كان جائزاً فمن المحتمل أن تكون القضية كاذبة في نفس الوقت الذي نبرهن فيه على صدقها، ومعنى ذلك: أنّ سقوط مبدأ التناقض يعصف بجميع قضايا الفلسفة والعلوم على اختلاف ألوانها. والنحو الثاني من المعارف الأوّلية هو: سائر المعارف الضرورية الاُخرى التي تكون كلّ واحدة منها سبباً لطائفة من المعلومات.
وبناءً على المذهب العقلي يترتّب ما يأتي:
أوّلاً - أنّ المقياس الأوّل للتفكير البشري بصورة عامّة هو: المعارف العقلية الضرورية، فهي الركيزة الأساسية التي لا يستغنى عنها في كلّ مجال، ويجب أن تقاس صحّة كلّ فكرة وخطأها على ضوئها. ويصبح بموجب ذلك ميدان المعرفة البشرية أوسع من حدود الحسّ والتجربة؛ لأنّه يجهِّز الفكر البشري بطاقات تتناول ما وراء المادّة من حقائق وقضايا، ويحقّق للميتافيزيقا والفلسفة العالية إمكان المعرفة. وعلى عكس ذلك المذهب التجريبي؛ فإنّه يبعد مسائل الميتافيزيقا عن مجال البحث، لأنّها مسائل لا تخضع للتجربة، ولا يمتدّ إليها الحسّ العلمي، فلا يمكن التأكّد فيها من نفي أو إثبات ما دامت التجربة هي المقياس الأساسي الوحيد، كما يزعم المذهب التجريبي.
وثانياً - إنّ السير الفكري في رأي العقليين يتدرّج من القضايا العامّة إلى قضايا أخصّ منها، من الكلّيات إلى الجزئيات، وحتّى في المجال التجريبي الذي يبدو لأوّل وهلة أنّ الذهن ينتقل فيه من موضوعات تجريبية جزئية إلى قواعد وقوانين عامّة، يكون الانتقال والسير فيه من العامّ إلى الخاصّ[25] ، كما سنوضّح ذلك عند الردّ على المذهب التجريبي.[26]
وثانياً: انطلاق السير الفكري للذهن البشري بصورة معاكسة لما يعتقده المذهب العقلي، فبينما كان المذهب العقلي يؤمن بأنّ الفكر يسير - دائماً - من العامّ إلى الخاصّ، يقرّر التجريبيون أ نّه يسير من الخاصّ إلى العامّ، ومن حدود التجربة الضيّقة إلى القوانين والقواعد الكلّية، ويترقّىٰ - دائماً - من الحقيقة الجزئية التجريبية إلى المطلق، وليس ما يملكه الإنسان من قوانين عامّة وقواعد كلّية إلّا حصيلة التجارب، ونتيجة هذا، الارتقاء من استقراء الجزئيات إلى الكشف عن حقائق موضوعية عامّة.
ولأجل ذلك يعتمد المذهب التجريبي على الطريقة الاستقرائية في الاستدلال والتفكير؛ لأنّها طريقة الصعود من الجزئي إلى الكلّي، ويرفض مبدأ الاستدلال القياسي الذي يسير فيه الفكر من العامّ إلى الخاصّ، كما في الشكل الآتي من القياس: (كلّ إنسان فانٍ، ومحمّد إنسان)، ف (محمّد فانٍ). ويستند هذا الرفض إلى أنّ هذا الشكل من الاستدلال لا يؤدّي إلى معرفة جديدة في النتيجة، مع أنّ أحد شروط الاستدلال هو: أن يؤدّي إلى نتيجة جديدة ليست محتواة في المقدّمات، وإذن فالقياس بصورته المذكورة يقع في مغالطة (المصادرة على المطلوب)؛ لأنّنا إذا ما قبلنا المقدّمة (كلّ إنسان فانٍ) فإنّا ندخل في الموضوع (إنسان) كلّ أفراد الناس، وبعدئذٍ إذا ما عقّبنا عليها بمقدّمة ثانية (بأنّ محمّداً إنسان) فإمّا أن نكون على وعي بأنّ محمّداً كان فرداً من أفراد الناس الذين قصدنا إليهم في المقدّمة الاُولى، وبذلك نكون على وعي كذلك بأ نّه (فانٍ) قبل أن ننصّ على هذه الحقيقة في المقدّمة الثانية، وإمّا أن لا نكون على وعي بذلك، فنكون في المقدّمة الاُولى قد عمّمنا بغير حقّ؛ لأنّا لم نكن نعلم الفناء عن كلّ أفراد الناس كما زعمنا.[27]
ولنأخذ الصفة الاُولى، وهي: أنّ القضية الفلسفية لا يمكن إثباتها، فإنّها تكرار لما يردّده أنصار المذهب التجريبي عموماً؛ فإنّهم يؤمنون بأنّ التجربة هي المصدر الأساسي والأداة العليا للمعرفة، وهي لا تستطيع أن تمارس عملها على المسرح الفلسفي؛ لأنّ موضوعات الفلسفة ميتافيزيقية لا تخضع لأيّ لون علمي من ألوان التجربة.
ونحن إذا رفضنا المذهب التجريبي وأثبتنا وجود معارف قبلية في صميم العقل البشري يرتكز عليها الكيان العلمي في مختلف حقول التجربة، نستطيع أن نطمئنّ إلى إمكانات الفكر الإنساني، وقدرته على درس القضايا الفلسفية، وبحثها في ضوء تلك المعارف القبلية على طريقة القياس والهبوط من العامّ إلى الخاصّ[28].[29]
ج) اثبات مبدأ العلیه
الرابع: أنّ مبدأ العلّية لا يمكن إثباته عن طريق المذهب التجريبي، فكما أنّ النظرية الحسّية كانت عاجزة عن إعطاء تعليل صحيح للعلّية كفكرة تصوّرية، كذلك المذهب التجريبي يعجز عن البرهنة عليها بصفتها مبدأ وفكرة تصديقية؛ فإنّ التجربة لا يمكنها أن توضّح لنا إلّاالتعاقب بين ظواهر معيّنة، فنعرف عن طريقها أنّ الماء يغلي إذا صار حارّاً بدرجة مئة، وأ نّه يتجمّد حين تنخفض درجة حرارته إلى الصفر، وأمّا سببية إحدى الظاهرتين للاُخرى والضرورة القائمة بينهما فهي ممّا لا تكشفها وسائل التجربة مهما كانت دقيقة ومهما كرّرنا استعمالها[30]. وإذا انهار مبدأ العلّية انهارت جميع العلوم الطبيعية كما ستعرف.[31]
وبهذا يتّضح: أنّ جميع النظريات التجريبية في العلوم الطبيعية ترتكز على عدّة معارف عقلية لا تخضع للتجربة، بل يؤمن العقل بها إيماناً مباشراً، وهي:
أوّلاً - مبدأ العلّية بمعنى: امتناع الصدفة؛ ذلك أنّ الصدفة لو كانت جائزة لما أمكن للعالم الطبيعي أن يصل إلى تعليل مشترك للظواهر المتعدّدة التي ظهرت في تجاربه.
ثانياً - مبدأ الانسجام بين العلّة والمعلول الذي يقرّر أنّ الاُمور المتماثلة في الحقيقة لا بدّ أن تكون مستندة إلى علّة مشتركة.
ثالثاً - مبدأ عدم التناقض الحاكم باستحالة صدق النفي والإثبات معاً.
فإذا آمن العالم بهذه المعارف السابقة على التجربة ثمّ أجرى تجاربه المختلفة على أنواع الحرارة وأقسامها، استطاع أن يقرّر في نهاية المطاف نظرية في تعليل الحرارة بمختلف أنواعها بعلّة واحدة كالحركة مثلاً. وهذه النظرية لا يمكن في الغالب تقريرها بشكل حاسم وصورة قطعيّة؛ لأنّها إنّما تكون كذلك إذا أمكن التأكّد من عدم إمكان وجود تفسير آخر لتلك الظواهر، وعدم صحّة تعليلها بعلّة اخرى، وهذا ما لا تحقّقه التجربة في أغلب الأحيان، ولهذا تكون نتائج العلوم الطبيعية ظنّية في أكثر الأحايين؛ لأجل نقص في نفس التجربة، وعدم استكمال الشرائط التي تجعل منها تجربة حاسمة.
ويتّضح لنا على ضوء ما سبق: أنّ استنتاج نتيجة علمية من التجربة يتوقّف - دائماً - على الاستدلال القياسي، الذي يسير فيه الذهن البشري من العامّ إلى الخاصّ ومن الكلّي إلى الجزئي كما يرى المذهب العقلي تماماً، فإنّ العالم تمّ له استنتاج النتيجة في المثال الذي ذكرناه بالسير من المبادئ الأوّلية الثلاثة التي عرضنا: (مبدأ العلّية) (مبدأ الانسجام) (مبدأ عدم التناقض)، إلى تلك النتيجة الخاصّة على طريقة القياس[32].[33]
ولنأخذ لذلك مثالاً من الحرارة: فلو أردنا أن نستكشف السبب الطبيعي للحرارة، وقمنا بدراسة عدّة تجارب علمية، ووضعنا في نهاية المطاف النظرية القائلة: (إنّ الحركة سبب الحرارة)، فهذه النظرية الطبيعية في الحقيقة نتيجة تطبيق لعدّة مبادئ ومعارف ضرورية على التجارب التي جمعناها ودرسناها، ولذا فهي صحيحة ومضمونة الصحّة بمقدار ما ترتكز على تلك المبادئ الضرورية. فالعالم الطبيعي يجمع أوّل الأمر كلّ مظاهر الحرارة التي هي موضوع البحث، كدم بعض الحيوانات والحديد المحمى والأجسام المحترقة وغير ذلك من آلاف الأشياء الحارّة، ويبدأ بتطبيق مبدأ عقلي ضروري عليها وهو مبدأ العلّية القائل: (إنّ لكلّ حادثة سبباً)، فيعرف بذلك أنّ لهذه المظاهر من الحرارة سبباً معيّناً، ولكن هذا السبب لحدّ الآن مجهول ومردّد بين طائفة من الأشياء، فكيف يتاح تعيينه من بينها؟
ويستعين العالم الطبيعي في هذه المرحلة بمبدأ من المبادئ الضرورية العقلية، وهو المبدأ القائل: (باستحالة انفصال الشيء عن سببه)، ويدرس على ضوء هذا المبدأ تلك الطائفة من الأشياء التي يوجد بينها السبب الحقيقي للحرارة، فيستبعد عدّة من الأشياء ويسقطها من الحساب، كدم الحيوان مثلاً، فهو لا يمكن أن يكون سبباً للحرارة؛ لأنّ هناك من الحيوانات ما دماؤها باردة، فلو كان هو السبب للحرارة لما أمكن أن تنفصل عنه ويكون بارداً في بعض الحيوانات.
ومن الواضح: أنّ استبعاد دم الحيوان عن السببية لم يكن إلّاتطبيقاً للمبدأ الآنف الذكر الحاكم بأنّ الشيء لا ينفصل عن سببه، وهكذا يدرس كلّ شيء ممّا كان يظنّه من أسباب الحرارة، فيبرهن على عدم كونه سبباً بحكم مبدأ عقلي ضروري. فإن أمكنه أن يستوعب بتجاربه العلمية جميع ما يحتمل أن يكون سبباً للحرارة، ويدلّل على عدم كونه سبباً - كما فعل في دم الحيوان -، فسوف يصل في نهاية التحليل العلمي إلى السبب الحقيقي - حتماً - بعد إسقاط الأشياء الاُخرى من الحساب، وتصبح النتيجة العلمية - حينئذٍ - حقيقة قاطعة؛ لارتكازها بصورة كاملة على المبادئ العقلية الضرورية، وأمّا إذا بقي في نهاية الحساب شيئان أو أكثر ولم يستطع أن يعيّن السبب على ضوء المبادئ الضرورية، فسوف تكون النظرية العلمية في هذا المجال ظنّية[34].[35]
مبدأ العلّيّة
القضايا المبتنية على مبدأ العلّيّة.
لماذا تحتاج الأشياء إلى علّة؟
التعاصر بين العلّة والمعلول.
إنّ من أوّليات ما يدركه البشر في حياته الاعتيادية، (مبدأ العلّية) القائل:إنّ لكلّ شيء سبباً. وهو من المبادئ العقلية الضرورية[36] ؛ لأنّ الإنسان يجد في صميم طبيعته الباعث الذي يبعثه إلى محاولة تعليل ما يجد من أشياء، وتبرير وجودها باستكشاف أسبابها. وهذا الباعث موجود بصورة فطرية في الطبيعة الإنسانية، بل قد يوجد عند عدّة أنواع من الحيوان أيضاً. فهو يلتفت إلى مصدر الحركة غريزياً؛ ليعرف سببها، ويفحص عن منشأ الصوت؛ ليدرك علّته. وهكذا يواجه الإنسان - دائماً - سؤال: لماذا...؟ مقابل كلّ وجود وظاهرة يحسّ بهما، حتّى إنّه إذا لم يجد سبباً معيّناً، اعتقد بوجود سبب مجهول انبثق عنه الحادث.[37]
[٢ -] العلّية والنظريات العلمية:
إنّ النظريات العلمية في مختلف ميادين التجربة والمشاهدة، تتوقّف بصورة عامّة على مبدأ العلّية وقوانينها توقّفاً أساسياً. وإذا سقطت العلّية ونظامها الخاصّ من حساب الكون، يصبح من المتعذّر تماماً تكوين نظرية علمية في أيّ حقل من الحقول. وليتّضح هذا نجد من الضروري أن نشير إلى عدّة قوانين من المجموعة الفلسفية للعلّية التي يرتكز عليها العلم، وهي كما يلي:
أ - مبدأ العلّية القائل: إنّ لكلّ حادثة سبباً.
ب - قانون الحتمية القائل: إنّ كلّ سبب يولّد النتيجة الطبيعية له بصورة ضرورية، ولا يمكن للنتائج أن تنفصل عن أسبابها.
ج - قانون التناسب بين الأسباب والنتائج، القائل: إنّ كلّ مجموعة متّفقة في حقيقتها من مجاميع الطبيعة، يلزم أن تتّفق - أيضاً - في الأسباب والنتائج.
فعلى ضوء مبدأ العلّية نعرف - مثلاً - أنّ الإشعاع الذي ينبثق عن ذرّة الراديوم له سبب، وهو: الانقسام الداخلي في محتوى الذرّة. وعلى ضوء قانون الحتمية، نستكشف أنّ هذا الانقسام عند استكمال الشروط اللازمة، يولّد الإشعاع الخاصّ بصورة حتمية، وليس من الممكن الفصل بينهما. وعلى أساس قانون التناسب نستطيع أن نعمّم ظاهرة الإشعاع، وتفسيرها الخاصّ لجميع ذرّات الراديوم، فنقول: ما دامت جميع ذرّات هذا العنصر متّفقة في الحقيقة، فيجب أن تتّفق في أسبابها ونتائجها، فإذا كشفت التجربة العلمية عن إشعاع في بعض ذرّات الراديوم، أمكن القول باعتباره ظاهرة عامة لسائر الذرّات المماثلة في الظروف المشخّصة الواحدة.
ومن الواضح: أنّ القانونين الأخيرين: الحتمية والتناسب، منبثقان عن مبدأ العلّية، فلو لم تكن في الكون علّية بين بعض الأشياء وبعض، وكانت الأشياء تحدث صدفة واتّفاقاً، لم يكن من الحتمي أن يوجد الإشعاع بدرجة معيّنة حين تكون هناك ذرّة راديوم، ولم يكن من الضروري - أيضاً - أن تشترك جميع ذرّات العنصر في ظواهر إشعاعية معيّنة، بل يصبح من الجائز أن يكون الإشعاع في ذرّة دون اخرى، لا لشيء إلّاللصدفة والاتّفاق، ما دام مبدأ العلّية خارجاً عن حساب الكون. فمردّ الحتمية والتناسب معاً إلى مبدأ العلّية.
ولنعد الآن - بعد أن عرفنا الفقرات الرئيسية الثلاث: العلّية، والحتمية، والتناسب - إلى العلوم والنظريات العلمية، فإنّنا سوف نجد بكلّ وضوح: أنّ جميع النظريات والقوانين التي تزخر بها العلوم، مرتكزة في الحقيقة على اساس تلك الفقرات الرئيسية، وقائمة على مبدأ العلّية وقوانينها. فلو لم يؤخذ هذا المبدأ كحقيقة فلسفية ثابتة، لما أمكن أن تقام نظرية، ويشاد قانون علمي له صفة العموم والشمول؛ ذلك أنّ التجربة التي يقوم بها العالم الطبيعي في مختبره، لا يمكن أن تستوعب جميع جزئيات الطبيعة، وإنّما تتناول عدّة جزئيات محدودة متّفقة في حقيقتها، فتكشف عن اشتراكها في ظاهرة معيّنة، وحيث يتأكّد العالم من صحّة التجربة ودقّتها وموضوعيتها، يضع فوراً نظريته أو قانونه العام الشامل لجميع ما يماثل موضوع تجربته من أجزاء الطبيعة. وهذا التعميم الذي هو شرط أساسي لإقامة علم طبيعي، لا مبرّر له إلّاقوانين العلّية بصورة عامّة، وقانون التناسب منها بصورة خاصّة، القائل: إنّ كلّ مجموعة متّفقة في حقيقتها، يجب أن تتّفق - أيضاً - في العلل والآثار، فلو لم تكن في الكون علل وآثار، وكانت الأشياء تجري على حسب الاتّفاق البحت، لما أمكن للعالم الطبيعي القول: إنّ ما صحّ في مختبره الخاصّ، يصحّ على كلّ جزء من الطبيعة على الإطلاق.
ولنأخذ لذلك مثالاً بسيطاً، مثال العالم الطبيعي الذي أثبت بالتجربة أنّ الأجسام تتمدّد حال حرارتها، فإنّه لم يحط بتجاربه جميع الأجسام التي يحتويها الكون طبعاً، وإنّما أجرى تجاربه على عدّة أجسام متنوّعة، كعجلات العربة الخشبية التي توضع عليها إطارات حديدية أصغر منها، حال سخونتها، فتنكمش الإطارات إذا بردت وتشتدّ على الخشب، ولنفرض أ نّه كرّر التجربة عدّة مرّات على أجسام اخرى، فلن ينجو في نهاية المطاف التجريبي عن مواجهة هذا السؤال: ما دمتَ لم تستقصِ جميع الجزئيات، فكيف يمكنك أن تؤمن بأنّ إطارات جديدة اخرى غير التي جرّبتها، تتمدّد هي الاُخرى - أيضاً - بالحرارة.
والجواب الوحيد على هذا السؤال هو: مبدأ العلّية وقوانينها. فالعقل حيث إنّه لا يقبل الصدفة والاتّفاق، وإنّما يفسّر الكون بالعلّية وقوانينها من الحتمية والتناسب، يجد في التجارب المحدودة الكفاية للإيمان بالنظرية العامة القائلة بتمدّد الأجسام بالحرارة؛ لأنّ هذا التمدّد الذي كشفت عنه التجربة لم يكن صدفة، وإنّما كان حصيلة الحرارة ومعلولاً لها، وحيث أنّ قانون التناسب في العلّية ينصّ على أنّ المجموعة الواحدة من الطبيعة تتّفق في أسبابها ونتائجها وعللها وآثارها، فلا غرو أن تحصل كلّ المبرّرات - حينئذٍ - للتأكيد على شمول ظاهرة التمدّد لسائر الأجسام.
وهكذا نعرف أنّ وضع النظرية العامّة لم يكن ميسوراً دون الانطلاق من مبدأ العلّية. فمبدأ العلّية هو الأساس الأوّل لجميع العلوم والنظريات التجريبية[38].
وبتلخيص: أنّ النظريات التجريبية لا تكتسب صفة علمية ما لم تعمّم لمجالات أوسع من حدود التجربة الخاصّة، وتقدّم كحقيقة عامّة. ولا يمكن تقديمها كذلك إلّاعلى ضوء مبدأ العلّية وقوانينها، فلا بدّ للعلوم عامّة أن تعتبر مبدأ العلّية وما إليها من قانوني الحتمية والتناسب، مسلّمات أساسية، وتسلم بها بصورة سابقة على جميع نظريّاتها وقوانينها التجريبية.[39]
[1] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۱۱، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[2] وقد توصّل المؤلّف قدس سره بعد تأليفه لهذا الكتاب إلى مذهب ثالث للمعرفة عرضه في كتابه القيّم «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» وسمّاه بالمذهب الذاتي للمعرفة تمييزاً له عن المذهبين الآخرين، وهذا المذهب يتّفق مع المذهب العقلي في الإيمان بوجود قضايا ومعارف يدركها الإنسان بصورة قبليّة ومستقلّة عن الحسّ والتجربة، وأنّ هذه القضايا تشكّل الأساس للمعرفة البشريّة، خلافاً للمذهب التجريبي الذي يؤمن بأنّ التجربة والخبرة الحسّيّة هي المصدر الوحيد للمعرفة، فلا توجد لدى الإنسان أيّ معرفة قبليّة بصورة مستقلّة عن الحسّ والتجربة، ففي هذه النقطة يتّفق المذهب الذاتي للمعرفة مع المذهب العقلي، ولكنّه يختلف معه اختلافاً أساسيّاً في تفسير نموّ المعرفة، بمعنى أنّ هذه المعارف القبليّة الأوّليّة كيف يمكن أن تنشأ منها معارف جديدة؟ فالمذهب العقلي لا يعترف عادةً إلّابطريقةٍ واحدة لنموّ المعرفة، وهي طريقة التوالد الموضوعي التي تعتمد على التلازم بين الواقع الموضوعي للمعارف القبليّة والواقع الموضوعي للمعرفة الجديدة، بينما يؤمن المذهب الذاتي بوجود طريقة اخرى أيضاً لنموّ المعرفة، وهي طريقة التوالد الذاتي التي تعني نشوء معرفةٍ من معارف اخرى قبليّة لا على أساس التلازم بين الواقع الموضوعي لتلك المعارف القبليّة والواقع الموضوعي للمعرفة الجديدة، بل على أساس التلازم بين ذات تلك المعارف القبليّة بوصفها اعتقادات ذهنيّة وذات المعرفة الجديدة بوصفها كذلك، من دون ضرورة التلازم بين الموضوعات الواقعيّة لتلك المعارف في خارج الذهن والموضوع الواقعي للمعرفة الجديدة في خارج الذهن أيضاً، ويعتقد هذا المذهب أنّ الجزء الأكبر من معارفنا يمكن تفسيره على هذا الأساس. (لجنة التحقيق)
[3] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۸۳، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[4] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۸۵، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[5] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۱۱۵، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[6] ومثال ذلك: أنّ العلوم الطبيعية تبرهن على إمكان تحويل العناصر البسيطة بعضها إلى بعض. فهذه حقيقة علمية تتناولها الفلسفة كمادّة لبحثها، وتطبّق عليها القانون العقلي القائل: بأنّ الوصف الذاتي لا يتخلّف عن الشيء، فنستنتج: أنّ صورة العنصر البسيط كالصورة الذهبية ليست ذاتية لمادّة الذهب، وإلّا لما زالت عنها، وإنّما هي صفة عارضة. ثمّ تمضي الفلسفة أكثر من ذلك، فتطبّق القانون القائل: إنّ لكلّ صفة عارضة علّة خارجية، فتصل إلى هذه النتيجة: إنّ المادّة لكي تكون ذهباً أو نحاساً أو شيئاً آخر بحاجة إلى سبب خارجي. فهذه نتيجة فلسفية مستندة إلى ما أدّت إليه الطريقة العقلية من قواعد عامّة لدى تطبيقها على المادّة الخام التي قدّمتها العلوم للفلسفة. (المؤلّف قدس سره)
[7] كما ضربنا الأمثلة على ذلك آنفاً، فقد رأينا كيف أنّ النظرية العلمية القائلة: إنّ الحركة هي سبب الحرارة أو جوهرها تطلّبت عدّة من المبادئ العقلية القبلية. (المؤلّف قدس سره)
[8] حتّى يمكن القول في ضوء ما قرّرناه - خلافاً للاتّجاه العامّ الذي واكبناه في الكتاب - بعدم وجود حدود فاصلة بين قوانين الفلسفة وقوانين العلم كالحدّ الفاصل القائل: إنّ كلّ قانون قائم على أساس عقلي فهو فلسفي، وكلّ قانون قائم على أساس تجربي فهو علمي؛ لأنّنا عرفنا بوضوح أنّ الأساس العقلي والتجربة مزدوجان في عدّةٍ من القضايا الفلسفية والعلمية، فلا القانون العلمي وليد التجربة بمفردها، وإنّما هو نتيجة تطبيق الاُسس العقلية على مضمون التجربة العلمية. ولا القانون الفلسفي في غنىً عن التجربة دائماً، بل قد تكون التجربة العلمية مادّة للبحث الفلسفي أو صغرى في القياس على حدّ تعبير المنطق الأرسطي، وإنّما الفارق بين الفلسفة والعلم: أنّ الفلسفة قد لا تحتاج إلى صغرى تجريبية، ولا تفتقر إلى مادّة خام تستعيرها من التجربة، كما سنيشير إليه بعد لحظة، وأمّا العلم فهو في كلّ قوانينه بحاجة إلى الخبرة الحسّية المنظّمة. (المؤلّف قدس سره)
[9] ومثال ذلك: قانون النهاية القائل: إنّ الأسباب لا تتصاعد إلى غير نهاية. فإنّ الفلسفة حين تقرّر هذا القانون لا تجد نفسها بحاجة إلى أيّ تجربة علمية، وإنّما تستخلصه من مبادئ عقلية أوّلية ولو بصورة غير مباشرة. (المؤلّف قدس سره)
[10] في الأصل: «الكلّ» ولعلّ الأنسب ما أثبتناه. (لجنة التحقيق)
[11] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۱۲۰، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[12] أشرنا سابقاً إلى أ نّه رحمه الله قد انتهى في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» إلى إمكان الاستدلال على القضايا الأوّليّة والفطريّة بالدليل الاستقرائي في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة، واستثنى من ذلك مبدأ عدم التناقض ومصادرات الدليل الاستقرائي، وفي نفس الوقت أكّد أنّ هذا لا يعني رفض المصدر العقلي القبلي لهذه القضايا، بل إنّما يعني أ نّنا حتّى لو استبعدنا العلم العقلي القبلي بها يظلّ بالإمكان إثباتها عن طريق الاستقراء. راجع: القسم الرابع من كتاب «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» تحت عنوان «تفسير القضيّة الأوّليّة والقضيّة الفطريّة». (لجنة التحقيق)
[13] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۱۸۲، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[14] الظاهر أنّ هذا الكلام يعبّر عن الجذور الأوّليّة التي نمت وترعرعت في ذهن السيّد المؤلّف رحمه الله بعد تأليفه لهذا الكتاب حتّى انتهت إلى القول بإمكان تفسير الجزء الأكبر من معارفنا - بما فيها القضايا الميتافيزيقيّة - بالطريقة الاستقرائيّة المتّبعة في القضايا الطبيعيّة، وهي طريقة التوالد الذاتي التي يؤمن بها المذهب الذاتي للمعرفة. وقد وضّح ذلك بالتفصيل في القسم الرابع من كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء». (لجنة التحقيق)
[15] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۱۸۵، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[16] لودفيغ فيورباخ: ٥٤
[17] المصدر نفسه: ١١٢
[18] وقد جاء في كلام (أنجلز) السابق التأكيد على ناحية القيمة الموضوعية لخلق ظاهرة وإنشائها، وأنّ في ذلك الردّ الحاسم على النزعات المثالية. ولا أظنّ هذا التأكيد حين يصدر من المدرسة الماركسية ينطوي على معنىً فلسفي خاصّ، وإن أمكن للباحث الفلسفي أن يصوغ من ذلك دليلاً خاصّاً على إثبات الواقع الموضوعي يرتكز على العلم الحضوري، نظراً إلى أنّ الفاعل يعلم بآثاره وما يخلق علماً حضورياً، والعلم الحضوري بشيء هو نفس وجوده الموضوعي. فالإنسان - إذن - يتّصل بالواقع الموضوعي لما يعلمه علماً حضورياً. فالمثالية إذا أسقطت من حساب المعرفة الموضوعية العلم الحصولي الذي لا نتّصل فيه إلّابأفكارنا، كفى للواقعية العلم الحضوري.
ولكنّ هذا الدليل يقوم على فهم مغلوط للعلم الحضوري؛ فإنّ أساس معرفتنا للأشياء إنّما هو العلم الحصولي. وأمّا العلم الحضوري فهو لا يعني أكثر من حضور المعلوم الواقعي لدى العالم، ولذلك كان كلّ إنسان يعلم بنفسه علماً حضورياً، مع أنّ كثيراً من الناس أنكر وجود النفس. ولا تتّسع حدودنا الخاصّة في هذه الدراسة للإفاضة في هذه الناحية. (المؤلّف قدس سره)
[19] ما هي المادّية؟: ٣٢
[20] ما هي المادّيّة؟: ٤
[21] ما هي المادّية؟: ٢١
[22] المادّية والمثالية في الفلسفة: ٦٨
[23] أشرنا في ما سبق أنّ السيّد المؤلّف قدس سره بعد أن توصّل إلى «المذهب الذاتي للمعرفة» في - - مقابل «المذهب العقلي» و «المذهب التجريبي» وآمن بأنّ التعميمات الاستقرائيّة لا يمكن تفسيرها إلّافي ضوء هذا المذهب، توجّه إلى الاعتقاد بأنّ الجزء الأكبر من معارفنا يمكن تفسيره على هذا الأساس. ومن جملة المعارف التي فسّرها على الأساس المذكور الإيمان بموضوعيّة القضايا المحسوسة، فقال: «والحقيقة أنّ افتراض موضوعيّة الحادثة ليس افتراضاً دون مبرّر كما تقوله المثاليّة، وليس أيضاً افتراضاً أوّليّاً ومعرفةً أوّليّة كما يقول المنطق الأرسطي، بل هو افتراض مستدلّ ومستنتج حسب مناهج الدليل الاستقرائي، كالقضايا التجريبيّة، والحدسيّة، والمتواترة تماماً» وفي ضوء ذلك أيضاً اعتبر الاعتقاد بوجود الواقع الموضوعي للعالم معبّراً عن معرفةٍ استقرائيّةٍ ناتجةٍ من تجميع القيم الاحتماليّة المتعدّدة بالواقع الموضوعي للقضايا المحسوسة، ولهذا كان التصديق بأصل وجود واقع موضوعي للعالم على الإجمال أكبر درجةً من التصديق بموضوعيّة أيّ قضيّةٍ محسوسةٍ بمفردها. وقد وضّح ذلك بالتفصيل في القسم الرابع من كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» تحت عنوان: «تفسير القضيّة المحسوسة». (لجنة التحقيق)
[24] موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۱۸۸-۱۹۵، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[25] هذا من جملة ما اختلف فيه رأي المؤلّف قدس سره بعد تأليفه لهذا الكتاب، حيث انتهى رحمه الله - في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة الذي طرحه في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» - إلى أنّ المجالات الفكريّة التي ينتقل فيها الذهن من استقراء الموضوعات الجزئيّة إلى قواعد وقوانين عامّة يكون السير الفكري فيها - حقّاً - من الخاصّ إلى العامّ، ولا حاجة فيها إلى ضمّ كبرى كليّة عقليّة مسبقة ليتحوّل السير الفكري فيها من العامّ إلى الخاصّ كما يدّعيه أصحاب المذهب العقلي للمعرفة. (لجنة التحقيق)
[26] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۸۷، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[27] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۹۰، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[28] أو على طريقة الاستقراء والصعود من الخاصّ إلى العامّ بالنحو الذي حقّقه المؤلّف قدس سره في كتاب «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة. (لجنة التحقيق)
[29] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۱۱۴، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[30] وقد أكّد المؤلّف قدس سره في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» أنّ مبدأ العليّة وسائر قضايا السببيّة التي تتضمّن معنى الضرورة واستحالة الانفكاك وإن كانت لا تخضع لوسائل التجربة مهما كانت دقيقة، ولهذا يعجز المذهب التجريبي عن إثباتها، ولكن يمكن إثباتها بالاستقراء في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة، وهذا لا يعني رفض المصدر العقلي القبلي لهذه القضايا، بل يعني أ نّا حتّى لو استبعدنا العلم العقلي القبلي بهذه القضايا يظلّ بالإمكان إثباتها في عالم الطبيعة عن طريق الاستقراء، وهذا ما أشار إليه في مناقشته للاتّجاه الأوّل من اتّجاهات المذهب التجريبي في الكتاب المذكور، كما أ نّه مشمول أيضاً لما أكّد عليه - في القسم الرابع من نفس الكتاب - من إمكان الاستدلال استقرائيّاً على جميع القضايا الأوّليّة والفطريّة عدا ما استثناه، فراجع. (لجنة التحقيق)
[31] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۹۴، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[32] أشرنا سابقاً إلى أنّ المؤلّف قدس سره انتهى في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» إلى إمكان معالجة مشكلة التعميم في القضايا الاستقرائيّة في ضوء ما تبنّاه من المذهب الذاتي للمعرفة، بنحو يبقى معه السير الفكري في تلك القضايا من الخاصّ إلى العامّ، من دون حاجة إلى ضمّ الكبريات العقليّة المسبقة التي تجعل السير الفكري فيها من العامّ إلى الخاصّ على طريقة الاستدلال القياسي. (لجنة التحقيق)
[33] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۹۸، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[34] حاصل هذا الكلام أنّ التجربة التي ينتقل فيها الذهن من استقراء الموضوعات الجزئيّة إلى قواعد وقوانين عامّة لا يمكن أن تورث القطع بالنتيجة المطلوبة إلّاإذا ضُمّت إليها كبريات عقليّة قبليّة ممّا يحوّل السير الفكري فيها من العامّ إلى الخاصّ بدلاً عن السير الفكري من الخاصّ إلى العامّ وإلّا كانت النتيجة ظنّيّة، وهذا ما تغيّر فيه رأي السيّد المؤلّف قدس سره كما أشرنا سابقاً، حيث انتهى في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» إلى إمكان حصول القطع بالنتيجة المطلوبة في القضيّة التجريبيّة في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة من دون حاجة إلى ضمّ الكبريات العقليّة القبليّة التي تحوّل السير الفكري فيها من العامّ إلى الخاصّ. (لجنة التحقيق)
[35] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۱۸۳، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[36] أشرنا سابقاً إلى أنّ السيّد المؤلّف قدس سره توصّل في كتابه (الاُسس المنطقيّة للاستقراء) إلى إمكان الاستدلال على قوانين العلّيّة بالطريقة الاستقرائيّة في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة، حتّى لو استبعدنا العلم العقلي القبلي بها. راجع مناقشته رحمه الله للاتّجاه الأوّل من اتّجاهات المذهب التجريبي في الكتاب المذكور. (لجنة التحقيق)
[37] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۳۳۱، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
[38] ولكنّه رحمه الله جدّد النظر حول مشكلة التعميمات الاستقرائيّة في كتابه «الاُسس المنطقيّة للاستقراء» وأثبت عجز المذهب العقلي للمعرفة - بما فيه من مبدأ العلّيّة وقوانينها - عن حلّ تلك المشكلة، كما أنّ المذهب التجريبي للمعرفة عاجز عن ذلك أيضاً، وانتهى إلى أنّ الحلّ الوحيد لمشكلة التعميمات الاستقرائيّة يتمّ في ضوء المذهب الذاتي للمعرفة، من دون حاجة إلى الإيمان المسبق بمبدأ العلّيّة وقوانينها. (لجنة التحقيق)
[39] صدر، محمد باقر، موسوعة الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر قدس سره / فلسفتنا، جلد: ۱، صفحه: ۳۳۶-۳۳۸، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، قم - ایران، 1434 ه.ق.
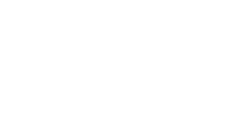
بدون نظر