١۵. ابوسؤار الغنوی
حاسوا و جاسوا واحد
یفرنی
و قال أبو زيد: سمعت أبا سوار الغنوي يقرأ [قوله تعالى]: {فجاسوا خلال الديار} فقال: جاسوا وحاسوا واحد، معناه: وطئوا، يقال: جاستهم الخيل[1].
السمين الحلبی
قوله: {وأقوم} حكى الزمخشري:» أن أنسا قرأ «وأصوب قيلا» فقيل له: يا أبا حمزة إنما هي: وأقوم!! «فقال:» إن أقوم وأصوب وأهيأ واحد «وأن أبا سرار الغنوي قرأ» فحاسوا خلال الديار «بالحاء المهمة فقيل له: هي بالجيم. فقال: حاسوا وجاسوا واحد» . قلت: له غرض في هاتين الحكايتين، وهو جواز قراءة القرآن بالمعنى، وليس في هذا دليل؛ لأنه تفسير معنى. وأيضا فما بين أيدينا قرآن متواتر، وهذه الحكاية آحاد. وقد تقدم أن أبا الدرداء كان يقرىء رجالا {إن شجرة الزقوم طعام الأثيم} [الدخان: ٤٤] فجعل الرجل يقول: اليتيم. فلما تبرم به قال: طعام الفاجر يا هذا. فاستدل به على ذلك من يرى جوازه. وليس فيه دليل؛ لأن مقصود/ أبي الدرداء بيان المعنى، فجاء بلفظ مبين[2].
زرکشی
من كلامهم إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض يقولون: مدحه ومدهه وهو كثير ألف فيه المصنفون وجعل منه ابن فارس قوله تعالى: {فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم} ، فقال: فالراء واللام متعاقبان، كما تقول العرب: فلق الصبح وفرقه. قال: وذكر عن الخليل- ولم أسمعه سماعا - أنه قال في قوله تعالى: {فجاسوا خلال الديار} إنما أراد فحاسوا فقامت الجيم مقام الحاء.
قال ابن فارس: وما أحسب الخليل قال هذا ولا أحقه عنه.
قلت: ذكر ابن جني في "المحتسب": أنها قراءة أبو السمال، وقال: قال أبو زيد - أو غيره: قلت له: إنما هو [فجاسوا] فقال: حاسوا وجاسوا واحد. وهذا يدل على أن بعض القراء يتخير بلا رواية ولذلك نظائر. انتهى.
وهذا الذي قاله ابن جني غير مستقيم ولا يحل لأحد أن يقرأ إلا بالرواية. وقوله:" إنهما بمعنى واحد " لا يوجب القراءة بغير الرواية كما ظنه أبو الفتح وقائل ذلك والقارىء به هو أبو السوار الغنوي لا أبو السمال فاعلم ذلك. كذلك أسنده الحافظ أبو عمرو الداني، فقال: حدثنا المازني قال: سألت أبا السوار الغنوي، فقرأ: [فحاسوا] بالحاء غير الجيم فقلت: إنما هو [فجاسوا] قال: حاسوا وجاسوا واحد، ويعني أن اللفظين بمعنى واحد وإن كان أراد أن القراءة بذلك تجوز في الصلاة والغرض كما جازت بالأولى فقد غلط في ذلك وأساء[3].
النسمه و النفس واحد
و اذ قتلتم نسمه
فخر رازی
وحدثني أبو بكر، رحمه الله، قال: حدثني أبو عبد الله بن الحسين، قال: حدثنا المازني، قال: سمعت أبا سرار الغنوي، يقرأ: فحاسوا خلال الديار فقلت: إنما هو جاسوا فقال: حاسوا وجاسوا واحد، قال وسمعته يقرأ: وإذ قتلتم نسمة فادارأتم فيها فقلت له: إنما هو نفس، قال: النسمة والنفس واحد قال الكسائي: يقال أحم الأمر وأجم إذا حان وقته، ويقال: رجل محارف ومجارف، قال: وهم يحلبون عليك، ويجلبون أي: يعينون، قال الأصمعي: إذا حان وقوع الأمر قيل: أجم، يقال: أجم ذلك الأمر أي: حان وقته[4]
[إن أقوم] وأصوب وأهيأ واحد، قال ابن جني، وهذا يدل على أن القوم كانوا يعتبرون المعاني، فإذا وجدوها لم يلتفتوا إلى الألفاظ ونظيره ما روي أن أبا سوار الغنوي كان يقرأ: (فحاسوا خلال الديار) بالحاء غير المعجمة، فقيل له: إنما هو جاسوا، فقال: حاسوا وجاسوا واحد وأنا أقول: يجب أن نحمل ذلك على أنه إنما ذكر ذلك تفسيرا للفظ القرآن لا على أنه جعله نفس القرآن، إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ابن جني لارتفع الاعتماد عن ألفاظ القرآن، ولجوزنا أن كل أحد عبر عن المعنى بلفظ رآه مطابقا لذلك المعنى، ثم ربما أصاب في ذلك الاعتقاد، وربما أخطأ وهذا يجر إلى الطعن في القرآن، فثبت أنه حمل ذلك على ما ذكرناه[5].
لا تجزی نسمه عن نسمه
زمخشری
يوما يريد يوم القيامة لا تجزي لا تقضى عنها شيئا من الحقوق. ومنه الحديث في جذعة بن نيار: «تجزى عنك ولا تجزى عن أحد بعدك» وشيئا مفعول به ويجوز أن يكون في موضع مصدر، أى قليلا من الجزاء، كقوله تعالى: (ولا يظلمون شيئا) ومن قرأ (لا تجزئ) من أجزأ عنه إذا أغنى عنه، فلا يكون في قراءته إلا بمعنى شيئا من الإجزاء. وقرأ أبو السرار الغنوي: لا تجزى نسمة عن نسمة شيئا. وهذه الجملة منصوبة المحل صفة ليوما. فإن قلت: فأين العائد منها إلى الموصوف؟ قلت: هو محذوف تقديره: لا تجزى فيه[6].
والثالث: وقرأ أبو السرار الغنوي: "لا تجزى نسمة عن نسمة شيئا[7]"
هیاک نعبد و هیاک نستعین
وقرأ أبو سوار الغنوي "هياك نعبد وهياك نستعين" بالهاء فيهما بدلآ من الهمز. قالوا: وهي لغة قليلة الإستعمال، وأكثر ما تجيء في الشعر[8].
[1] كتاب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج ٢، ص ۵٢٢
[2] الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج ١٠، ص ۵١٩
[3] كتاب البرهان في علوم القرآن، ج ٣، ص ٣٨٨
[4] كتاب أمالي القالي، ج ٢، ص ٧٨
[5] كتاب تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ج ٣٠، ص ۶٨۶
[6] كتاب تفسير الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ١، ص ١٣۵
[7] كتاب الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، ج ٣، ص ١٩۶
[8] كنز الكتاب ومنتخب الأدب، ج ٢، ص ۵٩۵
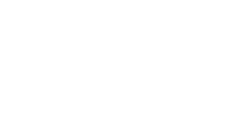
بدون نظر