١۴. یحیی بن سعید قطان
ابونعيم اصفهانی
حدثنا إبراهيم بن عبد الله , ثنا محمد بن إسحاق , قال: سمعت عبيد الله بن سعيد , يقول: «أخاف أن يضيق، على الناس تتبع الألفاظ , لأن القرآن أعظم حرمة ⦗٣٨١⦘ وسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا[1]»
خطیب بغدادی
أخبرنا أبو نعيم الحافظ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، ثنا محمد بن إسحاق السراج , قال: سمعت عبيد الله بن سعيد , يقول: سمعت يحيى بن سعيد , يقول: «أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ , لأن القرآن أعظم حرمة ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا[2]»
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي , قال: قرئ على أبي إسحاق المزكي , وأنا أسمع , سمعت أبا العباس , ح وأخبرنا أبو حازم العبدوي واللفظ له , قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن الأزهر يقول: سمعت أزهر بن جميل , يقول: كنا عند يحيى بن سعيد ومعنا رجل يتشكك , فقال له يحيى: «يا هذا , إلى كم هذا؟ ليس في يد الناس أشرف ولا أجل من كتاب الله تعالى , وقد رخص فيه على سبعة أحرف[3]»
ذهبی
وسمعته يقول: أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ، لأن القرآن أعظم حرمة، ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا[4].
قال أبو قدامة السرخسي: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أدركت الأئمة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص
وسمعته يقول: أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ، لأن القرآن أعظم حرمة، ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا[5].
سخاوی
وأيضا فقد قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل، لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه.
وسبقه لنحوه يحيى بن سعيد القطان فإنه قال: القرآن أعظم من الحديث، ورخص أن نقرأه على سبعة أحرف. وكذا قال أبو أويس: سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث، فقال: إن هذا يجوز في القرآن، فكيف به في الحديث! إذا أصبت معنى الحديث ; فلم تحل به حراما، ولم تحرم به حلالا، فلا بأس به.بل قال مكحول وأبو الأزهر: دخلنا على واثلة رضي الله عنه، فقلنا له: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا نسيان، فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا: نعم، وما نحن له بحافظين جدا، إنا لنزيد الواو والألف وننقص.قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون فيه وتنقصون منه، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة، حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى.واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه فرعون بألفاظ مختلفة في معنى واحد كقوله: {بشهاب قبس} [النمل: ٧] ، و {بقبس} [طه: ١٠] أو {جذوة من النار} [القصص: ٢٩] ، وكذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام في القرآن، وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة، وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى، وقد قال أبي بن كعب كما أخرجه أبو داود: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ {سبح اسم ربك} [الأعلى: ١] ، وقل للذين كفروا، والله الواحد الصمد» . فسمى السورتين الأخيرتين بالمعنى[6].
معاصرین
وروى الخطيب في كتاب «الكفاية» عن أزهر بن جميل قال: كنا عند يحيى بن سعيد ومعنا رجل يتشكك فقال له يحيى: يا هذا إلى كم هذا. ليس في يد الناس أشرف ولا أجل من كتاب الله تعالى وقد رخص فيه على سبعة أحرف, قال الشافعي: وإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه السخاوي في «فتح المغيث»: وسبقه لنحوه يحيى بن سعيد القطان فإنه قال القرآن أعظم من الحديث ورخص أن تقرأه على سبعة أحرف, وكذا قال أبو أويس سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس به, واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه بألفاظ مختلفة في شيء واحد كقوله: {بشهاب قبس} و {بقبس أو جذوة من النار} وكذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام في القرآن وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى, وقد قال أبي بن كعب كما أخرجه أبو داود كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بـ {سبح اسم ربك} وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد, فسمى السورتين الأخيرتين بالمعنى انتهى.وكلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم في جواز رواية الحديث بالمعنى كثير, وفيما ذكرته ههنا كفاية[7]
ومن دليل أصحاب هذا المذهب:
ما جاء عن يحيى بن سعيد القطان، قال: " أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ؛ لأن القرآن أعظم حرمة، ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا "
وقال الرامهرمزي: " ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب: أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا، كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير، والحذف والإلغاء، والزيادة والنقصان، وغير ذلك "
كذلك قال الخطيب: " اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وللسامع بقوله، أن ينقل معنى خبره بغير لفظه، وغير اللغة العربية، وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، سيما إذا كانوا السفير يعرف اللغتين، فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان وهو يعرف الخطاب بذلك اللسان؛ لأنه لا يأمن الغلط وقصد التحريف على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسه.
وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبره وأمره ونهيه إصابة معناه وامتثال موجبه، دون إيراد نفس لفظه وصورته.
وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول إلى دينه , والعلم بأحكامه[8].
٩٤٥- واستدل الشافعي رضي الله عنه لذلك بحديث: "أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه"، فإذا كان الله تعالى رحمة منه بخلقه -أنزل كتابه على سبعة أحرف لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم منه فغير كتاب الله تعالى أولى لأن تجوز فيه الرواية بالمعنى ما لم يتغير المعنى بتغير اللفظ، يقول مبينا ذلك: "فإن كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته، وإن اختلف اللفظ فيه، ما لم يحل معناه. وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه
٩٤٦- وقد روي ما هو شبيه بهذا عن يحيى بن سعيد القطان حيث قال: أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ؛ لأن القرآن أعظم حرمة، ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا[9]
[1] كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ط السعادة، ج ٨، ص ٣٨٠-٣٨١
[2] كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص ٢١٠
[3] كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص ٢١٠
[4] كتاب تاريخ الإسلام ط التوفيقية ، ج ١٣، ص ٢۵۶
[5] كتاب تاريخ الإسلام ت تدمري، ج ٨، ص ۴۶٩
[6] كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ج ٣، ص ١۴٣-١۴۵
[7] كتاب السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج، ص ١١٨-١١٩
[8] كتاب تحرير علوم الحديث، ج ١، ص ٢٨٠
[9] كتاب توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته، ص ۴٢٢
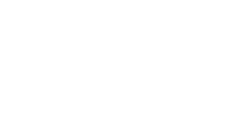
بدون نظر