سید محمد باقر صدر
۱. تعیین جعل برای بانک
حقوق البنك:
إنّ العضو الثاني يتمثّل في البنك، وهو في الواقع ليس عضواً أساسياً في عقد المضاربة؛ لأنّه ليس هو صاحب المال، ولا صاحب العمل - أي المستثمِر - وإنّما يتركّز دوره في الوساطة بين الطرفين، فبدلاً عن أن يذهب رجال الأعمال إلى المودِعين يفتّشون عنهم واحداً بعد آخر ويحاولون الاتّفاق معهم يقوم البنك بتجميع أموال هؤلاء المودِعين ويُتيح لرجال الأعمال أن يراجعوه ويتّفقوا معه مباشرةً على استثمار أيِّ مبلغٍ تتوفّر القرائن على إمكان استثماره بشكلٍ ناجح، وهذه الوساطة التي يمارسها البنك تعتبر خدمةً محترمةً يقدّمها البنك لرجال الأعمال، ومن حقّه أن يطلب مكافأةً عليها على أساس الجُعالة.
والجُعالة التي يتقاضاها البنك كمكافأةٍ على عمله ووساطته تتمثّل في أمرين:
الأوّل: أجرٌ ثابت على العمل يمكن أن يفرض مساوياً لمقدار التفاوت بين سعر الفائدة التي يعطيها البنك الربوي وسعر الفائدة التي يتقاضاها، مطروحاً منها زيادة حصّة المودِع من الربح على سعر فائدة الوديعة.
وهذا المقدار بقطع النظر عن الطرح منه هو الذي يمثّل الإيراد الإجمالي الربوي للبنوك، فإنّ إيرادها الربوي يتمثّل في الفارق بين الفائدة التي تدفعها للمودِع والفائدة التي تتقاضاها لدى تسليف الودائع.
غير أنّ البنك اللاربوي الذي نبحث عن صيغته الإسلامية لا يكفي أن يحصل على هذا القدر؛ لأنّ هذا البنك يختلف عن البنوك الربوية في نقطةٍ جوهرية، هي أنّ ضمان رأس المال المتكوّن من الودائع يقع على عهدته هو، بينما لا تتحمّل البنوك الربوية شيئاً من الخسارة في نهاية الشوط، وإنّما الذي يتحمّلها رجل الأعمال المقترِض من البنك، ولهذا يجب أن يزيد الجُعل الذي يتقاضاه البنك لقاء عمله على المقدار الذي يحصل عليه البنك الربوي من التفاوت بين سعر الفائدتين، كما سنرى.
الثاني (أي العنصر الثاني من الجُعالة المفروضة للبنك) أن يكون للبنك زائداً على ذلك الأجر الثابت جُعالة مرنة على العامل المستثمِر[1] تتمثّل في إعطاء البنك الحقّ في نسبةٍ معيَّنةٍ من حصّةٍ لعاملٍ في الربح، ويمكن أن تقدَّر هذه النسبة بطريقةٍ تقريبيةٍ تجعلها مساويةً للفرق الذي ينعكس في السوقين: النقدي الربوي والتجاري بين اجرة رأس المال المضمون، واُجرة رأس المال المخاطر به، فإنّ رأس المال المضمون تتمثّل اجرته في الأسواق الربوية في مقدار الفائدة التي يتقاضاها البنك الربوي من مؤسّسات الأعمال التي تقترض منه، ورأس المال المخاطر به تتمثّل اجرته في الأسواق التجارية في النسبة المئوية التي تعطى عادةً لرأس المال إذا اتّفق صاحبه مع عاملٍ يستثمِره على أساس المضاربة، وفي العادة تكون النسبة المئوية التي تعطى لرأس المال في حالة المخاطرة بدرجةٍ يتوقّع لها أن تكون أكبر من الفائدة التي يتقاضاها رأس المال المضمون عن طريق القرض.
وهذا الفارق بين الاُجرتين يُجعل للبنك كجُعالةٍ على عمله ووساطته.
وهذان الأمران اللذان يتكوّن منهما الجُعل الذي يتقاضاه البنك من المستثمِرين لقاء عمله ووساطته يمكن توضيحهما بدرجةٍ أكبر؛ وذلك بالبيان الآتي:
إنّ في الأسواق التي تتاجر برأس المال حدّاً أدنى لأجر رأس المال المضمون قيمةً ودخلاً، وهذا الحدّ الأدنى هو ما يدفعه البنك الربوي من فوائد للمودِعين الذين يضمنون بإيداعهم لنقودهم فيه قيمة المال ودخلاً ثابتاً باسم الفائدة. وهناك حدّ أعلى لأجر رأس المال المضمون قيمةً ودخلاً، وهو ما يدفعه رجال الأعمال من فوائد إلى البنك الذي يسلفهم ما يحتاجون إليه من نقودٍ مضمونةٍ عليهم قيمةً ودخلاً.
وهناك قسم ثالث: وهو رأس المال الذي يضمن قيمةً لا دخلاً، ومثاله الودائع في البنك اللاربوي من وجهة نظر المودِعين، فإنّه رأس مالٍ مضمون لهم قيمةً؛ نظراً إلى تعهّد البنك بتدارك الخسارة متى وقعت، ولكنّه غير مضمون الدخل؛ لأنّ دخل المودِع مرتبط بربح المشاريع التي أنشأها البنك على أساس المضاربة، وقد لا تربح تلك المشاريع، أو لا تحقّق الحدّ الأدنى المفروض من الربح وهو ما يساوي سعر الفائدة.
واُجرة رأس مالٍ من هذا القبيل تتمثّل في نسبةٍ مئويةٍ من الربح يقدر أن تعبّر عن مقدارٍ أكبر من الحدّ الأدنى لأجر رأس المال المضمون قيمةً ودخلاً بمقدار حاصل قسمةِ نسبةِ الفائدة على درجة احتمال عدم الربح.
وهناك قسم رابع: وهو رأس المال الذي يخاطر به قيمةً ودخلاً، كما إذا دفع شخص نقوداً إلى آخر ليتّجر بها على أساس المضاربة بمفهومها الإسلامي دون أن يضمن له أحد نقوده، فهو هنا مخاطر بقيمة النقود؛ إذ قد يخسر، ومخاطر بالدخل؛ إذ قد لايربح. ومكافأة رأس المال هذا الذي يتحمّل المخاطرة بالقيمة والدخل معاً يجب أن تكون أكبر من مكافأة رؤوس الأموال السابقة، أي نسبة مئوية من الربح يقدّر أن تكون أكبر من اجور رؤوس الأموال المضمونة.
ونحن هنا حين نفترض أجر رأس المال المضمون لا نتحدّث عن النظرية الإسلامية في الاُجور التي لا ترى لرأس المال النقدي أجراً يستحقّه الدائن على المَدين، وإنّما نتحدّث عن اجور رأس المال في الأسواق النقدية الربوية؛ لأنّ هذه الأسواق سوف تفرض اجورها في الوسط التجاري ويضطرّ البنك اللاربوي إلى أخذها بعين الاعتبار في تقدير الدخول اللاربوية التي يخطّط لها.
وعلى هذا الأساس إذا درسنا الوديعة التي يتسلّمها البنك اللاربوي في ضوء تلك الاُجور وجدنا أ نّها من وجهة نظر العامل المستثمِر الذي يحاول الحصول عليها عن طريق البنك اللاربوي رأس مالٍ مخاطر به قيمةً ودخلاً؛ لأنّ المستثمِر ليس ضامناً لقيمة رأس المال، ولا لدخلٍ معيَّنٍ في حالة عدم الربح. هذا إذا استثنينا الأجر الثابت الذي يتقاضاه البنك على أي حال؛ إذ إنّ المخاطر بقيمة رأس المال هو البنك الذي ضمن رأس المال للمودِع، والمخاطر بالدخل هو المودِع نفسه الذي كان بإمكانه أن يحصل على دخلٍ ثابتٍ عن طريق البنوك الربوية، فآثر المخاطرة بالدخل بإقامة دخله على أساس الشركة
في الربح، فيجب أن يكلّف العامل المستثمِر بدفع مكافأةٍ تتناسب مع رأس المال المخاطر به قيمةً ودخلاً ناقصاً سعر المخاطرة بالجزء الذي يتقاضاه البنك من تلك المكافأة كأجرٍ ثابت.
وهذه المكافأة يستثنى منها مقدار الحدّ الأدنى لاُجرة رأس المال المضمون قيمةً ودخلاً زائداً قيمة المخاطرة بالدخل فيعطى للمودِع، والباقي يكون من حقّ البنك اللاربوي.
وجميع المكافأة التي يكلَّف رجل الأعمال المستثمِر بدفعها وتوزّع بعد ذلك بين المودِع والبنك، تقتطع من الربح وترتبط به، فحيث لا ربح لا يكلَّف رجل الأعمال بشيءٍ منها سوى الأجر الثابت الذي يتقاضاه البنك اللاربوي كجُعَالة على عمله، وهو محدّد تقريباً بمقدار الفرق بين سعر الفائدة التي يدفعها البنك الربوي قيمة المخاطرة بالدخل وبين سعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك الربوية.
وهذا الأجر الثابت الذي يدفعه المستثمِر إلى البنك يُحسَب له حسابه منذ البدء عند تحديد النسبة من الربح التي سوف تقتطع من العامل المستثمِر وتوزّع بين المودِع والبنك، فإنّ هذه النسبة يجب أن لا تمتصّ كلّ المكافأة التي يحظى بها عادةً رأس المال المخاطَر به قيمةً ودخلاً في الأسواق التجارية؛ لأنّها لو امتصّت كلّ تلك المكافأة ولنفرضها (٧٠%)، فمعنى هذا أنّ رجل الأعمال المستثمِر سوف يكلَّف بأكثر من اجرة راس المال المخاطَر به قيمةً ودخلاً؛ لأنّه سوف يدفع تلك النسبة كاملةً زائداً الأجرَ الثابت، فلابد إذن أن يُحسَب للأجر الثابت حسابه لدى تقدير النسبة المقتطعة من ربح مضاربة العامل المستثمِر منذ البدء، فتخفض هذه النسبة بدرجةٍ يقدّر أ نّها لا تقلّ عن مقدار الأجر الثابت.
ويجب أن يكون واضحاً أنّ الجُعالة المرنة التي من حقّ البنك اللاربوي الحصول عليها زائداً على الأجر الثابت لقاءَ مخاطرته بضمان رأس المال لا يلزم أن تتجسّد في نسبةٍ محدّدةٍ بشكلٍ واحدٍ في كلّ المشاريع التي تنشئها مضاربات البنك اللاربوي، بل يمكن للبنك في كلّ مضاربةٍ أن يتّفق مع العامل المستثمِر على النسبة التي تحدّدها طبيعة تلك المضاربة ودرجة المخاطرة المتمثّلة فيها؛ لأنّ المخاطرة تختلف من قطاعٍ اقتصاديّ لآخر، ومن مؤسّسةٍ لاُخرى.
وعلى هذا الأساس، فالبنك اللاربوي يقوم بتقسيم الأرباح التي تظهر في كلّ مضاربةٍ وفقاً للاتّفاق الذي توصّل إليه مع العامل في عقد المضاربة، والذي قد يختلف من مضاربةٍ إلى اخرى، فيقتطع من الأرباح ما زاد على الحصّة المقرّرة للعامل في المضاربة الخاصّة التي قامت بينهما، وهذا المقتطع من أرباح مختلف المضاربات هو المجموع الكلّي للربح الذي يجب أن يوزّع بين البنك والمودِعين وفقاً للطريقة التي سوف نعرضها بعد قليلٍ لكيفية توزيع الأرباح.[2]
جذب سرمایه
حين يحسّ البنك بالحاجة إلى جذب الودائع:
وكلّما أحسَّ البنك بالحاجة الملحَّة إلى جذب ودائع أكثر لقوة حركة الاستثمار ونشاطها وزيادة الطلب من المستثمِرين أمكنه أن يستعمل طريقةً لجذب تلك الودائع، وهي فرض جُعالةٍ للمودِع زائداً على النسبة المقرَّرة له من الربح.
وصورة الجُعالة أن يفرض البنك لكّل مَن يودِع لديه وديعةً ثابتةً ويجعله وكيلاً عنه في المضاربة عليها مع أيّ مستثمرٍ يشاء وبأيّ شروطٍ يقترحها، جعالةً خاصّةً على أساس أنّ توكيل المودِع المضارِب للبنك عمل يخدم البنك وله قيمةٌ مالية فيصحّ أن يضع البنك جعالةً عليه. ونظراً إلى أنّ قيمة التوكيل تزداد كلّما ازداد المبلغ الموكَّل عليه فبالإمكان فرضُ الجُعالة بنحو يتناسب مع كمّية المبلغ المودَع، ويتحمّل البنك دفع هذه الجُعالة ويغطّي كلفتها من الاُجور الثابتة التي يتقاضاها من كلّ مستثمرٍ لقاءَ توسّطه لديه، كما يغطّي البنك الربوي الفوائد التي يدفعها إلى المودِعين منذ يوم الإيداع من الفوائد الثابتة التي يتقاضاها بعد ذلك لقاءَ تسليف تلك الودائع للمستثمِرين.
وليست هذه الجُعالة رِباً؛ لأنّها ليست شيئاً يدفعه المَدين إلى الدائن لقاءَ الدَين، نظراً إلى أنّ الودائع الثابتة ليست ديناً على البنك للمودِع لكي يكون ما يدفعه إليه في مقابل القرض، وإنّما هي باقية على ملكية أصحابها المودِعين لها، والجُعالة إنّما هي على التوكيل بوصفه عملاً ذا قيمةٍ ماليةٍ بالنسبة إلى البنك بما يُتيح له من فرصة اختيار المستثمِر وفرض شروطه عليه.
وبالرغم من هذا فإنّي أرى أنّ الأوْلى بالبنك اللاربوي أن لا يلجأ مهما أمكن إلى الجُعالة بهذه الطريقة لجذب الودائع الثابتة؛ لأنّها تتّفق من الناحية المظهرية مع الفائدة إلى درجةٍ كبيرة. وأتصوّرُ أنّ إغراءَ الربح وحده يكفي لجذب المزيد من الودائع الثابتة كلّما اتّسعت حركة الاستثمار وازداد طلب المستثمِرين؛ لأنّ ازدياد طلب المستثمِرين يعني وجود فُرَصٍ كبيرةٍ ومناسبةٍ جدّاً للربح، وهذا بنفسه كما يدفع المستثمِرين إلى طلب الدخول في مضارباتٍ بتوسّط البنك كذلك يدفع أصحاب الأموال الذين لا يَوَدّون ممارسة استثمار أموالهم مباشرةً إلی دفع أموالهم كودائع ثابتةٍ إلى البنك ويطلبون منه التوسّط في توظيفها على أساس المضاربة.[3]
راه فرار از معاملات ربوی
ما هي تخريجات المعاملات الربويّة مع البنوك، بحيث نخرجها عن كونها رباً؟ وهل تصحّ هذه التخريجات أم لا؟
نتكلّم هنا في مقامين:
المقام الأوّل: في تخريجات المعاملات الربويّة بشكل عامّ.
المقام الثاني: في المعاملات التي تقع مع البنوك.
١ - التخريجات العامّة للمعاملات الربويّة:
أمّا المقام الأوّل - وهو في التخريجات [بشكل عام] - فنذكر هنا تخريجين، وبكلامنا فيهما تتبيّن صناعة التخريجات في المقام، فنقول:
التخريج الأوّل: بيع النقد بأزيد منه مؤجّلاً:
أن يبيع المائة دينار - مثلاً - نقداً بمائة وعشرين ديناراً مؤجّلةً إلى ستّة أشهر بدلاً عن القرض الربوي، والنقود في زماننا ليست ذهباً أو فضة، ولا تحكي عنهما بحيث تكون المعاملة بالذهب والفضّة حتّى تدخل هذه المعاملة في البيع الربوي.
وبهذا يصل المرابي دائماً إلى مقصوده في القرض الابتدائي مع الفرار عن الربا، ويبقى هدفه في الانتفاع عند حلول الأجل إذا لم يكن المدين قادراً على الوفاء بالدّين. وبإمكانه تحصيل هذا الهدف بأن يشترط في ضمن ذلك البيع أن يكون عليه - على كلّ شهر يؤخّر الأداء فيه - كذا مقدارٍ من المال، وهذا شرط مشروع؛ فإنّ من يبيع شيئاً بإمكانه أن يشترط أن يكون عليه في كلّ شهر إعطاء درهم للبائع، وهنا قد جعل نفس الشرط، إلّاأ نّه مقيّد بعدم الوفاء بالثمن. وبهذا تصبح هذه الحيلة وافيةً بسهولة بكل أهداف المرابي، ولعلّها أدهى حيلة في المقام.
ولا يخفى أنّ هذه الحيلة إنّما تتمّ إذا لم نقل بأنّ أدلّة حرمة البيع الربوي في المكيل والموزون تشمل مطلق المثليّات. أمّا إذا أثبتنا ذلك بوجهٍ من الوجوه، كما يشهد لذلك التعريف القديم للمثلي والقيمي بالمكيل والموزون - والتعبير بالمثلي والقيمي لم يكن موجوداً في زمن الأئمّة عليهم السلام[4] -، فتبطل هذه الحيلة؛ لأنّ النقود مهما كان شكلها فهي مثليّة.
نعم، إن لم نقل بذلك كان لهذه الحيلة صورة؛ إذ النقود التي في زماننا ليست مكيلاً ولا موزوناً، وقد أفتى المشهور من طبقة المتأخّرين جدّاً - أعني طبقتنا والطبقة التي قبلنا - بصحّة هذه الحيلة، وقد ذهب السيّد الاُستاذ (مدّ ظلّه)[5] إلى التفصيل بين ما لو قيّد البدل بقيدٍ مغاير لما اعطي (كأن يعطي مائة دينار أوراقاً من فئة دينار، ويجعل ثمن ذلك اثنتي عشرة ورقة من فئة عشرة دنانير) وبين ما لو لم يقيّد البدل بقيد من هذا القبيل (كأن يبيع المائة دينار بمائة وعشرين ديناراً)، ويتحصّل من بعض عباراته وجهٌ لذلك، ومن بعض عباراته الاُخرى وجهٌ آخر.
ولنذكر كلا الوجهين مع بيان الحال فيهما؛ فنقول:
الوجه الأوّل: إنّ بيع مائة دينار بمائة وعشرين غير صحيح؛ إذ هذا مبادلة للشيء بنفسه مع زيادة، ومبادلة الشيء بنفسه غير معقولة، ومجرّد الكلّيّة والجزئيّة لا يوجب المغايرة وصحّة المبادلة. نعم، لو باع مائة دينار مثلاً من فئة دينار باثنتي عشرة ورقة من فئة عشرة دنانير، لم يرد عليه هذا الإشكال.
أقول: مضافاً إلى أ نّه لم يحلّ أصل مادّة الفساد[6]، فإنّه يرد عليه:
أوّلاً: إنّ مجرّد عدم كون ذلك بيعاً أو مبادلة لا يوجب بطلانه ما لم نثبت كونه قرضاً ربويّاً، وإلّا فهو عقدٌ من العقود لا يدخل تحت عنوان البيع أو أيّ مبادلة اخرى، فليقصد المتعاملان هذا العقد على ما هو عليه، وهو داخلٌ في إطلاق: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[7]، فيكون صحيحاً.
وهذا الإيراد يتوقّف وروده على القول بأنّ روايات: «لا يكون الربا إلّافي ما يُكال ويوزن»[8] تشمل كلّ المعاملات ما عدا القرض. أمّا لو قلنا: إنّها ليست كذلك، وإنّما هي مختصّة بالبيع مثلاً، أو يُتعدّى إلى غير البيع بعدم القول بالفصل - ومن المعلوم أنّ هذا الإجماع لا يشمل معاملةً غريبة من هذا القبيل -، فلا يرد هذا الإشكال؛ إذ تصبح هذه المعاملة حينئذٍ ربويّةً باطلة، وإن لم تكن في المكيل والموزون.
ثانياً: إنّ المغايرة بين النقد الخارجي وبين ما في الذمّة ليست مجرّد مغايرة عقليّة واعتباريّة، بل هي مغايرة عرفيّة، كيف! والذمّة من مخترعات العرف نفسه في مقابل الخارج، ويشهد لذلك بعض الروايات الواردة في صحّة بيع الثوب - وهو قيميّ - بثوبين نسيئةً[9]، وقد أفتى الفقهاء أيضاً بصحّة بيع المثل بالمثل مع الزيادة في القيميّات، سواءٌ كان بالنقد أم النسيئة[10].
الوجه الثاني: إنّ هذه المعاملة قرضٌ وليست بيعاً؛ فإنّها تمليكٌ للمال من الشخص الآخذ مع دخوله في ذمّته، وهذا هو القرض.
وهذا الكلام غير صحيح، حلّاً ونقضاً:
أ - أمّا حلّاً؛ فلأ نّه:
إن قصد من كون هذه المعاملة قرضاً أ نّها تفيد فائدة القرض، فهذا صحيح.
ولكنّ هذا البيان لا يكفي في إبطال الزيادة؛ فهل كلّ معاملة أفادت فائدة القرض تبطل فيها الزيادة؟ ولماذا؟!
وإن قصد بذلك كونها قرضاً حقيقةً، فإنّما يكون كذلك بناءً على التعريف الأوّل للقرض من التعريفات الماضية، والذي كان يُرجع القرضَ إلى المبادلة.
وأمّا بناءً على الوجوه الاُخرى[11]، فليس الأمر كذلك؛ فإنّ هذا مبادلة لمائة دينار مثلاً بمائة وعشرين ديناراً، والقرض:
إمّا هبة بتمليك العين مع الاستئمان على الماليّة، كما عليه المحقّق الإيرواني رحمه الله.
أو تمليك بضمان، كما عليه السيّد الاُستاذ (مدّ ظلّه) نفسه.
أو أ نّه يجعل اليد مؤثّرةً في التملّك والضمان، كما مضى تفصيله منّا[12].
وهذه كلّها غير المبادلة.
ب - وأمّا نقضاً: فلأ نّه لو كان بيع المثلي بالمثل مؤجّلاً قرضاً، لكان بيع القيمي بالقيمة مؤجّلةً قرضاً أيضاً: فلو باع شخصٌ شيئاً قيميّاً مؤجّلاً بسعرٍ أغلى من سعر السوق كان ذلك رباً محرّماً، وهذا ما لا يقول به أحد.
ونحن حينما كنّا نورد عليه (مدّ ظلّه) هذا الإشكال، كان يجيب بأنّ هناك فرقاً بين باب بيع القيمي بقيمةٍ أغلى مؤجّلاً وبين باب القرض، وهو أنّ القيمي يعيّن نوع ثمنه عند البيع، كأن يقال مثلاً: «بعت هذا بدينار»، أي الدينار العراقي، وأمّا في باب القرض فيأتي إلى الذمّة مطلق الماليّة.
وهذا الجواب غير صحيح؛ فإنّ نوع الثمن في باب القرض معيّن أيضاً، وهو نقد البلد: فمن يُقرض مائة دينارٍ يطلب حين حلول الأجل - بحسب الارتكاز العرفي - مائة دينارٍ من نقود ذلك البلد، ولو أعطاه من نقود [بلد آخر] بذاك المقدار من الماليّة كان له - عقلائيّاً - حقّ الرفض.
فقد تحصّل أنّ هذين الوجهين كلاهما غير صحيح.
تحقيق في إبطال التخريجات العامّة:
والتحقيق في المقام هو عدم جواز هذه الحيلة، ويتّضح ذلك بذكر مقدّمتين:
المقدّمة الاُولى: يوجد في المعاملات وراء السبب - الذي هو العقد - ثلاثة أغراض:
١ - ما اسمّيه: (الغرض العقدي)، وهو الغرض الذي يمتاز به كلّ نوع من أنواع العقد عن الآخر، ويشترك فيه تمام العقلاء، كالمبادلة بين المالين في البيع مثلاً.
٢ - ما اسمّيه: (الغرض النوعي الخارجي)، وهو ما يشترك فيه نوع العقلاء في كلّ نوع من المعاملات، كالتسلّط الخارجي على الثمن والمثمن في البيع، وليس هو المميّز لكلّ نوع من أنواع المعاملات عن الآخر: فقد يشترك نوعان منها في الغرض النوعي الخارجي، وذلك من قبيل إبراء الدَّين وهبته على من هو عليه، بناءً على صحّة ذلك؛ فإنّهما عمليّتان تنتجان غرضاً نوعيّاً خارجيّاً واحداً، وهو فراغ ذمّة المديون من دون أن يدفع شيئاً.
٣ - ما اسمّيه: (الغرض الشخصي الخارجي)، وهو الذي لا يميّز أنواع المعاملات بعضها عن بعض، كما لا يشترك بين نوع العقلاء: فربّ شخص يشتري الكتاب للمطالعة، وآخر للاقتناء في المكتبة، وثالث للإهداء، ورابع للتجارة، وهكذا.
والغرض الشخصي الخارجي خارجٌ عن قوام المعاملة، لكنّ الغرض النوعي الخارجي يشكّل - بحسب نظر العرف والعقلاء - حيثيّةً تقييديّة مأخوذة في قوام المعاملة، ولهذا نقول: إنّ تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه على القاعدة، بلا حاجة إلى تلك الرواية الضعيفة[13]؛ فإنّ العقلاء يقولون - مع فرض عدم التسليط الخارجي وتلفه قبل ذلك -: إنّ المعاملة لم تتمّ ولم يتحقّق البيع، وقد قال جماعةٌ من الفقهاء - ونِعمَ ما قالوا -: إنّ إيقاع العقد المنقطع على طفلة إلى مدّة لا يمكن الاستمتاع بها بوجهٍ من الوجوه باطل[14].
المقدّمة الثانية: إنّ النهي الإبطالي المتوجّه إلى العقد والمعاملة لا يتّجه طبعاً إلى الغرض الشخصي الخارجي؛ لخروجه عن العقد والمعاملة بكلّ وجه، وإنّما يتوجّه إلى السبب أو الغرض العقدي أو الغرض النوعي الخارجي، بحسب اختلاف مناسبات الحكم والموضوع:
أ - فقد يكون المناسب رجوعه إلى نفس العقد، كما في: «لا تبع وقت النداء»[15]؛ حيث إنّ هذه العمليّة تشغل الإنسان في وقت النداء عن العبادة والصلاة.
ب - وقد يكون المناسب رجوعه إلى الغرض العقدي، كما لو نهى عن بيع حقّ الشفعة[16]، حيث قيل[17]: إنّ هذا بنكتة أنّ هذا الحقّ لا يعدّ مالاً حتّى يقابل بالمال، لكن يمكن إسقاطه في ضمن عقد الهبة مثلاً.
ج - وقد يكون المناسب رجوعه إلى الغرض النوعي الخارجي، كما في تحريم الربا، حيث تترتّب المفاسد على الزيادة الخارجيّة والتسلّط الخارجي.
وهذا النهي، سواءٌ كان متّجهاً إلى السبب أم إلى الغرض العقدي أم إلى الغرض النوعي الخارجي:
تارةً: لا تكون له نكتة عقلائيّة ارتكازيّة، فيقتصر حينئذٍ على مورده.
واُخرى: تكون له نكتة عقلائيّة ارتكازيّة يُحتمل اختصاصها بالمورد، ولا يوجد ارتكاز عقلائي على عدم الفرق بين ذلك المورد ومورد آخر، وهنا أيضاً يقتصر على المورد الخاصّ.
وثالثةً: يوجد ارتكاز عقلائي يحكم بعدم الفرق، فيتولّد لكلام الشارع ظهورٌ ثانوي في العموم والإطلاق، فيتعدّى.
وهذا ليس قياساً؛ إذ في القياس لا يفرض ارتكازُ عدم الفرق بين مورد النصّ وموردٍ آخر، وإنّما يوجد ظنٌّ خارجي بعدم الفرق، غاية ما هناك أن تكون كبرى القياس نفسها وأماريّته ارتكازيّةً مثلاً، وهذا لا يولّد للكلام ظهوراً نأخذ به، بخلاف فرض ارتكاز عدم الفرق، حيث يولّد الظهورَ [المذكور]: فلو سئل عن ماء في حبّ على باب المسجد وقعت فيه ميتة فقال: «أهرقه»، لم يقتصر طبعاً على قيود المورد من كون الماء في حبّ، وكونه موضوعاً على باب المسجد. والتعميم والتضييق بواسطة الارتكاز هو شغل الفقهاء في موارد لا تحصى[18]، إلّاأ نّه أحياناً - ولشدّة وضوح الارتكاز - يُغفل عن كون هذا الظهور وليداً للارتكاز، ويتخيّل أ نّه ظهورٌ لِحاقِّ اللفظ ابتداءً.
وبالجملة، فالنهي المتوجِّه إلى معاملةٍ من المعاملات:
أ - تارةً: لا يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق بين مورده ومورد آخر، فلا يتعدّى، كما لو قال: «لا تبع في يوم السبت»، فلا يتعدّى إلى الصلح مثلاً؛ فإنّه لا يوجد هنا نكتةٌ مركوزةٌ رأساً، وإنّما هو حكمٌ تعبّديٌّ صرف يُقتصر على مورده.
وكذلك لو قال: «لا تبع معلّقاً»، أو «مع الغرر»، أو «مع عدم معلوميّة العوضين»، أو «بغير صيغة الماضي» مثلاً، فإنّه وإن كانت هنا نكتةٌ ارتكازيّة (وهي الرغبة في إحكام البيع، وجعله غير قابل لوقوع شيءٍ من الكلام والشجار والتزلزل فيه مثلاً)، إلّاأنّ ارتكاز عدم الفرق بينه وبين الصلح غير موجود؛ فلعلّ الشارع أراد أن يكون في الشريعة عقدٌ محكم وآخر غير محكم، حتّى إذا ناسب هدفُ المتعاملين الإحكامَ التجآ إلى الأوّل، وإلّا صحّ لهما الأخذ بالثاني مثلاً.
وكذلك لو نهى عن هبة الدَّين على من هو عليه، فلا يتعدّى إلى الإبراء؛ لاحتمال أنّ هبته - مثلاً - غير معقولة عند الشارع، فيكون النهي متعلّقاً بالغرض العقدي الخاصّ مثلاً.
ولو نهى عن بيع حقّ الشفعة، فلا يتعدّى إلى إسقاطه في ضمن الهبة؛ إذ لعلّه نهى عن الغرض العقدي الخاصّ باعتبار عدم كونه مالاً في نظره، فلا يقابل بالمال، ولا بأس بإسقاطه في ضمن عقد.
ب - واُخرى: يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق، كما لو قال: «لا تبع في يوم الجمعة وقت النداء»؛ فإنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي كون هذا النهي إنّما هو باعتبار إشغال ذلك عن العبادة والصلاة، من دون فرق بين أن يجريَه بصيغة البيع أو بصيغة الصلح مثلاً، فيتعدّى إلى صيغة الصلح.
وكما لو نهى عن بيع مال الغير؛ فإنّه يتعدّى إلى هبته أو التصالح عليه ونحو ذلك؛ إذ النكتة في ذلك حرمة مال الغير وسلطنة مالكه عليه، من دون فرق بين معاملة واُخرى.
إذا عرفت هاتين المقدّمتين، فنقول: إنّ النهي في باب الربا متعلّق - بحسب مناسبات الحكم والموضوع - بالغرض النوعي الخارجي، والنهي المتعلّق بالغرض النوعي الخارجي:
تارةً: لا يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق بين مورده ومورد آخر، فلا يتعدّى منه إليه. ومثاله: ما لو نهى عن استئجار المرأة للعمل الجنسي؛ فإنّ هذا نهيٌ عن الغرض النوعي الخارجي بحسب الارتكاز العقلائي، فليس الفساد في مجرّد إيقاع العقد أو الغرض العقدي، وإنّما الفساد في العمل الخارجي. ولا يتعدّى من الاستئجار إلى الزواج؛ فإنّ هذا النهي كأ نّه نهيٌ بلحاظ حرمة المرأة وكرامتها، وأ نّها أشرف من أن يمتلك بضعها بالاستئجار، وإنّما يجب أن يكون الاستمتاع بها في إطارٍ خاصّ محترم، وهو الزوجيّة، فلا يتعدّى من الاستئجار إلى الزوجيّة. نعم، يتعدّى إلى البيع والهبة ونحو ذلك.
واُخرى: يوجد فيه ارتكاز عدم الفرق بين مورده ومورد آخر، كما في النهي عن القرض الربوي؛ فإنّه - بمناسبات الحكم والموضوع - نهيٌ بلحاظ الغرض النوعي؛ لما فيه من المفاسد، ويتعدّى عنه إلى كلّ معاملة يكون الغرض النوعي منها هو الإلزام بالزيادة.
وأقصد بقولي: إنّ الغرض النوعي منها هو الإلزام بالزيادة: أن يكون طبع المعاملة سنخ طبع يوضح بنفسه أنّ المقصود به هو الإلزام بالزيادة. وأمّا إذا لم تكن المعاملة نفسها تستبطن ذلك، وإنّما كان الغرض الشخصي منها هو الزيادة، فلا بأس بذلك. ولو فرض أن تعوّد الناس عليه واشتهر هذا العمل، فبهذا لا يخرج عن كونه غرضاً شخصيّاً مباحاً.
نعم، للدولة الإسلاميّة الشرعيّة حينما ترى المصلحة النهيُ عن ذلك.
ومثال ما يكون طبع المعاملة فيه يقتضي كون الغرض هو الإلزام بالزيادة:
ما كنّا نتكلّم فيه، من أ نّه يبيع مائة دينار نقدي بمائة وعشرين ديناراً مؤجّلاً؛ فإنّه من الواضح أنّ الغرض من ذلك هو الإلزام بالزيادة. وكذلك لو باع شيئاً رخيصاً بقيمة غالية واشترط في ضمن البيع على البايع إقراض المشتري؛ فإنّ الغرض النوعي من ذلك عين الغرض النوعي من العكس، أي أن يقرض شيئاً ويشترط في ضمن القرض البيع المحاباتي.
وهناك رواية قد يستفاد منها جواز هذه الحيلة، أعني البيع المحاباتي مع اشتراط القرض، وهي رواية محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: «إنّ سلسبيل[19] طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف، فأقرضها[20] تسعين ألفاً وأبيعها ثوب وشي[21] تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس»[22].
١ - فإن قلنا: إنّ هذه الرواية لا تدلّ على أنّ الإقراض اخذ شرطاً في ضمن عقد البيع المحاباتي، وإنّما كان اتّفاقاً خارجيّاً دون أن يصبح البائع ملزماً بالإقراض، فتكون الرواية خارجةً عمّا نحن فيه.
٢ - وإن قلنا: إنّها تدلّ على ذلك:
أ - فإن قلنا: إنّ الملازمة بين حرمة الربا وبين حرمة ذلك تكون بدرجةٍ لا يقبل العرف التفكيك بينهما، فالرواية تصبح معارضةً لآية حرمة الربا، وتسقط عن الحجّيّة.
ب - وإن قلنا: إنّ الملازمة ليست بأقوى من الظهور [الإطلاقي]، فيكفينا حينئذٍ ضعف سند هذه الرواية[23].
ومثال ما تكون الزيادة فيه غرضاً شخصيّاً: أن يبيع داره بمائة دينار مع خيار الشرط على رأس السنة، والزيادة التي يأخذها المشتري هي منفعة الدار؛ فإنّ هذا لا بأس به؛ إذ طبع المعاملة ليس سنخ عمل ينحصر غرضه في الزيادة:
فقد يفكّر شخص ببيع داره لغرضٍ من الأغراض مع جعل خيار الشرط؛ لاحتمال الندم، دون أن يكون غرضه ولا غرض المشتري مسألة القرض الربوي.
ولو باع كتابه بثمن رخيص على نحو المحاباة مع إرجاعه بثمن أغلى:
فإن كان الإرجاع بمحض اختيار المشتري - ولو مع الاتّفاق عليه خارج المعاملة، من دون أن يكون ملزماً بذلك في ضمن العقد الأوّل - فلا بأس به؛ فإنّ طبع البيع المحاباتي لا يوحي بمسألة الزيادة الربويّة، بل قد يكون الشخص محتاجاً واقعاً إلى بيع كتابه، فيبيعه بالمحاباة.
وإن اشترط في ضمن العقد الأوّل الإرجاع بثمن أغلى، أصبح هنا الإلزام بالزيادة غرضاً نوعيّاً للمعاملة، فيأتي إشكال الربا.
وقد تحصّل من تمام ما ذكرناه: عدم صحّة بيع مائة دينار نقدي بمائة وعشرين ديناراً مؤجّلاً مثلاً، وإن كان الدينار في زماننا من غير جنس النقدين.
نصوص جواز البيع بالأكثر ونقد مدركيّتها لصحّة التخريج الربويّ الأوّل:
إلّاأنّ هنا إشكالاً، وهو أنّ روايات جواز البيع بالأكثر في غير المكيل والموزون تدلّ بإطلاقها على جواز ذلك، ولو مع كون الأكثر مؤجّلاً، ولو في بيع الدينار. إذن: تلك الروايات تدلّ بإطلاقها على صحّة هذه المعاملة.
والجواب عن هذا الإشكال أ نّه:
أ - إن قلنا: إنّ التفكيك بين حرمة الربا القرضي وبين حرمة هذه المعاملة غير ممكن عقلائيّاً، بحيث يعدّ دليل حرمة الربا القرضي كالنصّ في حرمة هذه المعاملة، فتلك الإطلاقات تقيّد - لا محالة - بدليل حرمة الربا القرضي الدالّ على حرمة هذه المعاملة الأخصّ من تلك المعاملات.
ب - وأمّا إن قلنا: إنّ دلالة دليل حرمة الربا القرضي على حرمة هذه المعاملة تكون بمستوى الإطلاق، فلا أقلّ من أ نّهما يتعارضان ويتساقطان، وتصل النوبة إلى المطلقات الفوقيّة الدالّة على حرمة الربا، الشاملة للربا القرضي والربا المعاملي، من دون فرق فيه بين المكيل والموزون وغيره، أو بين الحالّ والمؤجّل.
التخريج الثاني: وضع الجُعالة على القرض:
أن يجعل جُعالةً على القرض، بأن يقول: «من أقرضني كذا مقدار من المال فله كذا مقدار»، فتكون الزيادة مستحقّةً بإزاء العمل - وهو الإقراض - لا بإزاء المال حتّى يكون ربا. ولذا: لو فرض أنّ الجعالة كانت باطلةً بسببٍ من الأسباب وكان القرض صحيحاً، فهو لا يستحقّ حينئذٍ شيئاً من الزيادة.
ويرد على هذا التخريج:
أوّلاً: إنّ الغرض النوعي الظاهر من نفس المعاملة هو الزيادة، ويُصبح بالاقتراض مُلزماً بأداء الزيادة، فيأتي فيه ما مضى من التعدّي عن مورد دليل حرمة الربا إلى هذا المورد بارتكاز عدم الفرق.
ثانياً: إنّ هذه المعاملة باطلة في نفسها، وتوضيح ذلك يكون بتحقيق معنى الجعالة بنحوٍ ينكشف منه معنى جملة من أبواب المعاملات، من قبيل المضاربة والمزارعة والمساقاة والمغارسة ونحو ذلك من الأبواب، فنقول:
حقيقة الجعالة:
يتصوّر في الجعالة بدواً ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأوّل: أن تكون معاوضةً بين العمل والجُعل. وهذا الاحتمال ساقطٌ حتماً، فقهيّاً وعقلائيّاً، وذلك بالتسالم فتوىً وارتكازاً على أ نّه لا معاوضة بين العمل وبين الجُعل في باب الجعالة، وإلّا كان الجاعلُ يستحقّ العملَ في مقابل هذا الجُعل، مع أ نّه لا يستحقّه في مقابله.
وهذا هو الفرق بين باب الجعالة وباب الإجارة: ففي إجارة الأعمال يكون المستأجر مستحقّاً للعمل على الأجير، بخلاف باب الجعالة.
الاحتمال الثاني: أن يفرض أنّ الجعالة تمليكٌ للمال تمليكاً مشروطاً بالعمل، فبابه باب التمليك المجّاني، لكنّه معلّق على العمل، ويلتزم بأنّ هذا التعليق قد صحّ في المقام على خلاف القواعد الأوّليّة التي تقتضي عدم صحّة التمليك المعلّق، فلا يمكن أن يقول مثلاً: «لك هذا الدرهم إن أمطرت السماء».
لكن في خصوص موارد الجعالة صحّ ذلك، على خلاف القاعدة.
وهذا الاحتمال وإن كان أقرب من الاحتمال الأوّل، لكنّه أيضاً على خلاف الارتكاز الفقهائي والعقلائي؛ إذ لو حسبنا ما هو المركوز في الأذهان الفقهائيّة والعقلائيّة لرأينا أ نّه لا يمكن أن يفسّر على أساس هذا الاحتمال، وذلك:
أوّلاً: لا إشكال في أنّ المركوز في هذه الأذهان أنّ الجعالة ليست تمليكاً مجّانيّاً وهبةً مشروطة ومعلَّقة، ولهذا يسمّى الدرهم: «جُعلاً على العمل»، وهذا معناه أ نّه اخذ في معنى الجعالة التعويض بمعنىً من المعاني.
ثانياً: لا إشكال - بحسب النصّ والفتوى فقهائيّاً، وبحسب الارتكاز عقلائيّاً - في أ نّه إذا تبيّن بطلان الجعالة لسبب من الأسباب، يُرجع إلى اجرة المثل، كما صرّح بذلك الفقهاء[24]، ولا موجب لضمان اجرة المثل لو لم يكن هنا طعم المعاوضة، وإنّما كان مجرّد تمليك مجّاني تبيّن بطلانه، من دون أن يكون العامل قد أقدم على العمل بعنوان المعاوضة حتّى يقال: لو لم يسلّم له المسمّى ثبتت له قيمة المثل والبدل الواقعي بقواعد الضمان.
ثالثاً: من المصرّح به والمتسالم عليه فقهائيّاً - وهو على طبق الارتكاز العقلائي أيضاً - أ نّه إذا جعل جُعلين مختلفين؛ فقال أوّلاً: «لك عليّ درهم لو وجدت لي ضالّتي»، ثمّ قال [ثانياً]: «لك عليّ دينار لو وجدت لي ضالّتي»، كانت الجعالة الثانية ناسخةً للجعالة الاُولى. وهذا معناه وجود نوعٍ من المنافاة والمعارضة بالارتكاز بين الجعالتين، فتكون الثانية ناسخةً للاُولى.
ولو كانت مجرّد هبةٍ مشروطة فأيّ منافاةٍ بين الهبتين؟! ولماذا لا تصحّ كلتاها معاً؟! ومجرّد كونهما معلّقتين على شيء واحد لا يوجب منافاةً بينهما، كما هو واضح.
فعلى أساس هذه القرائن الثلاث - وقرائن اخرى يمكن تصيّدها من فقه الجعالة - يُعرف أنّ باب الجعالة ليس باب التمليك المجّاني الصّرف.
الاحتمال الثالث: وهو الصحيح، وحاصله: أنّ أحد موجبات ضمان العمل المحترم عقلائيّاً على الإنسان هو التسبيب: فلو أمر الحلّاق بأن يحلق رأسه دون أن يتعامل معه أو يجري معه عقد الإجارة، كان ضامناً لقيمة الحلاقة السوقيّة، وهذا الضمان هو ضمان الغرامة، من قبيل ضمان اليد بالنسبة إلى الأموال.
والأصل الأوّلي في ضمان الغرامة هو الضمان بالقيمة الواقعيّة، كما أنّ الأصل الأوّلي في ضمان الأموال هو الضمان بالقيمة الواقعيّة، ولكن كما قلنا في ضمان الأموال
إنّه وإن كان الأصل الأوّلي فيه هو الضمان بالقيمة، لكن يمكن للضامن والمضمون له أن يتّفقا على بدل معيّن يكون به الضمان، فيكون قانون ضمان الغرامة نفسه مقتضياً حينئذٍ لهذا البدل: فهذا القانون له اقتضاءان طوليّان: أحدهما: الضمان بالقيمة السوقيّة، وثانيهما: ضمان ما اتفقا أن يكون به الضمان.
ويأتي الكلام نفسه في المقام، فنقول: إنّ الجعالة في الحقيقة ليس بابها باب المعاوضة ولا باب المجّانيّة، بل باب التسبيب إلى العمل مع تعيين بدل الغرامة وتحويله من القيمة السوقيّة إلى شيء آخر؛ فالبدليّة المطعّمة في باب الجعالة هي بدليةُ باب الغرامة لا باب المعاوضة.
وهذه هي الحال أيضاً في المزارعة والمساقاة والمغارسة والمضاربة ونحو ذلك. وبهذا يُتحفّظ على النقاط الثلاث الارتكازيّة الماضية، وهي: ارتكازيّة البدليّة، وأ نّه لو بطلت الجعالة يُنتقل إلى القيمة السوقيّة؛ إذ مع بطلان التحديد الخارجي لما يضمن يُرجع إلى القاعدة الأوّليّة، وأ نّه إذا جعل جعالتين كانت الثانية ناسخةً؛ إذ ضمان الغرامة يستحيل أن يتحدّد بتحديدين مختلفين.
وبهذا كانت هذه الأبواب في مقابل الإجارة؛ لأنّ الإجارة تمليكٌ بعوض، وفي هذه الأبواب يحدّد ضمان الغرامة المفروض ثبوته في المرتبة السابقة.
وبناءً على هذا نقول: إنّ جعل الزيادة على القرض بنحو الجعالة غير معقول؛ لأنّ عمليّة القرض ليس لها ضمان ولا قيمة وراء قيمة المال المقترض نفسه، وليس هناك - مُسبقاً وقبل الجُعل - بدلان: أحدهما في مقابل المال، والثاني في مقابل نفس الإقراض؛ فلو جعل جُعلاً في مقابل الإقراض زائداً على ما هو في مقابل نفس المال، كان معنى ذلك ثبوت بدلين: أحدهما في مقابل نفس المال، والثاني في مقابل الإقراض، مع أ نّه لا ماليّة للإقراض عدا ماليّة المال المقترض نفسها، وليس له ماليّة اخرى وراء ماليّة ذلك المال.
ولا معنى لأن يفرض وجود ضمانين لهذه الماليّة الواحدة: أحدهما بعقد القرض، والآخر بعقد الضمان، وقد فرضنا أنّ الجعالة تعيينٌ للضمان المفروض مسبقاً.
إذن: لو صحّت الجعالة في المقام وصحّ القرض لكان معنى ذلك ثبوت ضمانين لهذه الماليّة الواحدة.
هذا تمام الكلام في التخريج الثاني ومناقشته، ونقتصر على هذين التخريجين؛ إذ بما ذكرنا فيهما اتّضحت صناعة التخريجات فی المقام[25]
[الملحق (١) مناقشة التخريجات التي تحوّل الفائدة إلى كسب محلّل]
يعالج هذا الملحق - على مستوىً موسّعٍ من الناحية الفقهية - التخريجات المتعدّدة التي تستهدف تحويل الفائدة إلى كسبٍ محلّلٍ وتطويرها بشكلٍ مشروع، مع مناقشة تلك التخريجات.
لاحظنا في وضع سياسة البنك اللاربوي تجاه الفوائد الربوية على القروض أن تصاغ بشكلٍ يميّزها بقدر الإمكان نصّاً وروحاً عن فكرة الربا المحرَّم في الإسلام.
وأمّا إذا قطعنا النظر عن هذه الملاحظة فهناك تخريجات فقهية متعدّدة يمكن تصويرها بصدد محاولة تحويل الفائدة إلى وجهٍ مشروع. ولكي يستكمل البحث عناصره الفقهية نذكر في ما يلي أهمّ ما يمكن أن يقال أو قيل فعلاً من هذه التخريجات مع مناقشتها:
[التخريج الأوّل:] إنّه في القرض يتمثّل عنصران:
أحدهما المال المقترَض من الدائن للمدين، والآخر نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من المقرض. والربا: هو وضع زيادةٍ بإزاء المال المقترَض. فالفائدة حيث توضع في مقابل المال المقترَض تصبح رباً محرَّماً، ولكنّها إذا فرضت بإزاء نفس الإقراض بما هو عمل يصدر من الدائن على أساس الجُعالة تخرج بذلك عن كونها رباً.
فالشخص الذي يحاول أن يحصل على قرضٍ يقوم بإنشاء جُعالةٍ يعيّن فيها جُعلاً معيّناً على الإقراض، فيقول: من أقرضني ديناراً فله درهم. وهذه الجعالة تُغري مالك الدينار فيتقدم إليه ويقرضه ديناراً، وحينئذ يستحق عليه الدرهم، وهذا الاستحقاق لا يجعل القرض ربوياً؛ لأنّه ليس بموجب عقد القرض، بل هو استحقاق بموجب الجعالة.
ولهذا لو فرض أنّ الجعالة انكشف بطلانها بوجهٍ من الوجوه ينتفي بذلك استحقاق المقرِض للدرهم وإن كان عقد القرض ثابتاً؛ لأنّ استحقاق الدرهم نتج عن الجعالة، لا عن عقد القرض. والدرهم في الجعالة موضوع بإزاء الإقراض بما هو عمل، لا بإزاء المبلغ المقترَض بما هو مال.
فهذا نظير من يجعل جعالةً لمن يبيعه بيته، فلو قال شخص: من باعني داره كان له درهم، كان البائع مستحقّاً للدرهم لا بموجب عقد البيع، بل بموجب الجعالة، وهو بإزاء نفس البيع والتمليك بعوضٍ بما هو عمل، لا بإزاء الدار المبيعة.
ولهذا لا يسري على الدرهم حكم العوضين.
والكلام حول هذا التقريب من جهتين: الاُولى من جهة الصغرى. والثانية من جهة الكبرى.
أمّا من جهة الصغرى فقد فرض في هذا التقريب أنّ الدرهم موضوع بإزاء نفس عملية الإقراض، لا على المال المقترَض، ولكن يمكن أن يقال بهذا الصدد:
إنّ الارتكاز العقلائي قائم على كون الدرهم في مقابل المال المقترَض، لا في مقابل نفس الإقراض، وجعله بإزاء عملية الإقراض مجرّد لفظ.
وعليه فلا نتصور الجعالة في ذلك؛ لأنّ الجعالة فرض شيءٍ على عمل لا على مال. وبعد إرجاع الدرهم في محلّ الكلام بالارتكاز العقلائي إلى كونه مجعولاً في مقابل المال لا تكون هناك جعالة، بل يكون الدرهم ربوياً؛ لأنّه زيادة على المال المقترَض.
وأمّا من جهة الكبرى بمعنى أ نّا لو افترضنا أنّ المتعاملَين - الدائن والمدين - تحرّرا من ذلك الارتكاز العقلائي واتّجهت إرادة المدين حقيقةً إلى جعل الدرهم بإزاء نفس عملية الإقراض فهل هذه الجعالة صحيحة أو لا؟
ولكي نعرف جواب ذلك لابدّ أن نعرف حقيقة الجُعالة، فإنّه يمكن القول فيها: إنّ استحقاق الجعل المحدّد في الجعالة ليس في الحقيقة إلّابملاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه التبرّع، فأنت حين تأمر الخيَّاط الخاصّ بأن يخيط لك الثوب فيمتثل لأمرك تضمن قيمة عمله وتشتغل ذمّتك باُجرة المثل.
وهذا نحوٌ من ضمان الغرامة في الأعمال على حدِّ ضمان الغرامة في الأموال، وبإمكانك في هذه الحالة أن تحوِّل اجرة المثل منذ البدء إلى مقدارٍ محدّد، فتقول:
من خاط الثوب فله درهم، أو إذا خِطْتَ الثوب فلك درهم، فيكون الضمان بمقدار ما حدّد في هذا الجعل، ويسمّى هذا جعالة.
فالجعالة بحسب الارتكاز العقلائيّ تنحلّ إلى جزأين: أحدهما الأمر الخاصّ أو العام بالعمل، أي بالخياطة مثلاً. والآخر تعيين مبلغٍ معيّنٍ بإزاء ذلك.
والجزء الأوّل من الجعالة هو ملاك الضمان، والضمان هنا من قبيل ضمان الغرامة، لا الضمان المعاوضي.
والجزء الثاني يحدّد قيمة العمل المضمونة بضمان الغرامة، حيث إنّ اجرة المثل هي الأصل في الضمان ما لم يحصل الاتفاق على الضمان بغيرها.
وإذا تحقّق هذا فيترتّب عليه أنّ الجعالة لا تُتَصوّر إلّاعلى عملٍ تكون له اجرة المثل في نفسه وقابل للضمان بالأمر به، كالخياطة والحلاقة.
وأمّا ما لا ضمان له في نفسه ولا تشمله أدلّة ضمان الغرامة فلا تصحّ الجعالة بشأنه؛ لأنّ فرض الجعل في الجعالة ليس هو الذي ينشى أصل الضمان، وإنّما يحدّد مقداره.
وعلى هذا الأساس لا تصحّ الجعالة على الإقراض بما هو عمل؛ لأنّ مالية الإقراض في نظر العقلاء إنّما هي مالية المال المقترض، وليس لنفس العمل بما هو مالية زائدة. ومع فرض كون مالية المال المقترَض مضمونةً بالقرض فلا يتصوّر عقلائياً ضمان آخر لمالية نفس عملية الإقراض.
وبتعبيرٍ واضح ليس عندنا في نظر العقلاء إلّاماليَّة واحدة، وهي مالية المال المقترض، وتضاف إلى نفس عملية الإقراض باعتبار ذلك المال، فليس هناك إلّا ضمان غرامةٍ واحد، ولا يتصوّر في الارتكاز العقلائي ضمانان من ضمانات الغرامة: أحدهما للعمل، والآخر للمال المقترض، والمفروض أنّ المال المقترَض مضمون بعقد القرض، والضمان الحاصل بعقد القرض هو من نوع ضمان الغرامة، وليس ضماناً معاوضياً، ومعه فلا مجال لفرض ضمان غرامةٍ آخر لنفس عملية الإقراض.
وبناءً على ذلك لا تصحّ الجُعالة على الإقراض؛ لأنّ الجُعالة دائماً تقع في طول شمول أدلّة ضمان الغرامة للعمل المفروض له الجعل، ففي موردٍ لا تشمله أدلّة ضمان الغرامة ولا يكون العمل فيه مضموناً بالأمر على الآمر لا تصحّ فيه الجعالة.
[التخريج الثاني:] إنّ الفائدة إنّما تحرم بوصفها تؤدّي إلى ربويَّة القرض، والقرض الربويّ حرام.
وأمّا إذا حوّلنا العملية من قرضٍ إلى شيءٍ آخر فلا تكون الفائدة رباً قرضياً، وتصبح بالتالي جائزة. وأمّا تحويل العملية من قرضٍ إلى شيءٍ آخر فيتمّ إذا استطعنا أن نميِّز بين الحالتين التاليتين:
الاُولى: إذا افترضنا أنّ زيداً مَدينٌ لخالد بعشرة دنانير ومطالب بوفائها فيأتي إلى البنك ويقترض عشرة دنانير ويسدّد بها دَيْنه.
الثانية: أنّ زيداً في الفرض السابق يتّصل بالبنك ويأمره بتسديد دَيْنه ودفع عشرة دنانير إلى خالد وفاءً لِما لَه في ذمّته.
والنتيجة واحدة في الحالتين، وهي أنّ زيداً سوف تبرأ ذمّته من دين خالد عليه، وسوف يصبح مديناً للبنك بعشرة دنانير، ولكنّ الفارق الفقهي بين الحالتين أنّ زيداً في الحالة الاُولى يمتلك من البنك عشرة دنانير معيّنةً على أن يصبح مديناً بقيمتها، وهذا هو معنى القرض، فإنّه تمليك على وجه الضمان. وأمّا في الحالة الثانية فزيد لايمتلك شيئاً، وإنّما تشتغل ذمّته ابتداءً بعشرة دنانير للبنك من حين قيام البنك بتسديد دينه. واشتغال ذمّته بذلك قائم على أساس أنّ البنك بوفائه من ماله الخاصّ لدَين زيدٍ قد أتلف على نفسه هذا المال، ولمّا كان هذا الإتلاف بأمرٍ من زيدٍ فيضمن زيد قيمة التالف، فالعشرة التي دفعها البنك إلى دائن زيدٍ لم تدخل في ملكية زيد، وإنّما هي ملك البنك ودخلت في ملكية دائن زيدٍ رأساً؛ لأنّ وفاء دين شخصٍ بمال شخصٍ آخر أمر معقول، كما حقّقناه في محلّه، وهذا معناه أ نّه لم يقع قرض في الحالة الثانية، وإنّما وقع أمر بإتلافٍ على وجه الضمان. فلو التزم زيد للبنك حين إصدار الأمر له بالوفاء بأن يعطيه أكثر من قيمة الدين إذا امتثل الأمر لم تكن هذه الزيادة الملتزم بها موجبةً لوقوع قرضٍ ربوي؛ لأنّ الضمان ليس ضماناً قرضياً، وإنّما هو ضمان بسبب الأمر بالإتلاف.
وبتعبيرٍ آخر: أنّ الربا المحرّم إنّما يكون في المعاملة كعقد القرض أو البيع أو الصلح ونحو ذلك، وأمّا ضمان الغرامة بقانون الأمر بالإتلاف فهو لا يستبطن تمليكاً معاملياً فلا يجري فيه الربا المحرّم، فلا يكون فرض زيدٍ في هذه الحالة فائدةً للبنك من الفائدة القرضية المحرّمة.
ويمكن المناقشة في هذا التقريب بأمرين:
الأوّل: أنّ الدليل الدالّ على حرمة إلزام الدائن مدينَه بزيادةٍ على الدين الذي حصل بالقرض يدلّ عرفاً - وبإلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي - على حرمة إلزام الدائن مدينَه بالزيادة فيما إذا كان الدين حاصلاً لا بسبب القرض، بل بسبب الأمر بالإتلاف، كما في المقام بحسب الفرض؛ لأنّ التفرقة بين الحالتين تعني أنّ المدين إذا أصبح مديناً في مقابل تملّك شيءٍ بالقرض فلا يجوز إلزامه بالزيادة، وإذا أصبح مديناً لا في مقابل تملّك شيءٍ فيجوز إلزامه بالزيادة، فكأنّ تملّك شيءٍ له دخل في الإرفاق به وتحريم إلزامه بالزيادة، وهذا على خلاف الارتكاز العرفي، وعليه فتثبت حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية أيضاً.
الثاني: أ نّا إذا سلّمنا عدم حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية لعدم كونها زيادةً في عقد القرض فلابدّ من سببٍ معامليّ يجعل المدين ملزماً بدفع الزيادة، والمفروض عدم وجود عقد القرض لكي يُشترط على المدين في ضمن ذلك العقد دفع الزيادة.
وقد يراد تصوير هذا السبب عن طريق جُعالةٍ يجعلها زيد فيقول للبنك: إذا سددت ديني البالغ عشرة دنانير فلك دينار، فيستحقّ البنك حينئذٍ عشرة دنانير بقانون ضمان الغرامة، وديناراً بقانون الجُعالة بإزاء عمله وهو تسديد الدين، وهذه الجعالة تختلف عن الجعالة التي مرّت بنا في الوجه السابق؛ لأنّ تلك جعالة على عملية الإقراض، أي بإزاء التمليك على وجه الضمان. وأمّا هذه فليست جعالةً على التمليك؛ لِمَا تقدّم من أ نّه لا يوجد تمليك من البنك لزيدٍ في الحالة الثانية التي ندرسها الآن، وإنّما هي جعالة على تسديد البنك لدين زيدٍ على أساس أنّ هذا التسديد عمل محترم يمكن فرض جعالةٍ له.
ولكن بالرغم من هذا فإنّ هذه الجعالة تواجه نفس الاعتراض الذي أثرناه على الجعالة المتقدّمة في التقريب السابق؛ لأنّ تسديد البنك لدين زيدٍ ليس له ماليَّةٌ إضافية وراء مالية نفس المال الذي يسدّده لخالد بعنوان الوفاء. والمفروض أنّ هذا المال المسدَّد مضمون فلا يتحمّل المورد ضماناً آخر لنفس عملية التسديد.
وإذا لم يُتصوّر الضمان لم تصحَّ الجعالة؛ لِمَا تقدّم من أ نّها لا تنشى الضمان، وإنّما تحدِّده في الجعل المعيَّن.
نعم، إذا افترضنا أنّ تسديد البنك لدين زيدٍ كانت له قيمة مالية زيادةً على القيمة المالية للمال المسدَّد جاء فيه ضمان الغرامة، وبالتالي صحَّت الجعالة فيه، وذلك كما إذا كان تسديد البنك لدين زيدٍ يتمثّل في جهدٍ زائدٍ على مجرّد دفع المال إلى دائن زيد، وذلك حين يكون دائن زيدٍ في بلدٍ آخر مثلاً ويأمر زيدٌ البنكَ بإرسال مبلغٍ من المال إلى ذلك البلد ودفعه إلى دائنه، فإنّ ممارسة البنك لهذه العملية لها قيمة مالية زائدة على القيمة المالية لنفس المال المدفوع، وهذه القيمة المالية الزائدة مضمونة على زيدٍ بسبب أمره للبنك بتسديد دينه وتحويله إلى دائنه، وفي مثل هذه الحالة يمكن لزيدٍ أن يقوم بجعالةٍ معيّنةٍ فيجعل للبنك جعلاً خاصّاً على عملية التحويل والتسديد[26]
[1] أو على المالك المضارِب بتعبيرٍ فقهي أصحّ؛ لأنّ المالك المضارب (المودِع) هو المالك في الأصل للربح كلّه فيمكن للبنك أن يلزمه بشرطٍ شرعي، مثلاً: بأن يتنازل عن نسبةٍ معيّنةٍ من أرباحه عند ظهورها، وعدم كون مقدار النسبة محدّداً لا يضرّ بصحة الشرط. وكما يمكن هذا، يمكن أيضاً من الناحية النظرية فقهياً أن يفرض كون حصّة العامل من الربح مشتملةً على تلك النسبة التي يتوقّعها البنك، ويلزم البنك حينئذٍ العامل بملزمٍ شرعيّ بالتنازل عن تلك النسبة من حصّته عند ظهور الأرباح. ولأجل التوسّع في تحقيق ذلك من الناحية الفقهية راجع الملحق رقم (٣) في آخر الكتاب. (المؤلّف قدس سره)
[2] صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، قم - ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: ۴، صفحه:۵۲-۵۷
[3] صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، قم - ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: ۴، صفحه:۷۰- ۷۱
[4] كما ذكر قدس سره تحت عنوان: (الإشكال الثاني: معارضة نصوص المكيل والموزون)
[5] لم نعثر على هذا التفصيل بهذه الصورة في تقريرات دروس السيّد الخوئي رحمه الله في دورتَيه الاُولى والثانية: (محاضرات في الفقه الجعفري)، (مصباح الفقاهة) و (التنقيح)، ويُحتمل أن يكون الشهيد الصدر قدس سره قد سمع منه هذه العبارات شفاهاً، وربما يؤيَّد ذلك بما يأتي منه قدس سره بعد قليل حيث يقول: «ونحن حينما كنّا نورد عليه (مدّ ظلّه) هذا الإشكال...»
[6] «إذ كما عرفت: يُمكن فرض أحد العوضين دنانير [من فئة] الآحاد مثلاً والآخر أوراقاً، كلّ ورقة منها من فئة عشرة دنانير، وما شابه ذلك». (منه قدس سره)
[7] المائدة: ١
[8] وسائل الشيعة ١٣٣:١٨، الباب ٦ من أبواب الربا، الحديثان ١ و ٣
[9] وسائل الشيعة ١٥٥:١٨، الباب ١٧ من أبواب الربا، الحديث ١
[10] انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل ٤٢٥:٨. ولكن لم يُتّفق على جوازه في النسيئة، فراجع: النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى ٣٧٨:١؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ٢٦٠:٢
[11] «حتماً لو ضممنا الوجهين أحدهما إلى الآخر - ولعلّه المقصود له في الوجه الثاني - لم يرد عليه هذا الإشكال» (المقرّر)
[12] تقدّم الحديث عن هذه المباني في أوّل البحث
[13] وهي: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»، فراجع: عوالي اللآلئ ٢١٢:٣، الحديث ٥٩؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ٣٠٣:١٣، الباب ٩ من أبواب الخيار، الحديث ١، وهو نبويٌّ جبره بعض الفقهاء بعمل الأصحاب كافّة، فراجع: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٨٣:٢٣
[14] كأنْ يعقد على الصغيرة لساعةٍ لتحرم عليه امّها، ولذلك لم يصحّح بعضهم العقد المنقطع فيما لو جعل المدّة بمقدار لا يصل إلى البلوغ (نموذج في الفقه الجعفري: ٢٤٥). والأرجح أ نّه قدس سره يقصد الميرزا القمّي رحمه الله في رسالته حول العقد على الصغيرة، فراجع: رسائل الميرزا القمّي ٣١١:١
[15] وسائل الشيعة ٤٠٨:٧، الباب ٥٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث ٤، بالمضمون
[16] راجع مثلاً: منهاج الصالحين (تعليقة الشهيد الصدر قدس سره) ٤١:٢، المسألة ١
[17] لاحظ ما ذكره قدس سره في: اقتصادنا: ٨٣٤، الملحق ٥
[18] «مثّل (مدّ ظلّه) للتضييق بجعل سراية النجاسة بالملاقاة مختصّةً بفرض الرطوبة، وإن كان لسان الدليل مطلقاً من هذه الناحية» (المقرّر)
[19] في بعض النسخ: «سلسيل» بدل: «سلسبيل»
[20] في الكافي: «فأقرضتها» بدل: «فأقرضها»
[21] في الكافي: «ثوباً وشيّاً» بدل: «ثوبَ وشيٍ»
[22] وسائل الشيعة ٥٤:١٨، الباب ٩ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١
[23] وذلك بعليّ بن حديد الذي ضعّفه كلّ من وجدناه قد تعرّض له من الفقهاء، وأوّلهم الشيخ رحمه الله، فراجع: الاستبصار ٤٠:١، ٩٥:٣
[24] وهذه قاعدة كلّيّة طبّقت على الجعل (المناهل: ٦١٣)، وراجع: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ١٥٤:١١؛ كفاية الأحكام ٥١٣:٢؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ١٩٣:٣٥
[25] صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، قم - ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: ۲۱، صفحه: ۳۵۹-۳۷۴
[26] صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، قم - ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: ۴، صفحه: ۱۶۷-۱۷۳
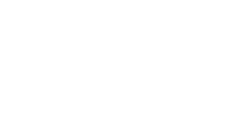
بدون نظر