التأویل فی مختلف المذاهب و الاراء
مفهوم التأويل
التأويل من «الأول» و هو الرجوع إلى الأصل. قال الراغب: و منه «الموئل» للموضع الذي يرجع إليه، و ذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علما كان أو فعلا. ففي العلم نحو: و ما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم[1]. و في الفعل كقول الشاعر:
|
و للنوى قبل يوم البين تأويل[2] |
و قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله[3]، أي: بيانه الذي هو غايته المقصودة منه، و قوله: ذلك خير و أحسن تأويلا[4] و[5]، أي: أحسن مآلا و عاقبة.
و الفرق بين «الأول» و «الرجوع»: أن «الرجوع» مأخوذ فيه العودة إلى حيث بدأ،
التأويل في مختلف المذاهب و الآراء، ص: ۱۰
يقال: رجع، أي: عاد إلى موضعه حيث كان. أما «الأول» فهو الانتهاء إلى الشيء الذي هو أصله و حقيقته، من غير أن يلحظ في مفهومه العودة.
و عليه فالتأويل: إرجاع لظاهر الكلام أو العمل إلى حيث حقيقته و أصله المراد منه، كما في باب المتشابهات من الأفعال[6] و الأقوال[7].
و هناك مصطلح آخر للتأويل، بمعنى: إرجاع ظاهر التعبير- الذي يبدو خاصا حسب التنزيل- إلى مفهوم عام يكون هو المقصود الأصل من الكلام. و قد اصطلحوا عليه بالبطن في مقابلة ظهر الآية، أي: المعنى العام الخابئ وراء ستار ظاهر اللفظ، و الذي انطوت عليه الآية في فحواها العام.
فالتأويل في باب المتشابهات هو توجيهها إلى وجهها المقبول، أما التأويل بمعنى البطن في مقابلة الظهر فهو الأخذ بمفهوم الآية العام بعد إعفاء ملابساتها الخاصة التي كانت تجعلها قيد التاريخ، و لتصبح الآية ذات رسالة خالدة عبر الدهور[8].
و جاء التأويل أيضا بمعنى تعبير الرؤيا في مواضع من سورة يوسف[9]، باعتبار أنها ترمز و تؤول إلى معان خافية يكشفها المعبر حسبما أوتي من علم بتأويل الأحاديث.
أما التأويل في دارج اللغة فيعني: الانتهاء إلى مآل الأمر و عاقبته المتوقعة، من خير أو شر: و زنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير و أحسن تأويلا[10] أي: أحسن
التأويل في مختلف المذاهب و الآراء، ص:۱۱
مآلا و عاقبة، هل ينظرون إلا تأويله أي: ماذا يؤول إليه أمر الإسلام يوم يأتي تأويله[11]، أي: تبدو لهم عاقبته السيئة لهم و لات حين مناص[12].
و قوله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله[13]، أي: كذبوا بهذا القرآن حيث لم يعرفوه المعرفة التامة و من جميع وجوهه، بل عرفوا منه معرفة ظاهرة سطحية، و من غير تعمق في اللب و الحقيقة، و من ثم كذبوا به، و لما يأتهم تأويله أي: و بعد لم يتبين لهم حقيقته الحقة الناصعة. فالتأويل هنا بمعنى التبيين الكاشف عن حقيقة الحال، و الناس أعداء ما جهلوا.
و التأويل بمعنى التفسير المتعمق فيه كان هو الشائع عند السلف، و منه دعاء النبي صلى الله عليه و اله لابن عباس: «اللهم، فقهه في الدين، و علمه التأويل»[14].
و الفقه هو الفهم الدقيق، كما أن التأويل هو التفسير العميق، و هكذا دأب أبو جعفر الطبري على التعبير بالتأويل في تفسيره للآيات. و لعل التعبير بالتأويل في باب المتشابهات جاء أيضا من ذلك، حيث هو تفسير متعمق فيه، لا يصلح له سوى من كان راسخا في العلم.
و عليه، فالتأويل بجميع التعابير الواردة فيه، سواء أكان بمعنى توجيه المتشابه أم الأخذ بمفهوم الآية العام أو تعبير الرؤيا أو عاقبة الأمر و مآله، كل ذلك يرجع إلى مفهوم واحد، و هو تفسير الشيء تفسيرا يكشف النقاب عن وجه المراد تماما و كمالا، و لا يدع لطرو الشك أو الشبهة فيه مجالا.
و الكلام هنا يقع في موضعين: في التأويل بمعنى توجيه المتشابه من قول أو فعل، و التأويل بمعنى تبيين المفهوم العام الذي انطوت عليه الآية، و إليك:
تأويل المتشابه
أما تأويل المتشابه فهو بمعنى توجيهه حيث يقبله العقل و يرتضيه الشرع. و هذا قد يكون في عمل متشابه، حيث أحاطت به هالة من إبهام ربما كان مثيرا للريب، كما في أعمال قام بها صاحب موسى، حيث أثار من ريبه ليقوم باستيضاحه عن جلي الأمر؛ مستنكرا عليه تارة بقوله: لقد جئت شيئا إمرا و أخرى: لقد جئت شيئا نكرا فكانت الإجابة المبررة: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا[15].
و قد يكون في كلام متشابه حيث علاه غبار إبهام و شبهة، كما في متشابهات القرآن، و هو موضع بحثنا هنا.
إذن، فالمتشابه من الكلام هو ما تشابه المراد منه، و احتمل وجوها لا يدرى وجه الصواب فيها ظاهرا. و هذا في قلة من آيات الذكر الحكيم، تعود إلى أوصافه تعالى الجمال و الكمال[16]، فلا يبلغ الواصفون حقيقة مفادها إلا النابهون الراسخون في العلم.
و هذا في مقابلة الأكثرية القاطعة من الآيات المحكمات، ذوات الدلالات الناصعة الواضحة البرهان.
التأويل نوع تفسير:
و عليه، فالتأويل- في باب المتشابهات- نوع تفسير يضم إلى رفع الإبهام عن وجه الآية، دفع الإشكال عنها أيضا؛ ليكون رفعا و دفعا معا.
إذ أن التفسير هو كشف القناع عن اللفظ المشكل، أي: رفع الإبهام عن وجهه، و الإبهام قد لا يكون عن شبهة، و إنما يكون عن غموض في التعبير أو إجمال في البيان، لا سيما و القرآن نزل حسب مناسبات و أسباب مستدعية لنزول وحي لعلاجها، فلا محالة كانت الآية- بلسان تعبيرها- ناظرة إلى تلك المناسبة أو السبب، فما لم تعرف المناسبة، و لم يعلم سبب النزول، لم ينكشف وجه المعنى تماما.
و كذا أكثرية آيات الأحكام- بما أنها نزلت لبيان أصول التشريع الإسلامي- فإنها مجملة المفاد، و إنما يفصلها و يبين تفاصيلها تبيين الرسول صلى الله عليه و اله[17] و خلفائه الكبار[18].
فما لم يراجع السنة الشريفة، لا يرتفع الإجمال من وجه الآية، و هكذا غير ذلك من أسباب الإجمال في تعابير القرآن، و يكون من وظيفة المفسر الخبير أن يقوم برفعها حسبما أوتي من حول و قوة.
و أما تأويل المتشابهات فهو مضافا إلى كونه عملية الكشف و رفع الإبهام عن وجه الآية، فإنه في نفس الوقت يعني بدفع الشبهة أو الشبهات المثارة حولها أيضا.
فهو أخص من التفسير و نوع منه.
و هكذا التأويل بمعنى الكشف عن المفهوم العام الخابئ وراء ستار اللفظ، نوع تفسير يعني بالمفاهيم الباطنة، و التي تشكل رسالة الآية الخالدة، يكشفها المفسر المضطلع الخبير، حسبما يأتي الكلام عنه.
إذن فالتأويل بكلا المعنيين، هو نوع تفسير يعود إلى عالم المفاهيم، و موطنها الذهن، يتجلى باللفظ و التعبير، و بالكتابة على الصحائف.
أما كونه ذات عين خارج الذهن و ملموسا بالحس كما حسبه ابن تيمية، أو ذات عين بسيطة خارج الألفاظ و المفاهيم كما تصوره سيدنا العلامة الطباطبائي، فهذا و ذاك قد يبدوان غريبين عن المتفاهم المألوف لدى السلف و الخلف. و سيوافيك الكلام عن ذلك.[19]
[1] ( 1). آل عمران ۳: ۷.
[2] ( 2). النوى: التحول من مكان الى مكان، أو الوجه الذي ينويه المسافر. أي: و لهذا التحول و التجوال قبل يوم الفراق نهاية و عاقبة ينتهي إليها، كما في قول معقر:
|
فألقت عصاها و استقر بها النوى |
كما قر عينا بالإياب المسافر |
[3] ( 3). الأعراف ۷: ۵۳.
[4] ( ۴). النساء ۴: ۵۹.
[5] ( ۵). المفردات للراغب: ۳۱ مادة« أول».
[6] ( 1). كما في قصة صاحب موسى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا الكهف 18: 78، أي: تفسيره على الوجه المقبول.
[7] ( ۲). كما في الآية: ۷ من سورة آل عمران.
[8] ( 3). و ذلك لأن كثيرا من الآيات نزلت علاجا لمشكلة عارضة تخص أناسا بأشخاصهم و في ظروف خاصة، فلو بقيت الآية على ظاهرها لكادت تكون عقيمة لا تحمل رسالتها العامة الخالدة، و القرآن نزل هدى للعالمين.
و سنشرح هذه الناحية بتفصيل.
[9] ( 4). الآيات: ۶ و ۲۱ و ۳۶ و ۳۷ و ۴۴ و ۴۵ و ۱۰۰ و ۱۰۱.
[10] ( 5). الإسراء ۱۷: ۳۵.
[11] ( 1). الأعراف ۷: ۵۳.
[12] ( 2). ص ۳۸: ۳.
[13] ( 3). يونس ۱۰: ۳۹.
[14] ( 4). أسد الغابة ۳: ۱۹۲- ۱۹۵، الإصابة ۲: ۳۳۰- ۳۳۴.
[15] ( 1). الكهف ۱۸: ۷۱، ۷۴، ۷۸.
[16] ( 2). و المتشابهات الأصل في القرآن لا تتجاوز المأتين آية حسبما أحصيناه، فلا تعود بالقدح على القرآن، و كونه بلسان عربي مبين، و أنه جاء هدى و بصائر للعالمين.
[17] ( 1). حسب قوله تعالى: و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم .. النحل ۱۶: ۴۴.
[18] ( 2). وفق حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين.
[19] التأويل في مختلف المذاهب و الآراء ۹-۱۵
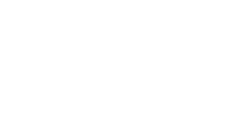
بدون نظر