التحریر و التنویر
و قد جرت عادة المفسرين بالخوض في بيان معنى التأويل، و هل هو مساو للتفسير أو أخص منه أو مباين؟ و جماع القول في ذلك أن من العلماء من جعلهما متساويين، و إلى ذلك ذهب ثعلب و ابن الأعرابي و أبو عبيدة، و هو ظاهر كلام الراغب، و منهم من جعل التفسير للمعنى الظاهر و التأويل للمتشابه، و منهم من قال: التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدليل فيكون هنا بالمعنى الأصولي، فإذا فسر قوله تعالى:
يخرج الحي من الميت* [الروم: 19] بإخراج الطير من البيضة، فهو التفسير، أو بإخراج المسلم من الكافر فهو التأويل، و هنا لك أقوال أخر لا عبرة بها، و هذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها إلا أن اللغة و الآثار تشهد للقول الأول، لأن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، و الغاية المقصودة من اللفظ هو معناه و ما أراده منه المتكلم به من المعاني فساوى التفسير، على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول قال الأعشى:
|
على أنها كانت تأول حبها |
تأول ربعي السقاب فأصحبا |
أي تبيين تفسير حبها أنه كان صغيرا في قلبه، فلم يزل يشب حتى صار كبيرا كهذا السقب أي ولد الناقة، الذي هو من السقاب الربيعية لم يزل يشب حتى كبر و صار له ولد يصحبه قاله أبو عبيدة، و قد قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله [الأعراف: 53] أي ينتظرون إلا بيانه الذي هو المراد منه، و
قال صلى الله عليه و سلم في دعائه لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل»
، أي فهم معاني القرآن، و
في حديث عائشة رضي الله عنها: «كان صلى الله عليه و سلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا و بحمدك، اللهم اغفر لي يتأول القرآن»
أي يعمل بقوله تعالى: فسبح بحمد ربك و استغفره [النصر: 3] فلذلك جمع في دعائه التسبيح و الحمد و ذكر لفظ الرب و طلب المغفرة فقولها «يتأول» صريح في أنه فسر الآية بالظاهر منها و لم يحملها على ما تشير إليه من انتهاء مدة الرسالة و قرب انتقاله صلى الله عليه و سلم، الذي فهمه منها عمر و ابن عباس رضي الله عنهما.[1]
[1] التحرير و التنوير ج1 ۱۴-۱۵
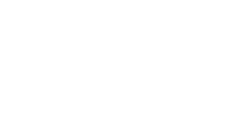
بدون نظر