تفسیر ماتریدی
ثانيا: التأويل
التأويل لغة:
يدور حول معنيين لا ثالث لهما:
الأول: بمعنى الرجوع و العود و العاقبة.
و الثاني: بمعنى تفسير الكلام و تبيين معناه.
و قد أشارت كتب اللغة إلى المعنيين، ففي اللسان أن التأويل من «الأول: الرجوع، آل الشيء يئول أولا و مآلا: رجع ... و في الحديث «من صام الدهر فلا صام و لا آل»[1]، أي: لا رجع إلى خير، و أول الكلام و تأوله: دبره و قدره، و أوله و تأوله: فسره»[2].
و قد كثر استعمال لفظ «التأويل» في القرآن الكريم بمعنييه، فمن الأول قول الله تعالى:
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله [الأعراف: 53] يعني ما يئول إليه في وقت بعثهم و نشورهم.
و من الثاني قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله [آل عمران: 7] فالتأويل هنا يعني التفسير و التعيين و التوضيح.
التأويل اصطلاحا:
التأويل عند السلف في تعريفه غيره عند الخلف؛ فالتأويل عند السلف يأتي على معنيين:
الأول: تفسير الكلام و بيان معناه، و بذلك يكون التأويل و التفسير مترادفين.
و الثاني: هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، و إن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به.
و بين هذا المعنى و الذي قبله فرق ظاهر، فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم و الكلام: كالتفسير و الشرح و الإيضاح، و يكون وجود التأويل فيه القلب و اللسان، و له الوجود الذهني و اللفظي و الرسمي. و أما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج، سواء أ كانت ماضية أم مستقبلية، فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوعها، و هذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التي نزل بها؛ و لهذا يمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن الكريم من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني[3].
أما الخلف من المتفقهة و المتكلمين و المتصوفين و غيرهم فقد رأوا أن التأويل يعني:
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به.
و المتأول عندهم يحتاج إلى أمرين:
الأول: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه و ادعى أنه المراد.
الثاني: أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، و إلا كان تأويلا فاسدا و تلاعبا بالنصوص[4].
و من ثم قال الزركشي: «التأويل: التمييز بين المنقول و المستنبط؛ ليحمل على الاعتماد في المنقول، و على النظر في المستنبط؛ تجويزا له و ازديادا»[5].
و أوضح من هذا ما قاله صاحب جمع الجوامع و شرحه: «التأويل: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل»[6].
ثالثا: المعنى:
المعنى لغة و اصطلاحا:
يراد بالمعنى لغة: القصد و المراد، جاء في اللسان: «عنيت بالقول كذا: أردت، و معنى كل كلام و معناته و معنيته: مقصده، و يقال: عرفت ذلك في معنى كلامه و معناة كلامه و في معنى كلامه»[7].
و له علاقة بالإظهار و الوضوح، كما تقول: عنت القربة: إذا لم تحفظ ماءها بل أظهرته، و منه عنوان الكتاب، أي: الجزء الظاهر منه و المنبئ عما بداخله[8].
و تجدر الإشارة إلى أن هناك لفظا رابعا له اتصال ما بألفاظ التفسير و التأويل و المعنى، و هو لفظ البيان، و يعني: إظهار المتكلم المراد للسامع، و هو أعم من الألفاظ الثلاثة جميعا؛ لشموله كلا من بيان التغيير و بيان التقرير، و بيان الضرورة، و بيان التبديل[9].
الفرق بين التفسير و التأويل:
يمكن القول: إن حاصل ما تضمنته عبارات العلماء العديدة في هذا المقام لا يخرج عن اتجاهين:
الاتجاه الأول: أن التفسير و التأويل ترجمة عن معنى واحد، بحيث إذا قلنا أحدهما على شيء قلنا الآخر عليه بلا أدنى فرق، و إلى هذا ذهب أبو عبيد و الطبري و طائفة[10].
و الاتجاه الثاني: أن التفسير و التأويل يختلف مدلول أحدهما عن الآخر اصطلاحا كما اختلفا لغة، و قد حمل لواء هذا الاتجاه النيسابوري و الزركشي و الراغب الأصفهاني و غيرهم ... و قد تشددوا في التفريق بين اللفظين أيما تشدد، حتى قال النيسابوري
معرضا: «قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير و التأويل ما اهتدوا إليه»[11].
و قد فرق العلماء بين اللفظين بفروق شتى، نورد أبرزها- خشية الإطالة- فمثلا الراغب الأصفهاني يقول: «التفسير أعم من التأويل، و أكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، و التأويل في المعاني»[12].
و أبو طالب الثعلبي يفرق فيقول: «التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا، كتفسير «الصراط» بالطريق، و «الصيب» بالمطر. و التأويل: تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأول، و هو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، و التفسير إخبار عن دليل المراد»[13].
و الماتريدي صاحبنا يقول: «التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا، و الشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، و إلا فتفسير بالرأي، و هو المنهي عنه، و التأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون قطع، و الشهادة على الله»[14].
و الأقوال كثيرة في التفريق بين التفسير و التأويل، بعضها يصل بمفهوم المصطلحين إلى حد التباين، و لعل أولاها بالقبول ما ذكره جملة من العلماء من أن التفسير يرجع إلى الرواية، و التأويل يرجع إلى الدراية و الاستنباط؛ لأن التفسير كشف و بيان عن مراد الله، و الكشف عن مراد الله لانجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي، و علموا ما أحاط به من حوادث و وقائع، و خالطوا رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. أما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، و هذا الترجيح يعتمد على الاجتهاد.
و من ثم قال الزركشي- فيما أشرنا إليه من قبل-: «و كأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير و التأويل، التمييز بين المنقول و المستنبط؛ ليحمل على الاعتماد
في المنقول، و على النظر في المستنبط»[15].
و خلاصة القول: أنه برغم الاختلاف بين المصطلحين، فإنهما يشتركان في معنى واحد، و هو محاولة الكشف عن حقيقة شيء، و أنه حين يستخدم كل منهما في شرح ألفاظ القرآن و بيان معانيه فإنه يجمعهما هذا المعنى العام.[16]
[1] ( 3) ذكره بلفظه ابن الأثير في النهاية( 1/ ۶۳).
و له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو
أخرجه البخاري( 4/ ۷۴۱) كتاب الصوم باب حق الأهل في الصوم( ۱۹۷۷)، و مسلم( 2/ ۸۱۴- ۸۱۵) كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر( ۱۸۶/ ۱۱۵۹)، و أحمد( 2/ 164، ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۵، ۲۱۲)، و عبد الرزاق( ۷۸۶۳)، و الحميدي( ۵۹۰)، و عبد بن حميد( ۳۲۱)، و الترمذي( 2/ ۱۳۲) كتاب الصوم باب ما جاء في سرد الصوم( ۷۷۰)، و ابن ماجه( 3/ ۱۹۴) كتاب الصيام باب ما جاء في صيام الدهر( ۱۷۰۶)، و النسائي( 4/ 206) كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه، و ابن خزيمة( ۲۱۰۹)، و الخطيب في تاريخه( 1/ ۳۰۷) من طريق أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو ... فذكره مطولا و قال في آخره قال النبي صلى الله عليه و سلم« لا صام من صام الأبد» مرتين.
[2] ( 4) ابن منظور: لسان العرب مادة( أول)( 1/ ۱۷۱)، و ينظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط( أول)( ۳/ ۳۳۱).
[3] ( 1) ينظر: د. الذهبي: التفسير و المفسرون( ۱/ ۱۹).
[4] ( 2) ينظر: السابق( ۱/ ۱۹، ۲۰).
[5] ( 1) البرهان في علوم القرآن( ۲/ ۱۷۱، ۱۷۲).
[6] ( 2) د. الذهبي: التفسير و المفسرون( 1/ 20) نقلا عن جمع الجوامع( ۲/ ۵۶).
[7] ( 3) اللسان، مادة( عنى).
[8] ( 4) ينظر: السابق، المادة نفسها.
[9] ( 5) ينظر: الجرجاني: التعريفات، مادة( أول).
[10] ( 6) ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن( ۲/ ۱۷۳).
[11] ( 1) السابق، الصفحة نفسها.
[12] ( 2) د. الذهبي: التفسير و المفسرون( 1/ ۲۱)، و د. السيد خليل: نشأة التفسير في الكتب المقدسة و القرآن ص 29 نقلا عن: مقدمة في التفسير للراغب ص ۴۰۲، ۴۰۳.
[13] ( 3) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن( ۲/ ۱۷۳). و ينظر: د. أبو شهبة: الإسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسير ص ۴۳.
[14] ( 4) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن( 2/ 173)، و التفسير و المفسرون( ۱/ ۲۱، ۲۲).
[15] ( 1) البرهان في علوم القرآن( ۲/ ۱۷۱، ۱۷۲).
[16] تأويلات أهل السنة ج1 ۱۸۲-۱۸۶
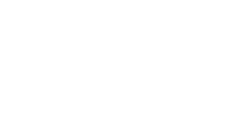
بدون نظر