تفسیر الطبرانی
التفسير و التأويل:
التفسير تفعيل من الفسر و هو البيان، تقول فسرت الشيء بالتخفيف أفسره فسرا، و فسرته بالتشديد أفسره تفسيرا إذا بينته. و الفرق بين التفسير و التأويل أن التفسير هو بيان المراد باللفظ، و التأويل هو بيان المراد بالمعنى. و قد اختصت كلمة التفسير عند الإطلاق ببيان آيات القرآن، و كلمة التأويل بتوجيه الفهم إلى العمل و أداءه في الفعل على الوجه المقصود شرعا.
قال تعالى: و لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق و أحسن تفسيرا[1] و التفسير هو التفصيل بالمثال و ما يقرب المعنى إلى الأذهان؛ بإظهار المعنى المعقول على قصد مراد الشارعشارع بما يزيل الإيهام الذي ربما علق في أذهانهم عند ما سمعوا الخطاب؛
فيرتبط التفسير بتكوين المعنى في الذهن بما يخدم في فهم النص و وعيه له. و التأويل هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كان أو عملا؛ أي إرجاعه إلى أصله؛ فالتأويل عملا بالطاعة لله و رسوله، و التأويل علما بإرجاع محل التنازع و الاختلاف إلى مظانه من كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا[2].
و التأويل على ضربين: الأول: تأويل شرعي للنص، و الآخر: تأويل عقلي.
و إذا علم أن المراد بالتأويل- على وجه العموم- ما يفيد في توجيه المعنى في دلالة الخطاب إلى طريقة القيام بالعمل و إنفاذه على وجهه الشرعي؛ أو بما يخدم فكرة الموجه للدلالة إلى مقاصده و غاياته. و الأول منهما؛ و هو التأويل الشرعي للنص؛ و هو المطلوب من المكلفين لفهم خطاب الشارع على قصد مراد الله سبحانه و تعالى؛ و يثمر للمكلف عند الله الأجر و الثواب و تتحقق العبادة في إنجازه. و الثاني: هو التأويل العقلي؛ فهو تحكم في توجيه دلالة النص إلى ما يفيد غرض المكلف و بما يخدم غاياته و أهدافه على قصد مراده البشري أو الشخصي أو المذهبي أو الطائفي؛ و هذا ليس مرادا في عرف الشارع كما سيظهر إن شاء الله. و على ما يبدو أن هذا النوع من التأويل وقع به غالب المتكلمين، و لإظهار المعنى بما يبني فكرة التأويل و مفهومه في عقلية المسلم نقول:
خاطب الله الناس، بكلامه في القرآن الكريم، و بما أمر به رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم أن يبين لهم ما أجمل في الكتاب أو عم أو أطلق. و جاء الخطاب بلسان عربي مبين، فصيح يحمل في دلالاته معاني تفهم منه من سياق النص مباشرة، أو من مفردات ألفاظ النص، أي تفهم المعاني المرادة بإدراك دلالة اللفظ باللغة العربية، أو بإدراك دلالة السياق بمعهود العرب و عرف لسانهم و خطابهم، أو تدرك المعاني من معرفة أسباب نزول النص و أسباب ورود البيان السني للكتاب. فيدرك المرء دلالة النص من تفسير ألفاظه و مرامي معانيه على الواقع، أو تأويله إلى ما يفيد العمل الفكري الذي
يجري في ذهن المكلف لتوجيه الرأي و الايمان و المعتقدات و الأحكام؛ أو إلى ما يفيد مباشرة العمل بإنفاذه على جوارح المرء و بأهليته الفردية أو الجماعية المجتمعية. لهذا لا يوجد في القرآن الكريم ما لا يعقل المكلف ألفاظه أو لا يفهم معانيه. فعقل الألفاظ و ما يحتاجه هذا التعقل الشرعي من مطلوب خبري على مستوى اللغة و الأثر و الحديث هو التفسير؛ و هو بيان معاني ألفاظ القرآن و فهم معانيه و استخراج أحكامه و حكمه؛ باستمداد ذلك من علم اللغة بما تدل عليه الألفاظ منها إلى معانيها؛ و بمعرفة علم النحو و التصريف و علم البيان الذي يلزم المرء الباحث بأساليب العرب في المخاطبة و التعلم و الإفهام، و علم القراءات و ما تحمله من دلالات السياق في التعبير عن المراد، و ما إلى ذلك مما يعرف بالعلوم الشرعية و ما يخدمها من علوم الآلة و العربية.
أما التأويل؛ فهو معرفة دلالة الخطاب على الواقع باعتباره نصا مسموعا يخبر عن قصد مراد الشارع من المكلف، و بوصفه كلا متماسكا و وحدة واحدة غير مجزأة تفيد المستمع بإنشاء الفكر عن الواقع و تكوين معنى يعبر به عنه و تبعث فيه إلى طلب ما يلزمه العمل.
و لم يكن عند سلف الأمة تفريق بين التفسير و التأويل في القصد المراد، لأن كليهما يلزم الآخر، و لم يكن عندهم تفريق بين الفكر و العمل من حيث أن الفكر للعمل و ليس بينهما مفاصلة إلا الصدق في المباشرة. و ليس الحال كما فرق المتأخرون.
فالتأويل عند السلف هو إفادة المستمع أو من في حكمه بإنشاء الفكر في ذهنه و تقصد العمل به؛ فالتفسير بيان المعنى في الخطاب، و التأويل بيان العمل و توجيه دلالة الخطاب إليه؛ و أحدهما يقتضي الآخر.
لهذا كان التفسير هو بيان المعنى بحسب مقتضى اللغة و دلالة اللسان بمعهود العرب حين إدراكهم للخطاب و وعيهم به، أي بما تدركه العرب و تفهمه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم. و التأويل؛ هو بيان هذا المعنى على وجه يفيد العمل بمقتضى هذا المعهود من لسان العرب و معهودهم و بمقتضى ما جاء من السنة المطهرة في بيانه. لهذا
قال سفيان بن عيينة: (السنة هي تأويل الأمر و النهي)[3]، و لقد جاء الأمر و النهي في القرآن الكريم، و جاءت السنة لتبين للناس طريقة العمل بهما، فالتأويل هنا؛ توجيه المعنى المراد في دلالة النص إلى معهود العرب للعمل بها وفق النسق المخصوص للمكلف حين مباشرته في الواقع. و على هذا يكون التفسير هو النظام المعرفي في إيجاد الفكر و تكوينه في ذهن المكلف، و التأويل هو الأثر الوظيفي للتفسير؛ و كلاهما في حقيقته المعرفية لا ينفصل عن الآخر، فهو لازم له.
فالتأويل عند السلف رضوان الله عليهم، بمعنى التفسير العملي للنص بترجمته في سلوك المكلف و حركته حين ممارسة الحياة؛ فهو إدراك قصد مراد الشارع و وعيه له فكرا و عملا، تفكيرا و تطبيقا لهذا تصف عائشة رضي الله عنها فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في ركوعه، بأنه يتأول القرآن، فتقول: [كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في سجوده و ركوعه:
سبحانك اللهم ربنا و بحمدك. يتأول القرآن][4] أي يفعل ما أمر به في القرآن الكريم من السجود و الركوع و الذكر فيهما على ما أمر به. و يقول جابر رضي الله عنه في خبر حجة الوداع: [و رسول الله بين أظهرنا ينزل عليه القرآن و هو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به][5] أي تأويل الرسول صلى الله عليه و سلم بيان لطريقة العمل بالكتاب؛ و هذا التأويل هو السنة و الطريقة و التفسير هو العلم الذي تعبر عنه السنة و تترجمه بالفعل، و لهذا يقول أبو عبيدة و غيره: (الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة)؛ قلت: لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية[6]. و بهذا يظهر الفرق بين دلالتي التفسير و التأويل. و حقيقة المفسر هو الذي يهتم بدلالة الألفاظ على الواقع فكريا، و لا يغفل الناحية العملية، أي التأويل للنص في مجال القول و العمل.[7]
[1] ( 2) الفرقان/ ۳۳.
[2] ( 1) النساء/ ۵۹.
[3] ( 1) ينظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية: ص 60؛ طبع المكتب الإسلامي. و الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة لابن قيم الجوزية: الفصل الرابع: ج 1 ص ۲۰۶-۲۰۷.
[4] ( ۲) عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت:( كان النبي صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول في ركوعه و سجوده: سبحانك اللهم ربنا و بحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب التسبيح: الحديث( 817). قال ابن حجر في الفتح: قوله( يتأول القرآن) أي يفعل ما أمر به فيه. و مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع:
الحديث( ۲۱۷/ ۴۸۴).
[5] ( 3) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم: الحديث( ۱۴۷/ ۱۲۱۸) و هو شطر حديث طويل.
[6] ( 1) ينظر: الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة لابن قيم الجوزية: ج 1 ص 175- 206، و الرسالة التدمرية مجمل اعتقاد السلف: ص 60. و البرهان في علوم القرآن للزركشي: ج 1 ص 13 و ما بعدها.
[7] التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم (الطبرانى) ج1 -ص۳۸-۴۲
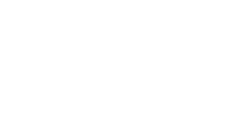
بدون نظر