التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب
معاني التأويل
جاء استعمال لفظ «التأويل» في القرآن على ثلاثة وجوه:
1- تأويل المتشابه، بمعنى توجيهه حيث يصح و يقبله العقل و النقل، إما في متشابه القول، كما في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله ..[1]، أو في متشابه الفعل، كما في قوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا[2].
2- تعبير الرؤيا، و قد جاء مكررا في سورة يوسف في ثمانية مواضع:
(۶ و ۲۱ و ۳۶ و ۳۷ و ۴۴ و ۴۵ و ۱۰۰ و ۱۰۱) ۳- مآل الأمر و عاقبته، و ما ينتهى إليه الأمر في نهاية المطاف، قال تعالى: و زنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير و أحسن تأويلا[3]، أي أعود نفعا و أحسن عاقبة.
و لعل منه قوله: .. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول، إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر، ذلك خير و أحسن تأويلا[4]، أي أنتج فائدة و أفضل مآلا.
و يحتمل أوجه تفسيرا و أتقن تخريجا للمعنى المراد، نظير قوله تعالى:
و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم[5]، و قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله[6]، أي هل ينتظرون ما ذا يؤول إليه أمر الشريعة و القرآن، لكن لا يطول بهم الانتظار يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين[7]، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار[8]، و لات حين مناص.[9] 4- و المعنى الرابع- للتأويل- جاء استعماله في كلام السلف: مفهوم عام، منتزع من فحوى الآية الواردة بشأن خاص؛ حيث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد.
و قد عبر عنه بالبطن المنطوي عليه دلالة الآية في واقع المراد، في مقابلة الظهر المدلول عليه بالوضع و الاستعمال، حسب ظاهر الكلام.
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «ما في القرآن آية إلا و لها ظهر و بطن».
سئل الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام عن هذا الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم،
فقال: «ظهره تنزيله و بطنه تأويله، منه ما قد مضى و منه ما لم يكن، يجري كما تجري الشمس و القمر»[10].
و
قال عليه السلام: «و لو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم، ماتت الآية و لما بقي من القرآن شيء. و لكن القرآن يجري أوله على آخره، ما دامت السماوات و الأرض، و لكل قوم آية يتلونها، هم منها من خير أو شر»[11].
و
في الحديث عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله، و هو علي بن أبي طالب»[12].
فإنه صلى الله عليه و آله و سلم قاتل على تنزيل القرآن؛ حيث كان ينزل بشأن قريش و مشركي العرب ممن عاند الحق و عارض ظهور الإسلام. أما علي عليه السلام فقد قاتل أشباه القوم ممن عارضوا بقاء الإسلام، على نمط معارضة أسلافهم في البدء.
و لهذا المعنى عرض عريض، و لعله هو الكافل لشمول القرآن و عمومه لكل الأزمان و الأحيان. فلولا تلك المفاهيم العامة، المنتزعة من موارد خاصة- وردت الآية بشأنها بالذات- لما بقيت لأكثر الآيات كثير فائدة، سوى تلاوتها و ترتيلها ليل نهار.
و إليك بعض الأمثلة على ذلك:
مفاهيم عامة منتزعة من الآيات
قال تعالى: و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى[13].
نزلت بشأن غنائم بدر، و غاية ما هناك أن عمت غنائم جميع الحروب، على شرائطها.
لكن الإمام أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام نراه يأخذ بعموم الموصول، و يفسر «الغنيمة» بمطلق الفائدة، و أرباح المكاسب و التجارات، يربحها أرباب الصناعات و التجارات و غيرهم طول عامهم، في كل سنة بشكل عام.
قال عليه السلام: «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى:
و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربى.
و هكذا
عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: «الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»[14].
و قال تعالى: و أنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[15].
نزلت بشأن الإعداد للجهاد، دفاعا عن حريم الإسلام، فكان مفروضا على أصحاب الثروات القيام بنفقات الجهاد، دون سيطرة العدو الذي لا يبقي و لا يذر.
لكن «السبيل» لا يعني القتال فحسب، فهو يعم سبيل إعلاء كلمة الدين و تحكيم كلمة الله في الأرض، و يتلخص في تثبيت أركان الحكم الإسلامي في البلاد، في جميع أبعاده: الإداري و الاجتماعي و التربوي و السياسي و العسكري، و ما شابه. و هذا إنما يقوم بالمال؛ حيث المال طاقة يمكن تبديلها إلى أي طاقة شئت، و من ثم قالوا: قوام الملك بالمال .. فالدولة القائمة بذاتها إنما تكون قائمة إذا كانت تملك الثروة اللازمة لإدارة البلاد في جميع مناحيها.
و هذا المال يجب توفره على أيدي العائشين تحت لواء الدولة الحاكمة، و يكون مفروضا عليهم دفع الضرائب و الجبايات، كل حسب مكنته و ثروته، الأمر الذي يكون شيئا وراء الأخماس و الزكوات التي لها مصارف خاصة، لا تعني شئون الدولة فحسب.
و هذه هي (المالية) التي يكون تقديرها و توزيعها على الأموال و الممتلكات، حسب حاجة الدولة و تقديرها، و من ثم لم يتعين جانب تقديرها في الشريعة، على خلاف الزكوات و الأخماس؛ حيث تعين المقدار و المصرف و المورد فيها بالنص.
فقد فرض الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق في كل فرس في كل عام دينارين، و على البراذين دينارا.[16]
ضابطة التأويل
و مما يجدر التنبه له أن للأخذ بدلائل الكلام- سواء أ كانت جلية أم خفية- شرائط و معايير، لا بد من مراعاتها للحصول على الفهم الدقيق. فكما أن لتفسير الكلام- و هو الكشف عن المعاني الظاهرية للقرآن- قواعد و أصول مقررة في علم الأصول و المنطق، كذلك كانت لتأويل الكلام- و هو الحصول على المعاني الباطنية للقرآن- شرائط و معايير، لا ينبغي إعفاؤها و إلا كان تأويلا بغير مقياس، بل كان من التفسير بالرأي الممقوت.
و ليعلم أن التأويل- و هو من الدلالات الباطنية للكلام- داخل في قسم الدلالات الالتزامية غير البينة، فهو من دلالة الألفاظ لكنها غير البينة، و دلالة الألفاظ جميعا مبتنية على معايير يشرحها علم الميزان؛ فكان التأويل- و هو دلالة باطنة- بحاجة إلى معيار معروف كي يخرجه عن كونه تفسيرا بالرأي.
فمن شرائط التأويل الصحيح- أي التأويل المقبول في مقابلة التأويل المرفوض- أولا: رعاية المناسبة القريبة بين ظهر الكلام و بطنه، أي بين الدلالة الظاهرية و هذه الدلالة الباطنية للكلام، فلا تكون أجنبية، لا مناسبة بينها و بين اللفظ أبدا. فإذا كان التأويل- كما عرفناه- هو المفهوم العام المنتزع من فحوى الكلام، كان لا بد أن هناك مناسبة لفظية أو معنوية استدعت هذا الانتزاع.
مثلا: لفظة «الميزان» وضعت لآلة الوزن المعروفة ذات الكفتين، و قد جاء الأمر بإقامتها و عدم البخس فيها، في قوله تعالى: و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان[17].
لكنا إذا جردنا اللفظ من قرائن الوضع و غيره و أخلصناه من ملابسات الأنس الذهني، فقد أخذنا بمفهومه العام: كل ما يوزن به الشيء، أي شيء كان ماديا أم معنويا، فإنه يشمل كل مقياس أو معيار كان يقاس به أو يوزن به في جميع شئون الحياة، و لا يختص بهذه الآلة المادية فحسب.
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي: فالميزان آلة التعديل في النقصان و الرجحان، و الوزن يعدل في ذلك. و لو لا الميزان لتعذر الوصول إلى كثير من الحقوق؛ فلذلك نبه تعالى على النعمة فيه و الهداية إليه. و قيل: المراد بالميزان: العدل؛ لأن المعادلة موازنة الأسباب[18].
و
روى محمد بن العباس المعروف بماهيار (ت ح 330)- في كتابه الذي وضعه لبيان تأويل الآيات- بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام قال: الميزان الذي وضعه الله للأنام، هو الإمام العادل الذي يحكم بالعدل، و بالعدل تقوم السماوات و الأرض، و قد أمر الناس أن لا يطغوا عليه و يطيعوه بالقسط و العدل، و لا يبخسوا من حقه أو يتوانوا في امتثال أوامره.[19]
و هكذا قوله تعالى: قل أ رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين[20] كانت دلالة الآية في ظاهر تعبيرها واضحة؛ إن نعمة الوجود و وسائل العيش و التداوم في الحياة، كلها مرهونة بإرادته تعالى وفق تدبيره الشامل لكافة أنحاء الوجود.
و الله تعالى هو الذي مهد هذه البسيطة لإمكان الحياة عليها، و لو لا فضل الله و رحمته لعباده لضاقت عليهم الأرض بما رحبت.
هذا هو ظاهر الآية الكريمة، حسب دلالة الوضع و المتفاهم العام.
و للإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام بيان يمس جانب باطن الآية و دلالة فحواها العام،
قال: «إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فما ذا تصنعون».
و
قال الإمام علي الرضا عليه السلام: «ماؤكم: أبوابكم الأئمة، و الأئمة: أبواب الله.
فمن يأتيكم بماء معين، أي يأتيكم بعلم الإمام»[21].
لا شك أن استعارة «الماء المعين» للعلم النافع، و لا سيما المستند إلى وحي السماء- من نبي أو وصي نبي- أمر معروف و متناسب لا غبار عليه.
فكما أن الماء أصل الحياة المادية و المنشأ الأول لإمكان المعيشة على الأرض، كذلك العلم النافع. و علم الشريعة بالذات، هو الأساس لإمكان الحياة المعنوية التي هي سعادة الوجود و البقاء مع الخلود.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم[22].
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين[23].
فهنا قد لوحظ الماء- و هو أصل الحياة- في مفهومه العام المنتزع منه الشامل للعلم، فيعم الحياة المادية و المعنوية.
و أيضا قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه ...[24]، أي فليمعن النظر في طعامه، كيف عملت الطبيعة في تهيئته و تمهيد إمكان الحصول عليه، و لم يأته عفوا، و من غير سابقة مقدمات و تمهيدات. لو أمعن النظر فيها؛ لعرف مقدار فضله تعالى عليه، و لطفه و رحمته؛ و بذلك يكون تناول الطعام له سائغا، و مستدعيا للقيام بالشكر الواجب.
هذا، و
قد روى ثقة الإسلام الكليني بإسناده إلى زيد الشحام، قال: سألت الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قلت: ما طعامه؟ قال: «علمه الذي يأخذه عمن يأخذه».[25].
و المناسبة هنا- أيضا- ظاهرة؛ لأن العلم غذاء الروح، و لا بد من الاحتياط في الأخذ من منابعه الأصيلة، و لا سيما علم الشريعة و أحكام الدين الحنيف.
و ثانيا: مراعاة النظم و الدقة في إلغاء الخصوصيات المكتنفة بالكلام؛ ليخلص صفوه و يجلو لبابه في مفهومه العام، الأمر الذي يكفله قانون «السبر و التقسيم» من قوانين علم الميزان (علم المنطق) و المعبر عنه في علم الأصول: بتنقيح المناط، الذي يستعمله الفقهاء للوقوف على الملاك القطعي لحكم شرعي؛ ليدور التكليف أو الوضع معه نفيا و إثباتا، و لتكون العبرة بعموم الفحوى المستفاد، لا بخصوص العنوان الوارد في لسان الدليل. و هذا أمر معروف في الفقه، و له شرائط معروفة.
و مثال تطبيقه على معنى قرآني، قوله تعالى- حكاية عن موسى عليه السلام-: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين[26].
هذه قوله نبي الله موسى عليه السلام قالها تعهدا منه لله تعالى، تجاه ما أنعم عليه من البسطة في العلم و الجسم: و لما بلغ أشده و استوى آتيناه حكما و علما و كذلك نجزي المحسنين[27] قضى على عدو له بوكزة وكزه بها، فحسب أنه قد فرط منه ما لا ينبغي له، فاستغفر ربه فغفر له. فقال ذلك تعهدا منه لله، أن لا يستخدم قواه و قدره الذاتية، و التي منحه الله بها، في سبيل الفساد في الأرض، و لا يجعل ما آتاه الله من إمكانات معنوية و مادية في خدمة أهل الإجرام.
هذا ما يخص الآية في ظاهر تعبيرها بالذات.
و هل هذا أمر يخص موسى عليه السلام لكونه نبيا و من الصالحين، أم هو حكم عقلي بات يشمل عامة أصحاب القدرات، من علماء و أدباء و حكماء و أرباب صنائع و فنون، و كل من آتاه الله العلم و الحكمة و فصل الخطاب؟ لا ينبغي في شريعة العقل أن يجعل ذلك ذريعة سهلة في متناول أهل العبث و الاستكبار في الأرض، بل يجعلها وسيلة ناجحة في سبيل إسعاد العباد و إحياء البلاد هو أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها[28].
و هذا الفحوى العام للآية الكريمة إنما يعرف وفق قانون «السبر و التقسيم» و إلغاء الخصوصيات المكتنفة بالموضوع، فيتنقح ملاك الحكم العام.
و في القرآن كثير من هذا القبيل، إنما الشأن في إمعان النظر و التدبر في الذكر الحكيم؛ و بذلك يبدو وجه استفادة فرض الأخماس من آية الغنيمة، و دفع الضرائب من آية الإنفاق في سبيل الله.
مزاعم في التأويل
هناك من حسب من تأويل القرآن شيئا وراء المفاهيم الذهنية أو التعابير الكلامية، و كان من نمط الأعيان الخارجية، و كان ما ورد في القرآن من حكم و آداب و تكاليف و أحكام كلها تعود إليه؛ إذ تنتزع منه و تنتهي إليه في نهاية المطاف، فكان ذلك تأويلا للقرآن في جميع آياته الكريمة.
و قد اختلفوا في تبيين تلك الحقيقة التي تعود إليها جميع الحقائق القرآنية في أصول معارفه و الأحكام:
ذكر ابن تيمية- في رسالة وضعها بشأن المتشابه و التأويل-: أن التأويل في عرف المتأخرين صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح؛ لدليل يقترن به. فالتأويل- على هذا- يحتاج إلى دليل، و المتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي يدعيه، و بيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر.
قال: و أما التأويل- في عرف السلف- فله معينان: أحدهما: ما يرادف التفسير و البيان، و هو الذي عناه مجاهد بقوله: إن العلماء يعلمون تأويل القرآن، أي تفسيره و تبيينه.
و الثاني: نفس المراد بالكلام، إن كان طلبا فتأويله نفس العمل المطلوب، و إن كان خبرا فتأويله نفس الشيء المخبر به.
قال: و بين هذا المعنى- الأخير- و الذي قبله- الذي جاء أولا في عرف السلف، و الذي جاء في عرف المتأخرين- بون؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم و الكلام كالتفسير و الشرح و الإيضاح و يكون وجود التأويل في القلب و اللسان، له الوجود الذهني و اللفظي و الرسمي.
و أما هذا- المعنى الثاني في عرف السلف- فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج، سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا نفس طلوعها.
قال: و هذا الوضع و العرف الثالث- الذي جاء ثانيا في عرف السلف- هو لغة القرآن التي نزل بها[29].
و قال في تفسير سورة الإخلاص- بعد كلام تفصيلي له عن تأويل المتشابه من الآيات، و أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، و استعظام أن يكون جبرائيل و محمد صلى الله عليه و آله و سلم و الصحابة و التابعون لهم بإحسان و أئمة المسلمين لا يعرفون تأويل متشابه القرآن، و يكون الله تعالى قد استأثر بعلم معاني هذه الآيات كما استأثر بعلم الساعة، و أنهم جميعا كانوا يقرءون ألفاظا لا يفهمون لها معنى، كما
يقرأ أحدنا كلاما ليس من لغته فلا يعرف معناه، من قال ذلك فقد كذب على القوم، و المأثور عنهم متواترا يناقض هذا الزعم، و أنهم يفهمون معنى المتشابه كما يفهمون معنى المحكم- قال بعد ذلك:
فإن قيل: هذا يقدح فيما ذكرتم من الفرق بين التأويل الذي يراد به التفسير، و بين التأويل الذي في كتاب الله.
قيل: لا يقدح في ذلك، فإن معرفة تفسير اللفظ و معناه و تصوره في القلب، غير معرفة الحقيقة الموجودة في الخارج، المرادة بذلك الكلام.
فإن الشيء له وجود في الأعيان، و وجود في الأذهان، و وجود في اللسان، و وجود في البيان. فالكلام لفظ له معنى في القلب، و يكتب ذلك اللفظ بالخط.
فإذا عرف الكلام و تصور معناه في القلب و عبر عنه باللسان، فهذا غير الحقيقة الموجودة في الخارج، و ليس كل من عرف الأول عرف عين الثاني.
مثال ذلك: أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و خبره و نعته، و هذا معرفة الكلام و معناه و تفسيره، و تأويل ذلك هو نفس محمد المبعوث؛ فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلك الكلام.
و كذلك الإنسان قد يعرف الحج و المشاعر، كالبيت و المساجد و منى و عرفة و مزدلفة، و يفهم معنى ذلك و لا يعرف الأمكنة حتى يشاهدها، فيعرف أن الكعبة المشاهدة هي المذكورة في قوله: و لله على الناس حج البيت و كذلك أرض عرفات و غيرها.
و كذلك الرؤيا يراها الرجل، و يذكر له العابر تأويلها فيفهمه و يتصوره، ثم إذا كان ذلك فهو تأويل الرؤيا، ليس تأويلها نفس علمه و تصوره و كلامه؛ و لهذا قال يوسف الصديق: هذا تأويل رءياي من قبل و قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتي التأويل،
فنحن نعلم تأويل ما ذكر الله في القرآن من الوعد و الوعيد، و إن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل المذكور في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله[30].
و قد أشاد السيد محمد رشيد رضا (منشئ مجلة المنار المصرية) من هذه النظرة التيمية بشأن تأويل القرآن، و أعجبته غاية الإعجاب. قال- بعد أن نقل عن شيخه الأستاذ محمد عبده، أن التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء و ينطبق عليه، لا بمعنى ما يفسر به[31]-: ليس في كتب التفسير المتداولة ما يروي الغليل في هذه المسألة، و ما ذكرناه آنفا هو صفوة ما قالوه، و خيرة كلام الأستاذ الإمام. و قد رأينا أن نرجع بعد كتابته إلى كلام في المتشابه و التأويل، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، فرجعنا إليه و قرأناه بإمعان، فإذا هو منتهى التحقيق و العرفان، و البيان الذي ليس وراءه بيان، أثبت فيه أنه ليس في القرآن كلام لا يفهم معناه، و أن المتشابه إضافي إذا اشتبه فيه الضعيف لا يشتبه فيه الراسخ، و أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو ما تؤول إليه تلك الآيات في الواقع، ككيفية صفاته تعالى، و كيفية عالم الغيب، و كيفية قدرته تعالى و تعلقها بالإيجاد و الإعدام، و كيفية استوائه على العرش. و لا كيفية عذاب أهل النار، و لا نعيم أهل الجنة، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين[32] فليست نار الآخرة كنار الدنيا، و إنما هي شيء آخر. و ليست ثمرات الجنة و لبنها و عسلها من جنس المعهود لنا في هذا العالم، و إنما هو شيء آخر يليق بذلك العالم و يناسبه.
قال: و إننا نبين ذلك بالإطناب الذي يحتمله المقام، مستمدين من كلام هذا الحبر العظيم، ناقلين بعض ما كتبه[33]. و جعل ينقل ما سرده ابن تيمية بإسهاب.
و هذا الذي ذكره ابن تيمية و أشاد به رشيد رضا، لا يعدو ما يعود إليه أمر الشيء، أخذا بالمفهوم اللغوي لمادة التأويل. أما العين الخارجية بالذات فلعله من اشتباه المصداق بالمفهوم، فإن الوجود العيني للأشياء هي عين تشخصاتها المعبر عنها بالمصاديق الخارجية، و لم يعهد إطلاق لفظ «التأويل» على المصداق في متعارف الاستعمال إلا أن يكون من عرفهما الخاص، و لا مشاحة في الاصطلاح.
و على أي تقدير، فإنهما لم يأتيا بشيء جديد، فإن مسألة الوجودات الأربعة للأشياء (الذهني و اللفظي و الكتبي و العيني) أمر تعارف عليه أرباب المنطق منذ عهد قديم، إلا أن الشيء الذي لم يتعارف عليه هو إطلاق اسم «التأويل» على العين الخارجية، باعتبارها مصداقا للوجودات الثلاثة المنتزعة عنها، سوى كونه مصطلحا جديدا غير معروف.
و لسيدنا العلامة الطباطبائي كلام تحقيقي لطيف حول مسألة التأويل، يراه متغايرا مع المفاهيم، بعيدا عن جنس الألفاظ و المعاني و التعابير، و إنما هي حقائق راهنة، موطنها خارج الأذهان و العبارات.
إنه رحمه الله تعرض لكلام ابن تيمية، فصححه من جهة، و خطأه من جهة أخرى؛ صححه من جهة قوله: بشمول التأويل لجميع آي القرآن، محكمه و متشابهه، و قوله: بأنه خارج الأذهان و العبارات. لكن خطأه في حصره للتأويل في العين الخارجية البحت، فإنه مصداق و ليس بتأويل. إنما التأويل حقائق راهنة، هي مصالح واقعية و أهداف و غايات مقصودة من وراء التكاليف و الأحكام، و كذا الحكم و المواعظ و الآداب، و حتى القصص و الأخبار و الآثار التي جاءت في القرآن.
قال- مناقشا لرأي ابن تيمية-:
«إنه و إن أصاب في بعض كلامه، لكنه أخطأ في بعضه الآخر. إنه أصاب في القول بأن التأويل لا يختص بالمتشابه، بل هو عام لجميع القرآن، و كذا القول: بأن التأويل ليس من سنخ المدلول اللفظي، بل هو أمر خارجي يبتنى عليه الكلام. لكنه أخطأ في عد كل أمر خارجي مرتبط بمضمون الكلام- حتى مصاديق الأخبار الحاكية عن الحوادث الماضية و المستقبلة- تأويلا للكلام»[34].
ثم قال: «الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية، من حكم أو موعظة أو حكمة، و أنه موجود لجميع الآيات القرآنية محكمها و متشابهها، و أنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ، بل هي من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ. و إنما قيدها الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب، فهي كالأمثال تضرب ليقرب بها المقاصد و توضح، بحسب ما يناسب فهم السامع، كما قال تعالى:
و الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. و إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم[35].
و قال- في شرح الآية-:
«إن هناك كتابا مبينا عرض عليه جعله مقروا عربيا، و إنما ألبس لباس القراءة و العربية ليعقله الناس، و إلا فإنه- و هو في أم الكتاب- عند الله علي لا تصعد إليه العقول، حكيم لا يوجد فيه فصل و فصل. فالكتاب المبين- في الآية- هو أصل القرآن العربي المبين، و للقرآن موقع هو في الكتاب المكنون، و أن التنزيل حصل بعده، و هو الذي عبر عنه بأم الكتاب و باللوح المحفوظ. فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن و حكمه الخالي عن التفصيل، أمر وراء هذا المنزل، و إنما هذا بمنزلة اللباس لذاك. إن هذا المعنى، أعني كون القرآن في مرتبة التنزيل بالنسبة إلى الكتاب المبين، و نحن نسميه بحقيقة الكتاب، بمنزلة اللباس من المتلبس، و بمنزلة المثال من الحقيقة، و بمنزلة المثل من الغرض المقصود بالكلام ...»[36].
و أضاف: «فالحقيقة الخارجية التي توجب تشريع حكم من الأحكام أو بيان معرفة من المعارف الإلهية أو وقوع حادثة هي مضمون قصة من القصص القرآنية، و إن لم تكن أمرا يدل عليه بالمطابقة نفس الأمر و النهي أو البيان أو الواقعة الكذائية، إلا أن الحكم أو البيان أو الحادثة، لما كان كل منها ينشأ منها و يظهر منها، فهو أثرها الحاكي لها بنحو من الحكاية و الإشارة»[37]. و أخيرا لخص كلامه في بيان التأويل بما يلي:
«التأويل في عرف القرآن هو الحقيقة التي يتضمنها الشيء و يؤول إليها و يبتنى عليها، كتأويل الرؤيا، و هو تعبيرها، و تأويل الحكم، و هو ملاكه، و تأويل الفعل، و هو مصلحته و غايته الحقيقية، و تأويل الواقعة، و هو علتها الواقعية، و هكذا»[38] غير أن وقفة فاحصة عند كلام هذا المحقق العلامة، تجعلنا نتردد في التوافق معه، إنه رحمه الله لو كان اقتصر على ما لخصه أخيرا، من جعل ملاكات الأحكام و المصالح و الغايات الملحوظة في التشريعات و التكاليف تأويلا، أي أصلا لها و مرجعها الأساسي لكل ذلك المذكور؛ لأمكننا مرافقته.
لكنه توسع في ذلك، و فرض من تأويل آي القرآن كلها أمرا بسيطا ذا إحكام رصين، ليس فيه شيء من هذه التجزئة و التفصيل الموجود في القرآن الحاضر الذي يتداوله المسلمون منذ أول يومهم فإلى ما لا نهاية، فإن ذاك عار عن كونه آية آية و سورة سورة، وجودا واحدا بسيطا صرفا، مستقرا في محل أرفع، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
و فرض من القرآن ذا وجودين: وجودا ظاهريا يتشكل في ألفاظ و عبارات ذوات مفاهيم معروفة، و هو الذي يتلى و يقرأ و يدرس، و يتداوله الناس حسبما ألفوه طوال عهد الإسلام.
و وجودا آخر باطنيا، هو وجوده الحقيقي الأصيل، المترفع عن أن تناله العقول و الأحلام، فضلا عن الأوهام، و ذلك الوجود الحقيقي الرفيع هو تأويل القرآن، أي أصله و مرجعه الأصيل.
قال- بصدد بيان نزول القرآن دفعة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان، و أنه لم يكن هذا القرآن المتلو الذي بأيدي الناس، فإنه نزل تدريجا بلا ريب-:
«و الذي يعطيه التدبر في آيات الكتاب أمر آخر، فإن الآيات الناطقة بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة القدر إنما عبرت عن ذلك بلفظ الإنزال الدال على الدفعة، دون التنزيل، و اعتبار الدفعة إما بلحاظ المجموع أو البعض، و إما لكون الكتاب ذا حقيقة أخرى وراء ما نفهمه بالفهم العادي، الذي يقضي فيه بالتفرق و التفصيل و الانبساط و التدريج، هو المصحح لكونه واحدا غير تدريجي و نازلا بالإنزال دون التنزيل؛ و هذا هو اللائح من الآيات الكريمة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت[39] فإن هذا الإحكام مقابل التفصيل، و التفصيل هو جعله فصلا فصلا و قطعة قطعة؛ فالإحكام كونه بحيث لا يتفصل فيه جزء من جزء، و لا يتميز بعض من بعض؛ لرجوعه إلى معنى واحد لا أجزاء فيه و لا فصول. و الآية ناطقة بأن هذا التفصيل المشاهد في القرآن، إنما طرأ عليه بعد كونه محكما غير مفصل، و أوضح منه قوله تعالى: حم و الكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. و إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم[40] فإنه ظاهر في أن هناك كتابا مبينا عرض عليه جعله مقروا عربيا، و إنما ألبس لباس القراءة و العربية ليعقله الناس، و إلا فإنه في أم الكتاب عند الله علي لا يصعد إليه العقول، حكيم لا يوجد فيه فصل فصل. فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن و حكمه الخالي عن التفصيل أمر وراء هذا المنزل و إنما هذا بمنزلة اللباس لذاك.[41] ثم أحال تمام الكلام إلى بيانه الآتي حول آية المتشابهات، قال هناك:
«الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية، و أنه موجود لجميع الآيات، و أنه ليس من قبيل المفاهيم بل من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ، و إنما قيدها الله بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم[42] و في القرآن تصريحات و تلويحات بهذا المعنى[43].
و بعد، فلنتساءل: ما هو السبب الداعي لفرض وجودين للقرآن الكريم:
وجودا لديه تعالى في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، عاريا عن التجزئة و التفصيل، متعاليا عن شبكات الألفاظ و العبارات؛ و وجودا أرضيا نزل تدريجا لهداية الناس، و ألبس لباس العربية لعلهم يعقلونه؟! و لعله للنظر إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ...[44] و قوله: حم و الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا[45] و قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر ...[46].
و
قد ورد في الحديث- من طرق الفريقين-: أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل تدريجا طوال عشرين عاما»[47].
و لذلك فرض علامتنا الطباطبائي وجودين للقرآن الكريم و نزولين. و كان نزوله الدفعي بوجوده البسيط الذي كان بمنزلة الروح لهذا القرآن، النازل تدريجا بوجوده التفصيلي.
و بذلك نراه قد جمع بين ظواهر الآيات و دلالة الروايات، و أيد ذلك بالفارق اللغوي بين لفظتي «الإنزال» و «التنزيل».
لكن تشريف شهر رمضان إنما كان بنزول هذا القرآن المعهود لدى المخاطبين بهذا الخطاب، لا بأمر لا يعرفونه! على أن القرآن النازل في هذا الشهر، قد وصف بكونه هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان[48] و معلوم أن الهداية و البينات، إنما هي بهذا الكتاب الذي يتداولونه، لا بكتاب مكنون عند الله محفوظ لديه في مكان علي لا تناله الأيدي و الأبصار.
كما أن الذي يبتغيه أهل الزيغ لأجل الفساد في الأرض، هو تفسير الآيات على غير وجهها، لا وجودا آخر للقرآن، هو في أعلى عليين.
فقوله رحمه الله: «و أنه موجود لجميع الآيات محكمها و متشابهها، و أنه ليس من قبيل المفاهيم بل من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ ...» غير مفهوم لنا. و الفرق بين «الإنزال» و «التنزيل» أمر أبدعه الراغب الأصبهاني، و لا شاهد له.
قال: و إنما خص لفظ الإنزال دون التنزيل؛ لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم نزل نجما فنجما. و لفظ الإنزال أعم من التنزيل، قال:
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل[49] و لم يقل: لو نزلنا، تنبيها إنا لو خولناه مرة ما خولناك مرارا.
و يرد عليه ما حكاه الله عن قوله العرب: لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة[50].
و كذلك قوله تعالى: و قالوا لو لا نزل عليه آية من ربه[51].
و قوله: و يقول الذين آمنوا لو لا نزلت سورة[52].
و قوله: و لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه ...[53].
و قوله: لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا[54].
كما جمع بين التعبيرين بشأن أمر واحد في قوله تعالى: و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون[55].
كما جاء استعمال «الإنزال» بشأن التدريجيات أيضا:
أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم[56].
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات[57].
لأن الكتاب الذي منه محكم و متشابه، هو هذا الكتاب الذي نزل تدريجا.
أ فغير الله أبتغي حكما و هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا[58]؛ إذ الذي نزل مفصلا هو هذا القرآن الذي نزل منجما.
و أخيرا فما هي الفائدة المتوخاة من وراء نزول القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا أو إلى السماء الرابعة، في البيت المعمور أو بيت العزة- على الاختلاف في ألفاظ الروايات-، ثم نزوله بعد ذلك تدريجا في طول عهد الرسالة؟
و هل لوجود القرآن بوجوده البسيط الروحاني- في ذلك المكان الرفيع- فائدة تعود على أهل السماوات أو سكان الأرضين؟
و أجاب الفخر الرازي عن ذلك، و علل وجود القرآن هناك، في مكان أنزل من العرش و أقرب إلى الأرض؛ ليسهل التناول منه لجبرائيل عند مسيس الحاجة.[59] و علل بعض الأساتذة المعاصرين ذلك، بأن الرابط بين ذلك القرآن المحفوظ لديه تعالى، و هذا القرآن المعروض على الناس، هو «رابط العلية» فكل ما في هذا القرآن من حكم و مواعظ و آداب، و تعاليم و معارف و أحكام، إنما تنشأ مما حواه
ذلك القرآن، على بساطته و علو رفعته؛ فهذا إشعاع من ذلك النور الساطع، و إفاضة من ذلك المقام الرفيع.[60] غير أن هذا كله تكلف في التأويل، و تمحل في القول بلا دليل، و لعلنا في غنى عن البسط فيه و التذييل.
و أما الآيات التي استندوا إليها لإثبات وجود آخر للقرآن محفوظ عند الله، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ... فهي تعني أمرا آخر غير ما راموه.
و ليعلم أن المقصود من الكتاب المكنون، هو: علم الله المخزون، المعبر عنه ب (اللوح المحفوظ) أيضا، و هكذا التعبير ب (ام الكتاب) كناية عن علمه تعالى الذاتي الأزلي، بما يكون مع الأبد.
و قد ذكر العلامة الطباطبائي- في تفسير سورة الرعد حديثا
عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «كل أمر يريده الله، فهو في علمه قبل أن يضعه، و ليس شيء يبدو له إلا و قد كان في علمه»
قال ذلك تفسيرا لقوله تعالى: يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب[61].
فقوله تعالى: و إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم[62] يعني قضى الله في علمه الأزلي الحتم أن القرآن- في مسيرته الخالدة- سوف يشغل مقاما عليا، مترفعا عن أن تناله أيدي السفهاء، حكيما مستحكما قوائمه، لا يتضعضع و لا يتزلزل، يشق طريقه إلى الأمام بسلام[63].
و كذا قوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ[64] أي هكذا قدر في علمه تعالى المكنون[65].
و هكذا ذكر الطبرسي و غيره في تفسير قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون[66] أنه إشارة إلى مقامه الرفيع عند الله، و قد جرى في علمه تعالى أنه محفوظ عن مناوشة المناوئين.
قال سيد قطب: «إنه لقرآن كريم: كريم بمصدره، و كريم بذاته، و كريم باتجاهاته. في كتاب مكنون: مصون، و تفسير ذلك في قوله تعالى بعده: لا يمسه إلا المطهرون. فقد زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به، فهذا نفي لهذا الزعم.
فالشيطان لا يمس هذا الكتاب المكنون في علم الله و حفظه، إنما تنزل به الملائكة المطهرون؛ و لذلك قال- بعدها-: تنزيل من رب العالمين، أي لا تنزيل من الشياطين»[67].[68]
[1] ( 1) آل عمران/۷.
[2] ( 2) الكهف/ ۷۸، ۸۲.
[3] ( 3) الإسراء/ ۳۵.
[4] ( 4) النساء/ ۵۹.
[5] ( 1) النساء/ ۸۳.
[6] ( 2) الأعراف/ ۵۳.
[7] ( 3) الفرقان/ ۲۲.
[8] ( 4) الاحقاف/ ۳۵.
[9] ( 5) ص/ ۳.
[10] ( 6) بصائر الدرجات، الصفار، ص ۱۹۵.
[11] ( 1) تفسير العياشي، ج 1، ص ۱۰، رقم ۷.
[12] ( 2) المصدر نفسه، ص ۱۵، رقم ۶.
[13] ( 3) الأنفال/ ۴۱.
[14] ( 1) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 6، ص 350، كتاب الخمس، باب 8، رقم ۵ و ۶.
[15] ( 2) البقرة/ ۱۹۵.
[16] ( 1) الوسائل، ج 6، ص ۵۱.
[17] ( 1) الرحمن/ ۹.
[18] ( 2) التبيان، ج 9، ص ۴۶۳.
[19] ( 1) نقلا بالمعنى، راجع: تأويل الآيات الظاهرة للسيد شرف الدين الاسترابادي، ج 2، ص ۶۳۲- ۶۳۳.
[20] ( 2) الملك/ ۳۰.
[21] ( 3) تفسير الصافي، الفيض الكاشاني، ج 2، ص ۷۲۷، و راجع: تأويل الآيات الظاهرة، ج 2، ص ۷۰۸.
[22] ( 1) الأنفال/ ۲۴.
[23] ( 2) آل عمران/ ۱۶۴.
[24] ( 3) عبس/ ۲۴.
[25] ( 4) تفسير البرهان، ج 4، ص ۴۲۹.
[26] ( 1) القصص/ 17.
[27] ( 2) القصص/ ۱۴.
[28] ( 1) هود/ ۶۱.
[29] ( 1) رسالة الإكليل، مطبوعة ضمن المجموعة الثانية من رسائله ص ۱۰ و ۱۷- ۱۸.
[30] ( 1) راجع: رسالته في تفسير سورة الإخلاص، ص ۱۰۲- ۱۰۳. و نقله محمد رشيد رضا في تفسير المنار، ج 3، ص ۱۹۵- ۱۹۶.
[31] ( 2) يرى الأستاذ عبده من متشابهات القرآن، الأمور الأخروية التي ورد ذكرها في القرآن، لأنها من ضرورة الدين و من مقاصد الوحي؛ حيث العقيدة بأحوال الآخرة من أركان الدين، فيجب الإيمان بها، الأمر الذي لا يمكن الوقوف على حقيقتها إلا بعد مشاهدتها في الآخرة، فهي تأويلها ذلك اليوم، كما قال تعالى: يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الأعراف/ ۵۳( المنار، ج ۳، ص ۱۶۷)
[32] ( 1) السجدة/ ۱۷.
[33] ( 2) تفسير المنار، ج 3، ص ۱۷۲- ۱۹۶.
[34] ( 1) الميزان، ج ۳، ص ۴۸.
[35] ( 1) الميزان، ج ۳، ص ۴۹، الزخرف/ ۴.
[36] ( 2) الميزان، ج ۲، ص ۱۴- ۱۶.
[37] ( 3) المصدر نفسه، ج ۳، ص ۵۳.
[38] ( 1) الميزان، ج ۱۳، ص ۳۷۶.
[39] ( 1) هود/ 1.
[40] ( 2) الزخرف/ ۴.
[41] ( 1) الميزان، ج ۲، ص ۱۴- ۱۶.
[42] ( 2) الزخرف/ 4.
[43] ( 3) الميزان، ج ۳، ص ۴۹.
[44] ( 4) البقرة/ ۱۸۵.
[45] ( 5) الدخان/ ۵.
[46] ( 6) القدر/ ۱.
[47] ( 1) بحار الأنوار، ج ۹۴، ص ۱۴، رقم ۲۳.
[48] ( 2) البقرة/ ۱۸۵.
[49] ( 1) الحشر/ ۲۱.
[50] ( 2) الفرقان/ ۳۲.
[51] ( 3) الأنعام/ ۳۷.
[52] ( 4) محمد/ ۲۰.
[53] ( 5) الأنعام/ ۷.
[54] ( 6) الإسراء/ ۹۵.
[55] ( 7) النحل/ ۴۴.
[56] ( 1) البقرة/ ۲۲.
[57] ( 2) آل عمران/ ۷.
[58] ( 3) الأنعام/ ۱۱۴.
[59] ( 4) التفسير الكبير، ج ۵، ص ۸۵.
[60] ( 1) مباني و روشهاى تفسير، ص ۷۳.
[61] ( 2) تفسير الميزان، ج ۱۱، ص ۴۲۰، الرعد/ ۳۹.
[62] ( 3) الزخرف/ ۴.
[63] ( 4) راجع: الطبرسي، مجمع البيان، ج ۹، ص ۳۹. و الطوسي، التبيان، ج ۹، ص ۱۷۹. و أبا الفتوح الرازي، ج ۱۰، ص ۷۴. و الفخر الرازي، ج ۲۷، ص ۱۹۴.
[64] ( 1) البروج، ۲۲.
[65] ( 2) راجع: تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد، ص ۲۹. و الفخر الرازي، ج ۲۳، ص ۶۶ و ج ۲۸، ص ۱۵۲.
[66] ( 3) الواقعة/ ۸۰.
[67] ( 4) في ظلال القرآن، ج 7، ص ۷۰۶. و راجع: المجمع، ج 9، ص ۲۲۶.
[68] التفسير و المفسرون فى ثوبه القشيب ج ۱ ص ۲۰-۴۸
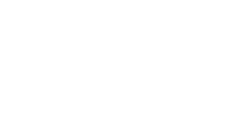
بدون نظر