حاشیه بر مدارک الاحکام
الف)قوله: فإن كل ما ثبت. (1: 46).
قيل: إنّ غالبه يدوم، و الظن يلحق بالأغلب، و كل ظن للمجتهد حجة إلا ما ثبت المنع منه بخصوصه، كالقياس
و منع بعضهم هذه الغلبة بأن الدوام مختص بالقار الذات، و هو غير غالب. سلمنا، لكن كون الحكم الشرعي منه ممنوع. مع أن كل دوام ليس على حد واحد، بل يتفاوت بتفاوت عادة اللّه تعالى، فلا يمكن الحكم به إلىان يثبت خلافه.
و منع بعضهم حجّيّة مثل هذا الظن مع تسليم تحققه و لا يبعد تحققه، بملاحظة أنّ الأحكام الشرعية غالبها يدوم حتى يثبت خلافها.
و استدل أيضا بما في غير واحد من الأخبار من أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا بناء على أن المراد كل يقين و كل شك بعده. و منع الدلالة بعضهم بأن الظاهر وروده في موضع ثبت دوامه إلى حد معين، و حصل الشك في تحقق الحد حتى يتأتى أن يقال: اليقين نقض بالشك، و إلا فالشك اللاحق لا يجامع اليقين السابق ، و فيه نظر، إذ الشك في الحد يوجب رفع اليقين من الحين، فالعبرة بالسابق.
و قال بعضهم بثبوت الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي لا نفسه ، يعني ثبت منه بقاء الموضوع و عدمه لا بقاء الحكم السابق إلى أن يثبت حكم شرعي لشيء. مثلا إذا لم يعلم أن الشيء الذي تحقق هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ لا يمكن إثبات عدم كونه حدثا بهذا الحديث، بل القدر الذي يثبت إثبات عدم تحقق الحدث المعلوم حكمه شرعا، أي حكم الشارع بأنه يبني على عدم حدوثه. و ادعى ظهور ما ذكره بتتبع موارد الأحاديث.
و ربما منع بأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل و لا يخلو عن قرب. نعم استصحاب الموضوع أظهر أفراده.
و يؤيد ما ذكرناه ما أشرنا إليه من غلبة الأحكام الفقهية في البقاء، و طريقة الفقهاء أنهم إذا ثبت حكم شرعي يحتاجون في حكمهم بخلاف ذلك إلى دليل شرعي، و أمرهم مقصور على ذلك، و لا يقولون في موضع بعد تحقق حكمه أن هذا الآن حكمه كذا فقط، و بعد ذلك الأصل عدمه، فليلاحظ كتبهم الاستدلالية و الفقهية، بل البقاء رسخ في أذهان المتشرعة بحيث يصعب عليهم فهم خلافه.
نعم عند تغير الموضوع بتغير العلة أو الوصف المشعر بالعلية يتأملون في البقاء حينئذ، مع أن ظاهر أكثرهم البقاء حينئذ أيضا، فتأمّل.
و ممّا ذكرنا لعله يظهر التأمّل في فهم العموم من الأدلة الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ، فإن قوله عليه السلام: «فإذا تغير الماء فلا تتوضأ» يحتمل أن يراد منه ما دام متغيرا. و رجوع الإطلاق إلى العموم الذي ليس ممّا وضع اللفظ له أزيد مما ذكر لعله يحتاج إلى إثبات، إذ لو قال: إذا فقدت الماء فتيمم وصل بذاك التيمم، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا، فتأمّل.
و بالجملة: لا بدّ من ملاحظة الأمثلة الشرعية و العرفية و غيرها و التأمّل فيها.
نعم ربما أمكن الفرق بين زوال العلة المؤثرة، و ما هو شرط في تأثير العلة، كالقلة في الانفعال بالملاقاة، فإن زواله لا يوجب انتفاء المعلول، لأنه ليس علة بل هو شرط لحصول التأثير، و قد حصل فهو متأثر مطلقا، فتأمّل[1].
ب)قوله: و يشهد لهذا القول أيضا. (1: 361).
لا يخفى أن المتداول بين الفقهاء و غيرهم التعبير بلفظ خصوص الغسل، مثل: أن تغتسل للحيض و الاستحاضة و النفاس، و: يجب في مس الميت الغسل، و: يجب غسل الميت، و: هل يجوز جماع الحائض قبل الغسل أم لا. إلى غير ذلك من أوّل الكتاب إلى آخره.
و كذا لو سألت عنا في المقامات نقول لها: اغتسلي، من غير تعرض لذكر الوضوء في مقام من المقامات.
و كذا الحال في الأغسال المستحبة فنقول: غسل الجمعة سنة، أو:
اغتسل للجمعة، و هكذا في سائر الأغسال، من غير إشارة إلى الوضوء.
و كذا الفقهاء في كتبهم من غير تعرض لذكر الوضوء أصلا، مع أنّه لا شبهة عندنا أنّا نريد الوضوء مع الغسل، و كذا الحال في سائر الأغسال.
فالمقام ليس مقام ذكر الوضوء حتى يقال: مع عدم ذكره ظاهر في عدم
وجوبه، لأنّا يقينا نريد الوضوء و نعتبره كالفقهاء جزما و لا نشير أبدا. مع أنّ رفع الحدث لعله كان مركوزا في طباع السائلين و الرواة، فلذا لم ينبهوا، فتأمّل، و قد بسطنا الكلام في تحقيق المقام في صدر الكتاب، فلاحظ و تأمّل[2].
ج)قوله: و يجب الغسل على من مسّ ميتا. (2: 277).
أمّا كون وجوب هذا الغسل لنفسه أو لغيره فقد مرّ الكلام فيه في أوّل الكتاب و يدل على كون المسّ حدثا و هذا الغسل طهارة له عبارة الفقه الرضوي: و إنّ من صلّى قبل هذا الغسل عليه إعادة الصلاة بعد هذا الغسل و في بحث أنّ كل غسل قبله وضوء إلّا الغسل من الجنابة التصريح أيضا بأنّ من صلّى و نسي هذا الوضوء أنّ عليه إعادة تلك الصلاة بعد ما توضّأ
و يدلّ عليه أيضا: وفاق الأصحاب على الظاهر، لأنّ منهم من صرّح و الباقي يقسّمون الغسل إلى واجب و مندوب، ثم يقولون:
فالواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة- أي الصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن- ثم يذكرون أمورا، ثم في ذكر الواجب من الغسل يقسّمونه إلى ستّة و يذكرون هذا الغسل منها.
و غسل [الميت] يخرج من القرينة، أو أنّه أيضا شرط للصلاة على الميت، فتأمّل جدّا.
و ممّا يدل أيضا: أنّ صيغة الأمر في الأحداث و الأخبار يتبادر [منها] الوجوب للغير مثل الصلاة أو غيرها، بلا تأمّل من أحد من الإشارة إلى وجهها، و ليس في جميع ما هو مسلّم عند الشارح و من وافقه (في المناقشة) في المقام ما يدلّ على كون الوجوب لأجل الصلاة. و أمّا ما ورد في بعضه ممّا يدل عليه لا ينفع بالنسبة إلى ما لم يرد، على تقدير صحة هذه المناقشة. و مع ذلك في المقام الذي ورد ربما لا يستجمع شرائط الحجّية عند مثل الشارح، و مع ذلك لا يتوقّف فهم الوجوب على ملاحظته، بل يتبادر كون الوجوب لمثل الصلاة لا لنفسه، و إن لم يدر ورود ما يدل على ذلك، مع أنّ ما يدل ظنّي و التبادر قطعي.
و ممّا يدل على ذلك أيضا: ما ورد: من أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اغتسل حين غسّل الرسول لجريان السنّة، و إلّا فالرسول طاهر مطهّر ، هذا مضمون الحديث، و ليس متنه ببالي.
و في العلل- في باب غسل الميت و الغسل من مسّه- بسنده عن الباقر عليه السّلام: «علّة غسل الميت لأنّه جنب، و لتلاقيه الملائكة و هو طاهر، و كذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين» و في حديث آخر: «الميت إذا خرج الروح عنه بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهّر له و يطهر»
هذا مع اتفاق المتشرّعة على كونه طهارة، لأنّ الطهارة عندهم عن الحدث الأصغر و هو الوضوء، أو الأكبر و هو الغسل، و يجعلونه ستّة:
الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و الموت، و مسّ الميت، من دون فرق منهم بين الأمور المذكورة في نصوص عباراتهم و ظواهرها، و لا يطلقون لفظ الطهارة على وضوء الحائض، كما لا يطلق عليه في الأخبار أيضا، مثل ما رواه ابن مسلم عن [الصادق] عليه السّلام أنّه قال له: الحائض تتطهّر يوم الجمعة و تذكر اللّه تعالى؟ فقال عليه السّلام: «أمّا الطهر فلا، و لكن تتوضّأ وقت كلّ صلاة، و تستقبل القبلة و تذكر اللّه تعالى» و ذكر بعض الفقهاء مثله في مبحث الطهارات استطراد و تقريب. (و أمّا الطهارات المستحبة قبل دخول وقت الصلاة و الواجبة بعد دخوله فكلها واجبة لغيرها قطعا، بل عند المشهور أنّ جميع الطهارات كذلك)
و إنّما قلنا بشمول الكل لغسل المسّ أيضا، لما عرفت من الأخبار أنّه طهارة، و كذا من اتفاق المتشرّعة. و معلوم أنّه إذا كان في الحديث قرينة صارفة عن إرادة المعنى اللغوي، يكون المراد هو المعنى الذي عند المتشرّعة حقيقة، كما هو مسلّم و محقّق، فبعد ثبوت كونه طهارة من الأخبار و غيرها، يكون هذا الغسل أيضا داخلا في العمومات مثل قولهم:
«لا صلاة إلّا بطهور» إذ ليس فيه تخصيص بطهور دون طهور[3].
د)قوله: و يتوجّه على الأوّل. (3: 456).
المتبادر ممّا دل على اشتراطها به كونها من أوّلها إلى آخرها على الطهارة على سبيل الاتصال و الاستمرار، و المتبادر من الصحيح المتضمّن لكون فرض الصلاة الوقت و الطهور أنّه مثل الوقت من فرائضها، فتأمّل.
و يؤيّده جريان العادة في الأخبار و كلام الأصحاب بأنّ منافيات الصلاة تقطع الصلاة بخلاف الوضوء و غيره، فإنّه لا يقال: يقطع الوضوء فتأمّل.
هذا.
على أنّه من أين ظهر كون هذه الصلاة شرعية و عبادة؟ مع كونها توقيفية موقوفة على الثبوت من الشرع، هذا إن قلنا إنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة، كما هو أحد القولين، و لعله أقربهما بالنظر إلى الدليل، كما حقّقناه في محلّه.
و أمّا على القول الآخر فإنّه لمّا ثبت من الشرع جزما أنّها لا تصح بغير الظهور و حصل الشك في أنّ الطهور على سبيل الدوام شرط أم على سبيل التوزيع يكفي، فقد قلنا: إنّ الظاهر من الأدلة هو الأوّل، و يعضده عدم جواز التوزيع عمدا، و عدم الصحة حينئذ يقينا و إن كان جهلا.
و حمل الأدلة على سبيل الدوام في حال العمد و الجهل، و على سبيل التوزيع في حال النسيان، فيه ما فيه.
و القول بأنّ الظاهر منه على سبيل التوزيع خاصّة و ثبوت الدوام فيه في غير حال النسيان من دليل آخر أيضا بعيد لعله لا يرضى به المنصف بعد ملاحظة الأدلة و ما أشرنا إليه، و لذا لو لم تكن الأخبار الصحيحة لما كان القائل بالصحة يقول بها بلا شبهة، و لا يبني على كون المراد حال التوزيع البتّة، كما لا يخفى على المتأمّل، سيّما مع ملاحظة تحقّق أفعال كثيرة (كلّ
واحد منها فعل كثير) (فباجتماع) الكلّ يمحو عند المتشرعة صورة الصلاة المتلقّاة من الشرع، المنقولة عنه، و على و تقدير تسليم عدم الظهور الذي ذكرناه فلا أقلّ من الشكّ، و الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فتأمّل جدّا.
على أنّه سيجيء من السيد رحمه اللّه أنّه حكم ببطلان الصلاة بمجرّد وضع اليمين على الشمال محتجّا بأنّه فعل كثير خارج من الصلاة ، فما ظنّك بأفعال كثيرة خارجة عنه[4]؟
ه)قوله: فإن كل ما ثبت. (1: 46).
قيل: إنّ غالبه يدوم، و الظن يلحق بالأغلب، و كل ظن للمجتهد حجة إلا ما ثبت المنع منه بخصوصه، كالقياس
و منع بعضهم هذه الغلبة بأن الدوام مختص بالقار الذات، و هو غير غالب. سلمنا، لكن كون الحكم الشرعي منه ممنوع. مع أن كل دوام ليس على حد واحد، بل يتفاوت بتفاوت عادة اللّه تعالى، فلا يمكن الحكم به إلىأن يثبت خلافه
و منع بعضهم حجّيّة مثل هذا الظن مع تسليم تحققه ، و لا يبعد تحققه، بملاحظة أنّ الأحكام الشرعية غالبها يدوم حتى يثبت خلافها.
و استدل أيضا بما في غير واحد من الأخبار من أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا بناء على أن المراد كل يقين و كل شك بعده و منع الدلالة بعضهم بأن الظاهر وروده في موضع ثبت دوامه إلى حد معين، و حصل الشك في تحقق الحد حتى يتأتى أن يقال: اليقين نقض بالشك، و إلا فالشك اللاحق لا يجامع اليقين السابق ، و فيه نظر، إذ الشك في الحد يوجب رفع اليقين من الحين، فالعبرة بالسابق.
و قال بعضهم بثبوت الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي لا نفسه ، يعني ثبت منه بقاء الموضوع و عدمه لا بقاء الحكم السابق إلى أن يثبت حكم شرعي لشيء. مثلا إذا لم يعلم أن الشيء الذي تحقق هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ لا يمكن إثبات عدم كونه حدثا بهذا الحديث، بل القدر الذي يثبت إثبات عدم تحقق الحدث المعلوم حكمه شرعا، أي حكم الشارع بأنه يبني على عدم حدوثه. و ادعى ظهور ما ذكره بتتبع موارد الأحاديث.
و ربما منع بأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل و لا يخلو عن
قرب. نعم استصحاب الموضوع أظهر أفراده.
و يؤيد ما ذكرناه ما أشرنا إليه من غلبة الأحكام الفقهية في البقاء، و طريقة الفقهاء أنهم إذا ثبت حكم شرعي يحتاجون في حكمهم بخلاف ذلك إلى دليل شرعي، و أمرهم مقصور على ذلك، و لا يقولون في موضع بعد تحقق حكمه أن هذا الآن حكمه كذا فقط، و بعد ذلك الأصل عدمه، فليلاحظ كتبهم الاستدلالية و الفقهية، بل البقاء رسخ في أذهان المتشرعة بحيث يصعب عليهم فهم خلافه.
[1] الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج1، ص: ۹۰-۹۲
[2] الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج1، ص: ۴۰۰-۴۰۱
[3] الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج2، ص: ۱۷۸-۱۸۲
[4] الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج3، ص: ۱۲۲-۱۲۳
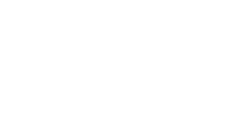
بدون نظر