سیدحسن بجنوردی
اشتراک احکام
الثالث: ارتكاز عامّة المسلمين حتّى العوام بأنّ حكم اللّه في هذه الواقعة واحد للجميع.
و لذلك ترى أنّ أحدهم لو سئل عن الإمام عليه السلام، أو عن مقلّده حكما شرعيّا لموضوع أو لفعل من الأفعال، و سمع ذلك الحكم غيره ممن هو مثله، لا يتأمّل و لا يتردّد في ثبوته في حقّه، و لا يحتمل أن يكون حكم اللّه في حقّ ذلك السائل غير حكم اللّه في حقّه فهذا المعنى أي وحدة التكليف و اشتراكه بين جميع المكلفين شيء مرتكز في أذهان جميعهم، و لا يمكن ذلك إلاّ بوصوله إليهم من مبدإ الوحي و الرسالة، ثمَّ من هؤلاء إلى من بعدهم، و هكذا إلى زماننا.
و لعلّ إلى هذا ينظر كلام بعض المحققين حيث يقول: و القول بأنّ الكون في زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله دخيل في اتّحاد الصنف الذي هو شرط شمول الخطابات، هدم لأساس الشريعة، و ذلك من جهة أنّ الأحكام إن كانت مخصوصة بالحاضرين في مجلس النبي صلّى اللّه عليه و آله المخاطبين، أو مطلق الموجودين في ذلك الزمان فقط، فانتهى أمر الدين - العياذ باللّه - و تكون الناس بعد ذلك كالبهائم و المجانين. و هذا أمر باطل بالضرورة، لأنّه يوجب هدم أساس الدين.
فادّعاء الضرورة على اشتراك الجميع في التكاليف لا بد فيه، بل هو كذلك.
و هذا لا ينافي اختصاص بعض التكاليف ببعض الطوائف دون بعض، بل ببعض الأشخاص دون سائرين، لأنّ المراد من الاشتراك عدم اختصاص التكليف بمن توجّه الخطاب اليه، كما أشرنا إلى ذلك و قلنا: إنّ قوله عليه السّلام لزرارة أو محمّد بن مسلم مثلا «أعد» أو «اغسل» أو «لا يعيد» مثلا، ليس من جهة اختصاص ذلك الحكم بهما و أمثالهما من الرواة و نقله الأحاديث، بل توجيه الخطاب إليهما أو إلى غيرهما من باب أنّهم من مصاديق طبيعة المكلّفين و يبيّنون حكم المسألة بهذه الصورة.
و هذا لا ينافي كون موضوع الحكم - أي المكلف - مقيدا ببعض القيود، أو متّصفا ببعض الصفات، أو كونه من طائفة خاصّة من الطوائف، أو كونه من النساء أو من الرجال، و أمثال هذه الاختلافات، بل لا بدّ منها لعدم كونه الأحكام جزافيّة، بل تابعة للمصالح و المفاسد التي في متعلّقاتها و موضوعاتها.
و الموضوعات و المتعلّقات تختلف من حيث المصلحة و المفسدة باعتبار اختلاف قيودها و أوصافها و حالاتها، كالحريّة و الرقيّة و الاستطاعة و عدمها، و السفر و الحضر، و غير ذلك من العوارض[1]
ب) قاعده احترام
الثاني: ارتكاز ذهن المتشرّعة قاطبة - حتّى النساء و الصبيان - على عدم جواز هتك حرمة هذه الأمور و إهانتها و استحقارها، و يعترضون على من يهينها و يستحقرها و ينكرونها أشدّ الإنكار، و إن كان بعضهم يفرّطون في هذا الأمر، و لا شكّ في أنّه لو شرب أحد سيكارة أو شطبا في حرم أحد أولاد الأئمّة عليهم السّلام ينكرون عليه أشدّ الإنكار، أو يدخل في حرمهم لابسا حذائه يصيحون عليه، و أمثال ذلك.
فالإنصاف أنّه لا يمكن أن ينكر ثبوت مثل هذا الارتكاز في أذهان المتشرّعة، و لا يمكن أيضا إنكار أنّ هذا الارتكاز كاشف عن ثبوت هذا الحكم في الشريعة.
نعم تختلف مراتب إنكارهم بالنسبة إلى هذه الأمور؛ فلو أهان شخص - العياذ باللّه - بالكعبة المعظّمة، أو ضريح الرسول صلّى اللّه عليه و آله، أو القرآن الكريم، فإنكارهم ربما ينجرّ إلى قتله، كما هو كذلك الحكم الوارد في الشرع بالنسبة إلى تلويث الكعبة المعظّمة، بل القرآن الكريم و ضريح الرسول صلّى اللّه عليه و آله؛ لأنّه كاشف قطعيّ عن كفره أو ارتداده إن كان مسلما. أمّا لو أهان نعمة من نعم اللّه، كما لو سحق الخبز برجله متعمّدا من غير عذر و لا ضرورة، ينكرون بالصيحة في وجهه لا أزيد من ذلك.
و الحاصل: أنّ أصل الإنكار بالنسبة إلى إهانة المحترمات في الدين من مرتكزاتهم، و إن كانت مراتبه مختلفة بالنسبة إلى مراتب المحترمات، نعم العوام كثيرا ما يشتبهون في تشخيص مراتب المحترمات كما هو شأنهم في كثير من الأمور[2].
ج) نجاست اولاد کافرین
و أمّا أولاد الكفّار غير البالغين فبناء الأصحاب على نجاستهم،
و يظهر عن كلام جماعة أنّهم ادّعوا الإجماع عليه.
و استدلّوا على ذلك بأمور:
الأوّل: الإجماع.
الثاني: السيرة المستمرّة من المتديّنين الملتزمين بالعمل بأحكام الدين على معاملة آبائهم.
و الإنصاف أنّ هذه السيرة ممّا لا يمكن أن ينكر وجودها و تحقّقها، بل البحث عن نجاستهم و عدم نجاستهم مخصوص بالكتب العلميّة، و إلاّ فالمرتكز في أذهان المسلمين أنّ حالهم حال آبائهم في النجاسة و عدمها، و لا يخطر ببالهم خلاف هذا[3].
[1] القواعد الفقهیة (بجنوردی)، قم - ایران، نشر الهادی، جلد: ۲، صفحه: ۵۵
[2] القواعد الفقهیة (بجنوردی)، قم - ایران، نشر الهادی، جلد: ۵، صفحه: ۲۹۵
[3] القواعد الفقهیة (بجنوردی)، قم - ایران، نشر الهادی، جلد: ۵، صفحه: ۳۵۸
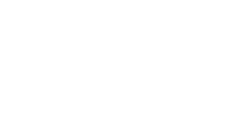
بدون نظر