بررسی اشکالات
«وجه»؛ مرکّب یا بسیط؟
-معلوم نیست که خود «وجه» مرکب باشد. بستگی به این دارد که تسمیه وجه را قبل از تحدید آن بدانیم یا قبل از آن. ممکن است چیزی باشد با اینکه اجزاء ندارد ولی بگوییم که وجه دارد[1].
نکته خوبی است. اگر ما وجه را از باب مسمّای قبل از تحدید بدانیم، این فرمایش خوب است که در آن اجزاء نیامده. اما درست است که ما قبل از تحدید، وجه میگوییم. ما قبل از تحدید مؤلفهها وجه را میگذاریم ولی علی ای حال آن مسمای ما قبل از تحدید هم اجزاء دارد. این را نمیتوانیم انکار کنیم.
- منظور ما از وجه، وجهی است که در انسان است یا از مطلق وجه صحبت میکنیم؟
نظریه روح معنا
ببینید ما یک بحثی داشتیم که آن را در اینجا مطرح نکردم. چون ریخت آن بحث، حساب دیگری دارد و آن این است که الفاظ برای روح معانی وضع شدهاند[2]؟
یا نه؛ روح معانی، یک حرف بیخودی است مثلاً؟
یا فوقش بعداً روح معنا یک معنای توسعه یافته مجازی است؟ این اساساً یک اختلافی است.
اگر ما بگوییم حتی وجه ابتدائا برای روح معنا وضع شده، خوب است. وجه به چه معنا است؟ «ما یواجه الشیء[3]». هر چیزی که به وسیله آن بین دو چیز، مواجهه صورت میگیرد. خب دراینصورت فضای دیگری به پا میشود.
و لذا اگر بگوییم «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه[4]» دیگر نیازی به تاویل نیست. نیازی به اینکه بگوییم مجاز است، نیست. بلکه میگوییم :«ما یواجه به الشی» در هر موردی بحسبه است. در مورد خداوند متعال هم روح این معنا بدون شائبه ی مجاز، صادق است. این بیان خوب است اما فعلاً من نخواستم به این شکل سیر کنم. فعلاً من میخواهم به همین معنای عرفیِ وجه سیر کنم.
الآن ولو قبل از تحدید تسمیه میکنیم، اما فعلاً بهصورت انسان، میخواهیم صورت بگوییم. در فقه اللغه یک مبنایی بود که نسبتاً قابل دفاع بود؛ چه بسا تمام پیکره لغت از تسمیه های دو حرفی یا بیشتر شروع میشود[5] که آن هم ناظر به مواردی است که مشاعر ما درک میکند. این بیان در آنجا قابل دفاع بود. اما اینکه چه اندازهای، حرف دیگری است. به گمانم در آن جا با نظریات دیگر مکمّل هم بودند و با آنها جمع میشد.
لذا اگر وجه را بهمعنای «ما یواجه به الشئ» بگیریم منافاتی ندارد که یک نوعی از وضع برای صورت انسان به کار رفته باشد یا صورت مطلق حیوانات بدون توسعه به کار رفته باشد. وقتی ما «کلمه» را وضع میکنیم، درست است که توجه نداریم دو حرف یا سه حرف است؛ درست است که وقتی «خانه» میگوییم، توجه نداریم که چند اتاق دارد یا ندارد، اما علی ای حال برای چیزی وضع میکنیم که این اجزاء و مؤلفهها را دارد. لذا شاید این حرف ما وجهی داشته باشد که رمز شکّ ما در صدق خانه، کلمه، وجه و امثال آن در سعه و ضیق آن است.
[1] اشکال یکی از دوستان حاضر در جلسه درس
[2] اصطلاح روح المعنی ظاهراً برای اولین بار در کلام غزالی مورد استفاده قرار گرفته است: و الكلب هو الغضب، فإن السبع الضاري و الكلب العقور ليس كلبا و سبعا باعتبار الصورة و اللون و الشكل، بل روح معنى السبعية الضراوة و العدوان و العقر، و في باطن الإنسان ضراوة السبع و غضبه، و حرص الخنزير و شبقه. فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاء و المنكر و السبع يدعو بالغضب إلى الظلم و الإيذاء(إحياء علوم الدين ؛ ج8 ؛ ص18)
آخوند ملاصدرا در مقام تبیین این مبنا، چنین می نویسد: قد مر أن الأصل في منهج الراسخين في العلم هو إبقاء ظواهر الألفاظ على معانيها الأصلية من غير تصرف فيها لكن مع تحقيق تلك المعاني و تلخيصها عن الأمور الزائدة و عدم الاحتجاب عن روح المعنى بسبب غلبة أحكام بعض خصوصياتها على النفس و اعتيادها بحصر كل معنى على هيئة مخصوصة له يتمثل ذلك المعنى بها للنفس في هذه النشأة فلفظ الميزان مثلا موضوع لما يوزن و يقاس به الشيء مطلقا فهو أمر مطلق يشمل المحسوس منه و المتخيل و المعقول فذلك المعنى الشامل روح معناه و ملاكه من غير أن يشترط فيه تخصيصه بهيئة مخصوصة فكل ما يقاس به الشيء بأي خصوصية كانت حسية أو عقلية يتحقق فيه حقيقة الميزان و يصدق عليه معنى لفظه فالمسطرة و الشاقول و الكونيا و الأسطرلاب و الذراع و علم النحو و علم العروض و علم المنطق و جوهر العقل كلها مقاييس و موازين يوزن بها الأشياء إلا أن لكل شيء ميزان يناسبه و يجانسه فالمسطرة ميزان الخطوط المستقيمة و الشاقول ميزان الأعمدة على الأفق و الكونيا ميزان السطوح الموازية للأفق و الأسطرلاب ميزان الارتفاعات القوسية من الأفق أولا و لجيوبها[2] و أوتارها ثانيا و النحو ميزان الإعراب و البناء للفظ على عادة العرب و العروض ميزان كمية الشعر و المنطق ميزان الفكر يعرف به صحيحه عن فاسده و العقل ميزان الكل إن كان كاملا فالكامل العارف إذا سمع الميزان لا يحتجب عن معناه الحقيقي بما يكثر إحساسه و يتكرر مشاهدته من الأمر الذي له كفتان و عمود و لسان و هكذا حاله في كل ما يسمع و يراه فإنه ينتقل إلى فحواه و يسافر من ظاهره و صورته إلى روح معناه و من دنياه إلى أخراه و لا يتقيد بظاهره و أولاه و أما المقيد بعالم الصورة فلجمود طبعه و خمود فطنته و سكون قلبه إلى أول البشرية و إخلاد عقله إلى أرض الحيوانية فيسكن إلى أوائل الفهوم و يطمئن إلى مبادئ العقول و لا يسافر من مسقط رأسه و معدن جسمه و منبت حسه و لا يهاجر من بيته إلى الله و رسوله حذرا من أن يدركه الموت و يفوته الصورة الجسمية ثم لا يصل إلى عالم المعنى لعدم وثوقه بما وعده الله و رسوله و عدم تصديقه بما قال تعالى وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهٰاجِراً إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ.
و الحاصل أن الحق عند أهل الله هو حمل الآيات و الأحاديث على مفهوماتها الأصلية من غير صرف و تأويل كما ذهب إليه محققو الإسلام و أئمة الحديث لما شاهدوه من سيرة السابقين الأولين و الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين من عدم صرفها عن الظاهر لكن مع تحقيق معانيها على وجه لا يستلزم التشبيه و النقص و التقصير في حق الله.(مفاتیح الغیب،٩٢-٩٣)
علامه ذیل آیه شریفه «هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام»البقره – ٢١٠می فرمایند:
ثم إن من الضروري الثابت بالضرورة من الكتاب و السنة أن الله سبحانه و تعالى لا يوصف بصفة الأجسام، و لا ينعت بنعوت الممكنات مما يقضي بالحدوث، و يلازم الفقر و الحاجة و النقص، فقد قال تعالى: «ليس كمثله شيء:» الشورى- ۱۱، و قال تعالى: «و الله هو الغني:» الفاطر- 15، و قال تعالى: «الله خالق كل شيء:» الزمر- 62، إلى غير ذلك من الآيات، و هي آيات محكمات ترجع إليها متشابهات القرآن، فما ورد من الآيات و ظاهرها إسناد شيء من الصفات أو الأفعال الحادثة إليه تعالى ينبغي أن يرجع إليها، و يفهم منها معنى من المعاني لا ينافي صفاته العليا و أسماءه الحسنى تبارك و تعالى، فالآيات المشتملة على نسبة المجيء أو الإتيان إليه تعالى كقوله تعالى: «و جاء ربك و الملك صفا صفا:» الفجر- 22، و قوله تعالى: «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا:» الحشر- 2، و قوله تعالى: «فأتى الله بنيانهم من القواعد:» النحل- 26، كل ذلك يراد فيها معنى يلائم ساحة قدسه تقدست أسماؤه كالإحاطة و نحوها و لو مجازا، و على هذا فالمراد بالإتيان في قوله تعالى: أن يأتيهم الله الإحاطة بهم للقضاء في حقهم.
على أنا نجده سبحانه و تعالى في موارد من كلامه إذا سلب نسبة من النسب و فعلا من الأفعال عن استقلال الأسباب و وساطة الأوساط فربما نسبها إلى نفسه و ربما نسبها إلى أمره كقوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس:» الزمر- ۴۲، و قوله تعالى: «يتوفاكم ملك الموت:» السجدة- ۱۱، و قوله تعالى: «توفته رسلنا:» الأنعام 61، فنسب التوفي تارة إلى نفسه، و تارة إلى الملائكة ثم قال تعالى: في أمر الملائكة: «بأمره يعملون:» الأنبياء- ۲۷، و كذلك قوله تعالى: إن ربك يقضي بينهم:» يونس- ۹۳، و قوله تعالى: «فإذا جاء أمر الله قضي بالحق:» المؤمن- ۷۸، و كما في هذه الآية: أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية، و قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك:» النحل- ۳۳.
و هذا يوجب صحة تقدير الأمر في موارد تشتمل على نسبة أمور إليه لا تلائم كبرياء ذاته تعالى نظير: جاء ربك، و يأتيهم الله، فالتقدير جاء أمر ربك و يأتيهم أمر الله.
فهذا هو الذي يوجبه البحث الساذج في معنى هذه النسب على ما يراه جمهور المفسرين لكن التدبر في كلامه تعالى يعطي لهذه النسب معنى أرق و ألطف من ذلك، و ذلك أن أمثال قوله تعالى: «و الله هو الغني:» الفاطر- 15، و قوله تعالى: «العزيز الوهاب:» ص- 9، و قوله «تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى:» طه- ۵۰، تفيد أنه تعالى واجد لما يعطيه من الخلقة و شئونها و أطوارها، مليء بما يهبه و يجود به و إن كانت أفهامنا من جهة اعتيادها بالمادة و أحكامها الجسمانية يصعب عليها تصور كيفية اتصافه تعالى ببعض ما يفيض على خلقه من الصفات و نسبته إليه تعالى، لكن هذه المعاني إذا جردت عن قيود المادة و أوصاف الحدثان لم يكن في نسبته إليه تعالى محذور فالنقص و الحاجة هو الملاك في سلب معنى من المعاني عنه تعالى، فإذا لم يصاحب المعنى نقصا و حاجة لتجريده عنه صح إسناده إليه تعالى بل وجب ذلك لأن كل ما يقع عليه اسم شيء فهو منه تعالى بوجه على ما يليق بكبريائه و عظمته.
فالمجيء و الإتيان الذي هو عندنا قطع الجسم مسافة بينه و بين جسم آخر بالحركة و اقترابه منه إذا جرد عن خصوصية المادة كان هو حصول القرب، و ارتفاع المانع و الحاجز بين شيئين من جهة من الجهات، و حينئذ صح إسناده إليه تعالى حقيقة من غير مجاز: فإتيانه تعالى إليهم ارتفاع الموانع بينهم و بين قضائه فيهم، و هذه من الحقائق القرآنية التي لم يوفق الأبحاث البرهانية لنيله إلا بعد إمعان في السير، و ركوبها كل سهل و وعر، و إثبات التشكيك في الحقيقة الوجودية الأصيلة.( الميزان في تفسير القرآن، ج2، ص: ۱۰۳-۱۰۴)
در این زمینه می توان به کتاب«نظریه روح معنا»یا مقالاتی مانند«نظریه روح معنا؛تقریرها و نقدها»و همین طور« بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه علامهجوادی آملی با انگارههای زبانشناسی شناختی»مراجعه کرد.
[3] کلمات لغویین در اینباره:
١.مستقبل کل شیء:
الوجه: مستقبل كل شيء(كتاب العين ؛ ج4 ؛ ص66)
قال الليث: الوجه: مستقبل كل شيء.( تهذيب اللغة ؛ ج6 ؛ ص186)
و الوجه: مستقبل كل شيء.( المحيط في اللغة ؛ ج4 ؛ ص23)
الواو و الجيم و الهاء: أصل واحد يدل على مقابلة لشىء.
و الوجه مستقبل لكل شىء. يقال وجه الرجل و غيره. و ربما غبر عن الذات بالوجه. [و] تقول: وجهى إليك.( معجم مقاييس اللغه ؛ ج6 ؛ ص88)
وجه كل شىء: مستقبله. و فى التنزيل: فأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: 115].( المحكم و المحيط الأعظم ؛ ج4 ؛ ص396)
٢.به معنای متعارف وجه:
و وجه الإنسان و غيره: معروف.( جمهرة اللغة ؛ ج1 ؛ ص498)
الوجه معروف، و الجمع الوجوه و حكى الفراء: حى الوجوه و حى الأجوه.( الصحاح ؛ ج6 ؛ ص2254)
وجه:الوجه: معروف، و الجمع الوجوه. و حكى الفراء: حي( لسان العرب ؛ ج13 ؛ ص555)
٣.جمع بین دو معنا:
أصل الوجه الجارحة. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم و أيديكم [المائدة/ 6]، و تغشى وجوههم النار [إبراهيم/ 50] و لما كان الوجه أول ما يستقبلك، و أشرف ما في ظاهر البدن استعمل في مستقبل كل شيء، و في أشرفه و مبدئه، فقيل: وجه كذا، و وجه النهار.( مفردات ألفاظ القرآن ؛ ص855)
[4] سورةالبقرة، آیه ١١۵
[5] صبحی صالح در دراسات با تقسیم این مبنا به الثنائیه التاریخیه و المعجمیه، در مورد قسم اول چنین میگوید:
أما الثنائية التاريخية: فتعود لدى أكثر القائلين بها إلى تفسير نشأة اللغة الإنسانية بمحاكاة الأصوات الطبيعية؛ كتقليد الإنسان أصوات الحيوان، وأصوات مظاهر الطبيعة، أو تعبيره عن انفعالاته الخاصة, أو عن الأفعال التي تُحْدِث عند وقوعها أصواتًا معينة "فالكلم وُضِعَت في أول أمرها على هجاء واحد، متحرك فساكن, محاكاة لأصوات الطبيعة، ثم فئمت -أي زيد فيها حرف أو أكثر في الصدر أو في القلب أو الطرف- فتصرف المتكلمون بها تصرفًا يختلف باختلاف البلاد، والقبائل، والبيئات، والأهوية.
فكان لكل زيادةٍ، أو حذفٍ، أو قلبٍ، أو إبدال، أو صيغة معناة، أو غاية، أو فكرة دون أختها، ثم جاء الاستعمال فأقرها مع الزمن على ما أوحته إليهم الطبيعة، أو ساقهم إليها الاستقراء، والتتبع الدقيق؛ وفي كل ذلك من الأسرار والغوامض الآخذة بالألباب، ما تجلت بعد ذلك تجليًّا بديعًا، استقرت على سُنَن وأصول وأحكام لن تتزعزع!.
ومن علماء العرب مَنْ مال إلى تقرير هذه الظاهرة اللغوية في نصوص واضحة، كابن جني الذي ينسب هذا الرأي إلى بعض العلماء، ثم يبدي إعجابه به وتقلبه له، فيقول: "وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات؛ كدوي الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء، وشحيح الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الطبي، ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن لك فيما بعد, وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل"(دراسات فی فقه اللغه، ص ١۴٨-١۴٩) ...ولا ريب أن في مراعاة اللين أو القوة، والخفة أو الشدة، والهمس أو الجهر، في التعبير عن هذه الطائفة من المعاني التي سبقت الإشارة إليها، دليلًا واضحًا على المحاكاة الإنسانية المقصودة لأصوات الظاهرات المعبر عنها. ونحن لا نحتاج إلّا كبير عناءٍ حتى نلمح العلاقة الطبيعية بين الألفاظ الموضوعة لمحاكاة الأصوات التي تصدر من الحيوانات، فالعصفور يزقزق، والحمام يهدل، والقمريّ يسجع، والهرة تموء، والكلب ينبح، والعجل يخور، والذئب يعوي ... إلخ. وأنت إذا قابلت مصادر هذه الأفعال: الزقزقة، والهديل، والسجع، والمواء، والنباح، والخوار، والعواء، بالأصواء التي تسمعها من الحيوانات أيقنت بأنها تقارب كثيرًا أصول تلك الأصوات. وقلْ مثل ذلك في هزيم الرعد، وحسيس النار، وخرير الماء، في حكاية أصوات الطبيعة، وفي شهيق الباكي، وتأوه المتوجع، وحشرجة المحتضر، ورنين المريض؛ وكرير المختنق، وتمتمة الحائر، وغمغمة الغامض، في حكاية الأصوات المعبرة عن الانفعالات الإنسانية المختلفة؛ وفي قدّ القميص، وقطّ القلم، وقطف الثمرة، وقطع الغصن، وقضم اليابس، وقطم العود، وفري الدم، وفرث البطن، وفرد الباب، وفرس العنق، وفرض الفضة، وفرض الخشبة، وفرع الرأس, في حكاية الأصوات الصادرة عن إحداث القطع.(همان، ص ١۵٢)
و در مورد الثنائیة المعجمیة:
من الثنائية التاريخية إلى الثنائية المعجمية:
د- ولكي يصح القول بالثنائية التاريخية في نشأة اللغة، كان ينبغي لهذه الثنائية أن تلازم وحدة المقطع المؤلف من صوتين بسيطين فقط....لذلك أطلق بعض الباحثين العصريين القول بأن: "الذي يتقرّى كلم العربية بإمعان نظر, يجد أن لمعظم موادها أصلًا يرجع إليه كثير من كلماته إن لم نقل كلها, خذ على ذلك مثلًا مادة "فل" وما يثلثها، تجد الجميع يدور حول معنى الشق والفتح, مثل: فلح، فلج، فلع، فلق، فلد، فلى, ومثل ذلك مادة "قط" وما يثلثها, تقول: قطَّ، قطع، قطر، قطف، قطن، وكلها بمعنى الانفصال.
وكل حرف زيد على الأصل الثنائي يجري على قانون التطور اللغوي تتويجًا، أو إقحامًا، أو تذييلًا، مع بقاء اللُّحمة المعنوية بين الثنائي والثلاثي، كما هي مستمرة بين الثلاثي والرباعي، وما فوقه من المزيدات, فكان من أسرار العربية، تبعًا لهذا، أننا كلما ردَّدنا موادها المزيدة إلى الصورة الثنائية التاريخية، وجدنا الحرف الذي ثَلَّثَ أصلها, ما يبرح ذا قيمة تعبيرية ذاتية توجه المعنى الأصلي العام توجيهًا خاصًّا، وتزيده تنوعًا وتقييدًا
فهذا ابن فارس في "المقاييس" يرد أصل "باب القاف والطاء وما يثلثهما" إلى معنى القطع، فيراه في "قطع" الذي يدل على صَرْمِ وإبانة شيء من شيء وفي "قطف" الذي يدل على أخذ ثمرة من شجرة، وفي "قطل" الذي يدل على قطع الشيء وفي "قطم" الذي يدل على قطع الشيء أيضًا]، فالعين والفاء واللام والميم جاءت أحرفًا زائدة على الأصل الثنائي "قط" فخصَّصَت" معنى القطع ونوَّعته بين الصرم والإبانة والأخذ، وردَّدته لأصواتها بين درجات الشدة والغلظة في إحداث القطع.(همان، ص ١۵٣-١۵۶)
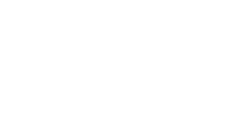
بدون نظر